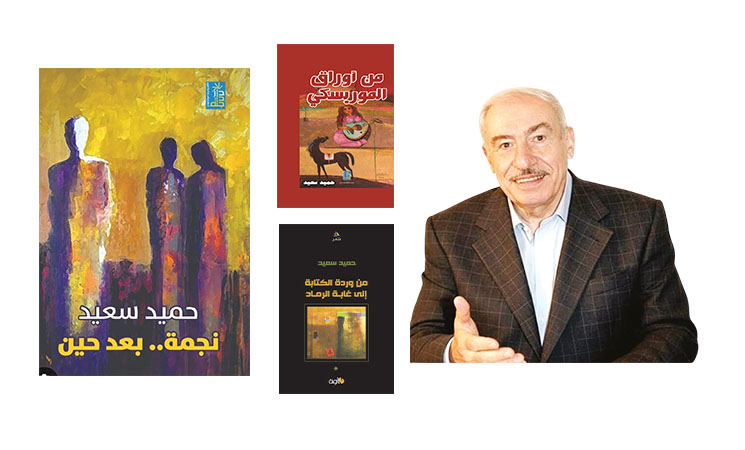« الإنسان مقياس كل شيء »
هذه العبارة الشهيرة التي لطالما قيلت واستعملت في الكثير من غير مواضعها هي ما سعى سقراط جاهدا إلى توضيح معناها لمحاوره تييتث مبينا ؛ من جهة أولى؛ أن الأشياء ليست إلا ما يظهر وأن الحركة – كما أقر ذلك بروتاغوراس من خلال النسق العام الذي صاغه هيراقليطس حول أصل و تكون العالم – هي في الوقت نفسه مبدأ وشرط وجود كل الأشياء. تحت ضوء هذا، يمكن القول بأنه لاشيء مطلق مادام أنه لا شيء يظل، كل شيء يصير، وكل شيء ينبثق من هذا التوالد السرمدي الذي يشكل القانون الأساسي للعالم .
ترى ما هو ذاك المقياس ؟ و الحال أن الأشياء لا تظل ثابتة على حال واحدة ومتعينة لأنها لا تظل كما هي؛ بل تصير في ما لا نهاية من الإمكانيات. و هذه التعددية غير الثابتة، باعتبار أنها مجرد انطباعات عن مظاهر الأشياء تمنحنا إياها حواسنا، هي الأخرى في حالة فرار ولا يمكن القبض عليها.
إن ما يراه، ما يسمعه، ما يتذوقه كل واحد منا هو ما يشكل المقياس الذي يقصده بروتاغوراس بعبارته التي يسعى سقراط الى توضيح معناها لتييتث. يستتبع ذلك أن ما يعرفه الإنسان هو فقط ما تقدمه له حواسه (نظر، شم، سمع …) نحن هنا أمام العلم والإحساس، والعلم والاحساس هنا كلمتان مترادفتان، ومن ثم يكون الإحساس وسيلتنا وسبيلنا الى تحصيل علم نكون به فقط مثل أي حيوان.. تلك كانت هي حجة أفلاطون .
لنقبل الأمر التالي على أنه أمر بديهي: هناك ثمة شيء نراه بعين ولا نراه بالعين الأخرى، سنكون علماء وجهلة في الآن نفسه ما دمنا نرى ولا نرى، أي نحس ولا نحس معا في ذات الوقت.
عبر هذا الافتراض الذي قبلناه نحن كما هو، سيعمل بروتاغوراس على تقويض كل أساس للأخلاق بشكل كلي. بالتالي سيضعنا أمام استحالة الجواب عن السؤال : ما العدالة من منظور الإحساس؟ ….إنها ما يظهر لكل واحد .. هذا ما سيكونه الجواب بكل تأكيد .
يستنتج أفلاطون مما سبق (على لسان سقراط دائما) أن السلوك الخاص وكذا الأمور العامة تنفلت من قبضة قانون ما يحدث. إن القيم والقوانين كما نفترضها ستكون عادلة في كل مكان طبقت فيه، فيصبح بعد ذلك الرأي والفعل هما الحق المدني والسياسي . غير أن سقراط لا يفوت الفرصة فيسأل وبصوت عال: ما الأفكار التي سيكوّنها الناس عموما حول أشياء أو أمور من هذا القبيل ؟ لعل الناس يدركون تماما بأنهم ليسوا جميعهم علماء؛ بل على العكس من ذلك أليسوا متيقنين من وجود أناس متعلمين بينهم الى جانب الكثير من الموجهين الرائعين؟ ألا يمتلكون فكرة حقيقية عن العلم والجهل ؟ عن الحقيقة والكذب؟ عن العدالة والجور؟ عن الحكمة والحمق؟ وإذا ما كانت هذه الاعتقادات موجودة، فكيف السبيل الى جعلها تتوافق والرأي الذي يقول بأن كل واحد هو حكم مستقل أمام كل شيء أو بالأحرى أمام كل الأشياء ؟
ينتقل أفلاطون في ما بعد ليبين أن نتيجة هذا التصور هي أننا أصبحنا ملزمين بالاختيار بين رجل واحد وكل النوع البشري، أي أن نؤمن مع بروتاغوراس بأن الإحساس يضم بين جنباته الضيقة العلم في كليته ، أو أننا سنجد أنفسنا ملزمين بأن نحتج بوعي بمعية كل الناس الآخرين لإقرار إمكانية معرفة أن ثمة أشياء هي أبعد ما تكون من الاحساس .
لتقويض رأي بروتاغوراس كان الوقوف عند مفهوم أن الحركة هي السلاح الأكثر ملاءمة بالنسبة لأفلاطون : الأشياء ليست ثابتة وإنما هي في صيرورة دائمة، وحركتها هي ما يحول بين الإحساس وإمكانية تحديد ماهية تلك الأشياء. والحال أنه مادامت الأشياء في حركة دائمة فلا مجال لمنحها تعريفا متعينا وقارا. لذلك تظل الصيغتان « لا شيء» و «لا كيفية « هما وحدهما ما يؤثث كل المعرفة التي يمنحنا إياها الإحساس .ثم يمضي أفلاطون في جداله لتأكيد كون الظواهر؛ و خاصة حين ننطلق من مبدأ أن الكل ليس إلا ما يبدو، كما أنه لا ظاهرة في العالم تابثة؛ هي الأخرى ماضية في حركة باستمرار، متجددة ومستبدلة بظواهر جديدة. ومنه فلا دعامة يستند عليها الإحساس، ولا شيء يعلمه لنا . وهكذا تكون الحصيلة هي ارتداد الإحساس ضد ذاته ويصبح القول الصادق هو: حيث يكون الإحساس لا يكون العلم ابدا .
يصبح المعنى المراد تشييده هنا واضحا عبر الانتقال إلى شرح فكرة أن النفس إذا ما أنهكت كل جهدها في نشاطات الحساسية، فستظل حبيسة الجهل من جراء عدم قدرة الحساسية نفسها على الوصول إلى ماهية الأشياء، ومن دون أن ننسى أن للنفس ملكات أخرى غير ملكة الإحساس.
إن النفس تمتلك القدرة على تأمل أحاسيسها، ومقارنة هذه الأحاسيس والتمييز بينها، كما تستطيع إضافة أحاسيس أخرى جديدة إلى الأحاسيس الأولى التي تنطلق منها. وبكلمة واحدة يمكن القول إن للنفس ملكتين هما ملكة الحكم وملكة التعقل. ليصبح السؤال أولا، هو معرفة ما إذا كانت النفس تبلغ بالملكتين وحدهما إلى معرفة الطبيعة الخاصة للأشياء وماهيتها اللامادية وغير المرئية و التي لا تغدو الظواهر إلا مؤشرات أو علامات عليها فقط؛ وثانيا، هو معرفة ما إذا كان الحكم و التعقل – مهما تكن الأشكال التي يتجسدان فيها – يؤسسان علما أو أنهما لا يؤسسان أي علم .
ينطلق سقراط مبدئيا من فكرة إصدار حكم حول ما لا نعرفه، وذلك ليسحب محاوره تييتث إلى التساؤل عما إذا كان هنالك نوعان من الأحكام: الحكم الصادق والذي سيكون هو العلم ، أي إصدار حكم حول ما نعرفه، ثم يكون الحكم الخاطئ هو أننا خارج العلم . وبهذا يرسم سقراط معالم الطريق التي ينبغي على طالب العلم هذا، أيتييتث، أن يبدأ فيها أول خطوة ..
لكن هل إصدار حكم خاطئ – يسأل سقراط في ما بعد – هو أن نحمل ما نعرف على أنه ما نعرف فعلا؟ والجواب هو النفي، لأن الذي يعرف شيئين اثنين لا يمكن أن يخلط بينهما. ومنه التساؤل هل الحكم ذاك هو أن نحمل ما لا نعرف على أنه ما نعرف ؟ و الجواب أيضا بالنفي ، لأننا لا نفكر البتة في ذاك الذي نجهله . ثم إن إصدار حكم خاطئ لا يعني أبدا أن نحمل ما نعرف على أنه ما لا نعرف ، وذلك لأنه وبكل بساطة لا وجود لأحد أبدا يأخذ ما هو معروف على أنه غير معروف .
ولكي يسير الجدال حول هذه النقطة قدما، سيفترض تييتث أننا لا نصدر الحكم على المعرفة التي لدينا أو التي ليست لدينا عن الأشياء، ولكن الحكم نصدره على الوجود وعلى اللاوجود. بالتالي فالحكم الخاطئ إنما يكمن في اللبس الذي ينجم عنه أننا نحمل الوجود على أنه هو اللاوجود، بمعنى اعتبار شيء موجود على أنه غير موجود. وهذه الأطروحة لا صدقية لها، فمهما كان الذي يصدر حكما فهو يصدر حكما على شيء يراه، أو يلمسه أو يسمع ، أي شيئا موجودا .. إن إصدار حكم سيفيد بكل تأكيد أن الأمر يتعلق بالحكم على الوجود؛ إذ من المستحيل الحكم على ما لا يوجد لا بالنسبة للحواس ولا بالنسبة للعقل، لكن أليس إصدار حكم خاطئ ؛يكرر تييتث؛ هو أن نأخذ عموما شيئا على أنه شيء آخر ؟ لا، إذ لو كان الحكم معناه سماع ثمة خطاب داخلي توجهه النفس لنفسها لتعرف ما تفكر فيه بخصوص هذا الشيء أو ذاك ؛ فمن ذا الذي قال في قرارة نفسه يوما بأن الإنسان ثور، أو أن القبيح قد يكون هو الجميل؟ لا أحد قال ذلك بكل تأكيد .
أعتقد أن المسألة واحدة من اثنتين: فإما أن الذي يحكم على شيء يعرف هذا الشيء ويعرف غيره، وبالتالي فهو لن يرتكب خطأ. وإما أنه يجهل الشيئين كليهما ولا يفكر فيهما كلية.
يتضح أنه من المستحيل معرفة ما هو الحكم الخاطئ حتى من خلال الفكرة التي يبسطها سقراط. فهو يرى بأن الخطأ يكمن في الخلط الذي يقع في أذهاننا من جراء التسرع في إصدار الحكم أو من جراء التساهل، أو من جراء التشويش الذي يطال الافكار التي لدينا عن الأشياء والحكم الذي نحمله عليها حينما تمثل أمامنا، بلا شك؛ لكن سينتج عن هذا اننا سنعرف بشكل افضل ما هو الحكم الخاطئ إذا ما عرفنا ما هي المعرفة.
تحضر ههنا ثلاث محاولات لشرح المقصود بالعلم انطلاقا من الحكم الصادق، وهي محاولات تم تقويضها الواحدة تلو الأخرى .. العلم لا يكمن في الحكم الصادق . فالحكم الصادق على الأشياء في أغلب الأحيان ليس إلا نتيجة للإقتناع الذي يعرف المتكلمون توليده في أذهان الشعب أو في أذهان القضاة، وذلك عندما يتناظرون حول الحقيقة: هذا الحكم لا ينتج علما في حقيقة الأمر، ما دام الذين يصدرونه لا يعرفون لماذا قالوا ذلك ولا لماذا هم مقتنعون بذلك الحكم. إن العلم لا يوجد أبدا في الحكم الصادق الذي نعقله، أي التعريف، لأننا لا نعلم إلا ما نستطيع تعريفه، وما لا نستطيع تعريفه لا نعلم عنه شيئا. نحن لا نستطيع تعريف هذا الذي من شأنه أن يكون هو الموضوع الأساسي للعلم، أي تلك العناصر التي تتكون منها الأشياء. فالبسيط ينفلت لكل تحديد ممكن ما عدا الإسم الذي نضفيه عليه…ثم يذهب سقراط الى حد القول بأننا حينما نضع تعريفا لما هو مركب، فإن تعريفنا يظل بعيدا جدا عن أن يكون علما . والحال أنه لا اختلاف حول كون المركب هو حصيلة عناصر/أجزاء مجتمعة. بالتالي فالشخص الذي لا يعرف ما تكون العناصر/الأجزاء، سيجهل ما هو المركب كذلك.
لكي يمكننا سقراط من تكوين صورة ذهنية شفافة وحقيقية عن تحليله السابق سيعتمد على آلية المقارنة، بحيث سيقارن بين الحروف والمقاطع التي تتألف منها الكلمات ومنها سيصل إلى القول بأن العلم ليس هو الحكم الصادق المصحوب بفكرة الاختلاف. فمن الواضح بكل تأكيد أننا لا نستطيع تمييز شيء عن شيء آخر إلا شريطة أن تكون لدينا معرفة بهما معا ؛ ومن دون ذلك كيف لنا أن نعرف أنهما شيئان مختلفان ؟ يستتبع ذلك أن معرفة الاختلافات تفترض توفر علم وليست هي التي ستشيد العلم .. ربما ليس هناك جواب لهذا السؤال. وهكذا يفترق المتحاورون كل الى سبيله من غير تثبيت أي جديد .
لعل الخلاصة التي تعاود الظهور من خلال هذا العرض هي أن محاورة « تييتث « لا تقود إلى أي نتيجة واضحة وإيجابية حول الإشكالية المثارة على طول صفحاتها بقدر ما تحيل على أشكال من الخطابات الممكنة. فأفلاطون لم يقم بأي شيء آخر غير إثبات الاقتراح التالي والسير به إلى الأمام : العلم لا يكمن في الإحساس ولا في الحكم؛ لكن إلى جانب أهمية هذه النتيجة المزدوجة، فالواضح أنه عند نهاية النقاش حول كل من الحكم والإحساس، يقدم أفلاطون العناصر التي تتألف منها الاشياء والكائنات البسيطة على أنها هي المبادئ الأولى للعلم . إنه يترك المجال مفتوحا أمام التعرف على فكره ويحيلنا بشكل غير مباشر على محاورات أخرى غير هذه حيث يعرض نظريته حول التذكر والتفكير، في حين يبقى الكتاب السادس من محاورة « الجمهورية « ثم محاورة « فيدون « هما المجال حيث ينبغي الذهاب للبحث عن تتمة الموضوع الذي تتطرق إليه محاورة « تييتث « ..
مناسبة هذا التعريج نحو فلسفة أفلاطون، وبالضبط التوقف مليا عند المحاورة المشار إليها أعلاه، هي لفت الانتباه إلى كم التضليل الذي يتم نشره على أوسع نطاق وفي شتى مجالات المعرفة باسم الاختصاص من لدن الذين يزعمون امتلاك المعارف دون أي تأصيل يؤشر على تملكها وليس امتلاكها فقط. هذا التملك للمعرفة هو وحده ما يحول دون انزلاق الفكر من خانة العلم الذي ينبغي توسله لتحليل الوضع الراهن نحو خانة الأيديولوجيا بما هي تزييف مقصود، يكون الهدف الأول والأخير منه هو بلترة الوعي الجمعي للأشخاص. ولقد قدمنا هنا ما نراه يكفي لرسم المسافة الفاصلة في ما بين الشيء والذات لنبين للقارئ كيف يكون السبيل إلى تلك البلترة غداة يصير المثقف هو عينه الآلية التي بها يتم طمس المشكلات الحقيقية واستبدالها بأخرى محفوظة صكوك شفراتها لا يطالها إلا الراسخون في ملكوت الكلمات المنفوخة على علاتها والتي بها يسحبون على الفكر صفة الجدية لإخفاء طابع التضليل فيه؛ فلننظر إذن بعين العقل في ما هو أصل التهافت نحو «الجندرة» في مقابل «العقل» و»الكوطا» في مقابل «الكفاءة» وما شابه ذلك على سبيل المثال وليس الحصر ..
وبين هذا وذاك، يجلو الظلم الحقيقي في ما سطره أفلاطون ذات يوم: الظلم؛ بل أشد الظلم هو أن نعلم الجهل …
في اليوم العالمي للفلسفة بلترة الوعي الجماعي..حرب جديدة

الكاتب : فاطمة حلمي
بتاريخ : 26/11/2021