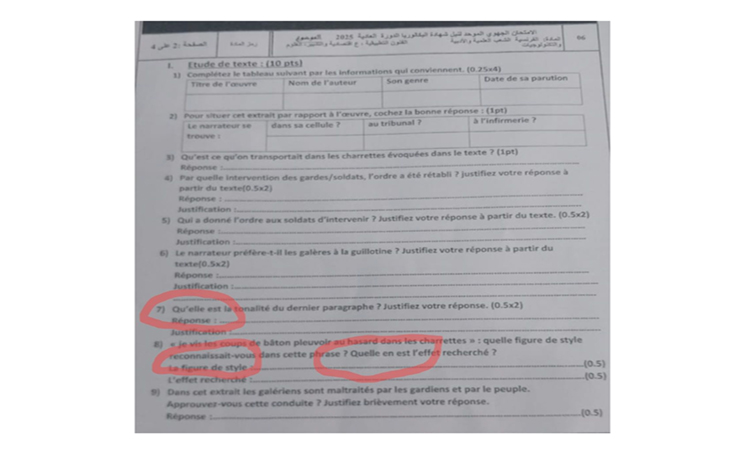في المشهد الأول من مسرحية « في انتظار غودو» للكاتب صمويل بيكيت، يصرخ فلاديمير في وجه صديقه إسترجون قائلا: «هذا هو الإنسان، يشكو من حذائه والعلة في قدمه»، وفي ديوان «جاؤوا لنقص في السماء» يفتتح الشاعر عبد الحميد جماهري نصوصه الشعرية بعنوان موغل في الإرباك: «في انتظار الحرب». بين الانتظارين معا، انتظار غودو وانتظار الحرب، تمتد أزمنة يستعصي الإمساكُ بها، وأحاسيسُ تقول كل الانفعالات الممكنة لتفضح مناحي العبث في كل شيء.
نص « في انتظار الحرب»، نص تنبعث منه رائحة الموت قوية وقاتلة، إلى حد يخبر فيه الجنديً الحربَ بأنه خجول أمامها، فهي لن تجد جثثا تليق بالقتل. إنها مأساة الجندي المليء بالطلقات غير أنه محروم من الحكي (ص 13 ). والشاعر في هذا الديوان يتولى مهمة الحديث عنه وباسمه.
يضعنا الديوان في أولى قصائده أمام مفارقات تراجيدية مضحكة – مبكية: [ رجل يحمل سيفا ولا يصل إلى أي حلم في بلاده ] ص 22 – [ شاب اكتشف طاعة الله في مكتب للضجر ] ص 22 – [ شابة هرَبت من عقدة أوديب / إلى حُضن رجل مسلح ] ص 22 – [ جزار يراسل الملائكة بلا جواب ] ص 22 – [ شاب يمسح مسدسه كمن يمسح دموعه ] . إنها صور شعرية تنبني على بلاغة المفارقة التي يجيد الشاعر رسم نقط التقاطع بين عناصر التوتر فيها.
هل نقول منذ البدء بأننا بصدد ديوان شعري يعري زيف الوجود وعبثية تواجد الإنسان فيه؟
في محاولة للاقتراب من دائرة الجواب الممكن عن هذا السؤال / اللغم، يبدو أن خطوط التماس بين ما قاله الشاعر وما تسمح به أسلاك التأويل الشائكة، تفصح عن مغامرة جمالية جريئة قام بها الشاعر للحفر إبداعيا في تاريخ الإنسانية.
من حيث الشكل، يضعنا الشاعر أمام خمس نوافذ شعرية اختار لها الترتيب الآتي: في انتظار الحرب – جاؤوا لنقص في السماء – اجلسي بقربي أيتها القسوة – سيرة عائلية لآدم – تعريفات الظل.
وتنفتح كلُّ نافذة من هذه النوافذ على مجموعة من النصوص المتفاوتة من حيث بنيتها الفنية، حيث تتجاور المقاطع الشعرية بدءا من المقطع / الشذرة إلى المقطع الممتد في بنية يتصادى فيها الشعر والنثر، عبر تأملات وترنيمات غنائية توفق الشاعر إلى حد كبير في عزف أناشيدها بنوتات لغوية مبهرة، كما أنها نصوص تتفاوت في إيحاءاتها ودلالاتها حسب موقعها من سلم ثنائية تشكل متكأ الديوان بأكمله: ثنائية الموت والحياة. وضمن هذه الثنائية تتداخل مقامات حوارية مع الذات حينا ومع الآخر المعلوم حينا آخر والمجهول أحيانا أخرى. ولكنه في كل الحالات حوار يتسم بتعدد في الأصوات المتماوجة بين ضمائر المتكلم والمخاطِب والمخاطَب، مع مساحات تتماهى فيها الضمائر فلا تواجهنا سوى صور شعرية محايدة على مستوى بنية الخطاب. إنها بكلمة أخرى خمسُ مناطقَ شعريةٍ متفاوتةٍ في اخضرارها وفي يبابها. وبالنظر إلى الخيط الدلالي الناظم بين هذه المناطق، يمكننا أن نختار، من بين موضوعات الديوان المتعددة، تيمتين اثنتين، هما تيمة الماء والنبوة، وتيمة الخلق والسقوط.
أولا– تيمة الماء والنبوة:
إن الشاعر في هذا الديوان يكتب سيرة الأنبياء بمداد الماء، فلولا الماء ما كان للأنبياء أن يربحوا رهان تميزهم النبوئي. يقدم الديوان الماء امتحانا لإثبات النبوة، فإبراهيم لم يكن ليكون نبيا لولا ماء زمزم، وحده هذا الماء من أنقذه من كساد النبوة، وأنقذ ابنته هاجر وشقيقها إسماعيل من ظمأ واد غير ذي زرع، وعيسى لو لم يمش على الماء لتاه في صحراء اللانبوة واللايقين، والماء هو من أسعف موسى ليكون كليم الله حينما انصاع البحر لعصاه، فانشق طواعية. والنبي يونس، ذو النون، لم يرتقِ سلم النبوة سوى عبر الرحلة الرهيبة والمظلمة في بطن الحوت، وحتى يوسف، النبي الجميل، ما كان له أن ينزل مصرا فيفجر نبوءته الناعمة إلى حد تُقطِّع فيه الجميلاتُ أصابعَهن، لولا أن حاور بقايا ماء في جب أراد إخوته أن يكون له ظمأ النهاية لولا أن انفرجت الطريق عن خطوات برأت الذئب من دم يوسف. والماء نفسه هو من جعل محمدا يعلن في الفيافي سِفر معجزته حينما استجاب السحاب ظلا وارفا وغيما ممطرا.
هكذا يختزل الديوان جدلية الماء والنبوة بقول الشاعر:
فما من نبي
خارج الصحراء
وما من نبوة
صارت نبوة
لم يمتحنها الماء. ص 38.
ثانيا: تيمة الخلق والسقوط:
الديوان توثيق إبداعي دقيق لسيرورة تشكل الوجود، وهو لذلك يستثمر بشكل لافت رموزا متعددة من المتخيل التراثي في أبعاده الدينية: آدم، إبراهيم، نوح – مريم المجدلية – هاجر – الخطيئة الأولى – الطوفان – الأنبياء…. إلخ.
والشاعر، في عملية التوثيق هذه، يغامر، هو نفسه، في تجريب امتهان معجزة الخلق، منطلقا في ذلك من مقايضة وجودية صارخة:
دليني على البطل
أدلك على تراجيدياه .. ( ص7 )
فيعمد شعريا إلى تشكيل أكوانِه ومجراتِه بتراتبية مدهشة، وينقلنا بسرد شعري مبهر إلى عَلياء عملية الخلق، حيث تتوالى مشاهد ومراحل تشكيل الكون بصيغته الشعرية: يبدأ بتكوين كوكب الألم، يليه كوكب اليأس، ثم كوكب الضجر.. ولكي ينهي معجزته هذه يرتق السديم المتناثر بين الكواكب بخيط من جراح.
ولإبراز صورة مشهدية أكثر وضوحا يلتقط الشاعر محنة سقوط آدم وهو يغادر الجنة في رحلة لم تتوقف إلى لحظتنا هذه، حيث يزخرف عملية السقوط لتظهر في حلة جارحة دلاليا، وكأنه بذلك يدعونا إلى التعاطف مع آدم في محنة سقوطه المدوية: أليس آدمُ أولَ ثوري يوقع شهادة الرفض ويدفع الثمن غاليا على ذلك؟.
من قصيدة إلى أخرى، يعمل الشاعر على التأصيل الإبداعي لبدايات محنة السقوط، فيكشف كيف أن آدم وشريكته فشلا في امتحان الثقة الإلهية عندما أكلا الثروة الممنوعة، وحتى عندما صرح آدمُ لشريكته بأنهما سينزلان إلى الأرض لينجبا أبناء يقتل الواحدُ منهم الآخرَ، فإنها وجدت نفسها في رحلة غريبة تهوي بها نحو مجاهل أرض لا أصول لها فيها، وهي أصلا، كما جاء في الديوان:
لم تكن مهيأة للأمومة
ولم تقرأ كتبا عن تربية الأبناء .. ( ص 64 )
وبين ثنايا الديوان تنبت أسئلة حائرة: كيف استوعب آدمُ وشريكتُه في رحلة السقوط الفجواتِ الفاصلةَ بين السماء والأرض؟ وما طبيعة الارتباك الذي أصابهما وهما يستعدان لإطلاق شرارة النسل الأولى.؟
من المؤكد أنهما وحدهما آدم وشريكته – التي لم يفصح الديوان عن اسمها لسبب لا يعلمه إلا الشاعر وحده – يعلمان وقع لحظة السقوط عليهما، ومقدار الحنين الذي لفهما حينما وجدا نفسيهما وحيدين في غابة الأرض الموحشة المحملة بعناصر اللاشيء واللازمن، غريبين بعد أن فقدا دفء الهناك، بعيدين عما ألفاه من خرير أنهار وزقزقة طيور. وبين الهنا والهناك نسجت البشرية قدرها النازف بآلام مخاض تحول إلى أبناء سلالات سكنوا هذا العالم بهوية واحدة ومشتركة: إنهم جميعا أبناء الخطيئة الأولى.
وكما أنه لا يمكن أن نسأل منتحرا عن نكهة الموت، فإن آدم نفسُه لم يعرف كيف صدر في حقه حكم الإبعاد لمجرد اقترافه غواية ًجميلةً، غواية َأصبحنا بفعلها – نحن البشر – ضحايا نؤدي ضريبة ذلك التجاوز المأساوي الذي يؤرخ لبداية نفي ساحق نحن فيه المنفى والمنفيون وحراسُ المنفى ذاته. نتأمل تلك المفارقة / المعجزة الأولى:
لما ألقى آدم
بنفسه من أعلى السماوات
إلى الأرض وظل حيا .. (ص 59)
وبذلك [ بدأت الإنسانية بمحاولة انتحار فاشلة. ] ص 59. أما نحن فنكتفي بضمان تجديد طقوس الحياة والموت على هذه الأرض التي تتفاوض فيها باستمرار المتناقضات: الأبيض والأسود، الخير والشر…!
إنها، بلغة الديوان وبرؤية الشاعر، معادلة غارقة في السوريالية الوجودية: أدم أكل التفاحة وغادر الجنة، ونحن نترجم خطيئة اللذة إلى طقس سيزيفي قاس: حملُ الصخرة ودحرجتُها إلى ما لا نهاية.!. نحن رهائن شهوة لسنا مسؤولين عنها، ولكننا ورثنا جيناتِها بالقوة والفعل معا.
غير أن تراجيديا السقوط لا تقف عند حد مغادرة آدم الجنة، إذ أن قصائد الديوان تنقل، وبلغة شعرية متدفقة، وقائع تكرار تلك التراجيديا باقتراف أول جريمة في تاريخ البشرية، حينما تجرأ قابيل وقتل هابيل: أخاه ومرآته الثانية. وبموت هابيل، وهو ما اعتبر في الديوان إبادة لربع البشرية، تتجلى تفاصيل نسخة ثانية من السقوط، ولكن هذه المرة في الاتجاه المعاكس لما فعله آدم وشريكته: سقوط من الأسفل إلى الأعلى.!
وفي سياق تفصيل الرؤية الشعرية لمحنة السقوط، وفي غفلة من كل العيون المتلصصة بتأويلاتها المغرضة، يفتتح الشاعرُ في الشارع الرابع من جغرافية الديوان مصحة نفسية، تلمع واجهتها بزجاج لغوي شفاف وأنيق جدا، ليعيد فيها تشريح رواية الخلق والكون وإعادة تركيب لسيرة آدم العائلية والوجودية، في ضوء معطيات علم النفس الحديث، وهي سيرة تضعنا أمام سؤال مستفز لكل ما نستر به عوراتنا اليوم: ترى ماذا كان آدم يرتدي قبل أن يتعرى؟.
يطلعنا تقرير الطبيب الشعري المختص في جراحة الاستعارات والانزياحات بأدوات الأنا والهو والأنا الأعلى، يطلعنا عن سر ما كان آدم نفسُه عالما به، إذ أنه – أي آدم – غضِب واندهش حينما اكتشف أن الطبيعة أضافت له أبناء آخرين لم يكن له علمٌ بهم. فيتساءل بين ثنايا الديوان: من أين جاء أذن كل أولئك الخونة والكلاب والذئاب التي تلمع في أفواههم أطقم بأسنان مذهبة / ومهذبة.؟ أليس ذلك عقابا أبديا له على ما اقترفته شهوته وهي تنجذب نحو التفاحة المعلومة.؟
وفي متاهة الوجود ضاع آدم وشريكته تتعقبهما الصحراء بحثا عن بئر حفرها الله في أعماقهما، وبذلك تتعمق مأساة الوجود الإنساني حين لا تجد سلالة آدم ما تقضمه غير طبيعة ميتة، وحتى الحنين لا يجد له أي أفق يسعده سوى ركام من الأحلام اليابسة، أما الحب فستطويه مسافات الاغتراب، ولن يجد أي أنشودة يعزفها سوى قصيدة صامتة. وحتى السماء التي اعتدنا في تمثلاتنا الرائجة، أن نعتبرها موطن الملائكة ومستقرها، يفاجئنا الشاعر بأن:
السماء التي يريد الذهاب إليها
لم تمتلئ
بعد / بالملائكة.. ( ص10)
إنها محنة السقوط والسكون الأبديين.. أليس الموتُ تجديدا يوميا لهذه المحنة وتطلعا لتلك المنطقة الظليلة والموعودة بأنهارها وخمرتها وحورياتها الحسان، حيث نسج آدمُ رقصةَ شهوته الأولى، قبل أن تطوحَ بها غوايةُ الفاكهة المحرمة إلى أقاصي صحراء ارتوت أول ما ارتوت بدم الجريمة الأولى في رحلة البشرية المضنية.؟
في ديوان «جاؤوا لنقص في السماء»، وبالنظر إلى مكونات حقله المعجمي، نلاحظ تقابلا بين مرآتين اثنتين، إحداهما تعكس محاولاتٍ حثيثةً لإنعاش الحياة بمزيد من احتمالات الأمل والفرح والتفاؤل، بينما الأخرى تعكس متواليات من التمزق والخراب والموت. ولأن المرآتين تعكس كل واحدة منهما الأخرى، فإن صور الحياة والموت تتداخل وتمتد إلى ما لا نهاية، فتتوالد المعاني عبر كثافة لغوية تجعل قصائد الديوان محملة بدلالات تفصح عن مأساة الشاعر نفسه، فهو حين يحاول أن يجد له هوية يعرف عبرها وبها أناه، فإنه لا يكتشف سوى كونه (سليل ما لا يراه وخليط الظل بالظل) ص 56. إنها مأساة الطفل الذي يستدعيه الشاعر ليكون صنوا لوجوده فيكتشف أنه ولد بلا يوم وأن حياته تأويل غير موفق. (81). وفي الضفة المقابلة يكتشف أيضا أن الأطفال حينما يريدون اللعب فإنهم يمارسون لعبة غريبة: يجربون كيف يولدون من جديد شيوخا.!
مرارة هذا الاكتشاف تجعله يتنازل ويدخل غمار مقايضة جديدة وهو يخاطب أباه:
أعد لي بعضا من طفولتي
وأعدك
يا أبي أنني لن أحلم من جديد ( ص 66 )
كم هو مكلف هذا الوعد الذي سيتطلب من الطفل التخلي عن أحلامه وإعادة ترتيب اليقين تحت ظل شجرة.! ، وبذلك نكتشف أن ديوان حال الشاعر ليس سوى معادل إبداعي لأحوال الكون كله.
بهذه الكيمياء الوجدانية الفائضة يختزل الشاعر فلسفته ورؤيته الخاصة لذاته وللكون، تلك الرؤية التي ترى أن الحياة ليست سوى لعبة ٍ علينا أن نمارسها بكل الذكاء الماكر، متظاهرين فيها بأننا غير أحياء (ص 53)، إنها المفارقة المدهشة: ألا نكون أحياء لكي نثبت أننا فعلا أحياء!
إن الشاعر في ديوان «جاؤوا لنقص في السماء» يقدم مرثية موجعة وجارحة لهوية يسيل منها نزيف الانتماء ليخبرنا بأننا:
كنا أغرب أمة
أخرَجَتْ للناس
أفكارا جامدة
في مناخ صحراوي. (ص 73)
إنه نزيف هوية يحفها «برد حضاري» قاتل من كل الجهات. لنقل إنها الهوية / الهاوية.
في الصفحات الأخيرة من الديوان، وبالضبط في الصفحة 80، نكتشف أن النقص الذي أوهمنا عنوانُ الديوان نفسُه بأنه نقص في السماء، ما هو في الحقيقة إلا تجلَ مرآوي لنقص في الأرض، وبعبارة أدق: نقص في الواقع.. لينفتح تساؤل رهيب أمامنا: أيهما إذن السبب في نقص الآخر: السماء أم الأرض.؟ إنه السؤال الذي تستدعي الإجابة عنه عدة مكثفة من التأويل الذي لا يمكن فك شفراته سوى بفعل قراءات متعددة لمسار الرحلة النازفة التي رسم لنا الديوان معالمها منذ بدء الخليقة حتى لحظتنا هاته، وهو بذلك يضع الإنسانية، عبر مسارها الطويل، في محك التجربة الدامية لمحنة السقوط الدائم والمتكرر، سقوط تتوارثه الأجيال قدرا تتجدد سيرته باستمرار بين نتوءات التاريخ البشري ومنعرجاته.