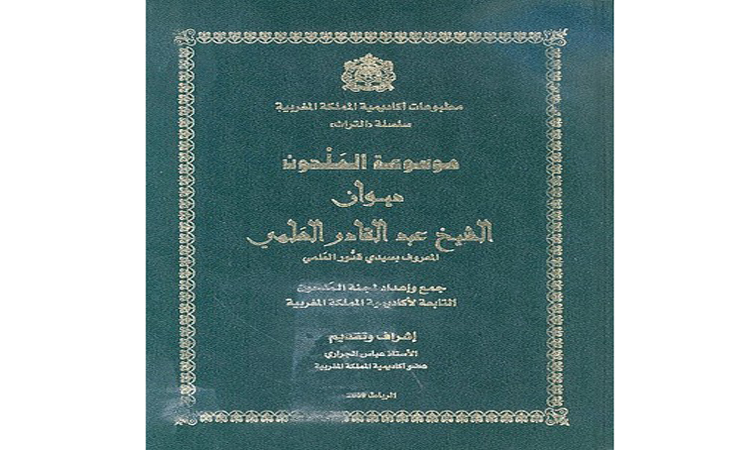إن القراء اليوم المولعين بـ «تراث فن الملحون» الأصيل يريدون أن يتعرفوا – بدورهم – على بعض الجوانب الخفية من حياة فرسان الزجل بالمغرب، وهي جوانب جد هامة ومفيدة، ظلت مخزونة بين ثانيا الصدور، ومحفوظة في الذاكرة الشعبية زمانا غير يسير، وعلى تعاقب الأجيال المغربية ؛ وقد رصدنا من أجل توثيقها مجموعة من اللقاءات والمهرجانات الفنية أزيد من خمسة عقود خلت.
سئل الشيح عبد القادر العلمي يوما حين زارَ مدينة مراكش، وهو بداخل ضريح الشيخ عبد الغزيز التباع – رضي الله عنه – : بم تذكرك هذه الزيارة؟ فقال : فوق هذه التربة الطاهرة، وبين جنباتها تضوع أريج مولى مكناس ، – ويقصد الشيخ بن عيسى حين زار مراكش- ، ومن هذه المدينة – ويعني مراكش – أخذ المفتاح واستراح : مفتاح الجزوليين، وبتعاليمهم استراحت نفسه وسما قدره ، وطارت شهرته في الآفاق؛ وعن الشيخ التباع ، أخذ الإذن بقراءة كتاب : دلائل الخيرات .
وذكر أهل الملحون في مجالسهم، أن العلمي كان يعجبه الاستماع إلى ما كان يحكى عن المتصوفة من حكايات التي تروَى عن السادة المشايخ – رضوان الله عليهم – وبخاصة منهم المجاذيب، والبهاليل ؛ وسمع يوما راويا يروي خبرا طريفا عن الشيخ الهادي بن عيسى – رضي الله عنه – يتعلق بالنساء، فأصغى إليه إلى النهاية ، ثم قال للراوي : نحن على رأي شيخنا في اعتزال النساء؛ وسئل يوما عن حال المتقين، فقال – رضي الله عنه – ما نصه : (حالهم ميزان واختبار لمن أراد الاقتداء)، وهو يشير إلى ما كان يروى عن الشيخ أبي الرواين – رضي الله عنه – حين سأل شيخه بن عيسى عن التقوى؛ فقال الشيخ ما نصه: من ادعى التقوى فاختبروه بصفات المحبة. وزنوا أخلاقه بميزان سمو النفس، وتقويمها، فإن وجدتم الرجل تميل كفة ميزانه إلى الهَوى، فاعلموا أن تقواه افتراء وكذب على الناس، وعلى الله، وإن وجدتم كفته تميل إلى محاسبة النفس الأمارة بالسوء، والإصغاء إلى نفسه اللوامة، فاعلموا أن تقواه صدق، وامتحان من ربه، وأنه يسلك طريق المجاهدة فترقبوا وصوله وحظوظه « إن شاء الله تعالى». وإذا تصورنا معالم شخصية سيدي قدور العلمي على النحو الذي تحكي عنه أخباره ومروياته على تعاقب الأجيال المغربية ، فإننا نجد معظم ما يقدم في هذه الأخبار، والمرويات تسمه ظروف اجتماعية، وفنية، وثقافية، ودينية، جاءت امتدادا لمشاهد حضارية، صوفية، عاشتها مكناس في مطلع القرن العاشر الهجري، واستمرت إلى زمن العلمي، حيث تناسلت هذه الأخبار، وهذه المرويات وإلى اليوم، بل إلى ما شاء الله تعالى ؛
* – ازدهار أدب الملحون، وفن الموسيقى في عهد العَلمي: لقد كان فن الملحون في عهد العلمي جزءا من الفنون الشعبية الأصيلة، التي تناسلت عن فنون أخرى، ومن أهمها فنا: الموشح، والزجل؛ فالموشح حين ظهر في الغرب الإسلامي، كان – يومه – ثورة على الشعر العربي المقفى ، ثم ظهر – بعد حين – فن الزجل، فكان – هو الآخر – ثورة على الموشح – وعلى توالي السنين، استقام فيها عود الزجل، ونضجت موضوعاته، (مبنى ومعنى) فطارت شهرته في الآفاق هنا، وهناك، إلى أن ثار عليه فن الملحون بمرماته وبحوره الجديدة على يد مجموعة من فرسان الزجل بالمغرب، ومنهم الشاعران العظيمان ، الشيخ عبد العزيز المغراوي ، والمبدع الأصيل، الشيخ المصمودي، وكلاهما قد ثارا على المرمات الزجلية القديمة، فأبدعا إبداعات من الروائع الخالدة ؛ ونلاحظ من خلال الإنتاج الأدبي الضخم الذي وصلنا ابتداء من هذه الفترة التاريخية الأولى لظهور فن الملحون، إلى زمن العلمي أحد أقطاب هذا الفن، أن هناك نهضة موسيقية، قد ساهمت في الازدهار الرائع الذي عرفته القصيدة الزجلية – على طول مُددها – في طبوعها، وميازينها؛ وفي هذا الصدد يذكر «المقري» نقلا عن «الفشتالي» أن أزيد من ثلاثمائة موشح نظمها المنصور السَّعدي، أو قيلت فيه ؛ ونقل بعضها المقري في «نفح الطيب» ؛ وما عصر العلمي، وازدهار فن الملحون فيه، إلا صورة من الماضي البعيد، تحكي عن الأشواط الفنية التي قطعتها الأجيال، تلو الأجيال ومع ذلك، فلكل جيل خصائصه، وإبداعاته الفنية، والثقافية، ومميزاته التي تميز عهده عن سابقه من العهود ؛
ففي قصائد العَلمي نفحة خاصة من نفحات الجمال الصوفي، إنه مخزون ثري عرفته المدينة الإسماعيلية خلال عصور خلت، ابتداء من ظهور الطريقة العيساوية التي أخذت أصولها عن الطريقة الشاذلية والطريقة الجزولية، وفي عهد العلمي عرف فن الملحون – أيضا – تطورا ، وتجددا في المبنى، أي في الأشكال، وفــي المعنى ، أي في الأجناس الأدبية ؛
وعليه، فالعلمي – بهذا التطور والتجدد – قد وضع أصلا من أصول التربية الصوفية، واعتبره نقاد شعره نبراسا مضيئا، يقدم لجمهوره العريض، ما ينشد به سعادتهم في الدين والدنيا، والاقتداء الحسن لأتباعه ومريديه؛ وهذا الأصل الذي أرشد إليه، هو : أن الخير كله في محبة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وفي آله وصحابته، وإذا حصلت هذه المحبة الصادقة، كانت – لا محالة – مفتاحا لأبواب شتى من أبواب الصفاء، والنقاء، وسعادة النفوس وكبح جماحها ؛ لنتأمل هذه الصورة الشعرية من نظم العَلمي، وهي تحلق بنا في سماء روحانية محبة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تضوع بأخلاقه وشمائله، وتقدم ألوانا من سيرته النبوية العطرة، ومشاهد حية من مكارم أخلاق الرسل :
اخْلـــــقْ آدَمْ فِيكْ ولْسَانْ اسمَاعـيلْ ** وبْها يُـــوسف اعْطاكْ ومحبّة دنيالْ
وازْهَدْ عيسَى الصَّابرْ وخلتْ لخلِيلْ ** واشجاعتْ نُوحْ هَيها لِكْ ذُو الجَلالْ
وشدتْ مُوسَى لـَكـْلِيمْ ورَضَا يَسرائيلْ*
وفصاحتْ لـُوطْ وصوتْ دَاوَدْ فالتمثَالْ
عَصمتْ يُونسْ وطاعْتْ أيُّوبْ الفضِيلْ ****
وزهدْ يوسَع وعلمْ شِئتْ على لـَكـْمَالْ
*****
على ضوء ما وقفنا عليه من قصائد تعنى عناية خاصة بالمجال الصوفي فإن السادة المتصوفة يهتمون من خلالها بتقويم النفس الإنسانية وإصلاحها ودعوتها إلى الأخلاق الحسنة، فعن طريق هذا التقويم يتم صلاح أمرها كما يقول الشاعر أحمد شوقي: – رحمه الله – في البيتين التاليين:
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه * فقوم النفس بالأخلاق تستقم
والنفس من خيرها في خير عافية * والنفس من شرها في مرتع وخِم
ومن طرائف أهل الملحون ذكروا أن الشيخ الهادي بن عيسى التفت يوما إلى مريده أبي الرواين فقال له : يا أبا الرواين من أحبك صادقا في محبته فقربه منك وخصه بمؤانستك واعلم أن المحبة لا تباع ولا تشترى.
قال الله تعالى – وهو يخاطب رسوله الكريم – «لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم».
ويقول الحكماء في مأثوراتهم: العقول حين تختلف تبني صرح العلم وتزيد من فيض معالم أسرارها، والقلوب حين لا تأتلف وتتوحَّد محبتها. فإنها تهدم كل شيء فيغدو ما بنته العقول خرابا موحشا.
يتبع …