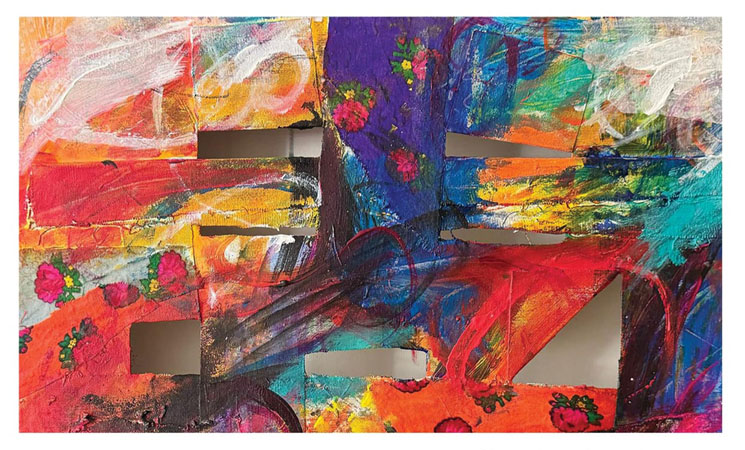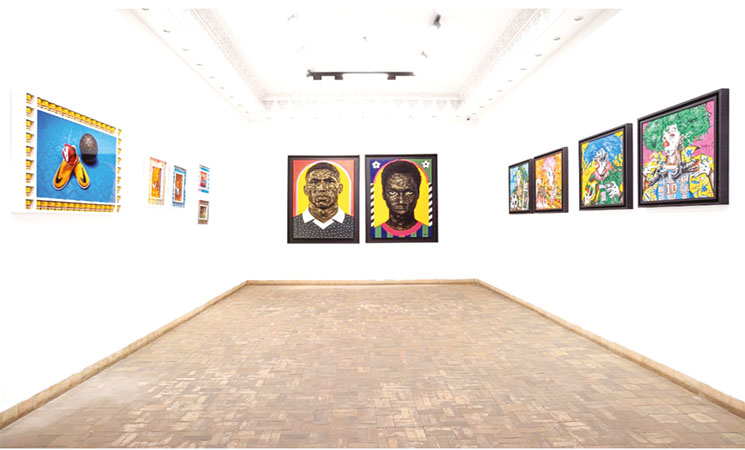«حمّى البحر المتوسّط» غير محصور في نوعٍ سينمائيّ واحدٍ، إذْ يجمع في حكاياته وحالات ناسه ويومياتهم بين النفسيّ والاجتماعي والتشويقي، مع نثرات ساخرة وأنماطٍ سوداوية، من دون تناسي السياسيّ والفلسطينيّ، وإنْ يحضران بسلاسة وبساطةٍ جميلتين، بعيداً عن تسلّط وإخضاع لنصٍّ سينمائيّ، من المؤكّد أنْ الفيلم المنبثق منه يستحقّ أكثر من مُشاهدة، وأكثر من مناقشة، وأكثر من متعةٍ بمعنى السينما وحيويتها

التفاصيل الصغيرة في يوميات أفرادٍ عاديين، مُضافة إلى مسائل حياتية ومآزق تمتدّ من النفسيّ إلى الاجتماعيّ، من دون التغاضي عن الوطنيّ، هوية وانتماءً وعيشاً في بلدٍ محتلٍّ؛ تلك التفاصيل تُشكِّل البنية الدرامية لـ»حمّى البحر المتوسّط» (2022)، ثاني روائيّ طويل للفلسطينية مها حاج (مواليد الناصرة، 1970)، الفائز بجائزة أفضل سيناريو في «نظرة ما»، في الدورة الـ 75 (17 ـ 28 أيار 2022) لمهرجان «كانّ» السينمائي، والمسابقة مُطلقة فيلمها الروائي الأول، «أمور شخصية»، في الدورة الـ 69 (11 ـ 22 أيار 2016) للمهرجان نفسه.
تفاصيل صغيرة تبدو، لوهلةٍ، عادية للغاية، في حياة فلسطينيين يُقيمون في حيفا، ويجهدون يومياً في تأمين عيشٍ، يُفترض به أنْ يكون طبيعياً، ضمن شروطٍ اجتماعية ـ اقتصادية ـ انفعالية، «يخضع» لها كثيرون. الاحتلال الإسرائيليّ غير غائبٍ، وإنْ يكن حضوره غير ظاهرٍ، فالحفر في الوجدان الفلسطيني، كما في حياةٍ وتحدّيات ومصاعبٍ وأهوالٍ وانكساراتٍ وخيباتٍ، تتعلّق كلّها بالفرد الفلسطيني، وبيومياته الخانقة والمخنوقة؛ هذا الحفر أساسيٌّ، من دون إغفال مأزق الاحتلال الإسرائيلي، وتأثيراته، المباشرة وغير المباشرة، على هذه اليوميات، وعلى نفوسٍ وتفكيرٍ ومشاعر تخصّ الفلسطيني في عيشه، كما في مواجهاته التي تبدو أنّها غير متناهية.
روائيٌّ، غير قادرٍ على تأليف أول رواية له؛ ومتورّطٌ في أعمال جُرميّة، يعجز عن الخلاص من ديونٍ تُثقل عليه، قبل أنْ ينكشف، نفسياً وانفعالياً، أمام ذاته والكاميرا (مدير التصوير: أنطوان إيبرل)، كانكشاف الروائيّ المؤجَّل أيضاً؛ يُشكّلان معاً عَصَباً درامياً أساسياً، يلتقط المسار الأساسيّ، ويصنع من التفاصيل حكاية بيئة وأناسٍ وعلاقاتٍ، ومصائر أحلامٍ (أتكون معطّلة؟) ورغباتٍ (أتكون معطوبة؟)، ونهاية خيباتٍ وقلاقل. والتفاصيل ـ إذْ تبدو مشتركاً بين كثيرين، في مدنٍ ومجتمعات عدّة ـ تمتلك، في جانبها الفلسطيني، عمقاً مختلفاً في مواكبتها أحوال أولئك الأفراد القلائل، الذين تختارهم مها حاج من واقعٍ وحياة، من دون أنْ يكون الاختيار تعميماً وشمولية، رغم كون التفاصيل الكثيرة مشتركاً عاماً.
أيّ أنّ فردية كلّ شخصية، مختارة في «حمّى البحر المتوسّط»، تبقى الأبرز في نصٍّ (سيناريو مها حاج) يُصبح مرآة شفّافة، تفضح المخبّأ في ذاتٍ وروح وجسدٍ، من دون إغفال أنّ المُعاش متشابهٌ، غالباً، وهذا لن يجعل الفيلم «ناطقاً» باسم جماعة أو بيئة. الفردية، بكلّ ما تملكه من حساسية ووعي وأسلوب عيش وعلاقات وتأمّلات ورغبات وإحباطات، تروي، في «حمّى البحر المتوسّط»، سِيَر أناسٍ يُحبَطون ويتألّمون وينكسرون بصمتٍ، وبعضهم يوحي بنقيض هذا، عبر إظهار سلاسة له في العيش، وحماسة وحيوية في التعاطي مع جيرانٍ وأهل الجيران، بينما المخبّأ في الذات والروح أقوى من أنْ تُخفيه السلاسة والحماسة والحيوية.
وليد (عامر حليحل) يريد تأليف أول رواية له، لكنّه عاجزٌ عن ذلك. يهتمّ بشؤون المنزل، فزوجته علا (عنات حديد) ممرضة في مشفى، وولديه نور (سينتيا سليم) وشمس (سمير إلياس) يذهبان إلى المدرسة، فيخلو المنزل له، لكنّه منمهكٌ في الترتيب والتنظيف وإعداد الطعام. ملامحه غير مُريحة، ففيه شيءٌ من حزنٍ، يقترب من كآبةٍ، تظهر لاحقاً. تتبدّل حياته كلّها، مع استئجار جلال (أشرف فرح) الشقّة المجاورة لشقّته، والإقامة فيها رفقة زوجته رنين (شادن قنبورة) وأولادٍ لهما مع كلبين. صدامٌ صامتٌ أولاً، فوليد ينزعج من الصوت العالي لأغنياتٍ يطرب لها جلال صباحاً، مع كأسٍ من العرق؛ ومباشر لاحقاً، عندما ينبح الكلبان، الأخطل وجوزفين/الخنسا، عليه (لاختياره هذه الأسماء أسباب، يرويها جلال بطرافةٍ لن تخلو من إشاراتٍ تدلّ على ثقافةٍ ووعي له، وقدرة على إسقاطات رمزية على وقائع مختلفة)، في الحديقة المقابلة للمبنى الذي يسكن فيه الطرفان.
هذه مقدّمات. اللاحق أهمّ، وتطوّر العلاقة من النفور والتوتّر والابتعاد، إلى صداقةٍ تتوطّد يوماً تلو آخر، تُنتج مساراً يجمعهما معاً، ويضعهما أمام لحظاتٍ مصيرية، فلكلّ واحدٍ منهما مخاطر عيشٍ وهموم حياة، وتحطيم الفاصل بينهما لن يكون صعباً، لأنّ أحدهما يحتاج إلى الآخر، وإنْ من دون أنْ يعي ذلك مباشرة (في بدايات الصداقة على الأقلّ)، أو لأنّ أحدهما يرى نفسه، أو شيئاً من نفسه، في الآخر، وإنْ من دون انتباهٍ علنيّ في البداية. كأنّ لاوعياً يُحرِّك الواحد منهما تجاه الآخر، وهذا حاصلٌ، مع تفتيت أقنعةٍ تحجب وليد عن جلال، وتُقرِّب أحدهما من الآخر.
لشمس ارتباكات في مدرسته، ينتبه إليها وليد لاحقاً، تتمثّل في خشيته من متابعة حصّة الجغرافيا، لأنّ للمُدرِّسة نهجاً ومفردات في التعليم، لن تُرضي وليد أبداً، لشدّة التزامه بحقٍّ وتاريخ ووطن، ضد احتلالٍ، يتعامل جلال معه بخفّة و»واقعية» (يتأكّد التزامه أكثر، مع «توبيخ» نور لتلفّظها مفردات وكلمات وتعابير باللغة العبرية، وهذا مُصوَّر بطريقة توحي بعفوية أبٍّ، حريصٍ على انتمائه الفلسطيني، وعلى أولوية أنْ يبقى ولداه عربيّين). إحدى جماليات السيناريو كامنةٌ في الابتعاد المطلق عن كلّ خطابية نضالية، وفي تأكيد فداحة العنف والتزوير الإسرائيليين في حقائق فلسطين وشعبها. عجز وليد عن كتابة أول رواية له، متأتٍ من أثقال حياتية، لن يغيب الاحتلال الإسرائيلي عنها. لامبالاة جلال، أو تعاطيه بخفّة مع «واقع» كهذا، إضافة سلبية لنفور وليد منه، قبل أنْ يعثر فيه على ما سيظنّ أنّه خلاصٌ له من كآبة تتآكله، ومن خيباتٍ تُوَتّره وتُقلقه، ومن شعورٍ دائمٍ بانسداد أفق، في عالمٍ يتمزّق وينحلّ وينهار.
الظهور المُكرَّر لعائلة وليد يُقابله اختفاء شبه تام لعائلة جلال، رغم ظهور زوجته وأولاده وكلبيه أكثر من مرة. اختفاء الجميع لاحقاً، في لحظات كثيرة، غير مفهومٍ وغير مُبرَّر درامياً، خاصة أنّ لجلال مكانة تتساوى ومكانة وليد في النصّ السينمائي ومسار حبكته وصوره البصرية واشتغالاته المتنوّعة، فنياً وحياتياً وإنسانياً (ألا يُفترض بهذا أنْ يكون دافعاً إلى إظهار عائلة جلال، كإظهار عائلة وليد؟). ما يطلبه وليد من جلال، بعد وقتٍ مديدٍ على توطّد العلاقة بينهما، ورفض جلال تحقيق ما يرغب وليد فيه، سيؤدّي بالروائي العاجز عن كتابة أول رواية له إلى مزيدٍ من التقوقع والقهر والصمت، ما يدفع بعلا إلى طلب المساعدة من جلال، الذي تبدأ ملامح مآزقه بالانكشاف في الفترة نفسها. الأفعال الجُرمية التي يرتكبها جلال تُعرّضه لمضايقات ومخاطر إضافية، بينما رنين لن تظهر كفاية، والتهديد بالموت يُعيد رنين إلى الواجهة، لبعض الوقت. التهديدُ بالتقل لقطةٌ جميلة، تُضاف إلى جمالية لقطات أخرى، إذْ يعتمد التهديد بالقتل على «ورقة نعوة» تقول بوفاة جلال، وبأوقات دفنه وجنازته وتقبّل التعازي، تُلصق على مدخل البناية. وهذا أحد أجمل التهديدات بالقتل، وأكثرها سخرية وترهيباً.
نباح الكلبين على وليد يجب أنْ يؤدّي إلى نباح عليه لحظة دخوله الأول إلى منزل جلال، قبل تثبيت الوفاق بين الجميع، وهذا غير حاصلٍ، فالكلبان يختفيان من المشهد (إنّهما في منزل متواضع، ولا بُدّ من ظهورهما عند زيارة وليد لجلال)، حتّى في تلك الأمسية الاحتفالية، التي تُقام في منزل جلال احتفاء بانتقاله والعائلة إليه، وفي تلك الأمسية، يكتشف وليد أنّ هناك أمراً ما غير مُريح يحصل مع جلال، إثر زيارة «مُريبة» لشابين «مُريبين».
والدا وليد، عزيز (يوسف أبو وردة) وهناء (نهاي بشارة)، يعيشان في منزلهما كأي عجوزين. لكنّ براعة جلال في التخاطب مع الآخرين تُقرّبه من هناء، وتدفع عزيز إلى قبول خدماته بإصلاح العفن في المنزل. شخصية جلال تُشبه شخصيات عدّة متورّطة في أعمال جُرمية، في عصابات عادية أو مافيات تحترف الجرائم المنظَّمة، فإذا بجانبها الإيجابيّ يبرز في لحظاتٍ غير متوقّعة، وفي حالات ومواقف غير مُنتظرة، تماماً كعدم توقّع وانتظار أنْ يكون لكلّ متورّط في أعمال جُرمية جانبٌ إيجابي. لكنّ خيباته وقلقه وانكساراته تتغلّب عليه، وعلاقة العشق التي تربطه بعشيقة تؤكّد أنّ خطْباً ما يلمّ به، ويدفعه إلى سوداوية قاسية، ستنتهي في فعلٍ، يسعى وليد إليه من دون جدوى.
«كتير هدوء هون، لا؟»، يسأل من سيُصبح جاراً جديداً لوليد، فيُجيبه الأخير، بنبرة قاتمة وغاضبة وساخرة: «آه، هدوء مقابر». هذا وحده كافٍ لتنقيبٍ إضافي في دلالات هدوء المقابر، بعد معاينة حسّية، يُزيدها متعةً، رغم مصائب وتشنّجات وقهرٍ وآلامٍ، توليفٌ (فيرونيك لانج) يوازن بين هوامش الحبكة ومتنها، بتبسيطٍ يُساهم في كشف المعمَّق والغائص في أحوالٍ وكآبات. أمّا بثّ قولٍ لأنطون تشيخوف في النهاية (يا له من طقسٍ رائع اليوم، لا أستيطع أنْ أختار بين شرب الشاي أو الانتحار شنقاً)، فإضافة مُحبَّبة إلى نصٍّ مُشبع بالألم والتقهقر والخسائر والخراب.
«حمّى البحر المتوسّط» غير محصور في نوعٍ سينمائيّ واحدٍ، إذْ يجمع في حكاياته وحالات ناسه ويومياتهم بين النفسيّ والاجتماعي والتشويقي، مع نثرات ساخرة وأنماطٍ سوداوية، من دون تناسي السياسيّ والفلسطينيّ، وإنْ يحضران بسلاسة وبساطةٍ جميلتين، بعيداً عن تسلّط وإخضاع لنصٍّ سينمائيّ، من المؤكّد أنْ الفيلم المنبثق منه يستحقّ أكثر من مُشاهدة، وأكثر من مناقشة، وأكثر من متعةٍ بمعنى السينما وحيويتها.