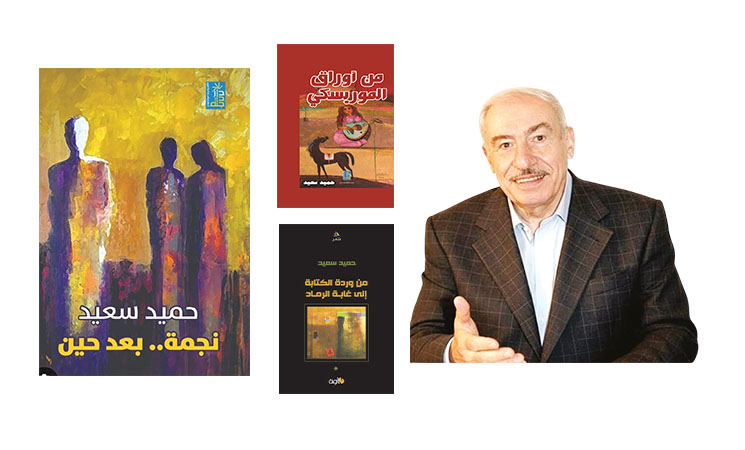تطرح المحنة الموريسكية التي اكتوى بنارها مسلمو الأندلس خلال القرنين 15 و16 الميلاديين، أسئلة مركزية حول أبعادها الإنسانية العميقة التي أرخت بظلالها الممتدة على مجمل التمثلات المتبادلة بين مجتمعي الضفتين الشمالية والجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط. وإذا كان المؤرخون قد دأبوا على ربط تداعيات هذه المحنة بظروف إسبانيا عقب اندلاع موجة «حروب الاسترداد» التي وضع أسسها الملكين الكاثوليكيين فرنادو وإيسابيلا، فإن الأمر تجاوز هذا السقف إلى ما هو أبعد من تداعيات الأحداث السياسية المرتبطة بسقوط غرناطة في يد الإسبان سنة 1492م باعتبارها آخر القلاع الإسلامية بالأندلس. لقد أفرزت «وصية إيسابيلا» الشهيرة، موجة عارمة من الحقد تجاه «الآخر الأندلسي»، المسلم واليهودي، في شكل حرب شاملة استهدفت اقتلاع الإنسان، ومسح الوجود، وجرف مجموع القيم والعقائد والتراث الرمزي الخاص بالفئات التي كانت مستهدفة بجرائم محاكم التفتيش وبالحروب المقدسة للكنيسة ضد مرحلة التعايش والتساكن للقرون الثمانية للعصر الوسيط.
وإذا كانت إسبانيا «حروب الاسترداد» قد استطاعت اجتثاث المكون المسلم من فضاء بيئته المحلية، فإن التراث الثقافي ظل قائما ومنتصبا ضد آلة النسيان، خاصة عندما غادر موطنه الأصلي واستقر بالضفة المغربية بشكل خاص. ونتيجة لذلك، أضحى المكون الموريسكي عنصرا مركزيا داخل تلاوين الهوية الحضارية والثقافية المغربية، منذ تلك المرحلة وإلى يومنا هذا. ويجد هذا الحضور تعبيرات شتى عن بقائه وعن تجذره، سواء على مستوى نظم التفكير الجماعية، أم على مستوى أنماط العيش المشترك، أم على مستوى تركيبة التمثلات الجماعية التي يحملها مغاربة الزمن الراهن تجاه هويتهم الثقافية الواحدة/المركبة. وقد اتخذ هذا المسعى نزعة تأصيلية بانفتاح الدرس الجامعي على الانشغال بالبحث في قضايا التراث الموريسكي المحلي في مجمل مستوياته المشار إليها أعلاه، إلى جانب الانفتاح الأدبي والفني والجمالي على قيمه الإنسانية المتميزة، مما أثمر حضورا وتوهجا متواصلا لتعبيراته الفنية في مجالات عدة، مثل الموسيقى والعمارة والشعر وعموم الكتابات السردية…
في سياق هذا الانفتاح المتواصل على ذاتنا الأندلسية، يندرج صدور النص الروائي «ترجمان الملك» لمؤلفه الأستاذ مراد زروق، سنة 2021، في ما مجموعه 193 من الصفحات ذات الحجم المتوسط. ويمكن القول، إن هذا العمل يقدم اختزالا سرديا راقيا، مُتخيلا ومُستلهما من حقائق التاريخ والانتماء، لشخصية موريسكية استطاعت تحصين ذاتها في مواجهة الإعصار الذي اجتاح بلاد الأندلس منذ القرن 15م. يذكرنا هذا النص بعمل روائي للأستاذ حسن أوريد صدر تحت عنوان «الموريسكي»، بنفس تخييلي رحب وبأفق إنساني واسع، استطاع أن يعيد أنسنة قضايا المحنة الموريسكية في أبعادها الأخلاقية المتداخلة.
ينهض نص «ترجمان الملك» على نفس سردي مثير، احتفظ بطابع خطي يغطي عقود القرن 16م من خلال سيرة السارد ألونسو الغرناطي، المواطن الموريسكي الذي جعله المؤلف ينتقل إلى زماننا الراهن، من خلال مخطوط يحدد معالم سيرة السارد ومحدداتها التي هيمنت على الأجواء العامة لبنية السرد. يقدم المؤلف -في مدخل الرواية- توطئة على لسان شخصيات معاصرة تكلفت بالتعريف بشخصية السارد، عندما قالت: «سأعطيكم فكرة مقتضبة عن المخطوط… لم ينتظر مروان جواب الرجلين، قلب الأوراق بين أصابعه الدربة، تتبع السطور بأنامله يتلمس المداد لعله يبوح بأسرار الناسخ.. ثم قرأ بصوت مسموع كأن جليسيه يفهمان العربية: «باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من ألونسو دي كاستيو إلى سلالة من ابتلي بالفتن من أهل هذه الديار. هذا بلاغ لمن يعتبر. اللهم قيد لرسالتي هذه من ينشرها بين الناس…». اعتدل مروان في جلسته وصرخ: «إنهم الموريسكيون !!! «. راح مروان يقلب الصفحات بين يديه وهو يكاد لا يصدق ما يراه في تلك العشية الحارقة منتصف شهر يوليو سنة 1997. لقد فعلها ألونسو دي كاستيو وترك لنا سيرته كاملة.. بعضها مكتوب بالعربية وبعضها الآخر بالرومانية، أو الإسبانية القديمة وإن كان الحرف عربيا…» (ص.8).
ينطلق النص من وقائع مدينة غرناطة سنة 1537، ليتتبع تفاصيل حياة ألونسو، في كتابة سردية تجمع بين المسار العام لمحنة الموريسكيين من جهة، وبين تقلبات الحياة الخاصة لألونسو في ظل تداعيات هذه المحنة من جهة ثانية. وداخل هذا المسار العام، تنهض تراجيديا المحنة الموريسكية بأبعادها المأساوية العميقة التي تكلف ألونسو بنقل تفاصيلها في إطار كتابة وصفية مباشرة، كثيفة، وسلسة، تعيد تركيب الأحداث والوقائع بشكل تجعل من ألونسو ذاتا وموضوعا للكتابة وللسرد. في هذا الإطار، تنبعث مدينة غرناطة، كحضن نوستالجي لألونسو. ومن معاناتها، تنبثق مأساة العائلة والمعارف والأهل وعموم مسلمي الأندلس.
كانت الأزمة شاملة، وكانت الجريمة قاسية، فكان الوصف مباشرا، ربما اختاره المؤلف مراد زروق لتبليغ أقسى درجات الأسى جراء المأساة الموريسكية. ينساب السرد سلسا، بلغة شفيفة تقترب من سقف الكتابة التاريخية بابتعادها عن لغة الإطناب وعن مهاوي المحسنات البلاغية أو الاستعارات الموازية التي تخلق حكايا على هامش الحكايا المركزية داخل متن السرد. يقول المؤلف -على سبيل المثال- في سياق حديثه عن ثورة البيازين التي انخرط فيها مسلمو إسبانيا بشكل واسع: «نعم يا بني. كانت قد مرت سبعة أعوام على تسليم غرناطة لفرناندو وإيسابيل. رغم كل العهود والمواثيق، كان الناس يحسون أنهم غير آمنين في بيوتهم وأموالهم وأعراضهم. كان جدي يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لخرجنا كلنا مع بثينة وسعيد إلى العدوة الأخرى. كان أهل غرناطة يعلمون ما يُدبر لهم في واضحة النهار. حتى إرناندو دي تلابيرا كبير الأساقفة أشفق على المسلمين لما عمد ثيسنيروس في أسبوع واحد، ولم يكتف بذلك. لقد أراد أن يغير نظام المواريث حتى يرث غير المسلم المسلم وهو لا يخاف أن يمنع. لم يكن جدك ممن يدعو إلى القتال،… لكن قضية المواريث والمرأة التي أهدرت كرامتها، جعلته يثور. كان النصارى يتأهبون للاحتفال بأعياد الميلاد في السنة السابعة بعد سقوط غرناطة، وكان أهل المدينة يشعرون بالحيف والغبن، ولاسيما بعد أن أُخذت المرأة إلى السجن هي وأولادها على مرأى ومسمع من الجميع. حينها رأيت جدك يحشد الناس ويستنهض الهمم في البيازين. لم يترك زقاقا إلا بحث فيه عن العون، طرق أبواب البيوت والدكاكين واحدا واحدا…» (ص ص.22-23).
وعلى هذا المنوال، ينساب السرد، ليعيد تركيب الوقائع في إطار مثير لشغف القارئ، ببعد يلهم طابع الفضول والإثارة. لم يقف الأمر عند ثورة البيازين، ولكن المؤلف اختار توسيع الرؤى من خلال تخصيص مساحات أرحب للحديث عن حرب البشرات التي هزت الأندلس سنة 1568، بقيادة إرناندو دي بالور، والذي أصبح اسمه بعد اندلاع الثورة مولاي محمد بن أمية، ثم بقيادة ابن عيوني الذي غمرت ثورته أحواز مدينة غرناطة.
يقدم نص رواية «ترجمان الملك» وصفا دقيقا لجرائم إسبانيا المؤطرة من قبل جبروت الكنيسة وبطش ملوكها المتعاقبين. وفي كل المحطات، ظل السارد حريصا على التوثيق لعمق المأساة ولفداحة المحنة. يقول في إحدى مروياته: «آه رجال الديوان المقدس بلباسهم الأسود ووجوههم الشاحبة الواجمة ونظراتهم الفاحصة التي يخيل لمن يقف أمامهم أنها تشق الجلود والقلوب شقا لتنقب في دواخلها عما يخالف معتقد النصارى كما يرونه هم. لم يسلم منهم مسلم ولا يهودي ولا نصراني مخالف. كانوا يذيقون من تقوده الأقدار إليهم كل صنوف العذاب، ويتفننون في التقتيل، وجعلوا لجرائمهم آلات للتمزيق والتقطيع، حتى أن من حكم عليه من المبتلين يتمنى أن تضرب عنقه ويرتاح ولا يجد إلى ذلك سبيلا. أما الكتب والمجلدات، فقد أحرقوا منها الآلاف في ساحات غرناطة…» (ص.57).
حرص المؤلف على نقل أوجه المعاناة من مختلف المراكز التي كان يتنقل عبرها ألونسو، مثل غرناطة وبلنسية وإشبيلية وقادس ومدريد. وتجاوز ذلك بأن جعل السارد نفسه شاهدا على مآسي الموريسكيين، وفاعلا أساسيا لبذل كل ما أمكن بذله للتخفيف من معاناة إخوانه في الدين وفي الانتماء. لقد كان ألونسو، من خلال عمله كمترجم للملك ولكبار عسكرييه وقساوسته وموظفيه، يسعى إلى تجنيب مسلمي الأندلس الكوارث، عبر تمكينهم من «عهد أمان» صادر عن الملك. فاستغل وظيفته كترجمان لدفع المسؤولين الإسبان نحو العدول عن التنكيل بالمسلمين، وكان خياره في ذلك، «اختلاق» ترجمات مفترضة لنصوص عربية تبرز معالم سمو الديانتين الإسلامية والمسيحية، وتقاربهما واحترامهما لبعضهما البعض. وعلى الرغم من نبل هذا الموقف، ظل ألونسو يعاني من نظرة الخيانة التي كان يحملها إخوانه المسلمين تجاهه، بما فيهم زوجته التي ظلت تحلم بالرحيل إلى المغرب حيث الملاذ الآمن.
كانت مهمة الترجمان شاقة، وخلفت جرحا بليغا في نفسية السارد. ولعل هذا ما عبر عنه بدقة وهو يتحدث عن طبيعة مهامه إلى جانب الملك الإسباني، عندما قال: «الترجمان هو الذي يؤجر ريشته أو صوته لغيره من الناس، فيترجم ما خطته أيديهم وما نطقوا به، أعجبه رأيهم ومنطقهم أم لم يعجبه» (ص.121). وفي ما يشبه التنفيس عن المآسي، حرص السارد على استحضار معالم الخسارة الكبرى التي تكبدتها إسبانيا نفسها، من جراء تنكيلها بجزء من مقومات وجودها الحضاري المتمثل في العنصر المسلم. يقول بهذا الخصوص: «ما المانع لو حُفظت العهود التي أُبرمت مع فرناندو قبل تسعين سنة ونيف؟ لو أقرنا القوم على ما كنا عليه لكنا أنفع لهم في شؤون التجارة والسياسة والحرب، لكن نفوسهم تأنف مساكنة من ليس على ملتهم، فكان لهم ما أرادوا وتلحف قومي في لحاف التقية…» (ص.137).
وبذلك، أصبحت «التقية» وسيلة ألونسو وإخوانه للإفلات من آلة الاستئصال الرهيبة. ومع ذلك، وعلى الرغم من الوضع الاعتباري الراقي الذي أضحى لألونسو داخل القصر الإسباني وداخل الكنيسة، ظلت نفسه مرتبطة بالحلم الموريسكي الذي انكسر على حد رماح «حروب الاسترداد» وعلى بطش محاكم التفتيش. وبين هذا وذاك، ظل الأمل قائما في الإفلات من الجحيم وفي الالتحاق بالمغرب كطوق نجاة اعترضت طريقه أشواك الكراهية المزمنة. وقد عبر السارد عن هذا الأفق بشكل بليغ، عندما قال مناجيا عدوة المغرب: «ما أقربك يا أيها المغرب وما أبعدك!!» (ص.132).
ظلت هذه الصرخة متجذرة في عمق الوعي الموريسكي، بعد أن وجدت لنفسها عناصر الامتداد التاريخي الذي جعل منها عنصرا متميزا داخل نسق الانتماء الحضاري المشترك بين عدوة الأندلس من جهة، وبين عدوة المغرب من جهة ثانية.