يقول بن عطاء الله السكندري: «مطالع الأنوار هي القلوب والأسرار» وأنا أتساءل إذا ما كان يمكن للقلب أن يكون فعلا بابا منه يتم النفاذ إلى سراديب المتن الروائي اليوم، وقد حصل أن البشرية قطعت شوطا طويلا ومهما جدا في مسار شغفها التاريخي بالبحث عن قبس من نور يقوض العتمة فينكشف به سر الكينونة البشرية في وجود حركي سيولي؟ثم كيف يكون ممكنا انقشاع الأنوار لمن كينونته مسيجة قسرا؟ أيعقل أن يُمَنِّي نفسه ببلوغ الحقيقة وكشف الأستار من كان نصيبه من مطالع الأنوار هو العتمة/المنفى؟
الخارج والداخل صنو جدلية النور والعتمة لا سبيل للنظر فيها إلا بالرجوع لقلب سليم، كما يقول ابن عطاء الله السكندري، وتلك أول مواجهة نصادفها مع الروائي المغربي عبد الحميد البجوقي.
هذا الرجوع ليس دعوة مني، وأنا أحيل على حكمة السكندري، للعود الى نقطة البدء حيث كان مسعى التفكير الأنطولوجي ما قبل الفيلسوف إيمانويل كانط هو تأصيل النظرة الذاتية وتوسيع أفق استخدامها ولا حتى إلى اللحظة الكانطية نفسها الموسومة برتق الفراغات المعرفية؛ إذ لم تقطع مع الخيوط التي تسدلها الحواس رغم الإصرار على العقل بما هو عين النور الذي يهدي إلى سبل الانعتاق من عبودية تلك الحواس.وبخصوص هذه المسألة لم يفت ابن عطاء الله أن يبين أن القلب واحد من أهم مطالع الكشف، لكن متى؟
عن هذا السؤال يرد السكندري مبينا أن الأمر ممكن، فقط وفقط إذا سلم القلب من النظر إلى أمور الناس بما هي الحال فيهم، ولم يبصر بأنها محض أحوال تؤول إليها منازلهم كلما صيروا أمورهم في غير أيديهم.
لكن لماذا استحضار هذه الحكمة؟ لأن الكتابة عن الكينونة في المنفى وعن المنفى، كشف وجداني لا يمتلك القدرة على ترتيب حروفها إلا الذين ذاقوا طعم النفي، ومرارة البعد قسرا؛ الذين سدت أعينهم، لكن صارت لهم قلوب راصدة تبصر أبعد مما تراه العين فتستشرف القادم بالنبش في الخفي..ولعلنا نرى ذلك في واحدة من روايات عبد الحميد البجوقي والتي كتبها تحت عنوان «المشي على الريح»: (مشكلتك الصغيرة، كما تدعي عزيزي، مرتبطة بهذه السياسات وهذه الأنظمة وهذه الحكومات وهذه الشعوب المستلبة في إرادتها…/ص:11)
في ثنايا «المشي على الريح» ثمة بنيات نصية، تلك التي تجسد واقعا محددا كما تعيشه الشخصيات وبنيات دلالية هي تلك التي تتجسد عبر الرؤى التي تقدمها الشخصيات من خلال الأحداث والأصوات. هذين البعدين، النصي والدلالي، ينسجهما الكاتب من صلب التقابل بين البنيات الاجتماعية -الثقافيةوالبنيات الأدبية -الفكرية وما يحفها من المظاهر الأيديولوجية. هنا لابد من التوقف عند ابعاد تلك الثنائية للإشارة إلى أنها تحيل على وعي خاص لدى الكاتب بأهمية مقولة ال»أين» لأن النقطة المفصلية فيه هي المكان، أي «المنفى» بالتحديد. غير أن المنفى في كتابات عبد الحميد؛ نذكر هنا «عيون المنفى»، «حكايات المنفى» و»المشي على الريح» الذي يحمل عنوانا فرعيا هو «موت في المنفى»، لا يشير إلى مكان بعينه ومن حيث إحالته على واقعين متقابلين، داخل المنفى وخارج المنفى؛ بل يشير إلى العالم لا كبنية مادية فقط ولكن كفضاء يستمد معناه الحقيقي من كونه فضاء معمورا من طرف الأنا والآخرين. كل مكان لست فيه كما تريد هو منفى ومنه فجميع الأمكنة كذلك، وحيث يفتقد الناس الحرية تمتد ثمة جغرافيا للمنفى داخل وعي الأنا؛ لذلك لم يستطع عبد الحميد البجوقي الكاتب الإبقاء على حيز صغير يمكن لأي من الشخصيات أن يربي فيه بعض الأمل، وذاك ما نقرأه في الصفحة 119من رواية «المشي على الريح» :
(… يبدو رشيد تائها وهو يمشي في شارع فوينكارال، يتوقف بين الفينة والأخرى …. يفكر في صديقه مامادو الذي يقبع في سجن صوطو ديل ريال…. يتذكر كامي التي ترقد في قسم العناية المركزة.. تصارع الموت…. في ابنها الذي لم تتمكن من اللقاء به، في معنى الوطن ومعنى الايمان ومعنى الحدود ومعنى الانتماء).
بهذه المقتطفات ندلل على طبيعة العلاقة التي يؤسسها الكاتب بين البنية النصية والبنية الدلالية.
في رواية «المشي على الريح» حيث يُفسح المجال لبسط العديد من المواجهات غير المرئية وغير المتوقعة إلى جانب المواجهة الأولى التي أقامها الكاتب بين العتمة والنور. إنها مواجهات بالمعنى الذي يَحيد بها عن التقابلات كما يشيدها الفلاسفة بين المفاهيم، لأنها لا تحمل في طياتها التضاد التام الذي يشكل أساس التقابل في الفكر الفلسفي؛ فنحن لسنا بإزاء بنية نصية وما يساوقها من بنية دلالية مباشِرة من جهة التلقي وواحدة أخرى على هامش النص من جهة التأويل.هذا ما يلفت انتباهنا إلى وجود مواجهة أخرى بين الراوي والكاتب، الأول متحمس بشغف نقل الأحداث بلسان أصحابها، والثاني مثقل بعاهات واختلالات طفولة متشظية بين الحلم والتمني والعوز. يريد الأول الاسترسال في سرد مجريات الحوار ليمنحنا فرصة النظر عن كثب في ما هو الواقع الفعلي للناس، إلا أن الثاني سرعان ما يزيغ عما هو موضوع الحوار ويغوص في ماضيه البعيد ليمنحنا هو الآخر فرصة لسبر غور النفس البشرية بوضع اليد على ما يمكن أن نعتبره أسبابا وراء تكدر هذه النفس لتصير نفوسا سواء تلك التي يجردها الخطاب الديني أو تلك التي يكشفها خطاب التحليل النفسي.
يستفز فهمي ما قرأته في بعض المقالات والأوراق النقدية التي كُتِبَت حول رواية «المشي على الريح» حينما يصرون على اعتبار الكاتب عبد الحميد البجوقي تاريخانيا من منطلق ما يمكن الوقوف عليه من لحظات الاتصال التي حدثت في ما بين المغرب واسبانيا مثلا، إنهم يلتفتون إلى ما ورد في الرواية من الإشارات. لكن هل يكفي هذا القليل بل حتى الكثير من الإشارات من قبيل أسماء الأشخاص والأمكنة وبعض التحديدات الزمنية لإصدار حكم حول المنجز أو حول الكاتب مصنفين إياه في خانة التاريخانية؟ والحال أن مثل تلك التحديدات والمعلومات وبالضبط كما وردت في المتن الروائي قيد الحديث؛ ليست أكثر من كونها معطيات لازمة وبالضرورة لتحديد سياقات الأحداث مجسدة الفعل البشري الذي يسعى الكاتب إلى تبيينه بما هو موضوع مفكر فيه أو بجعله موضوعا قابلا لذلك.. أليست الرواية نافذة على الواقع؟ ثم أليست الكتابة الروائية أفضل وسيلة لوصف الواقع الاجتماعي بهدف تصويبه، تغييره أو تقويضه؟إذ لطالما اعتبر المفكرون والنقاد روايات بلزاك وإميل زولا تصويرا محكما لدقائق الأمور في واقع معيش وبكل تجلياته وما تخلفه في نفسية الناس في واحد من أزمنة فرنسا الأشد سوادا وقهرا.
وردا على ذلك الحكم؛ لم يكن الحكي في «المشي على الريح» بنظري، بناء متبعا من لدن السارد لمسار تكون بنية اجتماعية، اقتصادية أو سياسية فيما بين تاريخ الأفراد من خلال الشخصيات الواردة في الرواية، وبين تاريخ المعرفة أو الفكر في شموليته ثم الربط بين الاثنين لجعل القارئ يستكشف عبر وعي الكاتب طبيعة وخصوصية ذلك المسار. إن كتابة تروم مثل هذا الربط وبالدقة اللازمة التي يقتضيها التوثيق والدراسات التحقيبية لا تكون فعلا تاريخانية ما لم ينكشف فيها التساوق السببي بين السلطوي وحياة الناس؛ إذ لا يكفي الحديث في الرواية عن أن ثمة جهة من الجهات التي تمتلك سلطة إصدار القرار وسلط تنفيذه من قبيل إصدار قرار الحبس أو قرار الترحيل أو النفي أو غيرها من القرارات ذات الصلة، واعتبار ذلك مؤشرات فعلية وحقيقية على طبيعة السلطة السياسية السائدة في البلد المعني، ثم الارتكاز عليها لتوسيع هامش التأويل وقراءتها كعلامات على حضور البعد التاريخاني عند عبد الحميد البجوقي. فهذه المعطيات غير قابلة لهكذا تأويل إلا من باب أن يكون للقارئ الناقد امتهان للنزعة التأويلية بات مضللا له قبل أي شخص آخر؛ ففي المتن الروائي لا يجب أن تحيد القراءة الناقدة عن فكرة أن المكان وكذلك الزمان قالبين ضروريين ليكون هنالك سرد في الأساس. أما الوثيقة التاريخية والتي لم تمنح هذه التسمية إلا لأهميتها في مجال التوثيق التاريخي، فإنها لا تخلو من تحديدات عن المكان والزمان علما بأن الأحداث الرئيس موضوع المتن الروائي لا تتصل بأي حدث يمكن أن نصفه بالتاريخي، فهو لا يكون تاريخيا إلا إذا ارتبط بما هو معرفي، وهو الأمر الذي شكل واحدا من الموضوعات الإشكالية التي اهتمت بها الفلسفة في مبحث الإبيستمولوجيا، خصوصا ما ارتبط بمصداقية المعارف التي تقدمها الوثيقة وما أثارته من تساؤلات كالتي تتعلق بإشكالية الموضوعية، إشكالية المنهج وإشكالية العلمية.
نعرج مع عبد الحميد البجوقي جهة مواجهة أخرى، يخطها بنفَس كاتب ثوري يلتفت إلى الماضي ليستشرف الغد لا ليوثقه، وهذي حجة أخرى لتقويض فكرة اعتبار البجوقي تاريخانيا. إنها المواجهة بين «الناس» في شخص كل واحد من شخوص الرواية و»الانسان»كما يتصوره كل مناضل يساري من ذات منفى. تينك هي المواجهة الجريئة بين الحقيقة والمسخ. ترى كيف السبيل لحياكة مثل هذه المواجهة العصية على التخييل؟ ذاك ما نجده بين دفتي الرواية.
في بداية الصفحة (103) من صفحات «المشي على الريح» يطلق السارد العنان للسان حال رشيد ليصور عبره المشهد الأكثر قتامة؛ فنقرأ: (لم يستطع رشيد إخفاء ملامح التأثر، كان يبدو مصعوقا وهو يستمع لسعيد، كانت نظراته تائهة، يحرك رجليه بعصبية ولا يفتأ يلاحق بنظراته مامادو الذي لا يكف عن النحيب، أخبره صديقه التطواني بأن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى السلام بالعاصمة مدريد، وألح عليه في حضور الاجتماع الذي دعت إليه منظمات مدنية ونقابية لتدارس سبل الرد على تنامي الاعتداءات العنصرية وشروع بعض المجموعات في تنفيذ اعتداءات على المهاجرين الأفارقة والموروس، والتي وصلت هذه المرة إلى حدود القتل).
تبين هذه الفقرة خصوصية مائزة في جميع كتابات هذا الروائي وبشكل واضح في «المشي على الريح» حيث سيزاوج السرد بسلاسة بين فيض من المشاعر الداخلية التي يزخر بها مخيال الروائي والتي مادتها الخام هي وعيه الشقي وبين الأحداث الخارجية التي سببتها أكانت ذاتية أم موضوعية؛ هذه المواجهة بين الداخل والخارج عادة ما نلاحظها في الكتابة الروائية بطريقة عكسية، فالحدث الخارجي هو الذي يولد الاحاسيس الداخلية، لكن لماذا تشد هذه السببية عن منطقها التاريخي عند عبد الحميد البجوقي؟
منذ البدء، في هذه الرواية طبعا، يظهر الكاتب وقد أخذ على عاتقه وعدا بتكسير أسوار الأوطان جميعها ليصير هنا وهنالك نظام بديل للمكان والزمان السائدين قبلا؛ نظام تنتفي معه أقسى المواجهات الممكن تمثلها على الاطلاق، تلك التي تولدها علاقات القوة؛ إذ تعلن هذا المكان «وطنا» وتعلن ذاك «منفى» فتُنتِج تبعا لهذا الأمر قيما تحَكُّمية بها يتم توجيه العلاقات الاجتماعية فيما بين الأفراد.فكيف يكون البجوقي كاتبا تاريخانيا وهو الذي كلما تكلم عن المنفى، كما في جميع رواياته التي سبق أن أشرنا إليها، نراه يقطع حبل الحوار الخارجي بسيف حوار آخر داخلي ؟ إنه يضعنا مرة أخرى أمام مواجهة تربك حسابات الذاكرة لدى المتلقي، لكن ليس بالشكل الذي ينفلت معه ترابط الأحداث وسيرورتها المتراصة بقوة وجودها، ولكن بشكل يفتح أفقا جديدا لتمثل ما أسميته نظاما بديلا للمكان والزمان في «المشي على الريح». فالكاتب يسعى إلى النبش في طبيعة الكينونة البشرية ليشيد معاني وتمثلات مغايرة لما ألفناه في المعطى سلفا مُنمْذجاً بموجب القيم الاجتماعية التي تغديها السلط التحكمية؛ إنه بكل تلك التفاصيل التي تتجذر تارة في واقعه العيني وتارة يجود بها خياله قد جعل من المنفى تيمة مركزية لجل إبداعاته أفقا يتسع لفهم جديد للمكان في الكتابة الروائية. لقد بين أن المكان ليس تأشيرة للركوب على متن التاريخانية ولا السياسوية الفجة لادعاء النضال السياسي والفاعلية الثقافية أو لاستجداء صكوكهما. إن فتح باب الترحيل والابعاد القسري من وإلى أمكنة كل منها ينتمي لثقافة خاصة ومغايرة للأخرى، كما ورد في «المشي على الريح» ليَشُد الانتباه إلى أهمية مبدأ القصدية في الفكر؛ ومنه لزوم الحذر مما قد يسقطنا فيه الامتثال الأعمى لبعض قواعد أو مستلزمات النقد الأدبي إذ تغدو صوتا من عَلٍ يزِلُّ به اليراع جهة تنميطٍ يُسكِت صوت الابداع، فنكون كمن يبحث في ما يقرأه عن أشياء وأبعاد سطرها في ذهنه هذا المنظور النقدي أو ذاك.
خلافا لما قيل أو يمكن أن يقال عما يقصده بالفعل عبد الحميد البجوقي وهو يحدثنا عن المنفى؛ فإنني رأيته في «المشي على الريح» على الخصوص،يكتب وصيته وليس رواية، ليخبرنا عما يمكن أن يكونه المنفى الحقيقي بالنسبة لكل واحد منا؛ فقد يكون المنفى ثمة حزن لم يستطع الشخص الافلات منه (انتبه رشيد إلى أن سحنة صديقه النيجيري مامادو تعلوها مسحة دفينة من الحزن، رغم مرحه وقهقهاته التي تسمع في كل الشوارع…/الصفحة 7).. قد يكون المنفى قانونا تم تعديله بجرة قلم شرعنته تصفيقات برلمانيين فيقذف بك خارج أسوار الإنسانية (حكومة اليمين أدخلت تعديلا على قانون الأجانب وعلى القانون المنظم له… التعديل العنصري… الاعتداءات الهمجية على المهاجرين المغاربة والأفارقة في قرية الايخيدو بألميريا لم تؤثر سلبا على الحزب…/الصفحة 9).. قد يكون المنفى هو ذاك الحلم العصي على التحقق والذي لم يجد عنه الشخص بديلا (ما يؤرقني، أخي رشيد، هو احتمال طردي من اسبانيا في أي لحظة.. ما يؤرقني أن أعود إلى جحيم الوطن، أن أعود دون تحقيق أمنيتي التي دفعتني إلى الهجرة وكلفتني أجمل سنوات عمري…/الصفحة 10).. قد يكون المنفى تشريع سماوي يئد الرغبة المتقدة بين جوانحك، فلا أنت تطفأ لهيبها ولا أنت بالغ جذوتها (…كنت أسترق النظر إلى مفاتنها وأقاوم هيجان شهوة تهز جسدي وشعورا بأنني على وشك ارتكاب ما ينهى عنه الله،…/الصفحة 13).. قد يكون المنفى هو كل الشوارع والأزقة على شساعتها لأنك لا تنتمي إليها (من جديد وجدت نفسي بدون مأوى متسكعا في شوارع مدريد أبيت في محطات الميترو او في زوايا بعض الحدائق…/الصفحة 28) وتتعدد المنافي: البيت، الشارع، الجسد، الذكرى، الطفولة والحلم؛ لكن وحده الحب وطن يتسع لكل الهويات بقوة الوعي (تذكر كلمته التي استهلها بمقطع من قصيدة طباق للشاعر الفلسطيني محمود درويش:
يحب الرحيل إلى أي شيء
ففي السفر الحر بين الثقافات
قد يجد الباحثون عن الجوهر البشري
مقاعد جاهزة للجميع.. /الصفحة 105)
وأما ما احتبس في ثنايا التمني مع الروائي عبد الحميد البجوقي في ساحة الواقع العيني فهو الأمل بغد أجمل للجميع كما ينشده رشيد بين دفتي «المشي على الريح» (…المشهد من بعيد يبدو فريدا بتعددية الألوان البشرية المجتمعة والمختلطة في فضاء الساحة، مواطنون أفارقة ولاتينيون وإسبان ومغاربة وعرب، تخيل للحظة أن ساحة القرية وكأنها عالم مصغر يعيش في أمن وسلام ومحبة وطمأنينة…/الصفحة 105)..
منفى عبد الحميد البجوقي: مواجهات بلا حدود
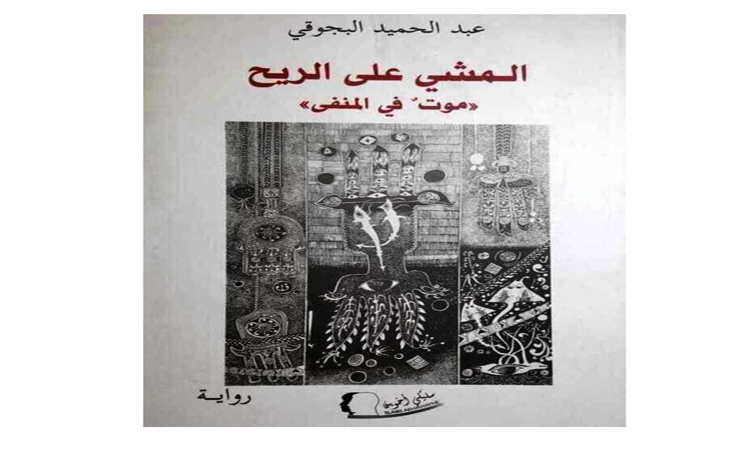
الكاتب : فاطمة حلمي
بتاريخ : 20/09/2024



