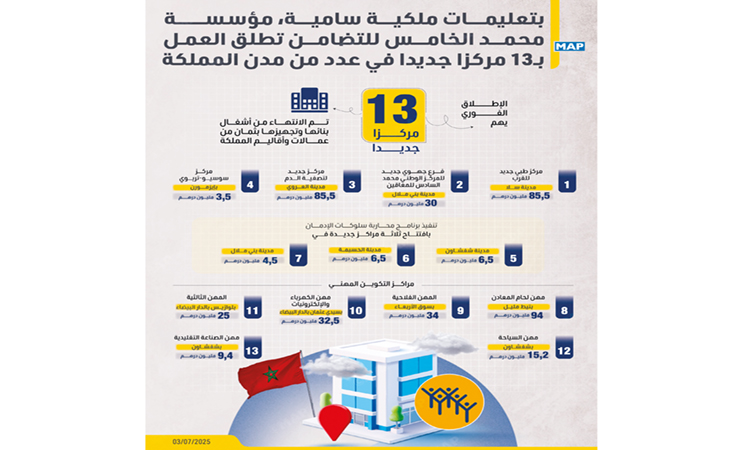ترمي القصة القصيرة، كما يكتبها أحمد بوزفور، في طريقنا مرايا (بصيغ الجمع) تعكس جهازا معرفيا موغلا في إيضاح المنعطفات والروابط والحدود بين بين نص وآخر، أو بين المتلقي والمؤلف، أو بين النظرية والإنجاز.. إلخ. إنها قصة تشتغل على نفسها، فتشرك القارئ في كشف بعض غموضها وهواجسها الذاتية، بل تكشف أمامه رحلة انضمامها إلى هذا الجنس الأدبي، كما أنها تقدم تصورات عن لغتها وقارئها وفلسفتها و أحلامها، بل إنها في أحيان كثيرة تعمد في حماس شديد إلى إدخال القارئ في متاهات تخييلية بما يمنحها انفتاحا وتنوعا و تعقيدا، فتصبح، وفق هذا التصور، مختبرا للتداخلات النصية وتحويلا كيميائيا لتقنيات كتابية شديدة التنوع، ثم إنها لا تخفي طموحها في تحقيق عملية نقدية للإمساك بالمعنى القصدي، أو على الأقل تقديم تفسير له، حتى وهي تدرك عجزها عن الإمساك بهذا المعنى، نظرا لتراكب عناصره وصعوبة اندماجه في نسق معرفي واحد.
ففي قصص بوزفور، ومنذ مجموعته الأولى (النظر في الوجه العزيز)، يبدي المؤلف والشخصيات معا رغبتهم الواضحة في مناقشة قضية التلقي وصوغ المادة السردية بما يوافق رؤيتهم الخاصة. فهم مدفوعون، دائما، إلى العمل على تصحيح مسارات السرد ونسق الأحداث إلى درجة أن كثيرا من تلك القصص تتضمن سجالات حول الكيفية التي ينبغي فيها أن تتركب المادة السردية، وبدل أن تنبثق الأحداث بشفافية من وسط السرد فإن الشخصيات تعلن عن حضوها ورغبتها في ترتيب تلك الأحداث، وذلك بلفت الانتباه إلى أدوارها ووظائفها في تضاعيف النصوص القصصية. وهذا معناه أن المدونة السردية تتعرض للانتهاك بحيث إن أحوال الشخصيات وانطباعاتها ورؤاها وتفسيراتها وتأويلاتها تتصدر الاهتمام فيما لا تستأثر الحكاية (المادة السردية) إلا بأهمية من الدرجة الثانية. وهذا الاستبعاد الذي تتعرض له الحكاية يختزلها إلى مجموعة من الوقائع المتناثرة التي غالبا ما تعرضها الشخصيات وتختلف في ماهيتها وكيفية وقوعها. بل إنها تجعل ذلك الانتهاك موضوعا سرديا لها، مما يفضي إلى انشطار الشخصيات وتغير منظوراتها.
إن هذا التراكب في الوظائف يفضح عمق التحولات التي تجري في القصة أو حولها، وأحيانا يضيء طبيعة التردد الذي يكتنفها، كما أن التعدد في أدوار الشخصيات ووظائفها ينعكس مباشرة على الحدث القصصي الذي تتفرق وقائعه وعناصره.
هذا المسلك في الكتابة يرتبط بالجماليات الحديثة المتسعة عموما بالإغراب والنزوع إلى إعادة بناء عناصر الواقع – بمختلف مستوياته- في ضوء الرؤية التي تصنعها الكتابة نفسها. رؤية لا تخلو من مفارقة. فكي «يكتب» المبدع عليه أيضا أن يكون ناقدا، بل أن ينتقل المؤلف من وضعية السارد إلى وضعية الناقد الذي يملك وعيا بالمادة القصصية. وهذا الانتقال من الإبداع إلى النقد هو ما يمنح موضوع الكتابة دينامية بإمكانها إنتاج معرفة خاصة بها، مادامت تنشغل بقضايا مثل (الجمال علاقة، الجمال فكرة، الجمال حذف واختزال).
إن قصة «صدر حديثنا»، على سبيل المثال، تحمل بعدا نقديا واضحا، تعلن معه القصة (الرواية) عن حياتها من داخلها وتكتب سيرتها الذاتية في الفضاء التخييلي الذي تنهض عليه. كما تقدم نفسها كأنها تقيم في عالم مغلق، مكتفية بذاتها وغير خاضعة لسلطة الزمن ولا لسلطة التلقي أو النقد. إنها تبني تجربة كتابة أساسها حلم، ولعبتها الفنية خدعة، ومجالها الكتابة، وأداتها تفكيك وتقويض المتعارضات، وأفقها استحالة الكتابة.
نقرأ :
-» الرواية التي صدرت مؤخرا تحت عنوان: «الفلاح والتاجر والكاتب» أثارت مجموعة من الانتقادات وردود الفعل المختلفة. والعرض التالي يحاول تقديم صورة عن هذه الرواية للقارئ مع مناقشة لأهم الانتقادات المثارة حولها « (ديوان السندباد.ص: 214)
ونقرأ:
-»الفصل الثالث: بعنوان (الكاتب)، ويحكي مأساة الكاتب «رجب» المهموم بالكتابة، والذي يحلم في البداية بكتابة رواية كبرى في حجم «الإخوة كرامازوف». لا يفكر في أية تفاصيل، يفكر في الحجم فقط، ثم يسأم فكرة الحجم ويسخر منها ليفكر في التركيب والتعقيد والتشابك وتكثيف الزمن والوعي، فتصبح روايته الحلم في شكل «أوليس» ثم تزداد صغرا وعمقا و تشع في خياله كالماسة من جميع الزوايا لتصبح قصيدة شعر، على أنه في الأخير يحلم بالجملة الخالدة، «الجملة الكمبيوتر» على حد تعبيره: جملة واحدة يجمع فيها الكون كله (…) ثم يمزق ما كتب، ويكتفي بكلمات وحروف من نوع «أنا…أنا…أ…أ…أ…إلى أن تغيب الكتابة كليا، ويبدأ الشرود والجنون والعنف البدائي المتوحش بحثا عن قربان من الدم البشري يقدمه على مذبح الكتابة، و حين يفشل في ارتكاب الجريمة التي خطط لها، ينتحر… هل انتحر؟ « (ديوان السندباد. ص: 216-217).
بعد ذلك، تنتقل القصة إلى خطاب نقدي صريح حول: البناء المفكك، والمنظور وموقف المؤلف وبناء الرواية المرآوي…إلخ.
إن هذا التدوير الذي تتعرض له «الرواية»- بوصفها شيئا قصصيا في «صدر حديثا»، يوضح أن الخطاب النقدي شبيه بالظل الذي يرافق صاحبه. فالقصة تقدم محكيين، كل واحد منهما مرآة ينعكس فيها وجه الآخر: الكاتب الذي يحلم بكتابة رواية كبيرة في حجم رواية «الإخوة كرامازوف» يقف أمام مرآة أحلامه المستحيلة، فيتسرب الملل إلى الحلم، ويتحول الاهتمام إلى قضايا «التركيب والتعقيد والتشابك «. وهكذا يتم الانتقال من الحلم بكتابة رواية إلى الحلم بكتابة قصيدة شعر. فيجد الحالم نفسه أمام سلم صعب ثم يتقلص الحلم ليصبح حلما بكتابة «الجملة الكومبيوتر»: الجملة التي تختزل الكون كله. ثم حين يصطدم باستحالة العثور على هذه الجملة يكتفي بكلمات وحروف: «أنا.. أنا.. أ.. أ… أ» (ديوان السندباد.ص: 216)، إلى أن تغيب الكتابة كليا، ويحل الشرود المفضي إلى الجنون المعادل لفعل الموت.
إن ظل الناقد في «صدر حديثا» ينظر إليه في بنائيته وإيقاعه وبلاغته مادام هيكل القصة متداخل. ومن هذا التداخل الملتف حول الكتابة تتولد أشكال حكائية متعددة: حكاية الفلاح وحكاية التاجر وحكاية الكاتب. إن نزعة التبنين، وإن كانت واضحة من خلال التوزيع، فإنها في الوقت نفسه خدعة لأساليب القراءات الخارجية. فهل معنى ذلك أن المؤلف يضع أمام القارئ أدوات القراءة؟ ذلك أن فصل هذه الأسئلة عن الحكائي معناه السقوط في ذلك الكمين الذي تنصبه الحكاية، من يستطيع الحديث عن الكتابة؟
إن أحمد بوزفور، في كل قصصه، يؤكد أن الحكي والقراءة معا هما قدما القصة البوزفورية و»لوحها المحفوظ». وإلا لما صنع منها «باليرينة» و»عازفة بيانو»، وإلا لما حولها بوخزة ساحر إلى نقطة سوداء في جبل أقرع ينمو ويتقدم ويقرأ الطالع.. وإلا لما قدمت قصصه وعيا عاليا ودقيقا باللغة. فهي لغة- كما تحضر في قصة «مدخل عن العطش»- غير مملوكة، وهي لغة موروثة ومثقلة بأصوات وأعراف وشياطين مالحة تحيط بها وتعلو وتصطخب وتشخر وتطلب الارتواء.
لا يكتب أحمد بوزفور قصة تتأتئ، بل قصة تحلم وتفكر: أي سر يحمله الغراب؟ وماذا تقول الغيوم للطائر أو الجبل؟ ولماذا تنهمل الدموع من البرتقال؟ ولماذا يعوي الهواء؟ ولماذا تتحطم الحلازين؟ وهل تكتب الأمواج رسائل الحب؟ ولماذا تحشرج الكمنجات؟ وهكذا.. أليس هو الخيميائي الذي يُقطِّر التجارب وينثر عطرها في الهواء لتسحر وتسلب وتقتل أحيانا (ويسألونك عن القتل)؟
بوزفور القاص/ بوزفور الناقد

الكاتب : سعيد منتسب
بتاريخ : 07/02/2025