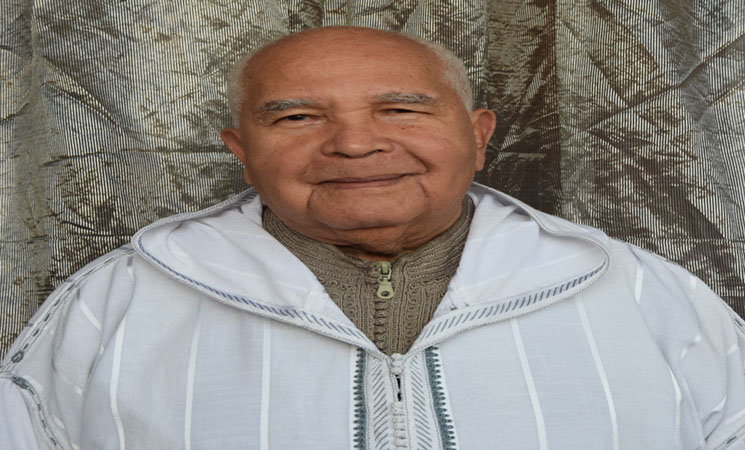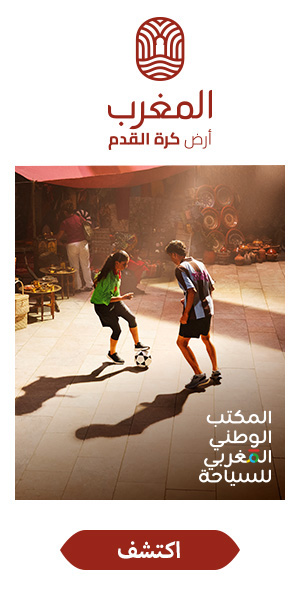تعززت المكتبة الوطنية أواخر السنة الماضية بكتاب مهم يحمل عنوان « على عتبة التسعين، حوار مع الذات « للشيخ عبد الرحمن الملحوني.و فيه يغوص الكاتب الذي عُرف بغزارة عطائه خدمة لتوثيق الذاكرة الشعبية بمراكش و لأدب الملحون، في ما أثمرته ستون سنة من البحث و التنقيب فيما تختزنه الصدور من رصيد شفهي، و في ما توارى من مكنونات المخطوطات و الكنانش والتقييدات، التي لولا انتباهه السابق لزمانه، لكان مصيرها إلى الإتلاف. ليضع أمام الوعي الجمعي المغربي رأسمالا استثنائيا من الدرس و التدقيق في مكونات الثقافة الشعبية المغربية عامة، و الثقافة المراكشية خاصة. في هذه السلسلة نستعيد مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني جوانب مما تضمنه هذا العمل، في جولة ساحرة تجمع بين ذاكرة الطفولة و تراكم العادات، و تقاطع الخطاب و فنون العيش في الحومات، إضافة إلى تطور سيرته العلمية في الزمان و المكان في احتكاك مع هواجسه المعرفية التي حركت أعماله.

سؤال: تحدثنا في الحلقة السابقة عن قصة لقب الملحوني، و كيف اختاره والدك الذي كان شاعرا، حسب ما أعرف، هل وثقت معلومات أخرى عنه في سيرتك، و عن عطائه في قصيدة الملحون؟
الشيخ عبد الرحمن الملحوني: اسم الشاعر والدي هو محمد، بن عمر بن الهاشمي، وأمّه زينب بنت عبد الرحمن، بن عمر، كان أبوه خضارا بحومة «درب ضباشي» كما تمت الإشارة إلى ذلك، وكان يسكن بدرب «الجامع» قُرب ضريح الولية «للاَّستٍّي» وكان ضريحها المخرَّب بداخل الدرب، ويحكي عنه الكثير أهل الحومة. ومن حكاياتهم، أن هذا الضريح قد بُني مند عهود قديمة، فتهدَّم بسبب الأمطار الغزيرة التي عرفها أهل مراكش بعد الجفاف الذي عانى منه الكثير من ساكنة المدينة قبل خلافة سيدي محمَّد بن عبد الله بقليل، وكلما أعيد بناؤه، تهدم، مما جعل أهل الدرب يتركونه، إلى أن تداعت أركانه، وحُطَّت دعائمه بصفة نهائية، حيث لم يبق منه إلا ما يخبر عن هجر طويل.
ويذكر والدي أنه كان يسمع بعض «البَراول» يؤديها أصدقاؤه في مسامراتهم الخاصة قريبة من أغاني «الهواريات»، مما يغلب عليه الطابع الديني، منسوبة إلى عائلته. وذكر لي الشيخ العربي امْجيمَر (من حفاظ الملحون) ومن معاصري السَّيد بن الهاشمي، أنه تـُروَى لجدي نقلا عن أصدقائه مقطعات زجلية من أشكال «العروبي» ممَّا كان يُنشد ببادية دكالة، كما كان والدي أيضا – مُعجبا بالشعر الملحون، منذ طفولته وصباه، ولعلَّ هذا قد فعل الكثير في ميله إلى هذا الفن الشعبي الأصيل حيث صادف ازدهارا لهذا الفن على مستوى النَّظم، والإنشاد.
و العروبي: هو مقلوب رُباعي، وهو على قسمين: ما ينسب للقصيدة الزجلية ويعتبر جزءا منها داخل لَمْرمَّة الموسيقية التي يجري عليها قياس القصيدة، كما هو الشأن – مثلا – في قصيدة «فاطمة شَرْعْ اللهْ مْعَاكْ» للجيلالي امثيرد من شعراء مدينة مراكش. وما يُنسب للشيخ عبد الرحمن المجذوب ولغيره من الزَّجالين الذين عرفوا بنظم هذا الشكل من أشكال الزَّجل. فالأول عبارة عن مجموعة أشطار، تنتهي بالرَّدمة (الشطر الأخير)، وأقلَّه خمسة أشطار، فأكثر، ويرجع ذلك إلى نفس الشاعر خلال كل قسم من أقسام القصيدة التي تجري تفاعيلها على هذا الشكل من أوزان المَلحون، وتتنوع تفاعليه، ومرمَّاته الموسيقية تنوعا بديعا لا يقدر عليه إلا فرسان الملحون. والنوع الثاني، يتألف من أربعة أشطار، على غرار ما اشتهر به المجذوب في رباعياته. والنوعان معا كانا يستخدمان في أغاني البدو بكثرة، وله نظائر في أغاني شعبية أخرى، كالعيطة – مثلا -، وأغاني «لـَكْريفْ» المعروفة عند الفنان الشعبي، حميد الزاهر المراكشي، وكذلك ما يُنشد في فن «الدقة المراكشية».
ذكر الأستاذ محمد بوعابد، أن تاريخ ميلاد جده ( أي والدي) كان بمراكش سنة: 1891، حسب التصريح الرسمي، والمثبت – أيضا – في كناش الحالة المدنية، والمؤرخ بتاريخ: 1958، وهذا التصريح غير مضبوط، فقد عاش الشاعر أكثر.
سؤال: هل ولد الشاعر والدك بمراكش؟
الشيخ عبد الرحمن الملحوني: نعم، مراكش مسقط رأس الوالد كانت في هذه الفترة التاريخية من بين المدن المغربية العتيقة التي حظيت بنسيج العلائق الحضرية على ضَوء عملية التَّحديث التي عرفها دخول الاستعمار إلى البلاد، والتي قد أسهمت – هي الأخرى – في الانتقال من نمط المدينة العربية القديمة، إلى نمط المدينة الحضرية الحديثة . وقد تأتـَّى هذا الانتقال في أطراف المدينة خارج السّور، وأيضا في فضاء بعض عرصاتها وبساتينها. ويؤكد هذه الظاهرة العمرانية ما جاء به ديوان الملحون في هذا العهد من وصف بارع لعرصات المدينة، وبساتينها، ويُسمَّى هذا اللون عند أهل الملحون ب «الرّْبيعيات». و هذه القصائد قد دُونت في إحدى الكنانيش التي أعدها الراحل بن علال المعروف ب «لـَحْسيكَة». وتعتبر من أروع ما جمعناه بمناسبة «مهرجان الرَّبيع» (و يمكن الرجوع إلى كتاب: القصيدة للدكتور عباس الجراري للتَّوسع).
وإلى اليوم، تسمَّى بعض حومات مراكش، بأسماء بعض عرصاتها التي كانت بها قبل زحف البناء، وما عرفته المدينة من توسيع عمراني في هاته الجهة أو تلك على حساب هاته العرصات التي كانت تزدان بها مراكش، وتلطف من مناخها وطقسها الحارّ. ونظرا لأهمية هذا الجانب من «أدبيات» فن الملحون التي واكبت حضارة مراكش، واعتنت كثيرا بعاداتها، وتقاليدها، فقد جمعت العديد من قصائد الربيعيات. بمناسبة تنظيم المهرجان الرَّبيعي الأول المُنظَّم من طرف عمالة مراكش المدينة 1992 في جزئين اثنين: «مُتابعات، وتوثيق». كانت فِكرة «توثيق» قصائد الملحون، مما يروج في حظيرة أهل الملحون، ابتدأت من سنة: 1975، حيث أحدثت جمعية «الشيخ الجيلالي امثيرد» مهرجان الربيع الذي تنظمه – من حين لحين – على المستوى الإقليمي، أو الجهوي، أو الوطني. وبهذا قد رَصدت الجمعية مجموعة من المحاور، عملت بواسطتها على متابعات وتوثيق الكثير من القصائد (على تعدد أغراضها) بالإضافة إلى تخزين مجموعة أخرى من المعارف والمعلومات. وهكذا كان شعار المهرجان الأول تحت عنوان: شاعر الملحون والطبيعة، والثاني: «شاعر الملحون في قفص الاتهام» والثالث: شاعر الملحون، وعادات النزايه والرابع، تحت شعار: «الجانب الاجتماعي، والوطني في الشعر الملحون». وقد نتج عن هذه المتابعات، وهذا التوثيق عدد من الأعمال، أثْرَت المكتبة الوطنية وأضافَتْ بعض الدّراسات، والأبحاث إلى سابقتها من أجل حماية هذا التراث والمحافظة عليه .
ومما لاحظه الأستاذ محمد بوعابد في «أطروحته» حين ترجم لجده محمَّد بن عمر الملحوني، أن شاعرنا قد ولد في فترة تاريخية عصيبة، كان فيها المغرب يعاني الأمرين من أحد الأطماع الأجنبية، الرامية – في الأساس- إلى فَرض امتيازات المستعمر بالمنطقة المغاربية، الهادفة إلى تمزيق وحدة الدولة، وتشويه حضارتها، وثقافتها، والساعية – وبكل الوسائل – إلى نَهب خَيرات المنطقة وتسخير أبنائها في معسكرات الحروب التي أخذت تشتعل نيرانها هُنَا، وهناك!
لقد سجل ديوان الملحون بعض الإرهاصات التي جاءت تؤكد أطماع الأجنبي، وترصده للاستفادة من أراضينا، ومن خيراتها، واستراتيجية المنطقة، وإلى هذا، كانت تُشير الجفريات القديمة في مضامين قصائدها. وانطلاقا ممَّا ذكر، نسوق هذا النموذج لسيدي لحسن وعلي، يتنبأ فيه باحتلال فرنسا للمغرب، وفيه – كما يقول الدكتور عباس الجراري في كتاب القصيدة، يصف حال الزمان كما أخبرت به الأجفار . فقد كتبت في ألواحها أنه في السَّنة الحادية عشرة، ستكدر عيون المياه، ويتفرعن الضفادع في الوديان، وتتقوى الذئاب، وتضعف السباع، وتصول البومة على النسور، وتنزل مكانة ذوي الهِمَّة والشأن، وتعلو مكانة السَّفلة، ويصبح الفجار في قرار مكين، ويغدو الوُجهاء والشرفاء، كالحيوان، ويظهر القَول الحق، تخبر به الأجفار، مُعلنا دخول الفرنسيين «ل،ف،ر،ن،ص،س» كما تنطقها العامة :
بَعْدْ اصْلتْ الرّْسُولْ نْــــــــوَضَّحْ بَالتـَّبْيينْ ** شَرْطْ السَّاعَة نْصِيف حـَالتُو فَي الزّْمَانْ
بهَا لَجْفَارْ خَـبّْـــــــــرُو وبَـاقِــــــي سنينْ ** نـظْــــــرُوهَا فَي اللْواحْ بَاحُو بَالكـَتـْمَانْ
فِي عَامْ حْضَاشْ يَظْهَرْ تـَخْوَاضْ الـْعِيــنْ ** وَتـْفَرْعَـــــنْ الجرَّانْ فـَي جْمِيعْ الـْويدَانْ
تـَقـْوَى الذَّيَابْ والسّْبَعْ يَـــــــرْجَعْ مَسْكِينْ ** حتـَّى مُوكَا تـْصُولْ عْـلَى جَمِيعْ الـْـبِيزانْ
وْهـْـلْ الرَّفْعَة تـَخْمَدْ يْعْلـَى مَـنْ هـُوشِينْ ** نَاسْ الرَّتْبَة تـْعُودْ خَفْضَا بَعْــــــدْ الشَّانْ
يَـــا أسَفِي الـْحَقْ يَـبْـــقـَى بَـيــــــــنْ أبيــنْ ** خـَبْرُو بـِهْ الجَفـَــــــــــارْ يَغْبَالِيسْ يْبَانْ
مَنْ لامْ، أوفـَا، وُرَا او نـُونْ، وْصَادْ وْسِينْ ** إلـَى وَصْلُو الـْغَرْبْنًا بَعْـــــــــدْ الْحَسَــانْ