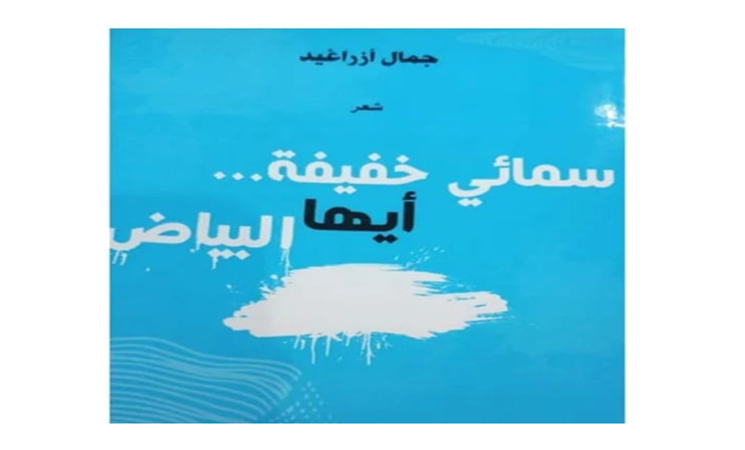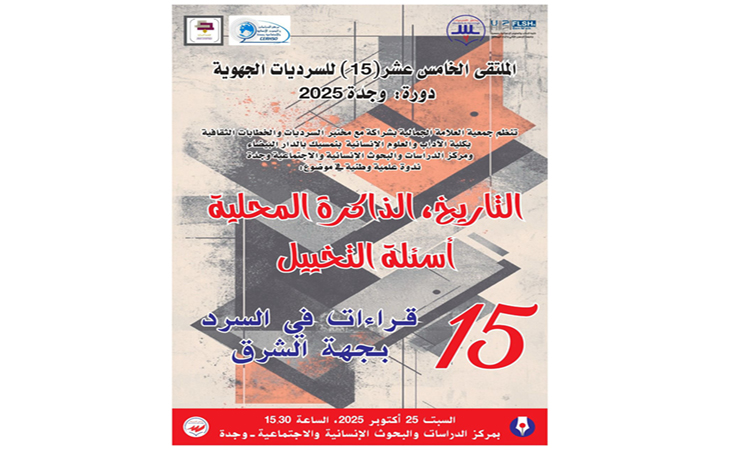شفيع بازين ناقد تونسي، أستاذ مساعد بكلية الآداب والإنسانيات بجامعة منوبة، اختصاص الأدب العربي الحديث (السرديات وكتابات الذات)، عضو في مخبر «السرديات والدراسات البينية»،رئيس الملتقى الثقافي العربي (منتدى ثقافي افتراضي) مشارك بورقات علمية عديدة في ملتقيات وندوات وطنية ودولية وصدرت له مقالات علمية عديدة في مجلات عربية وكتب جماعية مُحَكَّمة، من مؤلفاته :
– الرسائل بين الأدباء العرب في العصر الحديث: مقاربة تداولية، تونس، 2020.
– الإنشاء الشعري للكون، دراسة إنشائية في شعر المتنبي، تونس، 2022.
– التخييل والتأويل: قراءات في الرواية التونسية، تونس، 2024.
– رسائل عربية ، مؤلف جماعي في أدب الرسائل *، بالاشتراك مع د .إدريس جرادات
p أستاذ شفيع ما هو تصورك للممارسة النقدية؟ وكيف تمارس النقد؟
n النقد ضروري وكلنا في حاجة إلى الكتابات النقدية، كتاّبا ونقاّدا وقرّاء ومدرّسين ودارسين، لأن الأدب دون نقد يؤدي إلى «عماء» القراءة وفوضى التلقي واختلاط الكتابات والتباس الأجناس ولا يمكن لنا أن نميز الجيد من الرديء أو المبدع من المتصنع أو المجدد من المقلد…الخ.
وأنا أتصور الممارسة النقدية ممارسة صعبة وتتطلب تكوينا ودربة، وحسا فنيا عاليا وصبرا على القراءة وتأنيا في التأويل. ولعل صعوبة الممارسة النقدية تتأتى من جهة أولى من ضرورة الجمع بين العلم والفن أي المعرفة العميقة والواسعة بالنظريات والمناهج الأدبية وأجناس الأدب وتاريخه وجمالياته، فضلا عن التشبع بالنصوص والقراءة الموسعة للمدونات ومواكبة المستجدات في مجالي النقد والإبداع، وتتأتى من جهة ثانية من ضرورة امتلاك حس فني وجمالي عميق يمكن الناقد من توظيف معرفته وخبرته توظيفا يراعي خصوصيات النصوص ويجنبه الإسقاط والتعسف عليها. وأنا أمارس النقد بكثير من الحذر والتأني، وأحاول أن أبحث في كل موضوع أو عمل أدبي أتناوله نقديا عن المداخل المناسبة والمفاتيح الملائمة لقراءته قراءة تستكشف عوالمه وخصوصياته وتبرز شعريته. وإضافة إلى ذلك أحرص على تنويع المقاربات والمداخل وتطوير أدوات النقد والقراءة حتى أواكب التطورات والمستجدات في مجال المناهج والمقاربات النقدية، سعيا مني إلى تحقيق شرط مهم من شروط الممارسة النقدية وهو الجدة والحداثة.
p كيف يخدم النقد الإبداع؟ وهل لغيابه دور في رداءة الإبداع وكثرة الإصدارات؟
n النقد من المفروض أن يخدم الإبداع لا أن يكبح جماحه أو يقيده في قوالب ونظريات جاهزة، أو يشوهه عن طريق الإسقاط وبُعْد التأويل وتحميله ما لا يتحمل. ولا شك أن النقد يقدم خدمات جليلة للإبداع، فهو يعرّف به ويبرز مظاهرة الجدة والإبداع فيه، وهو كذلك يميز بين العمل الرديء والعمل الجيد، ويمد القارئ بأدوات ومداخل ومفاتيح ملائمة لقراءة النصوص الإبداعية قراءة ملائمة، وينظم الأعمال ضمن مقولات الأجناس والأنواع فيحدّ من الفوضى والتداخل، وهو يمثل حافزا إيجابيا للمبدعين على تجويد الكتابة وإنضاج التجربة فنيا فضلا عن كون العديد من النقاد والنظريات أسهموا في فتح آفاق أخرى في الكتابة وظهور أجناس أدبية جديدة كان منطلقها تنظيرات نقدية (على سبيل المثال: التخييل الذاتي نشأ مع سيرج دوبروفسكي في محاولة لملء الخانة الفارغة التي ذكرها فيليب لوجون). وما يؤكد ما ذكرته أن الفترات التي يتراجع فيها النقد- مثلما يحدث في عصرنا الحالي نتيجة الثورة الرقمية وهيمنة شبكات التواصل الاجتماعي- ينجرّ عنها إسهال في الكتابة والنشر واختلاط الكتابات وضبابية المشهد الإبداعي الذي لم يعد فيه المتلقي يميز بين النصوص الجيدة والنصوص الرديئة، بل لم يعد قادرا على التمييز بين ما ينتمي إلى دائرة الأدب وما لا يمت إليه بصلة. ولكني أرى مع ذلك أنها فترة تحوّل ومخاض وبحث ستؤدي تدريجيا إلى توضّح المشهد وتشكل الأنواع الجديدة، وسيعود النقد إلى سالف نشاطه مع تغيير أدواته وتطوير مقارباته ومعاييره. وهناك من يرى أن كثرة الإصدارات ظاهرة إيجابية تؤدي إلى المنافسة وتخلق حركية أدبية في الساحة الراكدة ولكن في النهاية سيفرض العمل الإبداعي نفسه ويبقى، وأما الأعمال المغشوشة أو الرديئة فستزول بفعل الزمن والغربلة، والقرآن يقول «فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ» ومثلنا التونسي العامي يقول: «ما يَبْقَى في الوَادْ كانَ حَجْرُهْ».
p يرى الناقد المغربي مصطفى الغرافي أنه «لا يمكن للممارسة النقدية ان تستقيم إلا على معرفة بالنظريات النقدية المختلفة، والأسس المعرفية التي انبثقت عنها». ما تعليقك؟
n أوافقه جدا هذا الرأي، وسبق أن ذكرت أن الممارسة النقدية تختلف عن الممارسة الإبداعية بضرورة امتلاك الناقد للأسس المعرفية والنظرية الضرورية حتى تكون ممارسة مستندة إلى خلفية فكرية ومنهجية وعلمية تجنبه المنحى الذاتي الانطباعي، وتكسب ممارسته قيمة علمية وصبغة موضوعية من جهة وتمكنه من قراءة الأعمال الأدبية قراءة ناجعة وملائمة وتقديم الإضافات المرجوة من ممارسته، فضلا عن ضرورة مواكبة المستجدات، والإلمام بالتطورات في مجال النظريات والمناهج النقدية حتى يستطيع الناقد أن ينشئ خطابا نقديا حديثا ويتمثل بعمق الآفاق والخلفيات المعاصرة التي يبدع الكتاب في إطارها. ولكن لا أعتقد أن الإلمام بالنظريات النقدية كاف لتكون الممارسة نقدية بالمعنى الدقيق والعميق للنقد، وذلك أن هذا الإلمام إذا لم يكمله أو يعضده الحس النقدي الجمالي، والدربة والخبرة بالنصوص والقدرة على إيجاد المداخل والمفاتيح المناسبة لقراءة النصوص يمكن أن يؤدي إلى ضرب من الإسقاط أو الكتابة الباردة، أو الاكتفاء بتطبيق قوالب ونظريات جاهزة على أعمال أدبية سمتها الحركة والتفرد والخصوصية.
p إلى متى سيظل الناقد العربي يغرف من مناهج النقد الغربي؟ ومتى سنرى نقدا عربيا أصيلا؟
n هذا سؤال مهم طُرِحَ كثيرا وتعددت الإجابات عنه، ويجب أن نفكر فيه بعمق وجدية. ظاهرة الأخذ عن الغرب عامة قضية مطروحة منذ النهضة وفي الواقع هناك عموما رأيان في هذه المسألة التي طرحتَها. الرأي الأول يقرّ بأن النقد العربي الحديث ظل ينهل من النقد الغربي، ولم يجدد فيه أو يؤسس لنقد عربي بديل أو مغاير، ويعتبر أن هذه التبعية النقدية جزء من التبعية الثقافية والحضارية عامة ولا يمكن لثقافة تابعة أو ضعيفة أو مستهلكة أن يكون فيها النقد استثناء. والرأي الثاني يرى أن النقد العربي رغم هذه التبعية كان باستمرار يسعى إلى التأصيل بالاستفادة من المنجز النقدي التراثي أو إلى الاختلاف والخصوصية بالاشتغال بمباحث ومدونات عربية ليست مقارباتها النقدية بالضرورية تطبيقا للنظريات الغربية. وأنا أرى أن النقد الأدبي راهنا قد دخل في عصر جديد عصر رقمي معولم أو كوني لا معنى فيه للتحديث والتأصيل بل هو نقد إنساني تساهم فيه مختلف الثقافات، وعلينا أن نستفيد من الروافد المتعددة لعلنا نساهم بدور ولو بسيط في هذا المنجز النقدي الكوني.
p صدر لك بحث بعنوان «الرسائل بين الأدباء العرب في العصر الحديث: مقاربة تداولية»، إضافة إلى إشرافك على عديد من الكتب الرسائلية. ما حكاية هذا الشغف بأدب الرسائل؟
n عبارة «شغف» تعبر جيدا عن علاقتي بأدب الرسائل. وهذا الشغف في الواقع اتخذ شكلين: شكلا ذاتيا يعود إلى ميلي الخاص إلى أدب الذات عامة وأدب الرسائل خاصة وهذا الميل الذاتي في الواقع يسنده وعي بأهمية هذا الأدب في المستويين الجمالي والإنساني، وتدفعه قناعة راسخة بأن الأدب العربي الحديث تغذيه مدونة إبداعية مهمة في مجال كتابات الذات عامة والكتابات الرسائلية خاصة لكنها مازالت مهمشة ومهملة، وتستحق الاهتمام وإعادة الاعتبار، وشكلا علميا أكاديميا راجعا إلى تخصصي منذ البداية (أطروحة الدكتوراه) في مجال أدب الرسائل بتوجيه من أستاذنا صالح بن رمضان الذي لفت اهتمامي إلى هذا الأدب. وفي هذا الإطار الأكاديمي وجدت من واجبي ألا أقتصر على هذا البحث، بل دوري الأهم أن أعنى بالتجارب الرسائلية الحديثة التي لم تنشر تحقيقا وتقديما أو الإصدارات الرسائلية بحثا وتعريفا. وأعتقد أنني قد نجحت إلى حد ما في إعادة الاعتبار إلى هذا اللون الأدبي المفقود أو المهمل في ثقافتنا أو أدب الاعتراف والبوح والكتابات الذاتية الحميمية.
p ما هي الرهانات الإبستيمية التي تتحكم في هذه المصطلحات: «الكون»، «الإنشاء الشعري» وأنت تقارب شعرية أبي الطيب المتنبي؟
n في الواقع كانت هذه الدراسة الموسومة ب»الإنشاء الشعري للكون: دراسة إنشائية في شعر المتنبي» مدارها فعلا على هاتين العبارتين المفتاحين «الكون» و»الإنشاء». وقد انطلقت من أطروحة في اللسانيات لأستاذنا صلاح الدين الشريف عن «الإنشاء النحوي للكون» لأختبرها بنقلها من مجال النظرية اللسانية أو النحوية إلى مجال النظرية الشعرية أو الإنشائية، وكانت الغاية من ذلك أن أبرهن عبر التحليل الإنشائي لشعر المتنبي أن الشعر عامة وشعر المتنبي أنموذجا ليس مجرد إجراءات أسلوبية أو اشتغالا جماليا على اللغة أو بناء للقصيدة وفق بلاغة الغرض، وإنما هو في جوهره إنشاء شعري للكون أي بناء لعالم أو كون تخييلي رمزي بالكلام وفي الكلام، والكائنات والوقائع والصور المتشكلة في قصيدة المتنبي ليست موضوعات أو صياغات بلاغية ولا هي تمثيلات للواقع أو تعبيرات عن الذات وإنما هي خلق لكون تخييلي قد يكون ترميزا ذاتيا وقد يكون تكميلا للواقع وما يشوبه من نقصان.
p في كتابك «التخييل والتأويل» قاربت كثيرا من الأعمال الروائية التونسية. كيف وجدت هذه الرواية؟
n هذا الكتاب هو ثمرة سنوات من البحث والاشتغال بالمدونة الروائية التونسية الجديدة. ولئن كان في الأصل مقالات متفرقة جمعتها ونسقتها فإن الجامع بينها- إضافة إلى المدونة التونسية- قراءة أو مقاربة متجانسة تقوم على محوري التخييل بما هو جوهر الخطاب الروائي والتأويل بما هو جوهر الخطاب النقدي. ولعل أبرز ما لاحظته في الرواية التونسية- اعتمادا على المدونة التي اشتغلت بها- ثلاث ظواهر لافتة: الأولى الحرية بل الجرأة في طرح قضايا أو تناول مواضيع كانت قبل هذه المرحلة تندرج ضمن المحظور والممنوع (الجنس- الدين-السياسة). الثانية هي الخصوصية الإبداعية أو التخييلية التونسية، سواء بالنظر إلى هيمنة الملامح التونسية في الشخصيات والبيئات والقضايا والتيمات، وحتى اللغة السردية المشبعة بالتعبيرات أو العامية التونسية. والثالثة ظاهرة النزوع إلى التجريب والبحث سعيا إلى كتابة مختلفة وحداثية ، وقد تجلى ذلك في مظاهر عديدة أبرزها التنويع في الأصوات والمنظورات السردية والاشتغال على الخطاب الواصف والميل إلى العوالم العجائبية، والتلاعب بنظام الحكاية وتشظية السرد والإكثار من الفراغات والمضمرات.
p كيف ترى واقع الأدب الرقمي ومستقبله؟ وهل تتعامل الجامعة التونسية مع هذا الأدب؟
n سؤال مهم ومطروح بإلحاح على النقد العربي اليوم. في الواقع انشغلت بهذا السؤال منذ مدة واطلعت على جل ما كتب عنه أو كتب في إطاره وقد صدر لي أكثر من مقال علمي في علاقة بما يسمى بالأدب الرقمي، كما عنيت بأشكال جديدة من الأدب الرقمي أذكر منها أدب الرسائل الرقمية أو الفايسبوكية (رسائل سنيا الفرجاني أنموذجا)، ولعل من أبرز المهتمين بهذا الأدب سعيد يقطين وزهور كرام (من المغرب) ومحمد سناجلة (من الأردن). والجدير بالاهتمام أن العصر الرقمي لم يفرض على الأدب استخدام الفضاء الرقمي أو وسائل الاتصال الرقمية وسيطا فحسب، وإنما أفرز كذلك أنواعا أو أجناسا أدبية رقمية مختلفة (القصيدة الرقمية- الرواية الرقمية…) وفرض على النقاد مواكبة هذا التطور فظهرت نظريات في الأدب الرقمي ومصطلحات خاصة به. وأنا أرى أن الأدب الرقمي لم يعد واقعا مفروضا فحسب وإنما أرى أنه مستقبل الأدب، المستقبل الذي يؤدي إلى اختفاء الوسيط الورقي والدخول كليا في العصر الرقمي مع تسارع تطور التكنولوجيات الرقمية وخاصة بعد ثورة الذكاء الاصطناعي، وبناء عليه أصبح مفروضا على الأدب والنقد العربيين مواكبة هذه التطورات والاستفادة من الوسائط والإمكانات الهائلة التي توفرها هذه التكنولوجيا الرقمية للدخول في العصر الرقمي الجديد، وإلا تحول أدبنا ونقدنا إلى تراث ومنجز خارج حركة التاريخ، وبما أن مصطلحات مثل العقل الرقمي والقارئ الرقمي والكتاب الرقمي والوسيط الرقمي مصطلحات متداولة ومفروضة، فكيف يمكن للأدب والنقد أن يبقيا خارج الحضارة الرقمية؟
p كثرت في الآونة الأخيرة كتابة القصة القصيرة جدا. ماذا عن الإضافات التي يشكلها هذا الصنف من الإبداع؟
n فعلا شهد عصرنا الحالي انتشارا بل اكتساحا ملحوظا للأجناس الوجيزة عامة وللقصة القصيرة جدا خاصة. وقد أوليت عناية بهذا الجنس الوجيز وكتبت عنه أكثر من مقال وشاركت بأكثر من ورقة نقدية. وخلاصة رأيي أن الأدب الوجيز ظاهرة طبيعية أفرزها عصر السرعة والإيجاز والفضاء الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي. ولعل القصة القصيرة جدا أكثر الأنواع الوجيزة تعبيرا عن روح العصر بما تتميز به من إيجاز وقصر وتكثيف وإدهاش. ولاشك أن هذا النوع القصصي الوجيز ليس سهلا أبدا بل يتطلب وعيا بالنوع، وامتلاكا لتقنياته وقدرة على التكثيف والإيجاز والحذف والإضمار لتحقيق الإدهاش وإشراك القارئ في الإنتاج التخييلي والتأويلي، ودون الإخلال بالقص شكلا ومعنى، ودون الوقوع في الابتذال أو الإغراب. غير أن الكثيرين مع الأسف استسهلوا هذا النوع من الكتابة، وأغراهم قصره وانتشاره فكثرت الإصدارات وقلت الإبداعات. وعلى كل يبدو أن هذا الجنس القصصي الوجيز قد فرض نفسه اليوم، وأثبت حضوره ولا شك أنه يمثل إضافة نوعية وإبداعية لأشكال الكتابة القصصية، ويستجيب لثلاثة مطالب اليوم: الإيجاز والتكثيف، والقدرة على الإدهاش، وإقحام القارئ في ملء الفراغات والتأويل ليكون قارئا مبدعا منتجا لا قارئ سلبيا مستهلكا. وإذا لم تحقق القصة القصيرة جدا أغلب شروطها الجمالية والفنية، فإنها تسهم على الأقل في التقليص من الثرثرة والإطناب والحشو وتخرج القارئ من سلبيته وعقليته الاستهلاكية.
p من موقعك ناقدا، كيف ترى مستقبل النقد مع كثرة الإصدارات الأدبية؟
n كثرة الإصدارات الأدبية تعتبر في ذاتها ظاهرة إيجابية تدل على حركية إبداعية واهتمام بالأدب ،كتابة ونشرا وتلقيا، غير أنني أخشى أن تكون هذه الكثرة أيضا نوعا من الإسهال أو الاستسهال وتمييع الساحة الأدبية واختلاط الحابل بالنابل، والغث بالسمين، وهذا ما يعسر مهمة النقد ويساهم في تراجعه وتهمشيه. فالناقد مهما كان مواكبا ومطلعا سيصعب عليه مجاراة هذا النسق المكثف والمتسارع للنشر، وسيصعب عليه بالتالي التمييز بين الأعمال الجيدة والأعمال الرديئة خاصة مع انتشار ظاهرة المحاباة والمجاملة والمبالغة في الكتابات النقدية. وقد يكون النقد مهددا بالاختفاء والغياب أمام هذا الفيض من الإصدارات وانهيار مختلف أنواع السلطة، بما في ذلك السلطة النقدية والأدبية. ولكن يبقى أمام الناقد أن يقوم بدوره المهم ويواجه هذه التحديات ويجدد أدواته ومقارباته وعلاقته بكل من القارئ والمبدع، وإلا فلا مستقبل له أمام هذه التحولات المتسارعة واجتياح الفضاء الرقمي الشبكي للعالم .وعندما يتراجع النقد أو يختفي نخشى أن يخلف فراغا جماليا ومعرفيا رهيبا ويجد القارئ نفسه ضائعا في «غابة السرد».
p أخيرا .. وقبل أن نسدل الستار، لماذا يجب أن تكون ناقدا؟
n لماذا يجب أن أكون ناقدا؟ سؤال جميل. دعنا نتساءل أولا ما معنى أن يكون المرء ناقدا؟ معناه أولا أن يتحمل مسؤوليته العلمية والأخلاقية والجمالية في تعامله مع الأعمال الأدبية لأنه يتعامل لا مع كاتب أو قارئ فحسب، وإنما يتعامل مع ما به تكون الأمة أمة والإنسان إنسانا: الإبداع. ولأنه مسؤول عن حفظ مستوى معين من الحس الجمالي والذوق الفني والمحمول القيمي في اختياره للأعمال المدروسة أو في قراءاته للنصوص أو نقدها. ووعيا بهذه المسؤولية وإيمانا بأهمية الإبداع في المجتمع وجدت أنني يمكن أن أتحملها وأتحمل أعباءها. ولكن قد يكون في القول بعض المغالطة لأنه يوهم بأنني اخترت هذا الطريق اختيارا حرا ، والواقع أن هناك عوامل عديدة ربما تدخلت في توجيهي نحو النقد.. قد يكون من بينها تكويني العلمي النقدي واهتماماتي القرائية والذوقية ومراجعي النقدية وعلاقاتي بالنقاد والباحثين…الخ. ولكن إضافة إلى ذلك أود أن أختم هذه الإجابة بالفكرة القائلة إن الناقد هو كاتب أخطأ طريقه أو مشروع كاتب فشل، والواقع أن هذه الفكرة لا تخلو من الصواب لأنني فعلا فكرت أو حاولت مبكرا الكتابة السردية وعدلت عن ذلك دون أن أعرف السبب، غير أن ميلي إلى النقد في الواقع لا يعود إلى فشل في الكتابة بقدر ما يعود إلى قناعة راسخة مفادها أن الساحة الأدبية في حاجة إلى النقد حاجتها إلى الإبداع ، وأن الناقد إذا أجاد عمله وأتقنه وأخلص له يمكنه أن يكون مبدعا بطريقته .ويكفي أن نذكر شاهدا على ذلك أستاذنا الجليل توفيق بكار رحمه الله الذي لم يكن ينقد النصوص الأدبية بقدر ما كان يبدع كتابة أخرى أو كلاما على الكلام.