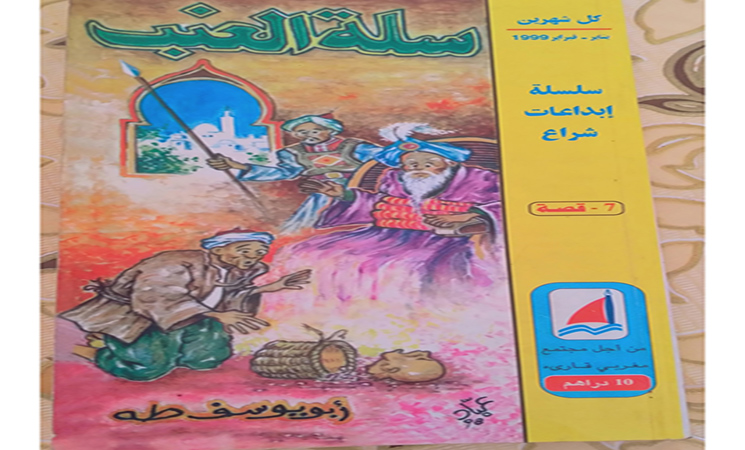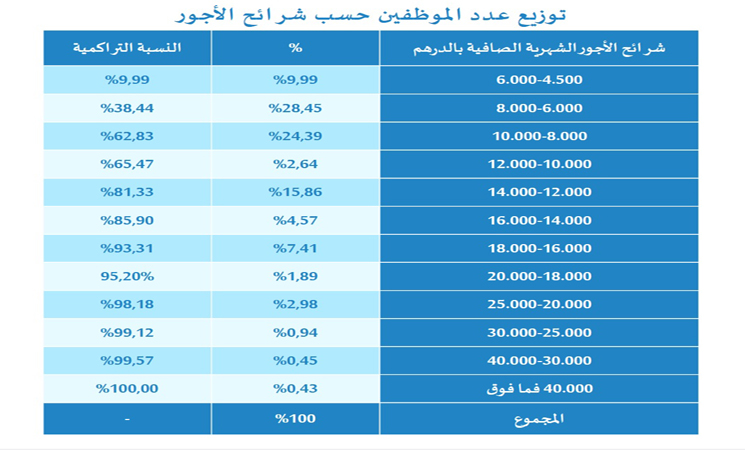يشهد المغرب خلال العقود الأخيرة دينامية أدبية مهمة وخصوصا على الصعيد السردي، سمحت بظهور الكثير من التجارب سواء في القصة أو الرواية التي نمت وانتعشت ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة سواء على مستوى آليات تناول الموضوعات أو تقنيات الكتابة وحتى التواصل مع الجمهور.
يشهد المغرب خلال العقود الأخيرة دينامية أدبية مهمة وخصوصا على الصعيد السردي، سمحت بظهور الكثير من التجارب سواء في القصة أو الرواية التي نمت وانتعشت ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة سواء على مستوى آليات تناول الموضوعات أو تقنيات الكتابة وحتى التواصل مع الجمهور.
وغير خاف أن ما نشهده اليوم من إنجازات لم ينبت كالفطر، ولكن الفضل فيه يرجع إلى أسباب عديدة لعلّ أحد أهم عناصرها الوجيهة ما راكمه جيل السبعينات الذي حمل على عاتقه عبء خلق إشعاع ثقافي حداثي يحمل في طياته قطيعة أو بوادر قطيعة مع التصورات التقليدية للكتابة السردية، واضطلع برمي الأعمال الإبداعية في أتون التجريب، والدفع بها نحو اختراق آفاق جديدة وغير مسبوقة.
وسأكون غير مجاف للصواب عندما أقول إن القاص أبو يوسف طه يشكّل أحد الفاعلين البارزين في هذه الدينامية. ومن هذا المنطلق تقترح هذه الورقة تأملات في تجربته السردية من خلال «سلة العنب» هذه المجموعة التي نعتبرها سلة للسرد ومعملا اختمرت فيه الكثير من مغامرات التجريب السردي. فمجموعة «سلة العنب» الصادرة عن سلسلة إبداعات شراع سنة 1999 تشكل خلاصة تجربة سردية طويلة تميزت بالتنوع والتجوّل عبر دروب طويلة من تقنيات القول والسرد. ومكابدة الصراع مع اللغة، ويمكننا القول إنها تنتظم ضمن خاصيات أساسية أهمها:
ــــ 1 . الكتابة وفق المذهب الواقعي، ويتجلى هذا المعطى من خلال قصة « الزنابق السوداء» التي تحلّق في عوالم هامشية على الرغم من أن المكان الرئيس فيها هو ساحة جامع الفنا القلب النابض للمدينة؛ فقد عمد مجهر السارد إلى التبئير على الجانب المهمّش منها حيث يسعى المتسولون والمتشردون إلى العيش على حافة الخطر، ووفق قانون الغلبة للأقوى.
ويتعزز هذا التركيز من خلال أسماء الأعلام التي تتراوح بين الاسم والكنية، وهي عادة مراكشية راسخة تقتضي أن نعطي لكل شخص كنية سوف تصبح بديلا حقيقيا لاسمه، ونعتا صحيحا لشخصيته وفق منظور الجماعة.
وعند استعراض الأسماء سنجد:
ـ «الروبيو» وهو اسم إسباني لنوع من الأسماك ذي رأس ضخم، ولعل هذا هو سر اللقب.
ـ رأس الحلوف: واللقب هنا فيه إشارة للخنزير خصوصا شراسته وقدرته على الهجوم والتقدم إلى الأمام.
وبالعودة إلى مفاصل القصة سنجد منذ الأول انضباطا قويا للمقوّمات الواقعية التقليدية في القصة انطلاقا من المقدمة حيث نجد رصدا لمكونات العالم أو الحالة العادية للعالم كنوع من التمهيد للحدث الطارئ الذي سيقلب الأوضاع يقول: «في تلك الليلة الصيفية القائظة، كان كلّ شيء يبدو طبيعيا، جامع الفنا تضجّ بالحركة، والمطاعم الشعبية تستميل الشهية بمعروضاتها، والمصابيح تتوهّج بقوة بينما يتحلّق الطاعمون حول صحونهم غير آبهين بالمارة من حولهم. وفي الحقيقة لم يكن يتلامح ما يثير الاهتمام1.
ويقتضي مسار القصة أن ينشب عراك بين الروبيو ورأس الحلوف حول من سيتزعم حشود الأطفال في ساحة جامع الفنا ويكون الآمر الناهي، فيكون مآل هذه المعركة هو انتصار الروبيو، وخضوع الجموع له بما فيهم عيشة البوالة التي كانت تكن الحبّ لرأس الحلوف. هكذا سينكفئ رأس الحلوف إلى كوخه خارج المدينة إلى أن يموت مهزوما مكسورا.
وبين الحدث الطارئ والنهاية الحتمية لمن احترف الهامش في ساحة جامع الفنا، سيتكفّل السرد والوصف بإضاءة هذا العالم الهامشي، والخلفية المأساوية التي تبرعم فيها رأس الحلوف.
لقد كانت عملية النقل لهذا العالم الهامشي، وكذلك عملية إثارة الانتباه للوجه الآخر للساحة تقتضي الالتزام بالواقعية السردية، ومحاولة نقل صورة مماثلة لما نعرفه عن العالم، لأن الهدف هو تكسير هذه الصورة المثالية لساحة جامع الفنا، وتكريس فكرة الغلبة للأقوى التي تقتضي حتى من الضعيف الذي هشّمته أن يمتثل لها ويخضع لقانونها.
ـــ 2 . حضور الأفق التجريبي بإلحاح؛ حيث لم يخضع الكاتب للمذهب الواقعي رغم أنه كان يمكّنه من توصيل أفكاره وفلسفته لجمهور القراء. لهذا بدأ يسعى إلى قول الأشياء بطريقة مخالفةـ ويجرّب تناول المواضيع التي يريد طرحها بشكل مداور يحضر فيه الجانب الجمالي؛ ففي نص «ترادف» نجد السرد ينجرّ إلى فضاءات بعيدة عن التقليد والتكرار، ويسعى إلى تنشيط الفعالية التخييلية لدى المتلقي من خلال تناوب في السرد بين الشخصية الرئيسية والسارد. فالشخصية الرئيسية رجل يدخل في حوار داخلي مع ذاته، ويحكي عما يعانيه من عسر في التعبير والكتابة، بحيث كلما همّ بالتعبير تنخلع كفّه فيغرق في الحيرة والتساؤل. وهو شخص يفضّل الصمت والاعتصام بتلّ ناء ومراقبة المدينة وإحراق الكتب للتدفئة بها في الليل المقرور. وفي الصباح يحلم بأنه طفل يلهو في الحقول الخضراء ولا يعكر صفو سعادته إلا أحجار مقالع الرمال التي تنهال عليه.
وأمام هذه الأحداث المتنافرة التي يرويها الرجل/ الشخصية الرئيسية بنفسه، والتي تدفع بنا نحو التعاطف معه. سيواكبه السارد وهو يحاول وصفه في سرد موضوع بين قوسين، غايته من ذلك فضح تصرّفاته وتوجيهنا نحو رؤيتها من وجهة نظر أخرى، فيذكر لنا ما تتميز به شخصيته من عشق للوحدة ومراقبة للسكارى والقطط، ويصف الطبيعة المحيطة به، والمرأة التي تنادمه وتلازمه في صمت رغم أنّه هشّم وجهها. كما يذكر لنا السارد أيضا أن هذه الشخصية تعاني حالة إعاقة حينما يتعلّق الأمر بمحاورة ليلى ومفاتحتها (وليس عسرا في التعبير مطلقا)، لأنه يعتقد أن لقاءه بها هو بمثابة إلقاء لؤلؤة في الوحل. وهو لا يريد إلا استضافتها في مشهد غروب وتركها تتأمل الأضواء والضلال، بينما هو يلامس نعومة جسدها الآسر.
إذن هناك نوع من التكامل بين الحوارات الداخلية للشخصية وما يقوله السارد؛ فالشخصية الحالمة تعيش أحلام وكوابيس غامضة (يجد نفسه في جزيرة النمل، حيث ستخرج عليه امرأة شوهاء تمسك بتلابيبه دون أن يفكر هو في الهرب. وحتى عندما لاذ بالصَّدَفَة المذهَّبة كان مشغولا بالقلعة المنيعة التي لم يمسك بسرّها، لأن الإمساك بهذا السرّ هو إمساك بروح الراوي) ولا تتوضح لنا هذه الأحلام إلا من خلال كلام السارد الذي يردّ هنا ـــــ كما أسلفنا ـــــ بين قوسين في شبه إضاءات، فقد اعتمد الكاتب ما يمكن أن نطلق عليه الحواشي أو الهوامش التي تستعمل كثيرا في الكتابة العالمة، ويكون الغرض منها التوضيح ولم لا الفضح.
ولأن التجريب يستثمر كلّ المسارات ويسير في كل الاتجاهات؛ فإننا نجد أثرا له في قصة «حضرة الحمار المحترم» حيث نجد صيغة سردية لاستحضار الحكي الشعبي عبر صيغة «الحكاية من داخل الحكاية» حيث ينتقل الكاتب من صوت السارد الأنيق العالم المفعم بالصور الشعرية إلى صوت الجدة الغرائبي والمملّح بالدارجة المحلية. يقول: «كنت أستعذب حكاياتها، وأتابع فمها المفتوح، وهي مضطجعة في ليل شتوي، فأرى من خلال دخان أزرق شفاف ينبعث من وجه كقمقم ويملأ الكوخ: حمارا وغزالة في الدهليز.. خرج فلاح للتو من الغرفة، وهو يدعك عينيه بكفيه. فقال الفلاح للحمار:
ـ قدامنا خدمة كثيرة ألغزيول!»(64). وفي هذا الانتقال احتفاء بالحكي التقليدي إعادة الاعتبار له بوصفه تعبير عن الوجود الحقيقي للجدة.
ــــ 3 . لا يشتغل الكاتب على سجل لغوي واحد أو معجم متناغم، ولكنه يعمد إلى تنويع السجلات التي يبني بها عوالمه السردية، ففي قصة «سلة العنب» يعمد إلى أسلبة اللغة الصوفية بطريقة بارودية، حيث إن الشيخ البهي سيدعو مريده الطهري إلى الاغتسال في نهر الخطايا في حين أن مقامات الصوفية تقوم على التقوى والورع والزهد. يقول: «اشتعل الشيخ البهي كعمود نور وخاطبني:
ـــ أيها الطهري، قم وادع أصفياءك ليتطهّروا بالاغتسال في نهر الخطايا، وليتخذوا معازلهم في طوايا الجبال، متبركين بالتأمل وقراءة كتاب الطهر المقدّس.. ستكون لهم آيات الكون سخرة، فيعمّ بطيبتهم النور والرخاء، وتصفو قلوب الذين أفسدوا ملكوت الله بخستهم ونذالتهم»(23)
ومقابل اللغة الصوفية يعتمد الكاتب في بعض الأحيان لغة إيروتيكية حتى عندما يتحدث عن عملية الكتابة والانشغال بها. ففي قصة «اشتغال التوالد» يقول وقد كان راقدا بجانب زهرة: «نهضت، غمست الريش في المحبرة، زحلقتها على القرطاس، كان البياض وحده منتشرا كالموت، غمست الريشة، مزقت القرطاس، نظرت إلى كومة القراطيس.»(28)
ولغة الكاتب المتألقة غير صافية، ولكنه بين الحين والآخر يستدعي لغة داخلية بوحية، ويكون هاجسه الأساس هو البوح والدفع بالسارد/ الشخصية الرئيسية نحو التعبير عن مكنوناته الداخلية، والإفصاح عمّا يخالجه من أحاسيس بدون اكتراث ببناء عالم سردي رصين. وبجانبها يكرس السارد حضوره عبر خرق اللغة السردية ببعض التعليقات التي تكسر رتابة السرد، وتستدعي من المتلقي التنبّه واستحضار ملكاته النقدية؛ يقول: «.. ولا شيء غير حطام الأجساد والصوامع والآلهة المصنوعة على مقاس، واللغات الهجينة الكريهة المنبعثة من أفواه المراحيض، والقتل الرمزي والجسدي، ومواسم اغتيال الملائكة.. عالمنا البديع الذي نأسف على مغادرته حين الوفاة. يا له من عالم!»(44) فصيغة التعجب تخلق توترا مع عبارة عالمنا البديع بشكل يوقظنا وينبهنا إلى عدم التعامل مع النص بوصفه معطى جاهز قابل للالتهام بدون فحص ولا تقليب.
ومع نبرة البوح تتصاعد أيضا اللغة الشعرية لتخترق المسارات السردية في شكل توقفات وصفية تأملية تعبر عن وضعيات مركبة ومعقدة؛ يقول: «إنني أستطيع أن أفهم تربية دالي المدعومة بحنان أمومي لشاربه الغريب كعجوز عاقر تعنى بقطة»(15)
والشيء نفسه سنجده أيضا في قصة «ملهم بن حدسان وتابعه المنغولي»؛ يقول:» الغروب يختال بانفجاراته اللونية المدهشة قبل أن تغوص عجلة عربة آلهة الضياء في بهمة الليل. من بعيد يترقرق نغم شجي لناي يستثير الملائكة اللواتي يرقصن في انسياب أثيري، وعلى الجانب الأيمن لرقوة شجرة مجدبة تمدّ قضبانها كقرون الأيائل، ومن الخلف تتجمّع المدينة على نفسها في بيات شتوي غارقة في غلالة من ضوء قرمزي»(56).
وفي قصة «المعطف» يدخل في حوار مع لغته الخاصة ويرسم لنفسه موقعا يخندق فيه لغته الخاصة؛ فحين طلب منه صديقه قدور العسكي الذي اعتبر نفسه هو فيودور دوستويفسكي وله مهمة تدقيق وتصحيح بعض العبا رات في إنتاجاته، يقول: « إننا نختلف، ولا يمكن أن أسدّ الثقوب التي تحدثت عنها، أنا أملك حساسية مغايرة، ولغتي فصيحة أكثر من اللازم، فصيحة بما يشبه التعمّد، لقد أقترح علي ذات يوم أن أكتب (متاعب موظف بسيط) على غرار الناس الفقراء، ألا تدرك أيها السيد المبجّل أنّ عليّ أن أتحرّر من لغتي باتجاه الشفوي والمحكي والملفوظ والمتلعثم المبتعد كلّما أمكن ـ عن رواسب البلاغة التي تختزنها ذاكرتنا خلسة وبدون موافقتنا»(53)
فالكاتب على وعي تام بلغته وبمكوناتها ومدى صلاحيتها في مقامات معينة فقط، ويستطيع أيضا الخروج منها نحو لغات أخرى.
ولكن كلّ هذا لا يمنعه من أن يدخل في علاقة مع أعلام الكتابة والشعر؛ ورغم مسحة التواضع التي يبديها في التعامل معهم، إلا أنه لا يستطيع أن يخفي مجابهته لهم، إذ هو يعبر عن عمق إدراكه لخاصيات أسلوبهم، وبجانب هذا يعلي من فرادة أسلوبه وطريقة تناوله، هكذا سنجد أنّه يعترف بأنه لا يمتلك مهارات أراغون للحديث عن جمال ليلى لأنها بالنسبة له شيء نادر وصاعق. ورغم ذلك يقوم بوصفها؛ يقول: «ملامحها تغني، رؤيتها تترك انطباعا غامضا، الذاكرة لا تستعيدها إلا شيئا لا يلمس بأصابع أو يلتقط ببؤبؤ.»(20) وفي موقع آخر يبدي السارد توجسا من محاولة كتابة كهف رمزي للأسرار عبر تقليد شكل الكتابة الشديد الاقتصاد لدى همنغواي، إذ تعتبر هذه العملية، حسب السارد، مغامرة خصوصا وأن الذي سيقوم بها لا يزال شابا طريا. وهو يروم وصف تدفقات شعورية كاسحة وشديدة الانفعال. وهذا التعبير ينم عن وعي شديد الحساسية بخصوصيات أسلوب همنغواي.
أعتقد أن استحضار الكاتب في قصصه لأعلام مشهورين بفرادتهم في عالم الكتابة يأتي هنا ليجعلنا نستحضر ما يعانيه الكاتب عموما من صراع مع اللغة، واتجاهه إلى خرق المواضعات اللغوية والمآزق الجماعية التي تضع الكاتب في صلبها من خلال سعيها الدؤوب إلى الدفع بالمبدع، كلّ مبدع، إلى الارتكان إلى ما راكمته وحققته من أبعاد تواصلية جماعية بالدرجة الأولى. ومن جهة أخرى يدفع بنا الكاتب نحو الاعتراف بتميّز أسلوبه وانتصاره حتى على هذه الأساليب المتفردة في الكتابة التي أصبحت، بحكم شهرتها، تندرج ضمن التقاليد الجماعية الواجب خرقها من أجل الانتصار على اللغة.
ـــ 4 . لا يستقيم الحدث في أي سرد دون وجود صراع، والصراع هنا داخل هذه المجموعة هو بالأساس بين السارد، لأن أغلب القصص يتماهى فيها السارد مع الشخصية الرئيسية، وبين الحياة واللغة. فهما الواقع الضاغط في جميع النصوص. والشخصيات تسعى دائما للهرب منهما أو التخلص منهما؛ يقول: «كنت قد التجأت إلى خلوتي متحررا من رطانة اللغات وبداءة السير المكتئب للحياة»(23). ويقول في مقطع آخر تعبيرا عن تلوث شخصيته وانهزامها « «ولدت في يوم ماطر نقطة ماء صافية كعين الديك، وبدأت أتعوّد على الذهاب إلى المقهى مسلما أذني للطنين الكاذب واللغة الرقيعة»(20). وبطبيعة حال السرد تنتصر اللغات دائما؛ ففي «كهرماء» يقول: «خاب ظني في اللغة نفسها لأنها تقتل عذرية الأشياء، وتقلّص حيويتها وامتداداتها.»(15) لهذا تبقى اللغة دائما غريما لا يفتأ يشعر السارد بالإحباط عندما يقف في مواجهته.
وإذا كانت اللغة معطى اجتماعي (أي أحد مظاهر الحياة) يفرض على الانسان الفرد إحداث اختراقات داخلها، لكي يحقق ذاته ويعلن انتصاره على الوجود، فإنها بشكل من الأشكال تقتل الفرد وتفرض عليه الانكفاء والتراجع إلى الوراء. ومن هنا تبرز لنا تيمة الموت التي تحضر في هذه المجموعة بقوة. فالإحباط من اللغة إعلان للموت، وانخلاع يد السارد عندما يريد الإفصاح عن ذاته إعلان للموت. وإيثار الكاتب البحث عن التواصل مع الأشياء خارج اللغة كلها تعبيرات عن هذه الرغبة القوية في الانتصار على الموت، وعندما لا يستطيع تحقيق هذه الرغبة فإنه الموت بعينه.
ــــ 5 . تعتبر الدراسات الحديثة أن الخط الفاصل بين القصة والحكاية يكمن في الوصف باعتباره عنصرا أساسيا يساهم في تشكيل العوالم السردية، ويوجهها نحو المسار الذي يرتضيه السارد أو الكاتب. وداخل هذه المجموعة ينتصب الوصف بشكل جلي وقوي في تحديد الفضاءات الزمانية والمكانية، ووسمها بالميسم المتناغم مع مسار الشخصية أو أحوالها النفسية. والوصف هنا بعيد عن الطابع التسجيلي، لأنه دائما مفعم بذاتية شعرية يمكن أن نقول إنها سحرية تركز على اللحظات الانتقالية أو المتحوّلة، وتمنحنا الطقس الملازم لدخول عالم القصة؛ يقول: «الصمت يوشوش للصمت، الليل وحده على العتبة، يحمل كناسة نهار ذابل والقمر في انزلاقه الواهن ونجوم شوارد تنز الضوء، كان صوت الفراغ يتصادى وعلى مبعدة شجرة جدباء توغل فروعها في جسد الضوء الزئبقي»(27)
كما يمكن أن نلاحظ أن الوصف يسير في اتجاه الدفع بنا نحو تنبي رؤية السارد الذي يرفض التابع ويسعى للإعلاء من قيمة مُلْهَم؛ يقول: «كان الاثنان مختلفين في الهيئة والمزاج، فالمنغولي قميء أكرش يبدو جلد جسده معبأ بما فوق الطاقة من لحم يكاد معه يتمزق، ورأسه الضخم، وجبهته العريضة، والشفتان الضخمتان، والعينان المفتوحتان في ضيق إلى الخلف الشبيهتان بعيني ذئب.. لقد كان مضجرا بحركاته العشوائية على خلاف متبوعه الذي يملأ الفضاء بحضور جسدي مؤثر رغم نحافته، بيد أنه كان فارغا، ذا ملامح متقاربة، لكنها لاذعة في إيحائها حتى لكأنّ الشعاع المنبعث من عينيه أذرع رقيقة..»(57)
ــــ 6 . يراهن السرد في لبوسه الحديث عن الإبراز القوي للفاعلية التخييلية التي لا تركن إلى المواضعات الاجتماعية والصورة المتعارفة عن العالم، ولكنها تخرق حواجز المعتاد في اتجاه عوالم جديدة. وتشتغل الفاعلية التخييلية للسارد في هذه المجموعة بقوة، وبنفس كافكاوي؛ فهو لا يرى نفسه إلا في التحولات التي يصير إليها. فعبر انتقاله فكريا في القطار سوف يطارده رجل سيتخذ ثلاث حالات فهو رجل نحيف يريد التودّد إليه، ولكنه يقابله بالتجاهل، فيتحوّل إلى عملاق يركب القمر، ومنه سوف يتقزّم إلى أن يصبح رجلا في حجم الإبهام. وخلال كل هذا سوف يستمرّ في مطاردة السارد الذي سيكتفي بإغماض عينه فقط كلما كان في مواجهته. وعندما سوف يدعكه بين يديه سيتلاشى السارد. فالصور الثلاث لهذا الشيء الذي يطارد السارد ماهي إلا تمثلات لحجم الخطر الذي يحسّ السارد أنه محدق به.
ـــــ 7 . الشخصيات في غالبيتها مبنية على أساس نفسي أو يحتل فيها الجانب النفسي حيزا مهما ـــ وهي شخصيات مشحونة برغبة قوية في البوح، وبوحها لا ينخرط في إطار المألوف، ولكنه يبحث عن لغة بعيدة عن الرطانات، لهذا فهي لا تفلح في التعبير عن ذاتها. يقول السارد في قصة «الترادف»: «ينسلّ مني ضوء لامع.. فيترك الجسد الطيني مرميا على الشاطئ كمعطف قديم، وأحيانا أبدو رخوا أتدفأ داخل صدفة مذهّبة.. وكلما هممت بتدوين ذلك تنخلع كفي، ثم تطير مهوّمة في فضاء الغرفة؛ أيُّ جنون يجبر على اغتيال الأصوات الهادرة والمويجات المتدافعة..»(18)
كما تبدو هذه الشخصيات معزولة أو تنشد العزلة في نوع من العشق للوحدة والطقوس الحزينة، لأنها تشكل مجالها للتأمل يقول في «الترادف»: «كان يمشي تحت الأضواء الخافتة مستسلما للصمت الهائل الذي يهب طعم الوحدة اللذيذ» (18) ويمتزج مع عشق الوحدة والانعزال عشق الابتعاد عن المدينة؛ إما لأنه وصل إلى نتيجة مفادها أن عالم الناس لم يعد جديرا بالعيش، وإما إثر الانهزام كما هو الحال مع شخصية رأس الحلوف في «الزنابق السوداء» الذي انكفأ إلى كوخه خارج المدينة وترك ساحة جامع الفنا حيث كان قائدا إثر انهزامه في المواجهة مع الروبيو. وبقي على هذه الحال إلى أن مات. لهذا لا يبدو غريبا أنّ العوالم التي يختارها السارد ويعتبرها جديرة بالسرد هي عوالم ضبابية رمادية يكتنفها الموت وتحيط بها الكآبة، وهي دائما مظلمة، بحيث تعبر عن دواخل الشخصيات، وعن السوداوية التي تطال مسارها، والتردد الذي يكتنف مسيرتها.
والشخصيات هنا لا تفعل، ولكنها تنفعل فقط بالواقع المحيط، وحتى حينما تُدفَع بفعل قوة خارجية لا تندفع بالشكل المطلوب؛ فالطُهري في قصة «سلة العنب» حتى عندما دعاه الشيخ البهي لم يتجاوب معه. يقول: «كنت قد التجأت إلى خلوتي متحرّرا من رطانة اللغات وبداءة السير المكتئب للحياة»(23)
وفضلا عمّا ذكر لا تستطيع هذه الشخصيات تحقيق الأهداف سواء المطلوبة منها أو التي حدّدتها هي لنفسها؛ فسارد قصة «كهرماء»، وهو طبيب نفسي، يجد نفسه عاجزا عن تقدير حجم المأساة المتولّدة عن عرض مسرحية «إمارة زهرة اللوتس»، وبالقدر نفسه هو عاجز عن الوصول إلى كنه شخصية الكاتب نظرا لقلة المعلومات عنه، ونظرا للعرض الفاشل للمسرحية.
ولا يوازي حالة العجز وعدم القدرة على الفهم إلا عدم انتصاره على الأولياء والصالحين الذين يستعملون علاجا وهميا رغم تسلحه بالنظريات والتقنيات.
وعموما الشخصية الرئيسية هي غالبا شخصية متعلمة تكشف لنا من خلال تشابكات النصوص، خصوصا نص «سلة العنب»، عن تلميحات إلى وضع المثقف الذي يبقى دائما متأرجحا بين أن يعتصم بأفكاره وينأى بذاته عن الجموع والسلطة، وبين أن يقدم بنات أفكاره خدمة للسلطان فيما يمكن أن يكون نوعا من الانتحار أو قتل للذات. لقد وصلت هذه الشخصية المتعلّمة إلى مستوى من الإحباط، لدرجة أنها أحرقت كتبها وجميع زادها؛ لأنه لم يظهر لها جدوى الكتابة والفعل الثقافي مع التوظيفات الانتهازية التي تعرضت لها. تقول: «لندع الثرثرة تستهلك نفسها، لقد عفت الكتابة، ياسيدي، يوم ذهبت في السيارة قال ذلك الأصلع الأمرد، القميء ذو العجيزة الضخمة والعين الحولاء الغمازة، الذي أكل بومبون البناء الديمو.. (لنطلق عليهم الكاتب يأكل أمخاخهم).. هل أطلق حنجرتي بالنباح، وأدور حول نفسي في هياج ثم أنطلق مسعورا أمزق الناس والأشياء، وأبول على جثث القيم المتعفنة؟!… (50)
ولعل فيما ذكرناه سالفا ما يسعفنا على القول في نهاية هذه الملاحظات أن مشروع الأستاذ أبو يوسف طه السردي، من خلال هذه الأضمومة، هو رحلة مجابهة مع اللغة العادية والمتداولة، عبر مجموعة من الشخصيات التي آمنت بأن مسارها محكوم بالفشل، وأن مآل سعيها هو الإحباط، لأنها لم تستطع التخلص من اللغة الرقيعة التي تقتل عذرية الأشياء، ولا من الفضاءات المدينية المفعمة بالرمادي، ولكنها لاتزال مصّرة على تأكيد ذاتها باختراق آفاق جديدة، وتوليد حالة متفردة وتجريب أدوات ترقى بها عن واقع مأزوم، وتعبّر عن عالم لا تتحكم فيه اللغة.
1 ـ أبو يوسف طه، سلة العنب، سلسلة إبداع شراع، يناير فبراير 1999، وكالة شراع لخدمات الإعلام الاتصال، طنجة. ص:33.