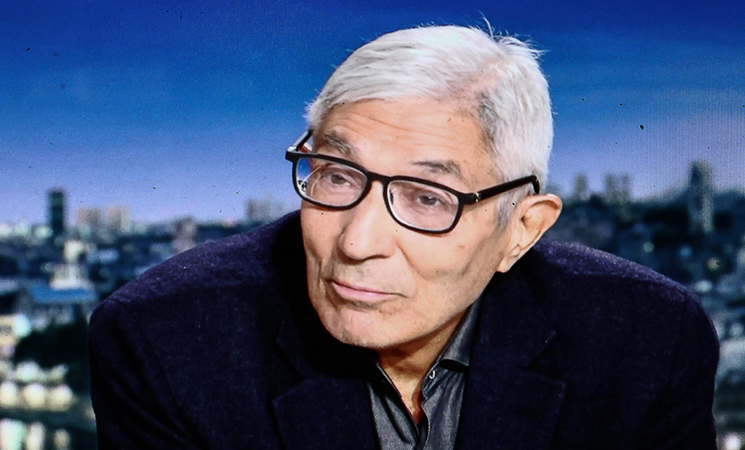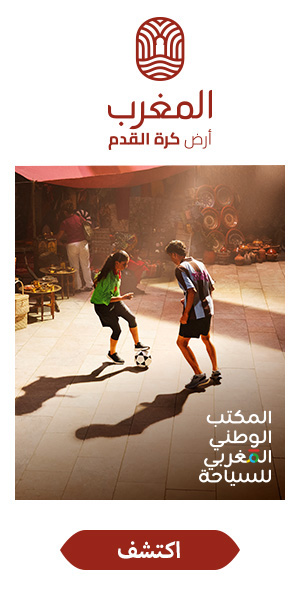لعل من الأمور الدالة بالنسبة لأسئلة البحث في مسارات أداء الحركة الوطنية بشمال المغرب، استمرار تجدد أسئلتها الموجهة للبحث وللسؤال، إلى جانب استمرار الارتكاز إلى زادٍ وثائقي غزيرٍ ومتنوع لم يحظ بكل عناصر الدراسة والتصنيف والتحقيق والاستثمار. وقد أدى هذا الوضع إلى إكساب مجال الدراسة صفة تحيينية قد لا نجد مثيلا لها بالنسبة لما أنجز بالمنطقة السلطانية التي كانت خاضعة للنفوذ الفرنسي. لذلك، أضحت أسئلة العمل الوطني التحرري بالشمال موضوعا متجددا بامتياز، بأسئلته وبقضاياه وبذهنيات قراءة مظانه ووثائقه. وعلى الرغم من حجم التخمة المعرفية التي أثمرها هذا الوضع، وعلى الرغم من استرسال صدور الأعمال القطاعية والمونوغرافية ذات الصلة، فقد ظل مجال الدراسة يتجدد من تلقاء ذاته تحت وقع الحافز العلمي المؤطر لجهود الباحثين والمهتمين، ثم تحت ضغط حالة الانزعاج المترسخ لدى نخب المنطقة من جراء حالة التهميش ووضعية التبخيس التي طالت تراث الحركة الوطنية بالشمال، جراء نزوع قيادات «المركز» نحو تكييف كتاباتها ومذكراتها، أو لنقل استيهاماتها، مع رؤى مغرقة في شوفينيتها التي ظلمت منطقة الشمال، وظلمت تراثها النضالي والإنساني والثقافي الخالد الذي أنجب هذا النهر الدافق المسمى بالحركة الوطنية التحريرية بالمنطقة الخليفية، الأمر الذي عكست معالمه الكبرى أعمال رائدة لرواد البحث في الموضوع، من أمثال محمد ابن عزوز حكيم، وعبد العزيز خلوق التمسماني، وعبد المجيد بن جلون، وامحمد بن عبود، وحسناء داود، وعبد العزيز السعود، وعبد الحفيظ حمان، ومحمد خرشيش …
في سياق تواتر مسار هذه الإصدارات العلمية، يندرج صدور كتاب «قضايا في تاريخ شمال المغرب المعاصر»، للأستاذ محمد الشريف، سنة 2024، في ما مجموعه 237 من الصفحات ذات الحجم الكبير، وذلك ضمن منشورات مؤسسة الشهيد امحمد أحمد بنعبود. وإذا كانت شهرة الأستاذ الشريف قد امتدت من موقعه كواحد من أبرز الباحثين المغاربة المتخصصين في قضايا تاريخ المغرب الوسيط، فإن انفتاحه على قضايا التاريخ المعاصر لم يكن بعيدا عن انشغالاته العلمية، الأمر الذي ترجمه في سلسلة من الأعمال المنشورة والندوات الأكاديمية والمنتديات العلمية الرفيعة، مما أكسبه وضعا اعتباريا رفيعا جعله واحدا من أبرز باحثي المغرب الراهن المشتغلين عل التراث النضالي والإنساني للحركة الوطنية بالشمال. وعموما، يظل الأستاذ محمد الشريف علامة ضوء فارقة في مسار شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، بالنظر لحصيلة منجزه العلمي الممتد في الزمن والمتوج بصدور عدد متتالٍ من الأعمال والدراسات العلمية الرصينة في مجالات التأليف والتحقيق والترجمة، نذكر من بينها كتاب «سبتة الإسلامية: دراسات في تاريخها الاقتصادي والاجتماعي»، وكتاب «قضايا في تاريخ المغرب والأندلس»، وكتاب «التصوف والسلطة بالمغرب الموحدي»، وكتاب «المغرب وحروب الاسترداد»، وكتاب «تطوان حاضنة الحضارة المغربية الأندلسية»، وترجمة كتاب «ملحمة الطريس: حقيقة الحماية الفرنسية الإسبانية بالمغرب»، وترجمة كتاب «ملاحظات حول تاريخ يهود سبتة في العصور الوسطى»، وتحقيق أجزاء من كتاب «تفسير نصرة الإسلام» لعبد الوهاب لوقش،…
يأتي الكتاب موضوع هذا التقديم ليستكمل الحلقات المسترسلة لعطاء الأستاذ الشريف، من زاوية التنقيب الرصين والبحث المتأني. لا يتعلق الأمر بمرويات لتجميع المعطيات المتناسلة داخل الإسطوغرافيات التقليدية والمجددة، بقدر ما يرتبط بوعي عميق لتوسيع مفهوم الوثيقة كأداة مرجعية في التنقيب، وفي النقد التاريخي كسلاح إجرائي لإضفاء البعد العلمي الخالص على النتائج وعلى خلاصات البحث ونتائجه. يقول محمد الشريف موضحا سقف هذا الأفق العلمي: «نعتقد أن البحث عن المصادر والوثائق واستنطاقها على ضوء ما تقدمه مناهج العلوم الاجتماعية المعاصرة، يشكل الخطوة الأولى لدراسة هذا الموضوع دراسة موضوعية علمية تشفي غليل الباحثين والمهتمين. فلا أحد يجادل الآن في أهمية استغلال ما توفره حاليا التقنيات المختلفة في معالج المعطيات التاريخية، وتوسيع الرصيد المصدري باستغلال الأفلام الوثائقية الخاصة بهذه الحركة، والممثلة في التظاهرات والإضرابات والمسيرات، واستغلال الصور الفوتوغرافية المنشورة بالجرائد والمجلات، والتقارير الأجنبية، هذا فضلا عن باقي الأدوات الأخرى الأكثر أهمية مما سبق ذكره من مصادر ووثائق، ومحاضرات، واجتماعات، وتقارير،… وعموما المصادر والمراجع التي لها صلة بالموضوع، إضافة إلى استغلال الروايات الشفوية، وفي مقدمتها الشهادات والإفادات الشفهية للفاعلين المباشرين. هذه الاعتبارات وغيرها دفعتنا إلى الإسهام في تجلية جوانب ظلت هامشية في كتابات المتخصصين في تاريخ الحركة الوطنية والمقاومة بشمال المغرب، وسندنا في ذلك هي مصادر ووثائق وتقارير قل ما استرعت اهتمام المتخصصين في الموضوع…» (ص ص.12-13).
توزعت مضامين الكتاب بين ثمانية مباحث، تناولت قضايا النضال الوطني التحرري بالشمال من زوايا مختلفة وبأدوات تنقيبية متباينة. ففي المبحث الأول، اهتم المؤلف بالبحث في أشكال تداخل البعد الشخصي والبعد الوطني في رسائل الشهيد امحمد أحمد بن عبود، وتناول المبحث الثاني المضامين الإنسانية للرسائل الشخصية المتبادلة بين قاضي تطوان سيدي التهامي أفيلال ونجله محمد الذي كان طالبا بجامعة القرويين بفاس خلال مرحلة ما بين سنتي 1906 و1912. وفي المبحث الثالث، توقف الأستاذ الشريف عند الجهاد والسياسة في كتاب «تفسير نصرة الإسلام» للفقيه عبد الوهاب لوقاش التطواني، المتوفى سنة 1923، في محاولة لإبراز أهمية المصادر الفقهية في دراسة الواقع المغربي والإسلامي خلال النصف الأول من القرن 20. أما المبحث الرابع، فخصصه المؤلف للتعريف بتنظيم الحكومة الخليفية بمنطقة الشمال وبوظائفها المتداخلة، وذلك بالاستناد إلى ذخائر الأرشيف الإسباني، وعلى رأسه أرشيف المقيم العام الإسباني الجنرال فاريلا. وفي المبحث الخامس، تتبع المؤلف أصداء رحلة الخليفة مولاي الحسن بن المهدي إلى إسبانيا سنة 1942، استنادا إلى ما نشرته الصحافة الإسبانية المواكبة للحدث. أما المبحث السادس، فاهتم بالكشف عن تقرير عسكري إسباني حول البنيات الاقتصادية والاجتماعية لمدينة شفشاون. واهتم المبحث السابع برصد الأصول الاجتماعية والثقافية لأعضاء المقاومة وجيش التحرير بإقليم شفشاون بين سنتي 1953 و1956، استنادا إلى تقنيات المنهج الكمي الإحصائي الذي أثمر نتائج هامة وغير مسبوقة في مجال الدراسات المتخصصة في الموضوع. وفي آخر مواد الكتاب، نجد ترجمة إلى الفرنسية للتقرير الخاص ب»دار الخليفة» بتطوان خلال عهد الاستعمار.
وفي كل هذه المحطات، ظل الأستاذ الشريف دقيقا في نبشه، عميقا في خلاصاته، متريثا في أحكامه. ولعل ذلك ما أضفى قيمة علمية رفيعة على مضامين البحث والتنقيب، ثم -أساسا- على أهمية استغلال المظان والوثائق. لقد كان الأستاذ الشريف محقا عندما أكد في إحدى خلاصاته المنهجية، أن مجال الدراسة لا يعدم مظانه ووثائقه، بقدر ما يفتقد إلى أسلحة البحث لتفكيك المضامين ولاستيعاب السياقات ولتفسير البياضات. يقول بهذا الخصوص: «الواقع أن تاريخ المغرب المعاصر لا يشكو من قلة المصادر والوثائق، بل من قلة الباحثين. فالمتخصصون في هذه الفترة يغرفون من بحر وثائقها ومستنداتها، عكس نظرائهم المهتمين بالتاريخ الوسيط الذين تعوزهم الوثائق ويشكون من شح المصادر، وهم في تعاملهم مع القليل من الوثائق التي بحوزتهم كأنهم ينحتون من صخر…» (ص.14).
إنها عين المؤرخ المنفتحة على ممكنات البحث، من أجل تحويل العدم إلى شلال للقراءة وللتأويل، عوض الاكتفاء باجترار السهل المتداول، وعوض الوقوف للتباكي على قلة المادة المصدرية والوثائقية. فمنطق البحث، وعدته المنهجية، وآفاقه التأويلية، تقتضي تسلحا بعناصر الصنعة التي تعيد قراءة حصيلة المنجز، وتشرئب لتجديد ذهنيات البحث والسؤال، في أفق تحويل الأرصدة الوثائقية والمصدرية الموجودة إلى حقل مشرع أمام أسئلة التفكيك العلمي، وأمام شروط عقلنة وظيفة المؤرخ وآفاق أسئلته المهيكلة للبحث وللتنقيب.
مع الأستاذ محمد الشريف في إصداره الجديد .. منطقة الشمال المعاصر أفقا للبحث وللتنقيب

الكاتب : أسامة الزكاري
بتاريخ : 04/09/2025