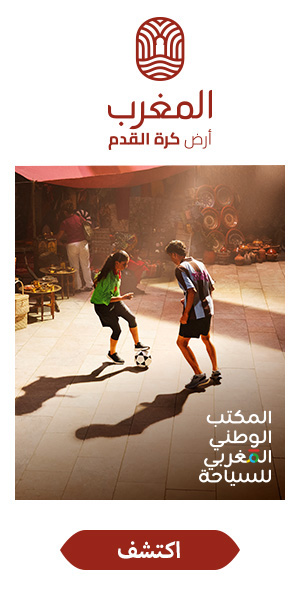الحراك الاجتماعي ونقد الشعبوية السياسية!

عبد الرزاق ايت بابا
يجب أن نميز بين الحركات التقدمية ذات الوضوح النظري والسياسي، وبين الحركات الشعبوية (mouvements populistes) الغامضة، والتي لا تحمل رؤية واضحة، أو لا تمتلك قيادة موثوقة جماهيريا، وقد تكون موجهة، بوعي أو بدون وعي من أصحابها.
فعلى سبيل المثال: كان القادة الثوريون أمثال لينين، قبل القيام بأي حركة، يكتبون تصورهم التكتيكي والاستراتيجي، وفهمه لمسائل الدولة والثورة والديمقراطية «?tat et r?volution, Que faire» وكذلك فعل المهدي بن بركة في الاختيار، أو عمر بنجلون في المقرر أو عبد السلام المؤذن في نظرية الدولة… إلخ. التقدمية هي إذن النضال تحت ضوء الشمس… الوضوح أمام العلن… القطع مع اي شكل من أشكال التضليل والضبابية التي تنتعش وسطها كل صنوف الانتهازية والرجعية والرغبة في الانتقام المرضي…
وعلى العكس من ذلك، تنتهي الحركات الشعبوية إما إلى الانتهازية السياسية (opportunisme politique)، أو إلى الشعبوية المفاهيمية (populisme conceptuel)، أو حتى إلى الانتحارية السياسية (suicidaire politique)، وهي مفاهيم ثلاث يمكن لنا من خلالها وصف أهم الحركات الاجتماعية التي عرفها الوطن العربي طيلة عقد ونصف أخير. والتي انتهت في جل حالاتها بالإنسان العربي للعودة إلى منطق ما قبل الدولة (على سبيل المثال، نشهد اليوم تفكك الوعي الوطني في سوريا مقابل انتعاش كافة أشكال الحس القبلي والعرقي والطائفي المتخلف).
لهذا يجب أن نحذر من »الراية العمياء« (أو العمية كما جاء في الحديث)، كما حذر منها النبي (ص)، أي من اتباع حركة أو قائد بلا بصيرة أو وضوح إيديولوجي. وخصوصا في زمن هو زمن الإمبريالية الجديدة، أي زمن الهجوم الشامل على مصادر الذات في دول العالم الثالث بتعبير الناقد الكندي تايلور (الدولة، اللغة، الأسرة) والتي تسعى إلى تفكيك الدول الوطنية، وخلق صراع بين إدارة الدولة وإدارة المجتمع.
فالإمبريالية تتمتع اليوم بقدرة خارقة على حجب أهدافها الحقيقية، والرجعية قادرة على إخفاء/تضبيب المفاهيم العميقة وراء شعارات إيديولوجية عولمية مثل «حقوق الإنسان»، و»الديمقراطية»، و»الوعي البيئي» و»حرية التعبير»…
لهذا، لا ينبغي أن نعتقد أن الحركة الحالية، تحمل جدة نظرية أو برنمجاتية أو غاياتية فقط لكونها تحمل اسما جديدا له سياق عولمي لنشأته، بل هي لا تحمل أي جدة نظرية إلا من حيث كونها استمرارا لمحاولة استئناف «الربيع» الذي هزم غير مأسوف عليه (في شروط أخرى)، على أن ترقى إلى مستوى «الحركات التقدمية» (mouvements progressistes) التاريخية التي طرحت مشروعا فكريا وسياسيا متماسكا في النظرية والبرنامج والغاية والأداة.
ويمكن أن نستحضر مثال فرنسا 1968 (وحتى أحداث السترات الصفر)، حيث اتخذ بعض «التقدميين»، أمثال لوي ألتوسير، أو من يسار الوسط (رايمون ارون)، موقفا غير متوقعا بدعم الجنرال ديغول اليميني المحافظ لأنه، وبالرغم من رجعيته، كان يدافع عن استقلال أوروبا أمام الهيمنة الأمريكية، خصوصا في ملف احتياطي الذهب والتحالف العسكري.
لهذا، يجب ألّا نقف تلقائيا مع أي حركة من باب سيكولوجية الجمهور، هذا ليس موقفا جدليا، أحرى به أن يكون وطنيا، في الشكل أو المضمون، بل اتخاذ مسافة نقدية (محايثة)، والانحياز دائما إلى ما يمثل الخط الوطني الديمقراطي (في حال تبلوره وتماسكه) الواضح الأهداف والأسس والأدوات. حتى إن استعمل في ظاهره، مواقف تبدو محافظة أو رجعية، أو على العكس، فالجدل التاريخي، هو التمييز بين الظاهر والباطن (أو كما يقول ماركس إنه لو تطابق الظاهر مع الباطن لما كنا في حاجة إلى علم التاريخ)، أي الخط الذي يؤطر أي احتجاج أو حركة في سياق وطني (يستحضر مصلحة كل الفئات والشرائح والطبقات الاجتماعية، ومصلحة إدارة الدولة وإدارة المجتمع)، ومن أجل دعم مسار الانتقال الديمقراطي، والذي يعتبر الشرط الوطني، الضرورة التاريخية له.
الكاتب : عبد الرزاق ايت بابا - بتاريخ : 04/10/2025