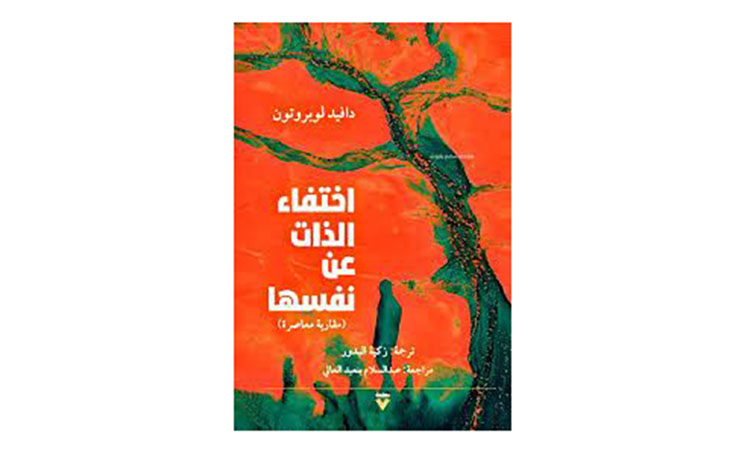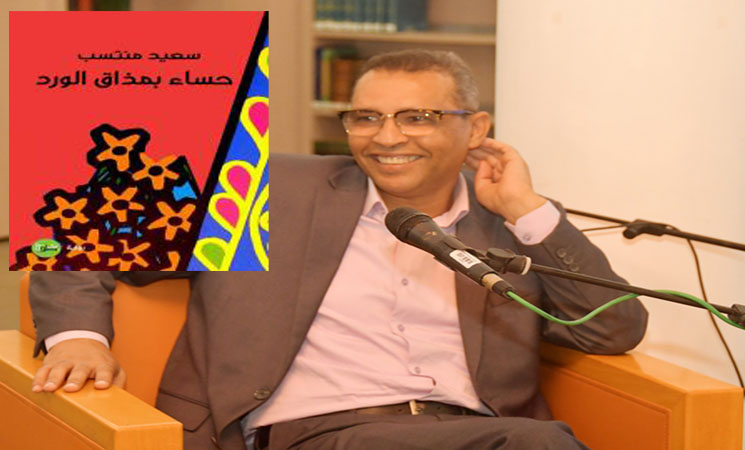الوُجودُ كإيقاعٍ، واللُّغةُ كترجَمةٍ: نَحوَ فَلسَفةٍ تَتَجاوَزُ حُدودَ التَّمثيلِ
تتمنع الماهية الفلسفية عن محاكاة التقليد والتكرار، غير عابئة بطوارئ الحياة والتباساتها. يأتيها سؤال الحاجة مسلوبا من إرادة التحول، وهي تنكشف عارية من كل الحقائق والتأويلات التي ألقمتها إياها الحدود العقلية المجردة، بما فيها التجارب التي طبعت دهرا عميقا في التفلسف والمحاورة وارتقاء الحكمة.
ألا يفترض هذا التجنيس الجديد للماهية الفلسفية، أن تتجسد روح الفلسفة وإيتيقاها، في التأسيس الملهم للفكر والحياة، والتحامهما على درجة متساوية، ليعبقا معا في أتون الصيرورة التي تحمل خطابها الوجودي والكينوني، بدرجة لا تفقد فيها هوية الإنسان وثقافته الغريزية قوة الحاجة وفرادتها المصيرية، بعيدا عن إفرازات اللازمني وتقاطعاته الثاوية.
ذلك ما يمكن استلهامه ونقده، في الفسحة الفكرية الراجفة التي حبلت بها إطلالة المفكر المغربي عبد الصمد الكباص «خيبة التمثيل: الجسد وأنثروبولوجيا الافراط» الصادر عن دار رؤية بالقاهرة عام 2021 (يقع في 223 صفحة من القطع المتوسط)، حيث تتسع الرؤية الثيولوجية للزمن، لتصبح فكرة الوجود تجربة مع فكرة أن كل ما يعاش داخلها يتحقق على قاعدة فقد أولي، كما لو أن فكرة «التجربة بكليتها تتحول إلى كائن منخور بمفارقة من الصعب تجاوزها، إلا باستعادة المفهوم باعتباره معيشا معرفيا».
يرى الكباص في تحليقه الأنطولوجي المفارق، أن بؤرة التفلسف هي بعض راسخ في باراديجم علاقة الحتمية (الفكر والحياة)، بل مركزيتها القدرية المتشاكلة، والمكتملة الرؤية، حيث «المحتوى الحق للفكر، هو الحياة ليس من حيث عمومية محضة، وإنما بصفتها تجربة بالمعنى المحدد»، مؤسسا لتراكم تمديدي (وليس تبديدي)، حيث الوجود غير قابل للإدراك إلا باعتباره صيغة متعينة في الموجود، .. كما الحياة، ليست متاحة إلا باعتبارها أسلوبا في الحياة».
وفي «خيبة التمثيل» تلك، التي ترصد دينامية الجسد وتخلقه النصي والاستقصائي، يستعيد المفكر الكباص وجها مغايرا لجسد أنطولوجي محايث، جسد في بعده الوجودي العميق، لا بوصفه مجرد مادة أو آلة بيولوجية، بل كشرط أساسي لتجلي الكينونة ولتجربة الإنسان للعالم. يستيقظ من وجومه السحري، ويتواجد بنفوره المتشاكس وقوته الرمزية، ليؤثث مجال استقطاب لذات خاصة وتجربة أخص، في سعي يتجاوز الرغبة المادية العليا، دون مقايسة للزمن، بل بتحوله إلى زمن مطلق إزاء نفسه، أو باعتباره مكانا منتجا للفائض عبر الرغبة.
التعريف، الهوية وشرط المعرفة
النواة الصلبة التي تشكل المعرفة وتطورها، هي يد التوحد. هو نداء دائم يتفوق على كل الارتهانات المؤججة للتفكير. هكذا يرى الكباص فهم قيمة المعرفة ووحدتها التي تشكلها وتتغياها. لذلك، يكون بناؤها لذاتها كاستدلالات وأقيسة وقضايا وأحكام وتعريفات ومفاهيم موجه لتلبية واجب الوحدة الذي يشكل بنظره مداها الذي من خلاله «يتحدد ما يمكنها أن تعرفه وكيف يجب أن يكون لتعرفه وكيف يمكن أن تعرفه». وواجب «الوحدة» هنا يمكن أن يستطيب هم الحقيقة التي لا تجد مُستقرَها إلا في الطابع الكلي للأشياء، متحلقة في البحث الحثيث عن إيجاد الهوية في الاختلاف والاستمرار والاتصال في كل انفصال وتقطع، والنظام في التشتت.
هو تماهٍ إذن يشيح بلثامه عن ثنائية ضاجة وعسرة، تنفعل فيها «الوحدة والمعرفة»، ما يؤدي بداهة إلى تولد مركب فاشي يعد نفسه الكل الذي يستوعب كل شيء، والذي لا يجب أن يكون خارجه أي شيء، يقول الكباص. بيد أن ثمة التباسا قابلا للتداول في هذه النظرية الواعدة، في طاقة العملية المعرفية، حيث لا يمكن النظر إلى التعريف على أنه مجرد تسمية أو وصف ثابت للأشياء، بل هو تجلٍّ حي لجدلية الاعتراف والتنكر. فكل مفهوم أو حقيقة تظهر أمامنا، تتشكل هويتها في مواجهة موقفنا منها؛ نقر بها ونعترف بوجودها، أو ننكرها ونرفضها، ليترسخ المعنى من خلال هذا التفاعل الجدلي. ومن هذه الديناميكية ينشأ نوع من المعرفة لا يقتصر على تراكم الحقائق، بل يسعى إلى الوحدة الداخلية والانسجام بين أجزائها، فتصبح المعرفة نتاجًا متكاملًا يحكمه منطق التماسك الداخلي.
إن فهم التعريف بهذه الطريقة يسمح لنا بتجاوز الرؤية السطحية للأشياء، ويجعل من كل محاولة للفهم رحلة استكشاف متشابكة بين الاعتراف بالوجود والتنكر له، بين الفهم والنقد، بين التفكيك والتركيب. وفي النهاية، ما نصل إليه ليس مجرد معلومات متفرقة، بل معرفة متماسكة تتجسد فيها وحدة الوعي وتماسك الفكر، وهو ما يجعل العملية المعرفية فعلًا ديناميكيًا مستمرًا، وليس حالة ثابتة من الإدراك. تماما كما ينبئنا الشيء الذي يجعل التعريف ممكنًا، هو ذاته الهوية الجوهرية للشيء، التي تبقى مضمرة حتى عند التعريف.
وفي الانتباه لهذه الزاوية الدقيقة من تداخل المفهومين، التعريف/ المعرفة، تنوجد حدود المضمرات والمصوغات المتقابلة لها، فتعتمل البواعث لصيرورة متغايرة ومستمرة، في محدد الهوية والتباس النقلة من (اللامعرفة إلى المعرفة)، وفرض وجود إرادة للتحرك المشمول بتعريفات الوحدة والماهية ومشكلة الاستقراء كمأزق للتشميل وقسريته، الذي تستدرجه لغة الزمن وصلاحيتها ومدى امتداد آثارها نحو المستقبل، وهو السؤال الذي لخصه كاتبنا في : «كيف يمكن في ظلِّ هذا الوعي القبلي بالوحدة والاتصال، أن نضمن أن الظاهرة غدًا ستكون هي نفسها التي لاحظناها اليوم؟ وكيف يمكن أن نحكم على المجهول بما حكمنا به على المعلوم؟.. وأي ضمانة ستضمن بدون تسليم مسبق أن ما لاحظناه في الماضي سوف يتكرر في المستقبل، وأن المستقبل سيكون مطابقا للماضي؟
لا مناص إذن من الاتكاء على وحدة المعرفة وليس فائضها، ذلك المجرى المتواتر في سلم التدافع، حيث تكتمل صورة تعلقنا بالمعرفة، بعيدا عن تعارضات التعريفات واجتزاءاتها ونقائضها لمشروع الوحدة، «فالنقطة التي يتقاطع فيها المجرى الأنطولوجي، أي سيلان احتمالات حدوث الكائن وكثرته وتعدده المنتج في اختلافه الدائم وتغايره المتعذر حصره، مع إرادة الوحدة التي ترتسم كقوة انتشالية تعمل على تجريد السيولة المتوثبة المستنزفة لإمكانية الواحد…»، هي ساحة معركة ممزقة يتجابه فيها التنكر والاعتراف، تجرنا إلى إعادة إثارة سؤال السياسة وليس سؤال المعرفة.
ترميم الأصل: عندما تندفع اللغة نحو حدها الأقصى
الإحالة إلى ترجمة العالم، ليست إيقاعا مختلفا عن عالم الترجمة أو «العالم مُترجما»، فهي فضاءات تتمثل في زخم تحقق فكرة العالم، تحت وضعية الانتماء للمشترك عابر للغات والرموز والعلامات والهوامش النوعية القريبة من تأويل الممكن. «العالم ـ كما يقول الكباص ـ مهمة ينبغي للترجمة إنجازها»، لكن في حدود ممارسة المعرفة بالحركة بين اللغات بوصفها استدعاء للغيرية المتعذرة على الاختزال.
لا سبيل إلى تحويل هذه الصورة، من مجرد اهتداء لفكرة الترويع إلى تنميط أو نقل متعمد، كما ليس من حق الفاعل الأسمى في تحديد الميكانيزم أن يبتدع طريقا زاحفا بالاختيار أو القرار الذاتي، بل يجب أن تكون بقوة وجودية متصلة، تبلغ فيها اللغة قيمتها العارمة، بغير اندفاع أو تجاوز حتى.
إن الترجمة، في تخوم هذا الاستلقاء المضمر لوجودها الحتمي والطبيعي، تستوفي دلالة السمو بالفكرة كفعل سيروري، كأساس يجعل من إمكانيتها ضرورة لا يمكن تفاديها. «مجال كاشف لتجربة صميمية لدى الانسان باعتباره كائنا يعاني في اللغة رغبته الأصيلة في العالم»، بتعبير الكباص، ثم يأتي اتساع الرؤية في نسق اللغات، كونيتها وشساعة دلالاتها المتصادمة، حيث تنبعث أرواح مهيبة، تلوذ بحصائلها إلى استعادة الفهوم وتحولاتها، مستدرجة طاقاتها الداخلية التي تجعل كل دلالة تبنى وتتحقق بوصفها حالة عدم اكتفاء. وحينما يسعفنا أثر الكوني في اللغة، يقول المفكر الكباص، على اكتشاف أن الوحدة البدئية لكل لغة، ليست هي وحدة الدال والمدلول، وإنما وحدة الدال والفقدان الجذري للمدلول، فإن كل لغة بطبيعتها الأسطورية تطلق مسلسلا للأبدية خارج السيطرة.
بيد أن اللغة أيضا تصطنع عالما خاصا بذاتها، إذ لا تنساق نحو تحويل غريب يتجاوزها أو يؤثر في أفق انتظاراتها وتمثلاتها لكل ما هو مؤجل وحتمي. وهو ما يجعل من قياس اندفاعها أو تدافعها، في أقصى قوتها المعاندة للتكلس والمعاندة، مجالا مفتونا لقول العالم، بعيدا عن إمكاناتها المعلقة على حواف الزمن وإمكاناته وتماسك دلالته. كما أن تشابك مفهوم العالم بوصفه حركة بين اللغات، يدير رحى الفرز وإيغال المعنى، فيما يولد المجازات ويوسع من مداخلها بما يمخض السيطرة البديعة لمشتركها وقابليتها للخلاص والتحقق الواعي بالحيز والاعتبار. فالترجمة هاهنا، ليست مجرد نقل كلمات من لغة إلى أخرى، بل هي نقل ثقافة وفكر ونمط تعبير. كما وأنها لا تتأثر اللغة المصدر بخصوصيات اللغة الهدف، ما يخلق حركات لغوية، من تغييرات في البنية النحوية أو ترتيب الكلمات، إلى استخدام مرادفات أو استعارات غير موجودة في اللغة الأصلية. علاوة على تأثير اللغة المترجمة على اللغة الأصلية (مثلاً إدخال مصطلحات جديدة). وهذه الظاهرة تسمى أحيانًا الاستعارة الثقافية اللغوية، وهي تُظهر كيف تتفاعل اللغات عبر الترجمة.
إن الترجمة فوق كل ذلك، ليست مجرد نقل للكلمات بين لغتين، بل هي تأويل للمعنى وتحرير له من حدود اللغة الأصلية. هي فعل إنساني أصيل، يرافق الإنسان منذ بدايات وعيه بالعالم والآخر، مما يجعلها مهمة أبدية تتجاوز الزمان والحدود، وتظل مرآة لعلاقة الإنسان بالمعنى والوجود. لكنها عند الكباص، تظل حقا غير مصرح به، يصعب من خلالها أن نفصل بين الحق في المعرفة والحق في الترجمة، بل إن الحق الأول متأسس بشكل غير قابل للتعويض على الحق الثاني؟.
ولتفكيك هذه الإشكالية، لا بد من استظهار علاقة المترجم الحسية والفكرية، على اعتبار الصورة التي تحصل بمجرد ممارسته المهمة بشكلها الحقوقي، باعتباره مقاوما ضد الفقر المعرفي. وذلك ما يؤسس انكشافه الجوهري على جدارية لغة الغير التي تفتقر إلينا، وتبحث عن معنى لتعويض نقصانها بارتقاء الأصل وإنتاج حقيقته الهاربة.
بول ريكور ينظر للترجمة على أنها تعبير عن الرغبة في الفهم والتواصل، وهي امتداد طبيعي للرغبة في التفاهم بين الثقافات، لكنها ليست مجرد تقنية لغوية. هذه الرغبة تنبع من، الاحتياج لفهم النصوص الأجنبية، عن طريق الرغبة في الوصول إلى المعنى العميق، وليس الكلمات فقط. وإعادة الحياة للنص الأصلي، إذ الترجمة تُعتبر نوعًا من «الولادة الثانية» للنص، تجعل معناه قابلًا للإدراك في سياق لغوي جديد، ثم التقارب بين الذات والآخر. فالترجمة عند ريكور فعل تأويلي وأخلاقي، لأنها تتطلب وضع نفسك في مكان الكاتب الأصلي، محاولة فهمه قبل إعادة صياغته.
من هذا المنطلق، نذهب بعيدا في أتون قراءة الترميم عند عبد الصمد الكباص، إلى أن الترجمة لا تحيد عن كونها فعلاً تأويليًا، حيث المترجم يشارك في الكشف عن المعنى، تقع فيه اللغة كوسيط للوجود. لغة ليست مجرد أداة، بل هي أفق للفهم؛ لذلك الترجمة تعكس علاقة الإنسان بالمعنى والعالم.
الجسدُ كإيقاعٍ، والطبيعةُ كشف: بوابة الوجود
يمثل الجسد المادة، الوعي، والوجود الإنساني. كما أن إيقاعه المهدر يرمز إلى الزمن، الحركة، والتناغم الكوني. فيما تعني الشفافية، تصوير الطبيعة بوصفها صريحة، مؤثرة، وموحية على الجسد والوجود. أما حركة الوجود فتجمع بين كل العناصر لتعكس العملية الديناميكية للكون والحياة.
هذا المنطق الفلسفي، يشغل جانبا مهما من كتاب «خيبة التمثيل»، بل يكاد يحدد الضلع الرئيس في خطاب الكباص الأنثروبولوجي/ الفلسفي، في اللغة والثقافة والهوية والتاريخ والتفكير والجسد والفرح والوجود والمجرى الأنطولوجي والغيرية والترجمة والرقص والسينما والزمان، وحركة التغاير والمتعة والرغبة والكون، والعدم والصورة والمفهوم والعالم والرؤية، والتجلي والقيمة والمحسوس والحواس والحركة والفن والكوجيطو… إلخ.
فليس من شرطية تحقق «اليوتوبيا» أو الفضاء المثالي، إحفاز النظام الاجتماعي أو السياسي، بل يمكن أن يتحقق من خلال الجسد نفسه والجسد هنا ليس فقط ككائن بيولوجي، بل كمكان للخبرة، للوجود، وللحرية. وبناء ميشيل فوكو على هذه الفرضية، توتير لقاعدة رؤيته الجسد كأداة للتمرد على القواعد، وكفضاء يمكن أن يتحقق فيه الفرد على حقيقته خارج السلطة والنظام الاجتماعي. إنه يحوّل مفهوم اليوتوبيا من كونه «مكانًا مثاليًا» إلى «تجربة وجودية» يمكن أن تتحقق في الفعل الجسدي، أي أن الجسد، بحريته وتجربته، يمكن أن يكون مساحة للخيال والتحرر. ويلتقي هذا النص أيضا مع فكرة تمنع الجسد عن الاختزال، الشيء الذي يؤكده موريس ميرلو-بونتي الذي يرى أن الجسد ليس مجرد موضوع بيولوجي، بل هو حيز خبرة وتجربة، يحتوي على الوعي والإدراك والتاريخ الشخصي والاجتماعي. الجسد إذن يصبح فضاءً للحياة، للذات، وللخبرة الإنسانية، ممتنعًا عن أن يُحوّل إلى مجرد شيء أو آلة.
الأجمل في الوضعية تلك، أن يصير نظام تصريف الجسد مرتبطا بعلامات صانعة للمحسوس، من حيث كونه يدبر قوة الإيقاع ودحض بعض من زيف وضعية جسد غير منتج للمعنى. كما لو أن الحقيقة، يقول الكباص، تنبش في ما بعد مظهرية الجسد الشكلي، من أجل تتبيث قدراته الهائلة في الكشف عن المخفي، حيث يكون الجسد «هو المكان الذي يستوي فيه العالم ويتضاعف». هناك حيث يتحول الجسد إلى خلفية ميتافيزيقية لكل ما يحدث.. خلفية تصبح من شدة كثافتها المادية المتعذرة على الاختزال، متخيلة، سابحة في الفراغ..».
فما علاقة ذلك بتحويل الجثة إلى حالة خاصة، يكون فيها تمويه الرقص وتلبسه، وعيا بالرغبة والوجود والحياة؟
يجيب الكباص مستشكلا، أن الجثة تشكل الحد البراني للجسد، أي أن الحد الخارجي الذي يستحيل على الجسد أن يتعرف فيه على نفسه، لأنه نمط من الوجود غير قادر على جلب قوى العالم وتفعيلها، ومن ثمة يستحيل على الجسد أن يتقاطع معه».
فالجثة باعتبارها مادة خاملة، لا تشارك في القوة الحيوية أو القدرة الفاعلة التي يمتلكها الجسد الواعي. ويشبه هذا التمييز بين الجسم المادي-الموجود في العالم والجسد الحي-الواعي الذي يدرك العالم ويؤثر فيه، كما عند ميرلو بونتي حين يفرق بين «الجسد المدرك» و»الجسد كموضوع فيزيائي».
وفي إدراك مغزى انتقال الكباص من الحد البراني إلى الخارجي، نفهم بالأساس استحالة التعرف على الجثة، فالجسد لا يستطيع التعرف على الجثة، لأنها نمط من الوجود غير قادر على تفعيل القوى، أي لا تمتلك فعالية ولا وعيا، وهذا يوصلنا إلى أن وعي الجسد يختبر العالم من الداخل، بينما الجثة مجرد شكل خارجي، فحدود الجسد الحيوي تنتهي حيث يبدأ الجماد أو الجمود. كما أن استحالة التقاطع مع الجثة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الجسد والجماد (الجثة) لا يتقاطعان، لأن الجسد يعتمد على القوى الحيوية والفاعلية التي تفتقدها الجثة.وهذا يفرض طرح المسألة الأنطولوجية للوجود: ما الفرق بين «الوجود الحي» و»الوجود الميت»، وما حدود الإمكانية الفعلية للجسد مقارنة بالمادة الجامدة؟
ومن داخل العقل الفلسفي، تبرز مستويات الثنائية حي/ميت، هل الجثة حقًا منفصلة تمامًا عن الجسد؟ فلسفيًا، يمكن القول إن الجثة لا تزال امتدادًا ماديًا للجسد، وتحتوي على الإمكانيات الفيزيائية نفسها، لكن غياب الحياة/الوعي يوقف تفعيلها. بمعنى آخر، الجسد والجثة ليستا كيانين منفصلين كليًا، بل هما نمطان مختلفان للتواجد ضمن نفس الكيان المادي.
صحيح أن الجسد والوعي الحيوي يمتلكان خصوصية في القدرة على التفاعل مع العالم، وهو ما يميز الجثة عن الجسد الحي. لكن المغالطة أن تطلق أحكامًا مطلقة عن استحالة التعرف والتقاطع، وتتجاهل الابعاد الرمزية والمادية والبيولوجية للعلاقة بين الجسد والجثة. وهذا يدفعنا إلى إمكانية إعادة صياغة المقولة بشكل أكثر دقة: «الجثة تمثل حدودًا للجسد الحيوي من حيث الفاعلية والوعي، لكنها تبقى جزءًا من عالم القوى الذي يظل يتفاعل معه بطرق غير واعية.»
*باحث وأكاديمي إعلامي من مراكش
*»خيبة التمثيل: الجسد وأنثروبولوجيا الإفراط» عبد الصمد الكباص، دار رؤية القاهرة، ط1 ـ 2021