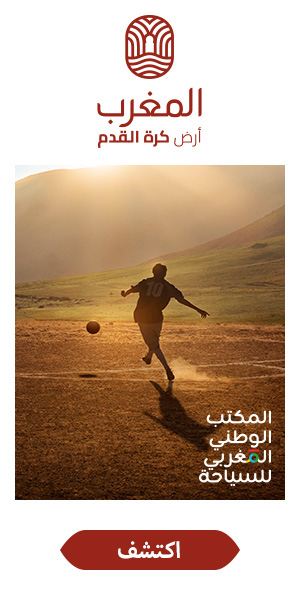نحو تمكين ديمقراطي للشباب المغربي
من التحدي الديمغرافي إلى التحول السياسي
يشكل الشباب المغربي اليوم، أكبر رصيد ديمغرافي واستراتيجي للمغرب المعاصر، حيث تمثل الفئة العمرية ما بين 15 و34 سنة أكثر من ثلث سكان المملكة، أي ما يقارب 11.5 مليون نسمة. وهو رقم يتجاوز دلالته الإحصائية ليُعبّر عن إمكان بشري فعال، يحمل في طياته طاقة هائلة للتحول، والإبداع، والمشاركة في بناء مغرب العدالة الاجتماعية والديمقراطية المواطِنة.
يعيش هذا الرأسمال البشري، في معزل عن السياسات العمومية المعنية بالإدماج الاجتماعي، مما يجعله عرضة للعديد من التدابير التي تتسم بالتذبذب وفقدان الرؤية الشاملة وتشتت الجهود، مما يؤدي إلى تفويت فرص تاريخية لتمكين الشباب، وتحويله إلى رافعة للتنمية البشرية والمجالية. فأصبح التحدي الديمغرافي، في ظل هذا التعثر، يتحول تدريجيا إلى أزمة اجتماعية مركبة، تتقاطع فيه أزمات البطالة، التهميش، ضعف المشاركة، العزوف عن الفعل السياسي، والهجرة، مفضيا إلى حالة قلق وجودي وشرخ في العلاقة بين الشباب ومؤسسات الدولة.
خصص تقرير ” النموذج التنموي الجديد ” موقعا مركزيا للرأسمال البشري، وفي طليعته الشباب، باعتباره مفتاح تجديد العقد الاجتماعي، لكن واقع الحال يكشف عن فجوة مؤلمة بين الخطاب الرسمي وممارسات الفاعل الحكومي . ففي الوقت الذي يؤكد فيه جلالة الملك محمد السادس، في أكثر من خطاب، على ضرورة إدماج الشباب في صلب المشروع التنموي، تبقى الإجراءات الحكومية عاجزة عن بناء منظومة متماسكة تعكس هذا التوجه، وتخرج الشباب من وضعية ” الفئة المستهدفة ” إلى” الفئة الشريكة “.
تستدعي الوضعية السوسيو اقتصادية للشباب اليوم، مسألة عميقة للبنية ونمط حكامة الشأن الشبابي بالمغرب، وانعكاساته الاجتماعية على هذا الرأسمال البشري. وفي هذا السياق، تُطرح هذه الورقة كإسهام نضالي وفكري يعكس الانخراط الواع لكل مكونات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في إعادة بلورة العلاقة بين الشباب والدولة من منظور تقدمي ديمقراطي حداثي . إنها ليست مجرد وثيقة تشخيصية ظرفية، بل دعوة إلى إرساء تعاقد سياسي جديد يعيد الثقة، ويكرس الإنصاف، ويُعلي من شأن الكفاءة والمشاركة الفعلية للشباب المغربي في السياسات العمومية.
نحن نؤمن، في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن تجاوز اختلالات السياسات الشبابية لن يتحقق دون تغيير في المنهج، وفي البوصلة. فالمطلوب ليس فقط مزيداً من البرامج، بل مراجعة عميقة لموقع الشباب في السياسات الوطنية، يتأسس على مشروع سياسي يجسد قناعات الاتحاديات والاتحاديين كون الشباب المغربي شكل دائما شريكاً في بناء الوطن لا تابعاً، فاعلاً لا متلقيا، منتجا وقائدا للحلول التنموية لا مجرد مستهلك لها. مشروع يراهن على الشباب كرافعة لبناء مغرب جديد، أكثر عدلا، وأكثر إدماجا، وأكثر ديمقراطية.
الواقع المركب للشباب المغربي: مظاهر الإقصاء وضعف الإدماج
يواجه الشباب المغربي اليوم وضعا بنيويا من الهشاشة والإقصاء المتعدد الأبعاد، في ظل تراكم اختلالات اقتصادية واجتماعية وسياسية تعرقل انخراطه الفعلي في دينامية التنمية والبناء الديمقراطي، وتنذر بتداعيات مقلقة على السلم الاجتماعي والاستقرار المجتمعي. ويعاني الشباب المغربي من إقصاء بنيوي يتجلى في محدودية فرص الولوج والتمكين من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتعتبر الإقصاء الاجتماعي سياسة ممنهجة من أجل حرمان الشباب المغربي من المشاركة الكاملة في جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للمجتمع الذي يعيشون فيه. ويعاني الشباب المغربي من الاستبعاد المتعدد الأوجه نتيجة هوياتهم الاجتماعية (مثل العمر، الجنس، العرق، الثقافة، اللغة) أو العوائق المادية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، شكلت نتائج تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2023 حول الشباب ناقوس خطر وإعلان صريح عن فشل التدابير الحكومية الترقيعية، حيث أشار التقرير أن فئة الشباب “NEET” تمثل أكثر من 4.3 ملايين شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة خارج منظومات التعليم والتكوين والعمل. وهو رقم صادم يعكس هشاشة بنيوية متعددة الأبعاد تطال هذه الفئة، وتكشف عن قصور عميق في نجاعة السياسات العمومية تجاه الشباب .
•الاقصاء الاقتصادي: البطالة وتآكل الأمل في المستقبل
يعتبر العامل الاقتصادي من أبرز الأسباب البنيوية التي تقف وراء تهميش الشباب المغربي، سواء في أبعاده المرتبطة بالبطالة، هشاشة الشغل، التفاوتات المجالية، أو ضعف الحماية الاجتماعية. فعلى الرغم من الخطاب المتكرر حول أهمية ” الرأسمال البشري ” و” أولوية الشباب “، لا تزال السياسات الاقتصادية التي تنهجها الحكومات المتعاقبة تعيد إنتاج نفس أنماط الإقصاء التي تعرقل ادماج هذه الفئة الحيوية في دينامية التنمية والاستفادة من فرص العدالة الاجتماعية .
يفضح ضعف نجاعة السياسات الاقتصادية في خلق فرص الشغل العديد من المعطيات الرسمية، والتي تشير إلى نسب بطالة مرتفعة ومزمنة في صفوف الشباب المغربي، خاصة بين حاملي الشهادات العليا. وبلغت نسبة البطالة بين الفئة العمرية 15 إلى 24 سنة حوالي 36.7%، وتبلغ 21% في الفئة من 25 إلى 34 سنة، مع تسجيل معدل بطالة مرتفع نسبيا يصل إلى 19.6% بين حاملي الشواهد، وهو ما يعكس إخفاق السياسات الاقتصادية والاجتماعية في استيعاب الطاقات الشابة وخلق فرص شغل ملائمة، لا سيما في ظل ضعف القطاعات المنتجة وصعوبة إدماج الشباب في سوق العمل الرسمي. ويمارس أكثر من 70% من الشباب النشيطين أعمالاً في القطاع غير المهيكل، دون عقود عمل، أو تغطية اجتماعية، أو تأمين صحي. حيث يعيش شباب القطاع غير المهيكل حالة لا استقرار الاجتماعي، وعدم قدرتهم على الولوج إلى التمويل، أو السكن، أو الحماية الاجتماعية، مما يكرّس تبعيتهم الاقتصادية، ويحول دون بناء مشروع حياة مستقل .
هذا الواقع يعكس فشل الدولة في تنظيم سوق الشغل، ويفضح اختلالا عميقا في البنية الاقتصادية التي لا تولي التشغيل اللائق الأولوية التي يستحقها، رغم تبني خطاب ” الدولة الاجتماعية”.
علاوة على ذلك، أعلنت الحكومة الحالية عن إطلاق برنامجي “أوراش” و”فرصة”، إضافة إلى تجديد برنامج “انطلاقة” والعمل على ضمان استدامته، في إطار التفاعل مع التوجهات العامة للنموذج التنموي الجديد.
غير أن تنزيل هذه البرامج طرح من جديد إشكالية النجاعة والفعالية، خاصة في ظل إسناد الإشراف عليها إلى قطاعات وزارية لا تمت بصلة لقطاع التشغيل أو قضايا الشباب، مما أضعف التنسيق وأفقد البرامج بعدها الاستراتيجي في الاستهداف.
وقد رافق هذه المبادرات اختلالات واضحة على مستوى التصميم والتنفيذ والتسويق، فضلاً عن غياب آليات المواكبة الفعلية، الأمر الذي أفرز شعوراً بالإقصاء لدى فئات واسعة من الشباب، كما زادت مظاهر المحسوبية والزبونية والتمييز على أساس القرب الحزبي من حدة هذا الإحساس بالإقصاء الاجتماعي الذي تسرب إلى نفوس الشباب المغربي، حيث تحولت هذه البرامج، التي تم الترويج لها كفرص واعدة، إلى مصدر خيبة ومرارة لدى مئات الشباب الذين وجدوا أنفسهم خارج دائرة الاستفادة، في خرق صريح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية.
أيضا تعمق الفوارق بين المدن والقرى، وبين الجهات، من حدة تهميش الشباب، فمعدلات البطالة ترتفع بشكل لافت في الجهات الأقل تطورا، والبنيات التحتية الاقتصادية والخدماتية تظل متمركزة في المدن الكبرى، ونتيجة لذلك، يجد الشباب في الهوامش أنفسهم مضطرين للهجرة الداخلية أو الخارجية، في غياب سياسات تنموية مندمجة تحفز الاستثمار والتشغيل في المجال الترابي المحلي، ويرسخ غياب تكافؤ الفرص بين الشباب حسب طبقاتهم الاجتماعية ومجالاتهم الجغرافية الفجوة بين من يملكون الموارد، والشبكات، والولوج، وبين من يعيشون على الهامش.
ففي غياب سياسات إعادة توزيع فعالة، يستفيد شباب الأوساط الميسورة من التكوين الجيد، والدعم، والعلاقات، بينما يُترك الفقراء في دوامة الإقصاء.
يكرس الاقصاء الاقتصادي، تداعيات نفسية واجتماعية، تتجاوز حد فقدان الدخل، بل يمتد إلى مستويات أعمق: الشعور بعدم الاعتراف، فقدان المعنويات، وغياب الإحساس بالانتماء، وهذا ما أكدته تقارير مثل “مؤشر الشباب للمعنوية”، التي أبرزت تراجع الأمل والثقة في المستقبل لدى الشباب المغربي مقارنة بالمعدل الدولي.
•الاقصاء الاجتماعي: هدر قدرات الشباب وترسيخ للقطائع
تظهر الدراسات أن الشباب المغربي يواجه تداعيات الاقصاء الاجتماعي باعتباره مظهرا من مظاهر الحرمان، بل باعتباره منظومة مركبة تعيد إنتاج الهشاشة وتعمق الفجوة بين الدولة وفئة حيوية من المجتمع. فالإقصاء الاجتماعي حالة هيكلية من القطائع المتعددة الأبعاد : انقطاع عن الفضاء العام، عن الاقتصاد الرسمي، عن التمثيلية السياسية، وعن المساهمة في التنمية .
في هذا السياق، يجد الشباب أنفسهم خارج دوائر الاعتراف والتمكين، رغم ما يملكونه من طاقات وكفاءات، ما يحولهم إلى فئة مهملة وغير مرئية في السياسات العمومية، ويؤدي هذا الوضع إلى هدر جسيم للرأسمال البشري الوطني، حيث تبدد الدولة، بصمْتها أو بتقاعسها، فرصا ثمينة لبناء نموذج تنموي قائم على مشاركة الجميع . فالشباب الذين يُقصون من فرص التكوين، الشغل، الإبداع والمبادرة، هم ذاتهم الذين كانوا قادرين على المساهمة في تنشيط الاقتصاد، وتحقيق التوازنات المجالية، وتجديد النخب، ودينامية التحول الديمقراطي.
الإقصاء هنا لا يعني فقط غياب الامتيازات، بل يجسد غيابا عميقا للعدالة، ويُغذي مشاعر الإحباط، واللامبالاة، وفقدان الأمل في الوطن. ويكرس هذا الوضع ثلاث قطائع عميقة بين الشباب والمؤسسات. أولها القطيعة التعليمية، تتجلى في انقطاع مئات الآلاف من الشباب عن صفوف التحصيل المدرسي دون مؤهلات حقيقية تسمح لهم بالولوج إلى سوق الشغل، مما جعل الهدر المدرسي تجليا ظاهرا للإقصاء الاجتماعي، حيث يغادر حوالي 331 ألف تلميذ سنويًا مقاعد الدراسة، خاصة بين السلكين الإعدادي والثانوي، نتيجة الفشل المدرسي، وصعوبة الولوج إلى المؤسسات، ولا سيما في المجال القروي، وضعف جاذبية التكوين المهني، إضافة إلى موانع سوسيو-ثقافية مثل تزويج القاصرات أو تشغيل الأطفال.
وثانيها القطيعة الاقتصادية، إذ لا توازي المؤهلات المتوفرة لدى الشباب، خصوصا حاملي الشهادات، أي عرض واقعي للشغل اللائق، بل غالبا ما يدفعون نحو قطاعات غير مهيكلة، تفتقر لأبسط شروط الكرامة والحماية. أما ثالث هذه القطائع، فهي القطيعة السياسية، حيث يشعر الشباب بانعدام التمثيلية، وضعف التأثير، وغياب القنوات التي تسمح لهم بالتعبير عن تطلعاتهم والمساهمة في رسم السياسات التي تمس حياتهم اليومية. ويتجلى الإقصاء أيضًا في ضعف الحضور الثقافي والإعلامي للشباب، وغياب المساحات العمومية المفتوحة التي تتيح لهم التعبير والمبادرة والانخراط، مما يعمق الشعور بالانعزال، ويؤدي إلى انسحاب تدريجي من الفضاء العمومي. وتزيد الهشاشة النفسية من حدة هذا الوضع، حيث أظهرت التقارير الدولية تراجعا ملحوظا في مؤشرات التفاؤل والمعنوية لدى الشباب المغربي، مقارنة بالمعدل العالمي، وهو ما يهدد التماسك الاجتماعي ويخلق بيئة خصبة لانتشار الأزمات الفردية والسلوكات الخطرة.
صار الإقصاء الاجتماعي للشباب حقيقة تطبع وضعية الشباب المغربي، نتيجة الحلول الترقيعية التي تنهجها الحكومة الحالية، والإجراءات الإحسانية التي تبنتها الحكومة السابقة. حيث الحاجة اليوم ماسة إلى مراجعة جذرية لمنطق بناء السياسات العمومية، عبر الانتقال من مقاربة ظرفية إلى رؤية استراتيجية تجعل من الإدماج الشامل ركيزة للاستقرار والعدالة. ويقتضي هذا التحول تبني سياسة وطنية مندمجة للإدماج الاجتماعي للشباب، تعيد الاعتبار للتعليم الجيد والتكوين الملائم، وتربط بين النمو الاقتصادي والتشغيل اللائق، وتضمن توزيعًا عادلًا للفرص على المستويين الترابي والاجتماعي. ويستشف مما سبق، أن الإقصاء الاجتماعي إذا ليس قدرا، بل نتيجة لاختيارات سياسية واقتصادية وثقافية حان الوقت لمراجعتها وتجاوزها، عبر إرادة للإصلاح الحقيقي تبدأ بالإنصات لصوت الشباب، وبناء تعاقد جديد معهم يؤسس لمواطنة كاملة وفعالة، تجعل من الكرامة والعدالة والتمكين أسسا لتجديد الدولة والمجتمع معا.
•الإقصاء الصحي واستبعاد الشباب من مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب
رغم التقدم الذي عرفه المغرب خلال السنوات الأخيرة في تعميم منظومة الحماية الاجتماعية، خصوصا بعد إطلاق الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، فإن فئة الشباب تظل من أكثر الفئات إستبعادا وإقصاء من هذا المشروع الطموح، سواء من حيث التغطية الفعلية أو من حيث الولوج المنصف والعادل للخدمات الصحية والاجتماعية. ويبدو هذا الإقصاء أكثر حدة لدى فئات الشباب غير المهيكل، والعاطلين عن العمل، وساكنة الهوامش، والنساء الشابات، ما يضعف أثر الإصلاح الاجتماعي ويحد من فعاليته في تحقيق العدالة الاجتماعية .
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن أغلب الشباب النشيطين اقتصاديًا، خصوصًا الذين يشتغلون في الاقتصاد غير المهيكل والذي يُشغّل أكثر من 73% من هذه الفئة، لا يتوفرون على تغطية صحية أو حماية اجتماعية. ويشمل هذا الغياب الحماية من حوادث الشغل، والتعويضات العائلية، والتأمين ضد فقدان الشغل، والمعاشات، وكلها آليات تعتبر جزءا أساسيا من عقد المواطنة في الدول التي تتبنى نموذج الدولة الاجتماعية. ونتيجة لذلك، يعيش آلاف الشباب المغاربة في هشاشة صحية دائمة، سواء عند المرض أو عند التعرض لحوادث العمل، أو أثناء فترات البطالة، دون أي شبكة أمان توفر لهم الحد الأدنى من الحماية والكرامة.
ويتفاقم هذا الوضع بسبب ضعف التغطية الصحية العمومية نفسها، سواء من حيث جودة الخدمات أو توزيعها الجغرافي، إذ تسجل تفاوتات صارخة بين الحواضر والمناطق القروية، وبين الجهات، فيما يتعلق بالولوج إلى البنيات الصحية، أو التخصصات الطبية، أو الفحوصات المكلفة. كما أن نسبة كبيرة من الشباب، حتى عندما يكونون منخرطين في منظومة التغطية، يجدون أنفسهم أمام عراقيل إدارية ومالية تحول دون استفادتهم الفعلية من الخدمات الأساسية، مما يدفعهم إلى القطاع الخاص أو إلى الامتناع عن العلاج.
ويضاف إلى هذا البعد الهيكلي، محدودية السياسات الصحية الموجهة أساسًا إلى الشباب، حيث لا تولي الاستراتيجيات الوطنية للصحة الأولوية الكافية لمشاكل الصحة النفسية، أو الإدمان، أو الصحة الجنسية والإنجابية، أو الأمراض المزمنة التي تصيب الشباب، وهي كلها مجالات تعتبر أساسية لضمان عيش كريم وسليم للفئة الشابة، وتمكينها من بناء مشروع حياة آمن ومتكامل.
ويعمق إقصاء الشباب من الحماية الاجتماعية، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ثقة الشباب في الدولة وفي المؤسسات، ويحول دون بناء مجتمع متوازن يضمن الحماية للجميع. كما أنه يقوض مرتكزات العدالة المجالية، باعتبار أن الفئات الأكثر تضررا من غياب التغطية الصحية الشاملة هي تلك التي تقطن في المناطق الهامشية والفقيرة.
إن الدولة الاجتماعية لا تكتمل بدون حماية صحية واجتماعية عادلة وشاملة لجميع الفئات، والشباب في طليعتها، واستمرار استبعاد الشباب من هذا الورش الوطني يعني تقويض أحد أعمدته الأساسية، ويجعل من شعارات المساواة والتكافؤ فارغة المحتوى. فالشباب المغربي لا يطلب الامتيازات، بل يطلب فقط عدالة وكرامة ومساواة، وأي نموذج تنموي لا يُلبّي هذه المطالب سيكون حتمًا عرضة للانتكاس والفشل.
•الإقصاء الثقافي والتعبيرات الشبابية: غياب الاعتراف ومصادرة الهوية
يشكل الإقصاء الثقافي أحد أبرز مظاهر التهميش المركب الذي يطال فئة الشباب المغربي، حيث تصادر حقهم في التعبير، وتختزل هويتهم في أنماط ثقافية رسمية لا تعكس واقعهم ولا تنسجم مع تحولاتهم القيمية والاجتماعية. وفي غياب فضاءات عمومية حرة ومنفتحة تتيح الإبداع والمشاركة والتأثير، يشعر كثير من الشباب بأن الثقافة، كما تنتجها الدولة أو تحتضنها المؤسسات، لا تمثلهم، بل تُقصيهم ضمنيًا من دائرة الاعتراف. ولا يتعلق الأمر فقط بندرة البنيات الثقافية، أو ضعف تمويل المشاريع الإبداعية الموجهة للشباب، بل بمشكلة أعمق تتصل برؤية الثقافة نفسها، باعتبارها مجالا للتحكم بدل أن تكون أداة للتحرر والتعبير. فبدل أن توظف الثقافة كوسيلة لبناء المواطنة، وتقوية الانتماء، والاعتراف بالاختلاف، يتم توظيفها أحيانا كأداة لإعادة إنتاج الهيمنة الرمزية والضبط الاجتماعي، ما ينتج تنافرا عميقا بين الثقافة الرسمية والتعبيرات الشبابية الصاعدة. وتشير خلاصات تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول ادماج الشباب عن طريق الثقافة، إلى أن الانخراط الثقافي للشباب المغربي يعاني من هشاشة هيكلية مرتبطة بعدم اندماجهم الفعلي في الحياة العامة، وغياب الاعتراف بثقافتهم، وتهميش الإبداع الشبابي الحديث. ويكشف التقرير عن غياب رؤية استراتيجية مندمجة تدمج الثقافة ضمن سياسات تطوير الهوية والمواطنة للمجتمع، ويفتقر العمل الثقافي العمومي إلى رؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار صوت الشباب كفاعل رئيس.
في الواقع، تمثل الفضاءات الثقافية الحكومية – من مسارح ومكتبات ومراكز شبابية – إما خطوطا متوارية أو غير متواجدة أساسا في الأحياء الشعبية والمناطق القروية. فتظل الثقافة الرسمية محصورة في مناسبات تراثية أو مهرجانات فصلية، بينما يجسد عدد من الشباب هويتهم من خلال ألوان موسيقية أخرى كموسيقى الشارع والراب، والغرافيتي، ومحتويات رقمية تناقش هموم الإصلاح والعدالة. لكن، تعاني هذه التعبيرات من سوء الفهم المؤسسي أو أنها تختار قاموسا عنيفا وغير لائق من الناحية القيمية، وغير متوافق على توظيفه في التواصل المجتمعي، فيدفع هذا التعبير بها إلى الوصم بكونها “انحرافا”، مقرونا أحيانًا بالحظر أو الحل الأمني.
ويثير هذا الاقصاء الثقافي ثلاث مخاطر جوهرية:
•مصادرة الهوية المتجددة: إذ يُمكن للإبداع الشبابي أن يساهم في بناء حرفية استراتيجية ثقافية وطنية مواكبة للتحولات، لكن غياب الاعتراف يفرّغ هذه الحيوية من معناها ويقوض الشعور بالانتماء.
•هدر الرأسمال الثقافي والاقتصادي: يتسبب نقص بنى تحتية متواصلة في هجرة الكفاءات الشابة إلى المشرق والمغرب، وتراجع الحضور الإبداعي المحلي.
•فقدان الثقة بالمؤسسات: حيث يؤدي التعامل الرسمي مع الثقافة الشابة كظاهرة هامشية إلى تراجع الشعور بالتمكين وتنامي الإحساس بالقصور الثقافي.
في هذا السياق، وجب التأكيد على ضرورة الاعتناء بمفاهيم جديدة لم يكن المجتمع العامي يلقي لها بالا، تتمثل في التراث المادي واللامادي، والتي أصبحت الجهات الرسمية وغير الرسمية تسارع للتعريف به والدفاع عن عناصر ومكونات الهوية المغربية، وصار المواطن والشباب بدرجة كبيرة ينخرطون في حملات التنبيه والتوعية والتحسيس، لكن يلاحظ قصور الفهم الكبير وعدم الدراية، بتاريخ الوطن، وسطحية المعطيات المتفاعل بشأنها، وهو ما يجعل الارتباط الهوياتي مهلهلا في غياب التعريف بالحضارة والهوية المغربية والقيام بالدور الرسمي الواجب ودعم المبادرات التي تسير في هذا الصدد .
فالثقافة ليست قطاعًا ثانويًا، بل هي جوهر التماسك، والإبداع، والحوار، وبناء الثقة، والإقصاء الثقافي للشباب هو شكل من أشكال الإنكار الرمزي الذي يُفاقم الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
لذا فإن تمكين الشباب ثقافيًا ليس ترفا، بل شرط أساسي لعدالة اجتماعية حقيقية، ولديمقراطية تنبني على الاعتراف، والمشاركة، والحرية.
•الإقصاء السياسي والمواطنة المعطلة
تظل المشاركة السياسية للشباب ضعيفة ومحدودة، سواء في مستويات اتخاذ القرار أو في التمثيلية المؤسساتية أو في الفعل السياسي المنظم. وتتجلى مظاهر الإقصاء السياسي بشكل واضح في نسب المشاركة المتدنية في الانتخابات، وفي العزوف عن الانخراط في الأحزاب السياسية والنقابات، وفي ضعف تمثيلية الشباب داخل المجالس المنتخبة. هذه الوضعية ليست ناتجة عن فتور ظرفي، بل عن اختلالات عميقة تؤدي إلى ما يمكن تسميته “بالمواطنة المعطّلة”، أي مواطنة تمارس جزئيا، أو تفرغ من بعدها التشاركي والحقوقي الكامل .
فالإقصاء السياسي للشباب لا يُختزل في ضعف الحضور الكمي، بل يُعبّر عن فقدان الثقة في الوسائط التمثيلية التقليدية، وعن شعور متنامٍ بعدم الجدوى من الانخراط في آليات لا تتيح التأثير الفعلي في القرار العمومي. فرغم دسترة مشاركة الشباب، وتنصيص الوثيقة الدستورية لسنة 2011 على أهمية إشراكهم في التنمية السياسية، فإن الواقع العملي لم يُترجم هذه المبادئ إلى ممارسات ملموسة. فالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الذي نص عليه الدستور، لم يُفعَّل بعد، وبشكل لا يرقى إلى تطلعات الفئات الشبابية في التمثيلية والمشاركة الحقيقية.
هذا الإقصاء المؤسساتي يدفع الشباب نحو التعبير عن آرائهم ومواقفهم من خارج الأطر الرسمية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والمبادرات المدنية غير المؤطرة، وأحيانًا من خلال التعبيرات الاحتجاجية ذات الطابع الثقافي أو الاجتماعي، مما يعكس حاجة الشباب إلى فضاءات بديلة تسمح لهم بإيصال صوتهم وصياغة مشروعهم المجتمعي. لكن هذه الدينامية المواطنة غير الرسمية، وبدل أن تحتضن وتطور، غالبا ما تواجه بالتضييق أو بعدم الاعتراف، مما يزيد من تهميش الشباب سياسيًا ورمزياً.
وفي ظل هذا المناخ، تتحول المواطنة، بالنسبة لفئة واسعة من الشباب، إلى مجرد صفة قانونية لا تتجاوز حمل البطاقة الوطنية أو ممارسة واجبات ضريبية، دون أن تتحقق كإطار فعلي للحقوق، المشاركة، المساءلة، والانتماء. ويُسهم هذا الواقع في تفريغ الفعل السياسي من مضمونه، ويجعل البناء الديمقراطي هشا، قائما على قاعدة اجتماعية ضيقة وغير متجددة. إن تجاوز هذا الوضع لا يقتصر على الدعوة إلى تشجيع الشباب على التصويت أو الانخراط في الأحزاب، بل يستلزم تحولا بنيويا في الفلسفة السياسية المتحكمة في بلورة وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بالشباب. إن الشباب المغربي لا يعزف عن السياسة عبثا، بل لأنه لم يجد فيها ما يعبر عن طموحه، ولا من يحتضن صوته بجدية. واستعادة الثقة، وتجديد العقد السياسي، يتطلبان إشراكا فعليا للشباب في صياغة السياسات العمومية، وتمكينه من الإسهام في قيادة التحولات، لا الاكتفاء بدور المتلقي أو المفعول به.
فالمواطنة ليست شعارا دستوريا فقط، بل ممارسة يومية، تقوم على الحق في الكلمة، والمبادرة، والاختلاف، والرقابة. وكل سياسة تُقصي الشباب من هذا الحق، تفرغ المواطنة من مضمونها، وتهدد ركائز الدولة الديمقراطية.
•الشباب والهجرة : الاغتراب مزدوج
في ظل تراكم أوجه الإقصاء السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، تعيش فئات واسعة من الشباب المغربي حالة تمزق وجداني ومجتمعي بين واقع وطني مغلق على إمكانات الحياة الكريمة، وأفق خارجي يُنظر إليه كملاذ للخلاص الفردي. لم تعد الهجرة – في نظرهم – خيارًا حُرًّا تُحدده الرغبة في التجربة أو الاستكشاف، بل ضرورة قاسية تفرضها انسدادات الأمل الداخلي، وتضاؤل فرص التمكين والانخراط، مما يحوّل فكرة ” الخروج من الوطن ” إلى حلم جماعي معلن. وقد كشفت نتائج دراسة استطلاعية حديثة صادرة عن البارومتر العربي، تحت عنوان “الرأي العام اتجاه الهجرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، عن معطيات صادمة، فـ 55% من الشباب المغاربة بين 18 و29 سنة يرغبون في مغادرة البلاد، مقابل 35% كمعدل عام وطني في بلدان أخرى، و24% فقط ممن تجاوزوا سن 30. هذه الأرقام لا تُعبّر عن تفضيل فردي، بل عن مؤشر واضح على أزمة مواطنة وانهيار الثقة بين الشباب والدولة، ونتيجة مباشرة لتراكم الفشل في السياسات العمومية، خصوصًا في التعليم، والتشغيل، والعدالة المجالية، والمشاركة السياسية. والمثير أن 42% من الراغبين في الهجرة هم من حاملي الشهادات الجامعية، ما يعكس تناقضا صارخا بين منظومة التكوين الوطني وحاجيات الاقتصاد، ويترجم شعورًا عارمًا بانعدام الجدوى من البقاء. الشباب المتعلم، الذي يُفترض أن يكون ركيزة لمشروع وطني حداثي، يتحول إلى كتلة هائلة من الطاقات المُهدَرة، الطامحة في الانتماء إلى منظومات أكثر عدالة وتقديرًا للكفاءات. وعلى صعيد الوجهات، يحتل الحلم الأمريكي والكندي والفرنسي الصدارة، وهي دلالة لا تخلو من رمزية: هؤلاء الشباب يبحثون عن فضاءات تعترف بأهليتهم، تضمن حرياتهم، وتحمي كرامتهم، ولو بثمن الاغتراب. بل إن ما يقارب 53% منهم يصرّحون باستعدادهم للهجرة بطريقة غير نظامية، أي أنهم على استعداد للمغامرة بأرواحهم ومصيرهم، مقابل فرصة العيش خارج شروط الإقصاء الوطني .
إن هذا الميل المكثّف نحو الهجرة غير النظامية لا يعكس فقط أزمة اقتصادية، بل انسحابًا رمزيًا من العقد الاجتماعي، و عندما تفقد المواطنة معناها – كحق في المشاركة، والكرامة، والفرص – يُصبح الرحيل فعلًا احتجاجيًا صامتًا، ورسالة قوية للنظام السياسي بأن ثقة الشباب قد بلغت نقطة اللاعودة.
ولعلّ أخطر ما في هذا النزيف البشري والمعنوي، هو أن الدولة لا تزال تتعامل مع الهجرة الشبابية كظاهرة أمنية أو كمجال للتعاون مع الشمال، بدل أن تُواجهها كمرآة عاكسة لعطب داخلي يتطلب إصلاحًا جذريًا للسياسات العمومية.
فالشباب لا يهاجرون فقط بحثًا عن عمل، بل هربًا من التهميش، ومن سلطة لا تُصغي، ومن مجتمع لا يُنصف، ومن ثقافة لا تُعبّر عنهم. لقد حان الآوان، من أجل العمل على صياغة سياسة وطنية جديدة للهجرة ترتكز على الاحتفاظ بالكفاءات وتعتمد مقاربة شمولية تدمج البعد التحفيزي والبعد المؤسسي، من خلال خلق بيئة حاضنة للإبداع والبحث العلمي، وتحفيز الاستثمار في الرأسمال البشري، وتحسين ظروف العمل والمعيشة للكفاءات الوطنية. كما ينبغي أن تتضمن هذه السياسة آليات ملموسة للاستماع إلى حاجيات النخب المغربية، سواء داخل الوطن أو خارجه، وتوفير حوافز تشجع على الاستقرار والمساهمة الفعالة في البناء الوطني، مع العمل في الآن ذاته على استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج عبر برامج مهيكلة للاندماج المؤسسي والتوظيف النوعي. وفي هذا الإطار، يضطلع حزبنا بدور محوري في الدفاع والتنظير لهذه المقاربة، من خلال تبنيه المتواصل لقضايا العدالة الاجتماعية والمجالية، وحرصه على صون كرامة المواطن المغربي وخصوصا الشباب. فقد جعل الحزب من قضية الاحتفاظ بالكفاءات والنهوض بالرأسمال البشري أولوية ضمن تصوراته التنموية، ودعا في العديد من المناسبات إلى سن سياسات عمومية عادلة توفر شروط العيش الكريم وفرص التميز داخل الوطن، وتقطع مع منطق النزيف البشري والعقلي الذي يكلف البلاد أثماناً باهظة. كما يجب إحداث شبكات لربط كفاءات المهجر بالمشاريع التنموية داخل الوطن بما يعزز من مساهمتهم الفعلية في المسارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد.
وتقتضي هذه الشبكات اعتماد مقاربة تشاركية تدمج مختلف الفاعلين: الدولة، والجماعات الترابية، ومؤسسات البحث العلمي وحتى الأحزاب السياسية، قصد بلورة مشاريع استراتيجية تستثمر في خبرات وكفاءات مغاربة العالم، وتوفر لهم إطاراً مؤسساتياً فعالاً للانخراط في تنمية الوطن. وننوه في هذا الصدد بالمجهودات التي يقوم بها الأخ الكاتب الأول في هذا الجانب كان آخرها استقباله لوفد جمعية الشباب المغاربة بتولوز يوم 04 يونيو 2025 بالمقر المركزي للحزب في إطار انفتاحه على مغاربة العالم وكفاءات المهجر. فالحزب يعتبر أن تعبئة كفاءات المهجر لا ينبغي أن تظل موسمية أو رمزية، بل يجب أن تؤطر ضمن شبكات مهنية واقتصادية وعلمية مندمجة.
•الشباب ووسائط التواصل – إمكانات التأطير وتحديات الوساطة
شهدت السنوات الأخيرة تحولاً عميقاً في أساليب تعبير الشباب المغربي وانخراطهم في الشأن العام، بفعل الثورة الرقمية التي جعلت من شبكات التواصل الاجتماعي فضاءات رئيسية للتفاعل والتأثير، بديلاً عن الإعلام التقليدي ومؤسسات الوساطة السياسية التي لم تعد قادرة على مواكبة تطلعات الجيل الجديد. ويظهر الاستخدام الكثيف لهذه المنصات – مثل فيسبوك، إنستغرام، تيك توك ويوتيوب – من طرف أكثر من 90% من الشباب، مدى مركزيتها في صياغة النقاش العمومي وتوجيه المواقف.
غير أن هذا الحضور الرقمي الكثيف لم يجد صداه في أداء الأحزاب السياسية، التي بقي تفاعلها مع هذه الوسائط محدوداً وموسوماً بطابع تقني وإخباري، بدل أن يشكل مدخلاً استراتيجياً لإعادة بناء العلاقة مع الشباب، وتجديد أساليب التأطير والمشاركة. فالممارسات الرقمية أفرزت ديناميات جديدة من أبرزها بروز رأي عام شبابي يتداول القضايا السياسية والاجتماعية بلغة مباشرة وجريئة، وتَشَكُّل نخبة جديدة من صناع المحتوى والمُؤثرين الذين يضطلعون بأدوار سياسية غير تقليدية، تتجاوز في تأثيرها أحياناً خطاب ومكانة الفاعلين الحزبيين. في المقابل، تفتقر هذه الديناميات إلى التأطير التربوي والسياسي، مما يجعل جزءاً منها عرضة للانفلات أو المساءلة القانونية والاجتماعية، في ظل غياب التأطير المؤسساتي.
وتواجه الأحزاب تحديات حقيقية في استثمار هذه الإمكانات، أبرزها غياب رؤية واضحة للتواصل الرقمي، وضعف التكوين والموارد المخصصة لهذا المجال، واستمرار فجوة لغوية وثقافية بين خطابها التقليدي وتعبيرات الجيل الرقمي، فضلاً عن الحضور الموسمي الذي يقتصر غالباً على الفترات الانتخابية. كما أن غياب التنافسية الجادة على تقديم محتوى ذي بعد مواطناتي أو معرفي، يفتح المجال لهيمنة محتويات سطحية أو عنيفة، مما يُفقد هذه المنصات دورها الممكن في تعزيز المشاركة السياسية وبناء الثقة بين الشباب والفاعلين الحزبيين.
•قطاع الرياضة، الطموح المعول عليه والمفارقات الحادة
شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة دينامية رياضية ملحوظة، تمثلت في تنظيم عدد من التظاهرات الدولية الكبرى، والمشاركة المشرفة في محافل عالمية مثل كأس العالم بقطر والألعاب الأولمبية بباريس، إلى جانب التطور النوعي في البنية التحتية الرياضية بعدد من الحواضر الكبرى. ورغم أهمية هذه المكتسبات وصداها الدولي الإيجابي، إلا أنها لا تعكس بشكل دقيق واقع الرياضة على المستوى الجماهيري، التي لا تزال تعاني من اختلالات بنيوية على مستويات متعددة.
فحسب تقارير وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لا تتجاوز نسبة الشباب المغاربة الذين يمارسون الرياضة بشكل منتظم 20%، وهي نسبة تكشف محدودية نجاعة السياسات العمومية في تعميم ثقافة الممارسة الرياضية. كما أن ضعف وتردي البنيات الرياضية في الأحياء الشعبية والمجالات القروية، مقابل تركّز الاستثمارات في المدن الكبرى، يكرس غياب العدالة المجالية في الولوج إلى الفضاءات الرياضية. وتتجلى أبرز مظاهر القصور في ضعف صيانة وتدبير المنشآت الرياضية المخصصة للعموم، وقلة الدعم المالي والتقني الموجه للجمعيات الرياضية ، مع إقصاء المواهب الشابة، خصوصاً في الرياضات الفردية، من فرص التأطير والمرافقة. كما يسجل تراجع واضح في التربية البدنية داخل المؤسسات التعليمية، سواء من حيث عدد الحصص الزمنية أو جودة التأطير التربوي والبيداغوجي.
في السياق ذاته، يلاحظ تركيز السياسات الرياضية بشكل شبه حصري على كرة القدم، في مقابل تهميش باقي الرياضات، وغياب إرادة حقيقية لتطويرها عبر توفير بنيات تحتية ملائمة، وتأهيل الأطر، وإرساء منظومة للمحاسبة في تدبير الجامعات والجمعيات الرياضية. كما أن البعد المتعلق بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في المنشآت الرياضية لا يزال مغيباً، خصوصاً في الأوساط الهشة، ما يشكل خرقاً واضحاً لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
إننا في الاتحاد الاشتراكي وأمام هذه الاختلالات مجتمعة، ندعو إلى ضرورة مراجعة شاملة للسياسات العمومية في المجال الرياضي، قوامها العدالة المجالية، والإنصاف الاجتماعي، والنهوض بالرياضة كحق جماهيري، وأداة من أدوات التربية والتماسك الاجتماعي والتنمية الشاملة.
السياسة الوطنية المندمجة للشباب في المغرب: بين التطلعات المتجددة والإخفاقات المؤسسية
•السياسة الوطنية المندمجة للشباب: السياق الوطني
تشير السياسات العمومية إلى مجموع التدابير والقرارات والتدخلات التي تقوم بها الدولة من خلال مؤسساتها الدستورية والتنظيمية، بهدف معالجة قضايا ذات طابع عام والاستجابة لمطالب المجتمع. إنها بمثابة تجسيد ديناميكي للدولة في وضعية فعل l’État en action، والتي تعبر عن الإرادة العمومية الممأسسة في مواجهة إشكاليات معقدة ومركبة، عبر مقاربات تشاركية وشاملة. وبهذا المعنى، فالسياسة العمومية ليست مجرد منتوج قانوني أو إداري، بل هي مسار مؤسساتي متكامل ينبني على التفاعل بين الفاعلين العموميين والخواص، داخل فضاء تتقاطع فيه الرهانات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتبنى السياسة العمومية الناجعة على أساس تشخيص دقيق للإشكاليات، ووضع أهداف استراتيجية قابلة للقياس، وصياغة آليات ووسائل التنفيذ، بالإضافة إلى تحديد مؤشرات التتبع والتقييم، بما يضمن النجاعة والفعالية والتأثير الإيجابي على الواقع المجتمعي. إنها بذلك عملية معقدة تتطلب تنسيقا مؤسساتيا فعالا وتوزيعا واضحا للأدوار بين الفاعلين، مع ضمان استمرارية السياسات ومردوديتها في الزمن.
وفي هذا السياق، تندرج السياسة الوطنية للشباب كأحد المجالات الحيوية التي تستوجب عناية خاصة، نظرا لما يشكله الشباب من رافعة ديمغرافية واستراتيجية للتنمية الشاملة والمستدامة. وتُعرف السياسة الوطنية للشباب، كما هو معمول به في أدبيات الأمم المتحدة، بوصفها رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تسعى إلى بلورة نموذج الإنسان المواطن – نساءً ورجالا – الذي تحتاجه المجتمعات في المستقبل، من خلال التمكين، والمشاركة، والدمج الفعلي في الحياة العامة. وتُترجم هذه السياسة إلى مجموعة من البرامج والتدابير والمؤسسات والميزانيات المخصصة، التي تعكس مدى التزام الدولة بقضايا الشباب، ومدى وعيها بدورهم الحاسم في بناء مجتمع متوازن، منتج وعادل. كما تمثل السياسة الوطنية للشباب إطاراً مرجعياً لتوجيه وتنسيق مختلف المبادرات القطاعية، وتُعد آلية لتعبئة كل الفاعلين المعنيين، من قطاعات حكومية، وهيئات منتخبة، ومجتمع مدني، وقطاع خاص، في أفق بناء تعاقد اجتماعي جديد يُمَكِّن الشباب من التمتع بحقوقهم والمشاركة الفعلية في صنع القرار. ومن هنا، فإن السياسة العمومية في شقها الشبابي، لا تقتصر على مجرد الاستجابة الظرفية لمطالب آنية، بل تستوجب تبني مقاربة استشرافية تنموية، تجعل من الشباب فاعلا محوريا لا مجرد مستهلك سلبي، وتضمن إدماجه الكامل في الدورة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، انطلاقا من مبدأ المواطنة الفاعلة والعدالة المجالية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، تعتبر تجربة حكومة التناوب عند نهاية التسعينات، انطلاقة حقيقية نحو بناء ملامح وعي سياسي في الخطاب العمومي المغربي حول ضرورة تطوير نمط حكامة ومعالجة أوضاع الشباب، ليس فقط باعتبارهم فئة عمرية واسعة تمثل ثروة ديمغرافية، بل كذلك باعتبارهم طاقة معطلة وغير مدمجة في سيرورة التنمية. فقد أجمعت مختلف المخططات القطاعية (كالميثاق الوطني للتربية والتكوين، وبرامج محو الأمية، وسياسات التشغيل المؤقت) على الطابع الاستعجالي لإعادة إدماج هذه الفئة داخل النسيج المؤسساتي والاجتماعي والاقتصادي. غير أن هذا الوعي ظل محدودا بإرادة النخبة السياسية والإدارية دون أن يترجم إلى سياسة شمولية ومنسقة.
لقد دفع حراك 2011، الدولة إلى مراجعة أولوياتها، فوضعت قضية الشباب في صلب الأجندة العمومية، من خلال مجموعة من الإجراءات الدستورية والمؤسساتية، لعل أبرزها دسترة المشاركة المواطنة، وإنشاء المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي (وإن ظل معلقا لحدود اللحظة)، وفتح ورش إصلاح منظومة التكوين المهني، بالإضافة إلى عدد من المبادرات ذات الطابع الظرفي، كمبادرة “دعم المقاولات الناشئة” أو “برامج التشغيل الذاتي”. غير أن هذه الدينامية، التي حملت في ظاهرها وعدًا بتحول بنيوي، سرعان ما اصطدمت بواقع مؤسساتي وقانوني يعيق الأجرأة الفعلية لأي سياسة مندمجة.
وفي هذا السياق، ظلت الخطابات الملكية تشكل أحد المحركات الرئيسة التي تبعث الحيوية في النقاش العمومي حول الشباب. فقد ما فتئ الملك محمد السادس يشدِّد، منذ مطلع الألفية الثالثة، على أهمية تأهيل الشباب ودمجهم في المشروع المجتمعي الوطني. وتجلى هذا التوجه بقوة في خطابه أمام البرلمان بتاريخ 13 أكتوبر 2017، حيث دعا إلى بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب، تقوم على التكوين والتشغيل وتقديم حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية. كما أكد على ضرورة إحداث “مؤسسات عمومية ناجعة، قادرة على تنزيل هذه السياسات ميدانيًا”، مما يعكس بوضوح أن الإشكال لا يكمن في غياب الرؤية، بل في محدودية أدوات التنزيل. ورغم هذه الرعاية الملكية المستمرة لقضايا الشباب، فإن تعثر الحكومات المتعاقبة في إحداث تحول ملموس يعود إلى عدة عوامل بنيوية وهيكلية، من أبرزها:
•هندسة حكومية غير منسقة: توزع الاختصاصات المرتبطة بالشباب بين وزارات متعددة (الشباب، التعليم، الشغل، الثقافة، الرياضة، الاقتصاد الاجتماعي، إلخ) أدى إلى تشتت المبادرات وغياب التنسيق الأفقي والعرضاني، مما أضعف فعالية البرامج وأفرغها من مضمونها الاستراتيجي؛
•ضعف الرؤية السياسية المتكاملة: لم تتمكن النخب السياسية، خاصة في سياق الحكومات السابقة، من بلورة تصور موحد ومندمج لنمط حكامة الشأن الشبابي، وهو ما أدى إلى التعامل معه بوصفه مجالا قطاعيا محدودا وليس أولوية وطنية عابرة للقطاعات؛
•منطق المحاصصة الحزبية: أثرت اعتبارات التوازن العددي والحزبي في تقاسم الحقائب الوزارية على تجانس الفريق الحكومي، حيث تم توزيع القطاعات ذات الصلة بالشباب بشكل غير متناغم، ما جعل تدبيرها يخضع أحيانا لحسابات ظرفية بدل رؤية استراتيجية؛
•ضعف آليات التنزيل الترابي: غياب هيئات جهوية ومحلية تتكامل مع المركز في تنفيذ السياسة المندمجة للشباب أدى إلى فجوة بين التخطيط الوطني والواقع المحلي، حيث تظل المبادرات غير متكيفة مع خصوصيات الجهات والمجالات الترابية.
هذا الوضع نتج عنه ما يمكن تسميته “بالسياسة المنقوصة للشباب”، أي سياسة تفتقد إلى مقومات الاستمرارية، والتقاطع المؤسساتي، والفعالية الترابية، والمقاربة الحقوقية. كما أنه يكرس، موضوعيًا، ما أسماه المجلس الاقتصادي والاجتماعي “بالمواطنة المعطلة”، حيث يشعر عدد متزايد من الشباب بعدم جدوى الانخراط في الشأن العمومي أو السياسي، نتيجة غياب فرص التمكين الفعلي والمشاركة المؤثرة.
•السياسة الوطنية المندمجة للشباب: الأحلام المؤجلة
أبانت تجربة إعداد السياسة الوطنية المندمجة للشباب عن إرادة سياسية غير مستكملة، حيث لم تنتقل من مرحلة التنظير إلى مرحلة الأجرأة العملية.
وإذا كان مشروع 2014 قد وفر مرجعية استراتيجية ضرورية، فإنه فشل في التحول إلى سياسة عمومية ملموسة وذات بعد استراتيجي. لذلك، فإن أي محاولة لإعادة إطلاق سياسة شبابية وطنية، لا بد أن تتجاوز العديد من مواطن الضعف، من خلال ربط الرؤية بإطار مؤسساتي ملزم، وإنشاء آلية حكامة تنسيقية عليا، وتوفير الموارد اللازمة، وإشراك حقيقي للفئات الشابة في رسم السياسات العمومية التي تمس حاضرهم ومستقبلهم.
اصبحت السياسة الوطنية المندمجة للشباب واحدة من “الأحلام المؤجلة” في مسار السياسات العمومية المغربية، بفعل سلسلة من التعثرات المؤسساتية والهيكلية والسياسية، مما جعل أثرها الميداني محدودا، إن لم يكن منعدماً. يمثل إرساء نموذج جديد لتدبير الشأن الشبابي جوهر السياسة الوطنية المندمجة للشباب، القائم على الالتقائية بين القطاعات الحكومية، واللامركزية في تنفيذ البرامج، والمقاربة التشاركية التي تدمج الشباب وتنظيماتهم في مراحل الإعداد والتنفيذ والتقييم. وفي هذا السياق، حاولت الحكومة السابقة سنة 2015، الالتفاف حول مطلب السياسة الوطنية للشباب، من خلال إعداد وثيقة يتيمة قدمت أمام البرلمان، وأمام المجلس الحكومي السياسة الوطنية المندمجة للشباب، وحددت هذه السياسة خمسة محاور استراتيجية، أبرزها: التمكين الاقتصادي، الإدماج الاجتماعي، المشاركة المدنية، تعزيز الولوج إلى الخدمات، وتوفير الفضاءات الآمنة والمفتوحة للتعبير والإبداع. ومع ذلك، فإن غياب إطار قانوني ملزم، وغياب آليات التنسيق الفعال بين القطاعات، وافتقار المؤسسات التنفيذية للكفاءة والموارد، كلها عوامل أدت إلى ترسيخ نوع من “القطيعة التطبيقية” بين الوثيقة المرجعية والطابع الفعلي للبرامج الموجهة للشباب.
ولعل من أبرز مظاهر هذا التعثر، غياب تنزيل فعلي للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الذي نص عليه دستور 2011، والذي كان من المفروض أن يشكل فضاء مؤسسياً يعبر من خلاله الشباب عن آرائهم ويواكب السياسات العمومية الموجهة إليهم. كما أن غياب مأسسة السياسة الوطنية المندمجة، من خلال قانون إطار أو هيأة وطنية مستقلة، جعلها عرضة للتقلبات السياسية والتبدلات الحكومية، مما أفقدها الاستمرارية والقدرة على التقييم والمساءلة. إضافة إلى ذلك، لم تنجح المبادرات الترابية والبرامج القطاعية في تفعيل مبدأ الالتقائية، وظلت تدخلات الوزارات والمؤسسات مشتتة ومرتبطة بالمنطق التدبيري التقليدي، دون رؤية استراتيجية موحدة.
من ناحية أخرى، فإن ضعف إشراك الشباب أنفسهم في صناعة القرار، ومحدودية آليات الحوار والمساءلة المتاحة أمامهم، عمقا الشعور بالاغتراب السياسي لديهم، حولا مفهوم “المواطنة” إلى مجرد انتماء إداري، خالٍ من الفعالية والقدرة على التأثير. فالشباب المغربي اليوم لا يفتقر فقط إلى الموارد والفرص، بل يعاني من “تعطيل المواطنة”، أي من غياب الإحساس بالفاعلية السياسية، والقدرة على الحلم والتخطيط لمستقبل أفضل. وهكذا، تتحول “السياسة الوطنية المندمجة” من رافعة للتحول إلى وثيقة مرجعية جامدة، لا تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي، مما يجعلها رمزاً لما يمكن تسميته بـ”السياسات المؤجلة”.
في ضوء ذلك، يبدو أن إعادة الاعتبار لهذه السياسة يقتضي أولاً تجاوز منطق التعامل معها كبرنامج قطاعي ظرفي، وتحويلها إلى مشروع مجتمعي طويل الأمد، مدعوم بإرادة سياسية قوية ومؤسساتية واضحة. ويتطلب ذلك إعادة صياغة الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لها، وتفعيل المجلس الاستشاري للشباب، وتخصيص ميزانيات مستقلة، وتقييم دوري وشفاف. كما لا يمكن الحديث عن سياسة شبابية فعّالة دون توفير فضاءات حقيقية للحرية والإبداع والمشاركة، وإعادة الثقة بين الدولة والشباب عبر القنوات التمثيلية والمؤسساتية.
في النهاية، فإن مستقبل المغرب رهين بمدى قدرته على تحرير الأحلام المؤجلة لشبابه من قيود البيروقراطية، ومن مفارقة السياسات الرمزية التي لا تجد طريقها إلى الواقع. لأن الحلم المؤجل لا يموت، بل يتحول إلى طاقة احتجاج، أو انسحاب، أو حتى هجرة، في حال لم يجد من يؤمن به ويسعى لتحقيقه ضمن إطار عدالة اجتماعية ومواطنة فاعلة.
•السياسة الوطنية المندمجة للشباب : تعثرات واختلالات مؤسساتية
تشكل السياسة الوطنية المندمجة للشباب وثيقة مرجعية حاولت الدولة من خلالها تبني رؤية شمولية لقضايا الشباب، تقوم على مقاربة أفقية تضمن الالتقائية بين القطاعات الحكومية، وتُعزز التفاعل مع الفاعلين الجمعويين والترابيين. غير أن هذه الوثيقة ظلت، منذ ولادتها، مشروطة وغير مكتملة. فرغم المصادقة عليها في مجلس الحكومة بتاريخ 3 أبريل 2014، فإنها لم تُعرض على المجلس الوزاري للمصادقة النهائية، كما ينص على ذلك الفصل 49 من الدستور، الأمر الذي حرمها من أي طابع ملزم، وأدخلها في دائرة الانتظار المؤسساتي. وهو تأجيل لا يُفهم فقط بوصفه إجراءً تقنياً، بل يُعبّر عن غياب الإرادة السياسية الواضحة لإعطاء الأولوية لقضايا الشباب داخل منظومة القرار الاستراتيجي.
وفي خضم هذه الوضعية المعلقة، شهد المغرب سنة 2017 مبادرة مؤسساتية جديدة تمثلت في قيام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بناء على طلب من رئيس مجلس المستشارين، بإعداد تقرير شامل حول الاستراتيجية الوطنية للشباب. وقد تضمن هذا التقرير، المعنون ب”مبادرة وطنية مندمجة للشباب”، عددا من التوصيات الهيكلية التي تروم تجاوز محدودية النسخة السابقة، والدعوة إلى بلورة استراتيجية جديدة تقوم على الإنصاف، التشاركية، والالتقائية.
إلا أن هذه المبادرة، رغم راهنيتها، لم تترجم إلى سياسة عمومية جديدة، كما لم تحدث نقاشا وطنيا أو برلمانيا واسعا، وهو ما يُظهر خللاً في التفاعل بين مؤسسات الحكامة والحكومة، ويؤشر على ضعف الثقافة التشاركية في بناء السياسات الموجهة للفئات المجتمعية الحيوية. لقد ترافق هذا الإخفاق مع تنامي مؤشرات فشل السياسة الوطنية للشباب في بناء جسور تواصل فعالة ومقنعة مع الشباب ومنظماتهم، كما أنها تعكس قصورا هيكليا في إدماج الشباب ضمن الفعل العمومي، ليس فقط كمستفيدين، بل كفاعلين وشركاء في صناعة وطن يتسع للجميع.
من جهة أخرى، ورغم الالتزام الذي أبدته الحكومة المنبثقة عن انتخابات أكتوبر 2021 بتفعيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد، الذي جعل من قضايا الشباب إحدى أولوياته، فإن الممارسة أظهرت أن أغلب البرامج التي تم إطلاقها ظلت محكومة بمنطق التدبير القطاعي المفتقر للرؤية الموحدة. لقد تم الإعلان عن مشاريع متعددة، مثل “جواز الشباب”، ورقمنة المؤسسات الشبابية، ومشروع بناء 150 قاعة سينمائية، وهي مبادرات روّج لها باعتبارها مؤشرات على انطلاقة جديدة في السياسات الشبابية. إلا أن عملية التنزيل واجهت صعوبات عميقة، أبرزها غياب العدالة المجالية في التوزيع، وافتقار الفئات المستهدفة للولوج المتكافئ للمعلومة والفرص، مما أدى إلى إحساس متزايد بالإقصاء، خصوصا لدى شباب المناطق القروية والهامشية. كما أن المقاربات المعتمدة في تنفيذ هذه البرامج، والتي ركزت على البعد التواصلي والتسويقي دون مواكبة تنظيمية أو تقويمية، فاقمت من حالة التوجس واللامبالاة لدى الشباب، الذين لم يجدوا في هذه المشاريع استجابة فعلية لحاجياتهم العميقة، سواء على مستوى الإدماج المهني أو الثقافي أو السياسي. إلى جانب ذلك، تم إطلاق برامج اقتصادية ذات ارتباط غير مباشر بالشباب، مثل “فرصة” و“أوراش”، التي وجهت بانتقادات متعددة تتعلق بتصميمها المركزي، وانعدام الوضوح في آليات الاستمرارية والاستدامة، مما أفقد هذه البرامج بعدها الاستراتيجي، وحولها إلى أدوات تقنية مفتقرة للفعالية والنجاعة. بل إن هذه البرامج، بدل أن تعيد بناء الثقة بين الشباب والدولة، زادت من تأجيج الإحساس بالتمييز والمحسوبية، خصوصاً مع تواتر شهادات عن اختلالات في معايير الانتقاء وغياب الشفافية.
إن هذه الوضعية المعقدة لا تعكس فقط إخفاق سياسة معينة، بل تُترجم فشلاً مركباً في بناء منظومة وطنية مستدامة تروم تطوير منظومة حكامة الشأن الشبابي . فالمشكل لم يكن يوما في قلة الوثائق أو ضعف المبادرات، بل في غياب الإرادة السياسية لمأسسة السياسة العمومية للشباب، وتوفير الموارد اللازمة لتنزيلها، وإشراك الشباب أنفسهم في جميع مراحلها. كما أن غياب المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الذي نص عليه الفصل 33 من الدستور، يمثل مفارقة ديمقراطية خطيرة، إذ يُفترض أن يشكل هذا المجلس آلية دائمة للتفكير والمساءلة، وفضاء للحوار المؤسساتي حول قضايا الشباب، وهو ما لم يتحقق إلى اليوم.
في ضوء ما سبق، فإن أفق بناء سياسة وطنية فعالة للشباب يمر بالضرورة عبر تحيين الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، وتحويلها إلى سياسة ملزمة عبر إطار قانوني واضح، مع إعادة توزيع المهام والمؤسسات على أسس وظيفية واضحة، وتوفير آليات تقييم مستقلة، مع ضمان تمثيلية الشباب في كل مستويات الحكامة. كما أن تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية في الولوج للفرص يتطلب قطيعة مع منطق التوزيع العشوائي أو التسويق الإعلامي للمشاريع، وتبني مقاربة تشاركية تستند إلى حاجيات فعلية ومعطيات ميدانية دقيقة.
الأفق الاتحادي: نحو تمكين ديمقراطي للشباب المغربي
يؤكد حزب الاتحاد الاشتراكي أن المسألة الشبابية بالمغرب لا يمكن اختزالها في منطق تقني أو في إجراءات قطاعية معزولة، بل يجب التعامل معها باعتبارها قضية سياسية واجتماعية بامتياز، تتطلب إعادة بناء العلاقة بين الشباب والدولة على أساس تعاقد جديد، قوامه العدالة، والمواطنة الكاملة، والاعتراف. ويستند الحزب في ذلك إلى رؤية تقوم على فهم مركب ومتعدد الأبعاد لوضعية الشباب، باعتبارهم الفئة السكانية الأكبر من حيث العدد، والأكثر عرضة للهشاشة، والإقصاء، والتهميش، ولكن في الوقت نفسه، الفئة الأكثر قدرة على التغيير والإبداع والمساهمة في بناء الوطن.
يشير التشخيص الذي تقترحه وثيقة الحزب إلى أن الشباب المغربي يواجه واقعا صعبا يتسم بالإقصاء المتعدد: إقصاء اقتصادي يتمثل في البطالة وغياب الشغل اللائق، إقصاء اجتماعي يعبر عنه الهدر المدرسي وتآكل شبكات الحماية الاجتماعية، إقصاء سياسي يتجلى في ضعف التمثيلية والمشاركة، إقصاء ثقافي يعكسه التهميش الرمزي لتعبيراتهم الفنية وضعف البعد الهوياتي، وإقصاء رياضي واضح من خلال غياب البنيات التحتية وضعف التأطير. هذا الواقع لا يرتبط فقط بندرة الموارد، بل هو نتيجة مباشرة لخيارات سياسية غير منصفة، ولمنطق حكامة يفتقد إلى الرؤية التشاركية، ويقوم على التجزيء والتدبير القطاعي، بدل التنسيق والإدماج والعدالة المجالية.
وفي ضوء هذا التشخيص، تبلورت قناعة راسخة لدى حزب الاتحاد الاشتراكي بأن السياسات الشبابية بالمغرب تعاني من أعطاب بنيوية، تتجلى في تشتت المسؤوليات المؤسساتية، وضعف الالتقائية بين القطاعات، وغياب الإطار القانوني الملزم، وغياب إرادة سياسية حقيقية تجعل من قضايا الشباب أولوية وطنية. فرغم التراكمات الإيجابية التي عرفها الخطاب السياسي بشأن الشباب، خاصة في الخطب الملكية، فإن الممارسة الحكومية ظلت مترددة، ومرتبكة، وغير قادرة على ترجمة هذا الخطاب إلى سياسات عمومية منصفة وفعالة. ولعل أبرز دليل على هذا التعثر، هو مصير “السياسة الوطنية المندمجة للشباب”، التي صيغت في شكل وثيقة مرجعية طموحة دون أن تتحول إلى سياسة عمومية مُفعّلة، بسبب غياب المصادقة النهائية عليها، وافتقارها إلى آليات التنفيذ والتتبع والتقييم.
انطلاقاً من هذا الوعي النقدي، يقترح حزب الاتحاد الاشتراكي استراتيجية بديلة ترتكز على تحويل الشباب من موضوع للسياسات إلى شريك فعلي في بلورتها وتنفيذها وتقييمها. وتقوم هذه الاستراتيجية على أربعة مستويات مترابطة.
•المستوى الأول هو إعادة الاعتبار للمشاركة السياسية للشباب من خلال تفعيل المؤسسات الدستورية المعطلة، وعلى رأسها المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، واعتماد إجراءات تشريعية تسمح بالتمييز الإيجابي لصالح تمثيلية الشباب في المجالس المنتخبة، بما يساهم في تجديد النخب وضخ دماء جديدة في الحياة السياسية.
•المستوى الثاني هو مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن الإدماج المهني، وتيسير ولوج الشباب إلى سوق الشغل، خاصة عبر الاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقوية قدرات الشباب على المبادرة الذاتية من خلال تمويل المشاريع، وتوفير المواكبة التقنية والمالية للمقاولات الشبابية، والعمل على تقعيد مبدأ العدالة المجالية في مال التشغيل ،بما يشمل الأقاليم والجهات التي يعاني شبابها من ضيق الأفق، بإحداث قطاع خدمات لا يحتاج توطينا، بل تكوينا ومواكبة وبنية تقنية عصرية .
•المستوى الثالث فيتعلق بجعل الثقافة والرياضة حقاً وليس امتيازاً، من خلال دمقرطة الولوج إلى الفضاءات العمومية، وتوسيع قاعدة الممارسة الثقافية والرياضية في المدارس والجامعات، والأحياء الشعبية، والقرى، مع دعم التعبيرات الثقافية الشبابية غير النمطية، والاعتراف بها كجزء من الهوية الوطنية المتجددة، وليس كأشكال منحرفة أو هامشية. ويشمل هذا المستوى أيضاً إرساء منظومة عادلة للرياضة تقوم على الإنصاف بين الجهات، والمساواة بين الجنسين، والاهتمام بالرياضة المدرسية والجامعية باعتبارها رافعة للتماسك الاجتماعي، وتنويع الاهتمام والرعاية بأصناف الممارسة الرياضية .
•المستوى الرابع بناء إعلام شبابي جديد يدمج التكنولوجيا والوسائط الحديثة كوسيلة لإعادة التواصل بين الشباب والسياسات العمومية، عبر إطلاق منصات تفاعلية، وتحفيز المحتوى الرقمي المواطن، وتكوين فاعلين شباب في مجال التأثير السياسي الرقمي.
في المحصلة، لا تقدم استراتيجية حزب الاتحاد الاشتراكي مجرد بديل قطاعي أو تقني، بل تسعى إلى إحداث تحول جذري في فلسفة التعامل مع قضايا الشباب، انطلاقاً من قناعة جوهرية مفادها أن الشباب ليس عبئاً على الدولة، بل هو رأسمال استراتيجي يجب الاستثمار فيه، وإطلاق طاقاته، وتمكينه من أدوات الفعل والمشاركة، في أفق بناء دولة ديمقراطية عادلة وشاملة. وهي استراتيجية تنسجم مع مرجعية الحزب التقدمية، وتستمد قوتها من ماضيه النضالي، لكنها في الآن نفسه تنفتح على المستقبل، من خلال استيعاب التحولات المجتمعية، والتغيرات التكنولوجية، والتعبيرات الشبابية الجديدة، بما يجعلها إطاراً قابلاً للتطوير والتفاعل، وليس مجرد برنامج انتخابي ظرفي.
إن تحقيق هذه الرؤية يقتضي أولاً إرادة سياسية صادقة، وثانياً تعبئة مؤسساتية قوية، وثالثاً انخراطاً فعلياً للشباب أنفسهم في صناعة القرار العمومي، لأن السياسات الموجهة للشباب لا يمكن أن تنجح إلا إذا صيغت بمشاركتهم، ونُفذت بإشرافهم، وقُيّمت بناءً على آرائهم وتجاربهم. وفقط حين يصبح الشباب فاعلين في السياسات، لا مجرد متلقين لها، يمكن الحديث عن مغرب جديد أكثر عدلاً، وأكثر إدماجاً، وأكثر إنصافاً.