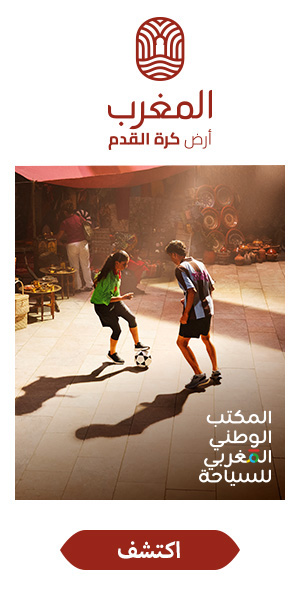1.تقديم:
تبرز التقلبات الهائلة التي شهدتها العقود الأخيرة إلى أي درجة أدى فيها التقدم العلمي دورا مهما في تسريع التحولات المجتمعية. فبالأمس، أحدث اختراع محركات السيارات، والكهرباء، واللقاحات، والفلسفة الوضعية، واللسانيات وغيرها ثورة في تنظيم المجتمعات البشرية. واليوم، غيّرت الثورة الرقمية، والتكنولوجيا الإحيائية، وعلم النفس بشكل كبير متوسط العمر المتوقع للإنسان ونوعية الحياة، مما ساهم في التغيرات الديموغرافية والاجتماعية. وغدا، سيواصل التقدم العلمي إعادة تشكيل المجتمع بوتيرة متسارعة بشكل أكبر. وهذا سيطرح تحديات أخلاقية واقتصادية واجتماعية، ولكنه سيوفر في الآن ذاته فرصا غير مسبوقة.
علاوة على ذلك، من البارز وجود علاقة واضحة، على الصعيد العالمي، بين أداء جامعات أي بلد، وتطوره الاقتصادي، ودمقرطة مؤسساته، والعدالة الاجتماعية في مجتمعه. لذلك، لا يمكن اعتبار التعليم العالي مجرد قمة هرم النظام التربوي، بل ركيزة أساسية، لا محيد عنها، للتنمية البشرية.
إن إنتاج معرفة جديدة ضروري لتكوين الأطر التي ستتخذ قرارات تؤثر في المجتمع بأسره. وبإمكان تطوير القدرات الفكرية، التي يعتمد عليها إنتاج المعرفة واستعمالها، أن يسهم في توفير الكفاءات الأساسية لسوق شغل متحول باستمرار. وعلى الرغم من هذا الواقع، لم يجد العديد من الدول حتى الآن حلولا مناسبة للمشاكل التي تعانيها في منظومة التعليم العالي. وفي هذا المجال، يمثل بلدنا حالة خاصة تتسم بمفارقة فريدة!
من المعروف أن المغرب بنى جامعته الأولى، جامعة القرويين، من طرف فاطمة الفهرية سنة 859 م، أي قبل جامعة بولونيا (1088) بـ 229 سنة، وقبل جامعة أكسفورد (1142) بـ 283 سنة، وقبل جامعة هارفارد (1636) بـ 777 سنة، غير أنه انتظر 1100 سنة لترى النور جامعته الثانية، جامعة محمد الخامس! إنها المفارقة الأولى!
وتنبثق المفارقة الثانية من أن السلطات فتحت ورش إصلاح النظام التربوي مباشرة بعد الاستقلال سنة 1957، والذي سيتم تسريع وتيرته بشكل ملحوظ في أواسط التسعينيات دون أن يسفر عن أي تحول حقيقي. وبعد اعتماد الرؤية الاستراتيجية، أعلن جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2015: «ندعو لصياغة هذا الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون – إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد، ويضع حدا للدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح، إلى ما لا نهاية».
منذ سنتي 1955 و1956 [1]، عندما كان عدد الطلبة في المغرب 353 طالبا فقط، أدت الجهود الحثيثة إلى تجاوز أكثر من مليون وثلاثمائة ألف طالب اليوم [2]، وإلى نجاح عدد كبير من المغاربة في الجامعات الأجنبية المرموقة، لكن يبقى معدل الهدر الجامعي (50 ٪) وبطالة الحاصلين على الشهادات (20 ٪) مرتفعا للغاية. إنها المفارقة الثالثة!
كيف يمكن إذن لمثل هذا النجاح التاريخي، الكمي والنوعي، أن يتأثر بمثل هذا الفشل؟
1.محطات تاريخية دالة:
1.2 العصر الذهبي:
اعتبارا لكونها أقدم جامعة في العالم لا تزال قائمة، ظلت جامعة القرويين مكة الطلبة والعلماء، أي القبلة التي تحج إليها هذه الفئة من جميع أنحاء العالم. في بلادنا، سيسود نظام يسمى «ما قبل نابليوني» [3]. ويتميز هذا النظام بتغير بطيء يكاد يكون غير محسوس. كان الإصلاح فيه تدريجيا، ويهم الجوهر والشكل. لكن مع مرور الوقت، سيغرق تدريجيا في جمود قاتل. وفي الواقع، كما هو الحال في بقية العالم الإسلامي، سيشهد المغرب ركودا تدريجيا يليه تراجع بطيء [4].
ومنذ القرن العاشر الميلادي، فإن «غلق باب الاجتهاد»، والحد من «نشاط العلماء في تفسير عقائد السلف»، واعتبار «أي تشكيك في تعاليم القدماء» بدعة، أدى كل ذلك إلى إحراق الكتب وإدانة العلماء. وهكذا، أُلقيت في النار مخطوطات ابن سينا والفارابي وابن رشد وغيرهم. وعم غضب حقيقي مضاد للفكر، وسارع المسلمون، من طرف إلى آخر، إلى التخلي عن مكتسباتهم العلمية والفلسفية، وكان هذا الأمر بمثابة انتحار ثقافي حقيقي [4] … ثم انتقل الإرث «المدرسي» لابن رشد إلى أوروبا، بالتزامن تقريبا مع نشأة معظم الجامعات في القارة العجوز. وفي وقت لاحق، أدت إصلاحات الجامعات، في الفترة التي أعقبت الثورة الصناعية، إلى دخول أوروبا وأمريكا مرحلة الحداثة.
وشكلت الحرب الأهلية سنة 1011، التي عصفت بالأندلس المسلمة، بداية ضعف عميق للدولة، وأدت إلى تفتيتها إلى عدة ممالك صغيرة مستقلة، أي الطوائف. وسهلت هذه المشاكل الداخلية الكثير من الأمور على الأعداء الخارجيين؛ ففي الغرب الإسلامي، كانت الهزيمة في معركة لاس نافاس دي تولوسا (1212) خطوة حاسمة في حرب الاسترداد سنة 1492. وفي الشرق الإسلامي، سقطت بغداد في أيدي المغول سنة 1258، إذ تم نهب المدينة، وقتل سكانها، وتدمير مكتبتها العظيمة بالكامل.
2.2 الحماية:
أهملت الحماية كليا التكوين في التعليم العالي، وركزت بدلا عن ذلك على تطوير البحث العلمي بهدف استغلال الثروات الطبيعية للبلاد. وهكذا، تم إعطاء الأولوية لمعاهد البحث (الحدائق النباتية، المعهد العلمي، …)، على عكس الجزائر التي بدأ فيها التعليم العالي مع الاستعمار: مدرسة الآداب في الجزائر العاصمة سنة 1832، ومدرسة الطب سنة 1833، ومدرسة العلوم سنة 1868 …
3.2 إنشاء جامعة حديثة لاستكمال الاستقلال الوطني:
منذ سنة 1957، نصب المغفور له جلالة الملك محمد الخامس لجنة ملكية تنكب على معالجة مشكلة التعليم، واعتمدت المبادئ الأربعة: المغربة، التعريب، التعميم، والتوحيد.
1.3.2 مغربة الأطر:
باعتباره أمرا ضروريا لاستكمال الاستقلال، كان غياب تعليم عال حديث عائقا أمام المغربة. ومنحت حكومة عبد الله إبراهيم جامعة محمد الخامس وضعا قانونيا سنة 1959، بعد أن ظلت تابعة لجامعة بوردو [6]. وسمحت لها الاستقلالية الواسعة بإعادة تنظيم نفسها بنفسها بسرعة، من خلال احتضان كليات العلوم والآداب والقانون والطب، والمدرسة المحمدية والمدرسة العليا للأساتذة. وتم الجمع بين التكوين الأساسي والتطبيقي من جهة والبحث العلمي من جهة ثانية.
وقد تم التخلي عن هذه السياسة الواعدة خلال فترة الستينيات. وبدأ تكوين النخب يخرج شيئا فشيئا من الجامعة حينما بدأ كل قطاع وزاري في تكوين أطره المستقبلية. وانحصرت هذه السياسة، التي اعتبرت مكلفة للغاية، في تشكيل نخبة صغيرة عدديا، مما أخر عملية المغربة [7]. وعلى الرغم من هذا الفشل، لم تغير الحكومات سياساتها، وشهدت السبعينيات تسريعا في إنشاء مثل هذه المؤسسات، حتى بالنسبة للتربية الوطنية! ويدل هذا المنعطف على وجود إرادة فعلية لتفكيك النظام الجامعي المغربي: فبعد أن فقدت التكوين التقني، واجهت الجامعة منافسة في الشعب الأساسية، مما أدى إلى الاستمرار في إضعافها.
وعلى الرغم من ذلك، لم تفلح هذه السياسة المكلفة للغاية في تحقيق نجاح بارز في تكوين المكونين، بما أنه انتظرنا سنة 1968 للقيام بمغربة التعليم الابتدائي، وسنة 1978 لمغربة التعليم الإعدادي، وسنة 1988 لمغربة التعليم الثانوي، ثم سنة 1998 لمغربة التعليم العالي [8]! وكذلك الأمر على المستوى النوعي، بما أنه كان ضروريا إعادة البدء من الصفر لبناء مؤسسات جديدة لتكوين الأساتذة. ففي الواقع، قررت الحكومة آنذاك إغلاق أول مدرسة عليا للأساتذة في البلاد، مستعدة بذلك للتضحية بـ 22 سنة من تجربة مؤسسة لم يكن ذنبها سوى أنها جزء من الجامعة! وتكررت المأساة سنة 2010 مع إلحاق المدارس العليا للأساتذة الثمانية بالجامعة، مع تجريدها من مهمتها الرئيسية لتكوين الأساتذة. هذه المدارس التي كانت قد حلت، سنة 1978، محل أول مدرسة عليا للأساتذة، والتي راكمت بذلك تجربة تمتد لـ 33 سنة! وإذا كان التاريخ يعيد نفسه في المرة الأولى كمأساة، ففي المرة الثانية يعيدها كصورة كاريكاتورية [9].
2.3.2 التعريب:
لم يبدأ التعريب إلا خلال سنوات الثمانينيات من القرن الماضي. وبتوقفه عند مستوى البكالوريا، أدى بأجيال من الطلبة، تائهين تماما، إلى ولوج تعليم عال ظل يلقن باللغة الفرنسية. وفي ظل هذا التنافر اللساني، لم تتمكن إلا أقلية، بفضل التكوين الموازي، من التغلب على النقائص في الجانب اللغوي. وهكذا، سيعاني التعليم من شرخ مزدوج: فضائي وزماني. الأول قسم الفضاء التربوي إلى جزء داخل الجامعة وجزء خارجها تابع لقطاعات وزارية أخرى، والثاني قسم الزمن التربوي إلى تدريس باللغة العربية قبل البكالوريا وباللغة الفرنسية بعدها!
3.3.2 التعميم:
بوصفه ضامنا للعدالة الاجتماعية، سيستغرق تعميم التعليم وقتا طويلا. وفي الواقع، تركت الخطة التي وضعتها حكومة عبد الله إبراهيم لإنجازه المجال أمام اعتماد «مذهب بنهيمة» الذي حد من ولوج التلاميذ ابتداء من المرحلة الابتدائية [6]. ولم يعد التعميم أولوية حكومية إلا مع نهاية التسعينيات [10]! وعلى الرغم من أن التعميم ظل نسبيا في التعليم العالي، إلا أن أرقامنا لا تزال دون المعايير الدولية. وبحسب مارتان ترو Trow Martin، يمر التعليم العالي بثلاث مراحل. مرحلة نخبوية بمعدل يقل عن 15 % من الفئة العمرية، ثم يصبح ديمقراطيا بمعدل يتراوح بين 15 % و50 %، ثم يصبح معمما عندما يتجاوز 50 % [11]. وبعد أن كان التعليم العالي نخبويا لفترة طويلة، بدأ يصبح ديمقراطيا بعد سنة 2010، مما يعد نتيجة لجهود تعميم التعليم الابتدائي في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثانية. وهكذا، انتقلنا من 353 طالبا سنة 1955 إلى 250 ألف طالب سنة 1999، ثم إلى مليون و300 ألف طالب اليوم [12].
4.3.2 التوحيد:
كان الهدف من توحيد التعليم هو إنشاء مدرسة مغربية وحيدة لتحل محل المدارس المختلفة التي تم إنشاؤها خلال فترة الحماية. وعلى عكس التعليم الابتدائي والثانوي، نشأ التعليم العالي موحدا بعد الاستقلال. وكان علينا انتظار أواسط ستينيات القرن الماضي ليتم اعتماد النظام الفرنسي المزدوج. وهكذا، سيشمل مؤسسات غير جامعية (مثل المعهد الزراعي، المدرسة الغابوية، المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، المعهد الوطني للبريد والمواصلات، المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، …) [13] ومؤسسات جامعية. كانت المؤسسات الأولى، مهنية، ذات موارد أكثر، وبدون أية إمكانية للقيام بالبحث، والتي ستصبح مع كثرة الراغبين في الولوج إليها، ذات استقطاب محدود. بينما كانت المؤسسات الثانية، أكاديمية، ذات موارد أقل، مع إمكانية القيام بالبحث، وظلت ذات استقطاب مفتوح رغم كثرة الراغبين في الولوج إليها. وقد قامت هذه الازدواجية بفصل التكوين المهني عن البحث، والجامعة عن التكوين المهني. ودفع هذا الانفصال المغرب إلى «تقديم» معارف أساسية لا يستطيع الاستفادة منها، واستيراد معارف تقنية لا يستطيع إنتاجها.
ومع مرور الوقت، ارتبط البحث العلمي بالترف، مما أدى في النهاية إلى الاقتناع بعدم جدواه. ومن عدم جدوى البحث إلى عدم جدوى الجامعة نفسها، لم تكن هناك سوى خطوة واحدة، وهي الخطوة التي تمت تدريجيا بعد تراجع دور الدولة بسبب إعادة التقويم الهيكلي في أوائل سنوات الثمانينيات، مما أدى إلى تسارع انهيار التوازن الهش في سوق شغل الحاصلين على الشهادات [14]. وقد حافظ تنويع العرض الجامعي (كليات العلوم والتقنيات، المدارس العليا للتكنولوجيا، …) الذي أعقب هذه الأزمة، على نفس المنطق الثنائي، في صيغة الولوج (محدود أو مفتوح) وفي طبيعة البرامج (مهنية أو أساسية).
وبالإضافة إلى الثنائية الأصلية، شهدت سنوات التسعينيات بروز بعد ثالث ساهم في إضعاف الجامعة المغربية مع إنشاء جامعة الأخوين. وظلت هذه الحلقة استثناء إلى حدود وصول حكومة سنة 2012، التي أدخلت على نطاق واسع الجامعات المدفوعة الرسوم. وعندما يتم تكوين النخب خارج الجامعات العمومية، لا يمكن للسلطات العمومية أن تهتم بإصلاحها أو إعادة هيكلتها أو تعزيزها [15]. إنها تميل بطبيعة الحال إلى فك الارتباط بها وعدم الاهتمام بها. والسؤال إذن هو: لماذا هذا الجهد المتواصل للحفاظ على الجامعة ضعيفة هيكليا منذ إنشائها تقريبا؟
2.2 تهميش الجامعة:
في فرنسا، أدت «سلسلة من الخيارات، سياسية أكثر منها تربوية» ، إلى إرساء ثنائية في نهاية القرن الثامن عشر. ونظرا لحذرها من الجامعة، أنشأت الحكومة «المدارس الكبرى» لتوظيف الأطر العسكرية والتقنية للدولة فيها: مدرسة القناطر والطرق سنة 1747، مدرسة المناجم سنة 1783، مدرسة البوليتكنيك والمدرسة العليا للأساتذة سنة 1794… وفي الواقع، تعارض الطلب على الأطر التقنية للثورة الصناعية مع أوجه القصور في جامعة غارقة في المدرسية تحت تأثير الكنيسة. وأدى تطرف الثورة الفرنسية سنة 1792 إلى إلغاء الجامعات في فرنسا تماما بموجب قانون 15 شتنبر 1793؛ لم تتم إعادة فتحها إلا بعد قرن من الزمان بموجب قانون 10 يوليو 1896! في غضون ذلك، تم تطوير شكل آخر من التعليم العالي، تحكمه مبادئ مختلفة تماما، بالنسبة لاستقطاب الطلبة، كما الشأن بالنسبة لأهداف التكوين [17].
وقد أدى هذا التتابع للخيارات المتناقضة إلى إرساء نظام حيث التماسك غير مؤكد على الأقل [14]. وتعتبر هذه الثنائية، «في قطاعين متوازيين، هي الخطيئة الأصلية»، وهي المسؤولة الرئيسية عن جميع نقاط الضعف اللاحقة! وتكون تداعيات هذه الثنائية على أداء البحث العلمي، على مستوى إنتاج الجودة والمنظورية، بالغة الأهمية. ويظهر تصنيف شنغهاي Shanghai للجامعات أن أفضل 100 جامعة تتميز بجذب أفضل الطلبة والأساتذة، بموارد مالية ضخمة، بتعدد التخصصات، وبحجم وازن [18]. فجامعات النظام الفرنسي لا تستجيب للمعايير الثلاثة الأولى، بينما لا تستجيب المدارس للمعيار الثاني والمعيارين الأخيرين. وهذا ما يفسر بأن جامعات النموذج الهومبولتي هي التي تحتل دائما المراكز الأولى في مختلف التصنيفات الدولية.
في الوقت نفسه تقريبا، قام هومبولت Humboldt بإصلاح الجامعة الألمانية. ولم يقم هذا الإصلاح، الذي قطع مع نظام القرون الوسطى دون تبني الجانب النفعي الصارم للمدارس الفرنسية، بالفصل بين التدريس والبحث، ولا بين التكوين الأساسي والتكوين المهني. وامتدت الحرية الأكاديمية لتشمل البحث وأيضا التعليم والتعلم. وتم ضمان الاستقلالية من خلال تمويل الدولة دون مراقبة مباشرة من الصناعة أو السوق. وعزز هذا الإصلاح التطور الشخصي للطلبة، وأهّلهم ليس فقط للمسارات المهنية، بل أيضا للحياة الاجتماعية. وشكل هذا الإصلاح نموذجا يحتذى به بالنسبة لجميع دول العالم باستثناء فرنسا ومستعمراتها السابقة.
5.2 الآثار على المغرب:
مع ذلك، لا يفسر تأثير الحماية الحماس من أجل تهميش الجامعة المغربية؛ فقد كانت هناك عوامل داخلية أخرى حاسمة. وفي الواقع، عكس التعليم الابتدائي والثانوي، الذي كان مبلقنا خلال فترة الحماية، نشأ التعليم العالي موحدا. فالولوج إلى الجامعة كان مفتوحا ومتساويا في جميع الشعب الأساسية والمهنية. ومع ذلك، فإن العدد القليل من الخريجين في ستينيات القرن الماضي (بالكاد 3000 طالب سنة 1960) وحذر المعسكر المحافظ من جامعة متمردة للغاية، سيطرحان التساؤل حول وجود بديل، مما أدى «بشكل طبيعي» إلى النموذج الفرنسي. وسيتم استثمار كل الوسائل لفصل تكوين الأطر عن الجامعة. وأدى عدم المساواة في الولوج إلى جعل هذه الشعبة آلة حقيقية لإعادة إنتاج النخب، وبالتالي التضحية بنجاح الأغلبية على حساب نجاح الأقلية [19]. وهكذا، لم يعد التعليم رافعة اجتماعية، بل أصبح آلة لإعادة إنتاج الفوارق والتفاوتات.
6.2 المصالحة مع الجامعة:
منذ السنوات الأولى لحكمه، أطلق جلالة الملك محمد السادس دينامية واسعة من المصالحات الوطنية والإصلاحات الكبرى في المغرب، تهم الذاكرة التاريخية والهوية والأوضاع الاجتماعية. وهكذا، شهد المغرب إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، وإطلاق سراح السجناء وعودة المنفيين، والاعتراف باللغة والثقافة الأمازيغيتين. كما ستشهد بلادنا أيضا تقدما في مجال حقوق المرأة. وفي غمرة هذه الأوراش، سيعرف العقد الأول من هذا القرن مصالحة مع الجامعة. وهكذا، بعد اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين من طرف اللجنة الخاصة للتربية والتكوين سنة 1999، انطلق الإصلاح بإصدار قانون التعليم العالي (01.00).
لقد بدا أن إصلاح التعليم العالي قد بدأ بالفعل. فمع القانون الجديد، لم تعد الجامعة مجرد قناة للمراسلات بين المؤسسات المستقلة تماما والوزارة الوصية، بل أصبحت فاعلا رئيسيا. وفي الواقع، ساهم التقدم في استقلالية الجامعة في تمكينها من وضع سياساتها الخاصة. وبفضل البرامج المعتمدة بانتظام، أصبحت المناهج الدراسية الجامدة سابقا قابلة للتكيف، قانونيا على الأقل، مع السياق الاجتماعي والاقتصادي، وذلك بفضل نظام الإجازة الماستر الدكتوراه.
ويستمر الإصلاح بالتفكير حول تمويل البحث العلمي، مما سيؤدي إلى «هيكلته». وكان الضعف الرئيسي هو إنشاء الجامعة كمؤسسة عمومية، بينما التشريع المغربي لا يعترف بطابعها الخاص كمؤسسات أكاديمية، مما يحرمها من المرونة في مجال التدبير المالي. كان الخطأ هو الخلط بين الاستقلالية واللامركزية. ومع ذلك، كما كان الحال في فرنسا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، لم يتمكن المغرب من القطع مع الثنائية الأصلية. وهكذا، على الرغم من أن الجامعة تتمتع الآن بنفوذ أكبر بكثير مما كانت عليه قبل القانون 01.00، فقد احتفظت المؤسسات باستقلالية كبيرة. لم يكن التوحيد والتنسيق والممرات في التعليم العالي في الموعد، على الرغم من التوصيات الواضحة للميثاق والقانون.
7.2 إعادة توجيه الإصلاحات:
تأخر صدور المرسوم المحدد لقائمة المؤسسات غير التابعة للجامعة إلى غاية سنة 2006، وتضمن مفاجأة كبرى: التحفظ بشأن المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية! وبالتالي، «لم تتحقق فكرة العمل على الاندماج الجهوي لمؤسسات تكوين الأطر التربوية في الجامعة» [21]. إن التخلي عن هذه الفكرة «الأساسية لإجراء الأبحاث التربوية وتنفيذ برامج ملائمة للاحتياجات الجهوية» [20]، سيكون له تداعيات سلبية على النظام التربوي بأكمله.
لقد كان من الممكن أن يسهم ربط هذه المؤسسات بالجامعة في الشروع في عملية التوحيد. ومع ذلك، ستقوم الحكومة بإدماج المؤسسات التربوية في المراكز الجهوية لمهن التدريس، والتي ربطتها بالأكاديميات الجهوية بدلا عن الجامعات، كما أوصى بذلك الميثاق. وستتولى هذه المراكز صلاحيات المدرسة العليا للأساتذة، مما جعل هذه الأخيرة بدون صلاحيات! وستضم الجامعة مؤسسات أكاديمية ذات استقطاب مفتوح ومؤسسات مهنية ذات استقطاب محدود. يُضاف إلى ذلك كليات متعددة التخصصات، ومؤسسات ذات استقطاب مفتوح لكنها تتوقف عند الباكالوريا زائد سنتين! وكما هو الحال مع تكوين الأطر، فإن هذا الانفصال بين الكليات المتعددة التخصصات والمدارس العليا للتكنولوجيا من جهة والبحث من جهة ثانية سيحرم البلاد من أساتذة باحثين شباب موهوبين ويمنعهم من التقدم في مساراتهم المهنية!
8.2 إصلاح الإصلاح!
مع مرور الوقت، بدأت تتضح حدود الإصلاح. وكان التقييم الموضوعي ضروريا للقيام بالتصويبات اللازمة. ولعل توحيد التعليم العالي وإدخال الخصوصية الأكاديمية في نظام الجامعات، باعتبارها مؤسسات عمومية فريدة، قد ساهم في هذه التصويبات. وفي النهاية، حاول المخطط الاستعجالي «إصلاح» الإصلاح. وتم ضخ مبالغ طائلة في جامعات عانت من نقص التمويل لفترة طويلة جدا. ونظرا لعجز الجامعة عن إنفاق هذه الأموال بالشكل الأمثل بسبب الجمود البيروقراطي والرقابة المسبقة، عانت الجامعة من أجل الوفاء بالتزاماتها. ونظرا لعدم تمكينها من التكوينات المهنية، وإثقال كاهلها بأعداد كبيرة من الطلبة غير المحفزين، وتشريعات غير مناسبة، وموظفين غير مؤهلين بالقدر الكافي، لم تكن الجامعة مستعدة للتعاقد. وقد أقنع هذا الوضع في نهاية المطاف الرأي العام بوجهة نظر تبسيطية تحمل الجامعة مسؤولية فشل السياسات العمومية.
9.2 الربيع العربي وتسليع الجامعة:
في أعقاب الحركات التي سميت «بالربيع العربي»، سيساهم إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات مبكرة في توفير الظروف المناسبة لوصول ائتلاف محافظ إلى السلطة. وكما كان الحال بالنسبة للنضال من أجل الاستقلال، بعث «الربيع» الذي وعد بالتنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية أملا كبيرا. وكما وقع في السابق، ترك الأمل المكان للخيبة. فكما سمح الخطاب القومي بهيمنة الأنظمة الاستبدادية الساعية وراء الريع في جميع أنحاء العالم العربي، سمح الخطاب الإسلامي هذه المرة بجعل الأجندة النيوليبرالية أكثر قبولا. وأفسح سقوط الأنظمة الديكتاتورية، التي كان من المفترض أن تطلق العنان للمبادرات و»ضمان تنمية أكثر عدالة»، المجال لـ»خريف نيوليبرالي» في تونس ومصر … وسيتم إرساء السياسات النيوليبرالية في التعليم العالي بسرعة. وبهاجس تجاري أكثر منه أكاديمي، اختارت الحكومات تقليص تدخل الدولة بشكل أكبر. وهكذا، سنصل في النهاية إلى حالة شبه «ماكدونالدية» في التعليم العالي، وهو ما ترغب فيه الرأسمالية العالمية التي تتبنى فضائل السوق دينا وحيدا لها [22].
وهكذا، كان أول إجراء اتخذته الحكومة الجديدة بالمغرب هو مراجعة قانون المالية لسنة 2012 بهدف تقليص عدد مناصب التعليم العالي. وبعد ذلك، ستقوم الوزارة الوصية، ولأول مرة، بإجراء المعادلة لشهادات القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، ستقوم وزارة الإسكان والتعمير وسياسات المدينة بمراجعة القانون المتعلق بشروط ممارسة خريجي القطاع الخاص لمهنة الهندسة المعمارية [26]. وأخيرا، ستسعى الحكومة إلى مراجعة القانون رقم 01.00 بهدف تعزيز الخوصصة.
10.2 دورة الإصلاحات:
مع ميثاق التربية لسنة 1999 والقانون 01.00 لسنة 2000 انبعث أمل كبير: الحلم بجامعة موحدة ومتعددة التخصصات، تجمع بين الشعب الأساسية والمهنية، بين التكوين والبحث، بنفس صيغ التوظيف والتكوين والإشهاد، باختصار، الانضمام إلى نموذج هومبولت… للأسف، لم يتحقق التوحيد ولا المعيرة ولا كسر الحواجز. في سنة 2003، بدأ فصل جديد! في مواجهة معدلات الهدر الجامعي المثيرة للقلق (45 ٪) وبطالة الحاصلين على الشهادات، بدأت الوزارة الوصية «إصلاحا بيداغوجيا». وفي خضم عملية بولونيا، تم إدخال الهندسة الجديدة: الإجازة – الماجستير – الدكتوراه، ووحدات اللغات والتواصل. كان من المفترض أن تسد هذه الوحدات الثغرات التي تراكمت لدى الطلبة خلال دراساتهم قبل البكالوريا وكان من الواجب أن تمكنهم من الولوج إلى سوق الشغل!
11.2 الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار:
في سنة 2015، تبنى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وثيقة: «من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء: رؤية استراتيجية 2015-2030». وفي خطاب العرش ليوم 30 يوليوز 2015، أعطى جلالة الملك توجيهه «لاعتماد قانون-إطار». وستتولى الحكومة إعداد هذا القانون الإطار، وعرضه على البرلمان، واعتماده في غشت 2019.
وعلى الرغم من أن هذا القانون، كما هو الحال بالنسبة للرؤية، لا يزال محدودا فيما يتعلق بالتعليم العالي، إلا أنه يركز على ثلاث مواد رئيسية: المادة 12، والمادة 50، والمادة 51. في المادة 12، يضع القانون إشكالية التوحيد مع التأكيد على «إعادة هيكلة التعليم العالي، من خلال تجميع مختلف مكوناته لما بعد البكالوريا، على أساس الانسجام والتكامل والفعالية، وفق مخطط متعدد السنوات متشاور بشأنه بين جميع الفاعلين، يتم تنفيذه بصفة تدريجية، ووفق برمجة زمنية محددة». ثم يشدد على «اعتماد نظام بيداغوجي يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية، وينفتح على التجارب الدولية، مع توفير الوسائل والإمكانات المناسبة لتطبيقه وتطويره بكيفية مستمرة ودائمة». وأخيرا، يكلف الحكومة «بوضع خريطة وطنية استشرافية للتعليم العالي، وإقامة أقطاب جامعية موضوعاتية، وإحداث مركبات جامعية جهوية متكاملة، تتوفر فيها الشروط الملائمة للتعليم والتكوين، والتأطير والبحث، والخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية».
وتنص المادة الأخرى ذات الصلة (المادة 50) على أن «تسهر الحكومة على مراجعة شاملة لمساطر وإجراءات الإنفاق العمومي على قطاع البحث العلمي، بما يحقق تبسيطها وشفافيتها وعقلنتها وفعاليتها، قصد تسهيل عمليات تدبير برامج ومشاريع البحث العلمي المعتمدة، وتوفير شروط النجاعة في تنفيذها وتحقيق الأهداف المتوخاة منها».
بعد ست سنوات من المصادقة على هذا القانون، لا نزال ننتظر تنفيذه: لم يتم بعد فتح لا مشروع تجميع كل مكوناته لما بعد البكالوريا، ولا مشروع رسم الخريطة الوطنية المستقبلية، ولا مشروع الإجراءات المالية والضريبية!
12.2 تيهان الحكومة:
منذ سنة 2017، ستنتقل الحكومة (وهي تصرف المالية العمومية) من «أيام دراسية» إلى «أيام وطنية» و»مناظرات جهوية»، ستفضي جميعها إلى «ضرورة» الإصلاح البيداغوجي»! وقد أسفر ذلك عن تعديلات طفيفة، مثل استبدال «اللغات والتواصل» بـ»اللغات والمهارات الناعمة» أو «المهارات الناعمة» بـ»المهارات القوية». وبالتالي، لم تستطع لا التوصيات الواضحة للميثاق، ولا توصيات الرؤية الاستراتيجية والتقرير حول «إصلاح التعليم العالي» [27]، ولا القوانين، التي يُفترض أنها ملزمة، القانون 01.00 أو القانون الصادر مؤخرا 51.17، إقناع الحكومات المتعاقبة بأي شيء سوى تكرار نفس وصفة «الإصلاح البيداغوجي» على مدار 22 سنة الماضية، معتقدة في كل مرة أنها ستحقق نتيجة مختلفة عن سابقتها! لقد عرف ألبرت إينشتاين الجنون بأنه عمل نفس الشيء مرارا وتكرارا وانتظار نتيجة مختلفة!
وهكذا، أطلقت حكومة التناوب إصلاحا حقيقيا مستوحى من الميثاق (التوحيد، …). ولكن كما كان الحال في فرنسا أواخر القرن التاسع عشر، تعثر هذا الإصلاح في البداية ثم «تم نسيانه» تدريجيا بدء من حكومة سنة 2002. هذه الأخيرة أطلقت مشروع الإصلاح البيداغوجي. وأطلقت حكومة سنة 2007 ورشا جديدا: تعاقد الجامعات مع الدولة… وبعد «الربيع العربي»، غيّرت الحكومة الإسلامية الليبرالية، التي هي في الواقع أقرب إلى الليبرالية الجديدة منها إلى الليبرالية، المسار تماما في سنة 2012: تخلت عن التعاقدية لتفتح ورش الخوصصة! وسيتم هذه المرة استكمال هذا الورش إلى آخره! أعادت حكومة سنة 2017، بقيادة نفس الائتلاف الإسلامي الليبرالي، فتح ورش الإصلاح البيداغوجي …
بعد انتخابات شتنبر 2021، قدمت الحكومة الجديدة نفسها على أنها الحكومة التي ستطوي صفحة العقد الإسلامي – النيوليبرالي. وبعثت المفاوضات مع النقابات الوطنية للتربية الوطنية ونقابة التعليم العالي الأمل في إصلاح قائم على التوافق. لكن للأسف، ثبت أن الإغراء «التربوي» أقوى من اللازم! فتم تعليق ورش الإصلاح مؤقتا مع انتظار إصلاح الإصلاح «التربوي». ثم، فجأة، وكما لو أنه من خرج العدم، وصل مشروع جديد إلى المجلس الأعلى في أكتوبر 2024. حاول هذا المشروع أن يتميز ببعض التفاصيل البسيطة عن مشروع الحكومة السابقة المطروح في يونيو 2021. لكن في النسخة النهائية، عادت الحكومة إلى صيغة كانت أقرب ما يكون لمشروع الحكومة الإسلامية – النيوليبرالية المطروح في يونيو 2021! إن قراءة هذه النسخة الأخيرة تبرز بوضوح أن هذا المشروع سيطوي صفحة مسالك الإصلاح الواردة في ميثاق سنة 1999 وستتبخر آمال القانون 01.00 دون مراعاة المواد 12 و50 و51 من القانون الإطار!
1.بين اللوبيات والطابوهات:
1.3 الإرث الفرنسي:
منذ هزيمتها أمام ألمانيا سنة 1870، بذلت فرنسا جهودا متكررة لتبني نموذج هومبولت، لكن دون جدوى. وقد أعاق إرث تطرف ثورتها سنة 1792، وجماعات الضغط التي أنتجتها، والطابوهات التي فشلت في تجاوزها، هذه المحاولة الإصلاحية لمدة قرن، حتى ماي 1968. وفي الواقع، كما يذكر بذلك بيير بورديو Pierre Bourdieu، خلقت الثورة نخبة جديدة من خلال عملية تم فيها استبدال طبقة النبلاء القديمة بـ»طبقة نبلاء الدولة» [28]. إنه النظام التربوي الذي يؤدي «دورا مركزيا في إضفاء الشرعية الرمزية على هذه النخبة من خلال إخفاء هذه التفاوتات الأولية وفرض الثقافة المهيمنة على أنها عالمية» [26]. وفي الواقع، وجدت فرنسا نفسها عالقة بين هذه «الطبقة الجدية من النبلاء» التي كانت تمسك بمقاليد السلطة وتطلعات الطبقات الشعبية، بتشجيع من اليسار والنقابات، والتي كانت تحلم بإعادة إيجاد المصعد الاجتماعي في التعليم العالي. وقد أدت هذه الثنائية بين المدارس الشديدة الانتقائية والجامعات بدون انتقائية إلى أن تصبح الأخيرة «الخيار الافتراضي لكل حاصل على الباكالوريا». وتواجه الجامعة تساؤلا حول هدفها (وخاصة) فيما يتعلق بشعب العلوم الإنسانية، والعلوم «الدقيقة»، والعلوم الاقتصادية. ففي جميع هذه المجالات في الواقع، يتنافس قطاع قوي من المدارس، بأسلحة متفاوتة إلى أبعد حد، مع البرامج التي تقدمها الجامعة. ومن المفارقات، أن التكوين المهني لما بعد البكالوريا أدى عمليا إلى المزيد من إضعاف الجامعة. وفي الواقع، أدت القيود المالية ومحدودية فرص الشغل إلى أن يجعل من التكوين المهني شعبا انتقائية [15].
حالت هذه المعضلة دون تجاوز فرنسا للطابو المتعلق بالولوج إلى التعليم العالي، مما أدى بها في النهاية إلى الإبقاء على النظام المزدوج. ومع مرور الوقت، وأمام الطابو المتعلق بكلفة الدراسات، دخل القطاع الخاص تدريجيا في التعليم العالي لتصل نسبته إلى ما يقارب 30 % هذا السنة! ويبرر كلود أليغر، وزير التربية الوطنية والبحث والتكنولوجيا سنة 1997، استحالة إرساء التوحيد (بسبب عمليات الانتقاء)، ووضع رسوم التسجيل، والاستقلال الذاتي للجامعات، بفترة طويلة من «الاضطرابات، وانهيار الحكومة، وتفكك النسيج الجامعي» [29].
2.3 اللمسة المغربية:
واجه المغرب، المتأثر بنظام الحماية وعلاقاته الوثيقة بفرنسا، صعوبات مماثلة. ومع ذلك، في بداية الاستقلال، اختارت بلادنا نموذجا يشبه إلى حد كبير نموذج هومبولت، لكنها سرعان ما عادت إلى النموذج الفرنسي. لا يفسر تأثير القوة الاستعمارية السابقة كل هذا الحماس لتهميش الجامعة، فقد كانت هناك عوامل أخرى ذات طبيعة سياسية كبرى أكثر حسما. وفي الواقع، وبتشجيع من «النبلاء» الجدد، كانت الحكومات المحافظة حذرة من جامعة تبالغ في النقد. ومنذ البداية، أعاق هذا النوع من الانقسام أي إصلاح للنظام. ولكن بالإضافة إلى صعوبة الولوج والتمويل، أصبحت اللغة عائقا إضافيا، مما جعل الوضع المغربي أكثر تعقيدا من الوضع الفرنسي. وهكذا، أصبح لدينا الآن تعليم عال مبلقن كليا: أصيل وحديث، مؤدى عنه ومجاني، خصوصي وعمومي، تابع للجامعة وغير تابع لها، مهني وأكاديمي، باستقطاب مفتوح واستقطاب محدود! وهكذا، فإن 80 % من الطلبة الذين لم ينجحوا امتحانات المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود والذين يفتقرون إلى الوسائل المالية لدفع تكاليف دراستهم، ينتهي بهم الأمر في مؤسسات الاستقطاب المفتوح، ويتلقون تعليما أساسيا بموارد محدودة للغاية. ولا يمتلك هؤلاء الطلبة عموما لا الحافز لمتابعة الدراسات التي لم يرغبوا بها أبدا ولا الخلفية اللازمة للدراسات الأساسية الصعبة للغاية . وفي هذا النموذج الفرنسي، الفريد من نوعه في العالم، تستقبل كليات الاستقطاب المفتوح طلبة متوسطين للغاية لتكوينهم في مجالات متخصصة جدا مثل نظرية النسبية لإينشتاين، ومبدأ عدم اليقين لهايزنبرغ Heisenberg، وجبر بول Boule، ولسانيات تشومسكي Chomsky، وفلسفة هيجل Hegel، أو اقتصاد ريكاردوRicardo ! وهذا هو بالفعل السبب الحقيقي وراء كثرة الطلبة الذين لا يكملون دراستهم وبدون شهادة جامعية أو وراء ارتفاع بطالة الحاصلين على الشهادات. ولن يحل أي إصلاح بيداغوجي هذه المشاكل! لكن الحكومات المتعاقبة غير متفقة على ذلك.
على سبيل الختم:
من الواضح اليوم أن التشرذم الحالي، الموروث من تطرف الثورة الفرنسية سنة 1792، هو الخطيئة الأصلية. هذا التشخيص، الذي توصلت إليه دراسات عديدة في فرنسا، ومؤتمرات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، واللجنة الخاصة للتربية والتكوين في الميثاق الوطني للتربية والتكوين لسنة 1999، ثم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في الرؤية الاستراتيجية سنة 2015، سيعود مرة أخرى مع القانون رقم 01.00 لسنة 2000 والقانون الإطار 51.17 لسنة 2019. وبالتالي، فإن إعادة هيكلة التعليم العالي، ومراجعة التشريعات المنظمة للمؤسسات العمومية، والتحفيزات الضريبية، وجميع الأحكام الواردة في هذه القوانين، لا تزال تنتظر التنفيذ.
من المفروض على التعليم العالي، الموجه للبالغين المستقلين تماما، أن يوجههم ويؤطرهم. لذلك، يكمن دور التعليم الإعدادي في تهيئ المراهقين ليصبحوا أكثر استقلالية للدراسة في التعليم العالي. فهذه المستويات الثلاثة مترابطة للغاية، ولا يمكن إصلاحها بشكل منفصل. وللأسف، ولأسباب تنفلت من التفسير، لا يوجد تنسيق كاف بين الوزارتين الموصيتين، وحتى عندما يشرف وزير واحد عليهما.
لقد أدى الضغط الشعبي في أعقاب الاستقلال مباشرة على المدارس القليلة القائمة إلى جعل مسألة إصلاح التعليم، الموروث عن الحماية، مسألة مستعجلة. لكن، أصبحت هذه المسألة ساحة للتعارك السياسي. من الأكيد أن الأمية المزمنة، وهي إرث الحماية، جعلت من تعميم التعليم أولوية، إلا أن محدودية الموارد والأطر أعاقت هذا الحماس. ومع ذلك، بذل المغرب جهودا كبيرة لتعميم فرص الولوج إلى المدرسة، محققا معدلات تمدرس عالية نسبيا. غير أنه لم تتم دائما مواكبة هذه الدمقراطة في الولوج بتحسين الجودة. فالتقييمات الوطنية والدولية تكشف أن المكتسبات الدراسية لا تزال ضعيفة. وبالتالي، يبدو أن التحدي يكمن في التحول من الكم إلى الجودة، مما يستلزم إجراء عدة تغييرات على مستويات مختلفة للارتقاء نحن الأعلى.
وعلاوة على ذلك، هناك حاجة استعجالية إلى تنفيذ سياسات تهدف إلى التقريب بين مستويات الإصلاح في البداية، مثل وضع مناهج دراسية مشتركة، وإرساء نظام ائتماني حقيقي، وتيسير الممرات بين مختلف المناهج الدراسية.
(*) – محمد جمال الدين صباني: منسق قطاع التعليم العالي الاتحادي، الكاتب العام للفيدرالية الدولية للعمال العلميين، الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية للتعليم العالي.