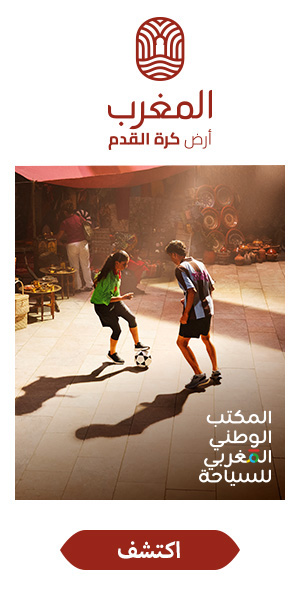*إنّ ما يسمّيه البعض «أزمة مهاجرين» يسمّيه موران أزمة خيال جماعي. عطب في القدرة على تصور «نحن» أوسع من حدود الدين واللون والأصل
حين نقرأ إدغار موران، لا نتصفح مجرد كتاب، بل نقف أمام مرايا متعددة للوجود، مرايا تكشف عن هشاشتنا، وعن المسارات المتشابكة التي نسميها تاريخًا وحضارة ومجتمعًا. وما يثير الانتباه في كتابه الساحر الذي اخترناه ليكون رفيقنا «لنستيقظ»، ليس سرد الأحداث أو تفسير الأزمات، بل القدرة على جعل القارئ شريكًا في التفكير، مواطنًا في عالمه، ضميرًا واعيًا في مواجهة المجهول.
موران يضعنا أمام صعوبة العصر الحديث. فالعالم لا يقدم إجابات جاهزة، كل يقين يتهاوى، وكل نظام يبدو عاجزًا عن احتواء الانحرافات أو التكيف مع التعقيد. وهنا، تصبح القراءة تمرينًا على التأمل النقدي، دعوة لاستجواب الذات والآخر، والزمان والمكان، والتحولات البيئية والاجتماعية، لتسائل كل ما نعتبره مسلّمات وحقائق ثابتة.
في هذه الرحلة، ليس المطلوب أن نعرف كل شيء، بل أن نتعلم كيف نعيش مع اللايقين، وكيف نعيد صياغة علاقاتنا مع أنفسنا والعالم، وكيف نصنع أفقًا للفكر قادرًا على احتواء التناقضات. فالفلسفة، عند موران، ليست مكتبة أفكار جاهزة، بل ورشة عمل فكرية مفتوحة، حيث كل قارئ هو شريك في البناء والتحليل.
تفكيك البلاغة الجمهورية
لم يعد الوعي الإنساني، في مطلع هذا القرن، قادراً على تفادي الأسئلة المقلقة التي تهزّ أسس وجوده. فكلما اتّسعت معرفة البشر بأنفسهم وبالعالم، ازداد شعورهم بأنهم يسيرون في دروب لا يقين لها، وأن التاريخ الذي ظنّوه خطّيًا يخبّئ تعرجات لا يمكن التنبؤ بها. وسط هذا القلق الفكري والأنثروبولوجي، ينهض إدغار موران كأحد آخر الأصوات التي ما زالت تُصرّ على أن الفكر قادر، وربما مُلزَم بإعادة بناء المعنى المهدّد بالانهيار.
كتاب «لنستيقظ» لإدغار موران، من ترجمة الكاتب التونسي المنتصر الحملي، هو تمرين على إعادة تعليم الإنسان كيفية الإنصات إلى هشاشته وإلى العلامات الدقيقة التي تسبق الكوارث. تماما ككتابه السابق، «لحظة أخرى أيضًا» لنفس المترجم، درس في الحكمة التي يولدها العمر حين يقترن بالتأمل، إذ تصبح كل تجربة فردية مدخلاً إلى سؤال كوني. فالدهشة التي يضعها موران في صلب التفكير، في كلا التجربتين، وإن اختلفتا منهجا وتفكيرا ورؤية، ليست انفعالاً عابراً، بل هي الشرارة الأولى التي تُحرّر الإنسان من ثِقَل العادة وتجعله يرى العالم بما هو عليه: معقّد، متشابك، غير نهائي.
وبقدر ما يقترب موران من شيخوخته، يقترب أكثر من تلك الحالة الروحية التي وصفها الفلاسفة القدماء بـ»النضج المتأمل»، حيث يصبح الزمن أكثر عمقاً، والحياة أشبه بنبيذ مُعتّق تُختزل فيه حكمة تجارب طويلة ومتشعّبة.
يسيح موران في هذا الكتاب كما لو أنه يرى التاريخ من علٍ، دون أن يفقد حضور التفاصيل الصغيرة التي تصنع المأساة الإنسانية. إنّ دعوته إلى «الاستيقاظ» ليست أخلاقية بقدر ما هي إبستمولوجية. استيقاظٌ ضدّ الأوهام، وضدّ التغافل، وضدّ انبهار الإنسان بالتقنية إلى درجة ينسى معها حدود قدرته وحدود جسده وحدود الأرض التي يعيش عليها.
يرى موران أنّ البشرية تعيش تحت سطوة ثلاثة أوهام كبرى، وهم السيطرة، حيث الإيمان بأن التكنولوجيا يمكن أن تعوّض الحكمة. ووهم التقدّم الحتمي، حيث الاعتقاد بأن التاريخ يسير دائماً نحو الأفضل. ووهم الهوية الثابتة، حيث الادعاء بأن الجماعات تُعرَّف بجوهر لا يتغيّر.
هذه الأوهام، مجتمعة، تخلق إنساناً فاقداً للبوصلة، مهدّداً بالوقوع في يقينيات قاتلة، أو في شكوك مشلّة.
في هذا الكتاب الذي نقرأه اليوم، يشغل موران جزءاً واسعاً من تأملاته بإعادة قراءة فرنسا، ليس من زاوية مركزيتها الأوروبية، بل باعتبارها مختبراً مكثّفاً لتناقضات الحداثة. فـ»الفرنسة» ليست هوية صافية، بل متتالية تاريخية تتقاطع فيها أربع فرنسات، فرنسا الجمهورية الإنسانية وريثة قضية دريفوس، دولة الحقوق. وفرنسا الرجعية الهووية، المنشغلة بالحنين إلى الملكية، امتياز الكاثوليكية، وعداء اليهود. وفرنسا اليسار الشيوعي التي حملت حلم العدالة الأخوية رغم انكساراته. وفرنسا الرأسمالية الليبرالية، المتصالحة مع منطق السوق، إلى جانب الديغولية كتركيب سياسي بين السيادة والواقعية.
موران لا يكتب هذا لإعادة رسم المشهد السياسي، بل ليُظهر أن الهوية تماماً كما يفهمها في مشروعه الفكري، هي عملية دينامية، لا يمكن اختزالها في شعار أو تصور أحادي. إنه يتقاطع هنا مع نوربرت إلياس في فهم الدولة، الأمة كتكوين تاريخي متقلب، ومع بيار بورديو في فهم الهويات بوصفها رهانات صراع، ومع بول ريكور في فهم الذاكرة كحقل للتوتر لا للتوافق.
يعتبر موران أن اللحظة الراهنة هي أخطر من جميع أزمات القرون الماضية؛ لأن الإنسان يواجه لأول مرة عجزه الوجودي أمام ذاته، لا أمام الطبيعة أو الآلهة أو التاريخ. فالأزمة ليست بيئية ولا سياسية فقط، بل هي أزمة تصور الإنسان لنفسه. والاقتصاد الذي يلتهم كل شيء ويحيل البشر إلى وحدات استهلاكية. أما التقنية التي توسّع قدرات الإنسان فإنها تُضعف قدرته على الحكمة. بينما الإعلام يعيد تشكيل الوعي تحت منطق الإثارة والخوف. كما وأن اللامساواة تجعل المجتمع فضاء طبقيًا مشحونًا بالعنف المحجوب. لهذا يدعو موران إلى تأسيس أنثروبولوجيا جديدة، تعترف بأن الإنسان ليس كائن عقل فقط، بل هو أيضاً كائن خطأ، كائن هشّ، كائن متشابك مع الآخرين والعالم.
إنها أنثروبولوجيا تحرّر الفكر من استبداد التبسيط، وتعيد إليه قوة التعقيد، بوصفها قوة للحياة لا للارتباك. فالفكر المركّب، كما يطرحه موران، ليس مجرد تقنية تحليل. إنه أخلاق لفهم العالم دون تشويهه، والإنسان دون اختزاله، والمستقبل دون التنبؤ الساذج به. فالتعقيد بنظر موران، ليس دعوة إلى الغموض، بل إلى الاعتراف بأن الواقع لا يُختزل في ثنائيات، وأن المعرفة لا تنفصل عن المسؤولية، وأن الحرية لا تنفصل عن حدودها، وأن العقل لا ينفصل عن القلب.
إن مشروع موران في كتابنا هذا يرتقي كامتداد لنقد ديكارت، وتفكيك كانط، ومساءلة هيدغر، وإعادة تركيب طموحة بين العلوم الطبيعية والإنسانيات. إنه يضعنا أمام إعادة اكتشاف الإنسان ككائن متعدد الطبقات، لا يمكن فهمه بالمنهج الواحد ولا باللغة الواحدة.
لا يقدّم موران وصفة للنجاة، ولا يدّعي امتلاك الحقيقة. ما يقدّمه هو ما تحتاجه البشرية في لحظة الانهيارات الكبرى. مرآة ترى من خلالها تناقضاتها، وجرس إنذار يذكّرها بأن حضارتها ليست خالدة، وبارقة أمل بأن الوعي قادر على تغيير المصير إذا امتلك شجاعة النظر إلى ذاته.
«لنستيقظ» ليس مجرد كتاب، بل وصيّة فكرية يتركها أحد كبار حكماء العصر. ولعله يطلب منا شيئاً بسيطاً وعميقاً في آن واحد: «أن نتوقّف عن السير نياماً.»
سيكولوجيا الكراهية المؤسّسة
في الفصل الذي يُدرجه إدغار موران تحت عنوان «الهجرة: عتبة التسامح»، لا يعود الحديث مجرّد معالجة تقنية لظاهرة اجتماعية ضاغطة، بل يتحوّل إلى تفكيك جذري لصورتنا عن أنفسنا كبشر قبل أن يكون نقاشًا حول سياسات الحدود. فالهجرة، عند موران، ليست فائضًا ديمغرافيًا يقتحم المجال الأوروبي، ولا حالة استثناء تاريخية نبحث لها عن قوانين تنظّمها؛ إنها أوّلًا مرآةٌ حرّة تكشف هشاشة إنسانيتنا حين نستيقظ على الحدود التي نقيمها داخل دواخلنا قبل أن نقيمها على تخوم الدول.
يكتب موران الهجرة بوصفها امتحانًا للأخلاقي قبل أن تكون أزمة سياسية. فمن «كرم الضيافة»، المفهوم الذي يعيده إلى جذوره الأنثروبولوجية، لا يريد موران ذلك الكرم المشروط، المربوط بتأشيرة أو بعقدِ عمل، بل الكرم الأصلي الذي تحدّث عنه الفلاسفة الأخلاقيون من كانط إلى ليفيناس، الاستعداد لاستقبال وجه الآخر كما هو، لا كما نرغب نحن أن يكون. ولهذا ينتقد موران، بحدة محسوبة، أولئك الذين يجرّمون سكان المناطق الحدودية لأنهم مارسوا، ببساطة، ما يراه هو «أخوّة غير قانونية». أخوّة تُدينها الشرطة ويعترف بها الضمير الإنساني.
ويتقاطع موران هنا مع كلود ليفي شتراوس، حين يستعيد منه مفهوم «عتبة التسامح»، لكنّه يوسّعه من المجال الإثنولوجي إلى الفضاء السياسي المدني. فليست هناك، يقول موران، صياغة قانونية يمكن أن تضبط معنى «التسامح»، لأن كلّ قانون هو بالضرورة قيدٌ، بينما تتطلب الأخلاقيات مساحة هشّة لا تُقاس بالعدد بل بالاستعداد النفسي لاستقبال الاختلاف. لذلك تصبح عتبة التسامح، في عمقها، ليست إحصاءً ديمغرافيًا بل حدثًا نفسيًا؛ لحظة عبورٍ يكتشف فيها الفرد إلى أي حدّ يستطيع احتمال الآخر حين يدخل عليه من دون استئذان، بملامحه، بلغته، وبتاريخ لم يُكتب في دفاتر الأمة.
وفي نقده لبلده فرنسا، يسائل موران ، «أيّ معنى لفرنسا «الجمهورية الإنسانية» حين تتصدّع أولًا أمام اختلافات هي صنيعة تاريخها الاستعماري؟
فرنسا التي تشكّلت من أرخبيل أعراق وثقافات، من الغوربة إلى الاستعباد، تبدو في نظر موران، وكأنها تخشى اليوم نتاجاتها هي، فترى في أحياء الضواحي «صورة مصغّرة لفرنسا معرَّبة ومزنَّجة»، صورة تستفزّ الذاكرة أكثر مما تهدّد الواقع.
إنّ ما يسمّيه البعض «أزمة مهاجرين» يسمّيه موران أزمة خيال جماعي. عطب في القدرة على تصور «نحن» أوسع من حدود الدين واللون والأصل. وهنا يلتقي موران مع هابرماس في نقده لفكرة الهوية المغلقة، ومع بول ريكور الذي نبّه إلى ضرورة الفصل بين سرديات الهوية وحقائق العيش المشترك. ومن ثمّ، تصبح «عتبة التسامح» حالة وجودية أكثر مما هي سياسة عمومية:
عتبة ينهار عندها جهازٌ نفسيٌّ يرفض رؤية جزار للحوم الحلال، أو وجهًا ذا بشرة سمراء، أو مجموعة من الأطفال في ساحة عامة يتحدثون بلغتين. هذه ليست أزمة دولة بل أزمة الذات الحديثة التي خافت من نفسها حين رأت العالم يدخل إلى داخلها.
إنّ موران، بهذا التفكيك، لا يدعو إلى قبول المهاجرين فقط، بل إلى إعادة تعريف الإنسانية بوصفها حركة دائمة، وتداخلًا مستمرًا، وجرحًا مفتوحًا يعيد تشكيل معنى الانتماء. وفي هذا كلّه تعود الهجرة لتكشف ما حاولت الدولة القومية إخفاءه، أنّ البشر لم يُخلقوا للسكن في هوية مغلقة، بل للعبور المستمر، وأنّ التسامح ليس قانونًا تنظيميًا، بل فضيلة الوجود في عالم يتغيّر دون توقف.
ما بعد البشر…
وما قبل الإنسانية
يقرّ إدغار موران بصرامة المفكر الذي لا يخشى مواجهة بيته الداخلي، بأن ما يعتمل في فرنسا ليس مجرد أزمة عابرة، ولا اضطرابًا سياسيًا يمكن رتق شقوقه عبر إصلاحات ظرفية. إن ما يعيشه البلد، كما يقول، يتجاوز أعطاب الأحزاب المتهاوية، وانحطاط الممارسة الديمقراطية المبتلاة بالعجز ذاته في كل بقاع العالم، ويتجاوز أيضًا جيفة الدولة البيروقراطية التي تسكنها الطفيليات، وتتغذّى على شرايينها لوبيات منفلتة من كل مساءلة. بل يتخطى حتى الانهيار الأخلاقي لمجتمع باتت روحه مسكونة بمنطق الربح، يزحف على كل شيء ويحوّل القيم إلى سلع.
أزمة في القدرة على الفهم، على التمييز، على بناء رؤية تحصّن الإنسان من العمى الكوني الذي أصبح يبتلع العالم. يستدعي موران تاريخًا متشابكًا من المآزق التي تراكمت عبر القرون. يبدأ الأمر من سنة 1492، التاريخ الرمزي لولادة «العصر الكوكبي»، حيث انطلقت أوروبا في مشروعها الإمبراطوري الذي سيعيد تشكيل العالم من خلال غزو الأمريكيتين وبداية التوسّع البحري، فاتحًا الطريق أمام سلسلة من التحولات التي ستبلغ ذروتها في الأزمنة الحديثة. ثم ينتقل إلى 1972، العام الذي استيقظ فيه العالم فجأة على هشاشته البيئية، حين ظهر لأول مرة وعي كوني بأن الأرض ليست مجرد مسرح محايد لفعاليات الإنسان، بل كيان حيّ ينهار تحت ثقل حضارة شرهة. هنا تبدأ الأزمة البيئية الكوكبية، أزمة الذات البشرية وقدرتها على البقاء.
بعد ذلك، تدخل البشرية منعطفًا آخر، الزمن ما بعد البشري. حيث إنه في الثمانينيات، تنفلت تخيلات جديدة تدعو إلى تجاوز الطبيعة البشرية ذاتها، وإعادة هندسة الإنسان، جسدًا ووعيًا ومجتمعًا. تصبح المعادلة هي، كائن ما بعد إنساني، كائن يفوق الإنسان ويتجاوزه، مدفوعًا بوهم القدرة على اختراع ذات جديدة من خلال التكنولوجيا، غير أن موران يرى في هذا الخطاب أسطورة جديدة، تُغذيها رؤية تبسيطية للعقل والوجود. إنها أسطورة المجتمع الذي يُديره ذكاء اصطناعي متعالٍ، يُتوقع منه أن يقضي على الفوضى، دون إدراك أن القضاء على الفوضى يعني القضاء على الإبداع، على المبادرة، على الحياة نفسها. لأن النظام المعصوم كما يقول موران، ليس سوى نظام بلا رحمة، نظام يغتال الحرية باسم الانسجام، ويقتل التنوع باسم الكفاءة. ومن هنا ينفذ موران إلى صلب الفكرة. فالمشكلة ليست في تكثير القدرات التقنية، بل في ترقية الشروط الإنسانية التي تجعل العيش أكثر امتلاءً بالمعنى. ليست الرهانات في إعادة تشكيل الطبيعة البشرية، بل في صيانة الممكن الإنساني من أسوأ انحرافاته، وتعزيز أفضل ما فيه. إن النزعة ما بعد البشرية، كما يحلل، ليست سوى غطاء يخفي الحاجة الحقيقية، تجديد البشرية نفسها، وليس إلغائها.
ولمّا كان الثالوث الحديث، العلم، التكنولوجيا، الاقتصاد، قد تحوّل إلى قوة منفلتة، فإن ما يُنتجه ليس مستقبلًا أكثر إشراقًا، بل عالمًا مُدجّجًا بالقوة، ومحرومًا من الحكمة. قوة تُنجب عجزًا، وتقدّمًا يولّد كوارث، وازدهارًا يخلق هشاشة سياسية واجتماعية، ويدفع نحو قيام دول سلطوية أو خاضعة لإملاءات الرأسمال المالي.
وفي خلاصة تحليله، يضع موران الإصبع على الجرح، إذ إن الوباء، مثل كوفيد19، لم يكن مجرد حادث صحي، بل تجليا لبنية أزمة أشمل. فالعولمة التقنية/الاقتصادية، التي وُعدنا بأنها ستوحّد العالم، باتت تولّد الشك بدل التضامن، وتكشف انكشاف الدول وتبعيتها بدل قوّتها. أصبح الوباء قلب الأزمة البشرية، لا لأنه مَرَض، بل لأنه كشف عمق ترابط الأزمات، وتشابكها المرعب.
إنها إذًا، كما يصر موران، أزمة فكر قبل أن تكون أزمة عالم. أزمة في القدرة على رؤية المصير المشترك، وسط عالم يتحرك بسرعة تفوق قدرة الإنسان على الفهم والتروي.
اللايقين والوضوح: الإصلاح الأنموذجي للعقل البشري
ينطلق إدغار موران في تأمله من جوهر الأزمة، معتبرًا إياها أكثر من مجرد اضطراب مؤسسي أو سياسي. إنها عجز القواعد التنظيمية عن منع الانحرافات أو كبحها. وإذا سمح للانحرافات أن تتطور بلا رادع، فإنها لا تظل مجرد شذوذ عابر، بل تتحوّل إلى اتجاهات قوية تهدد أعمق صلب المنظومة. وعندما يتم حل الأزمة بانتصار هؤلاء المنحرفين، ليس الأمر مجرد تبدّل في القيم. بل قد تنشأ منظومة جديدة، أو تندمج أداة هؤلاء المنحرفين داخل المنظومة القديمة، فيصبح المنحرف هو المعيار الجديد، بينما يُطرد سادة النظام السابق أو يُصنّفون كمنشقين أو منحرفين.
وفي قراءة موران، تكمن الخاصية الجوهرية للمجتمعات الحديثة في هشاشتها البنيوية، أي توقف للنمو، أو أي تراجع في قوى التنظيم، يفضي مباشرة إلى أزمة يمكن أن تصل إلى أقصى درجاتها. فالمجتمعات المعاصرة، بحسبه، ليست منصفة في استقرارها، بل هي مسرح دائم للصيرورات العاصفة، حيث لا شيء يظل ثابتًا، ولا شيء مضمونًا.
لكن موران يتجاوز الأزمة كمفهوم إداري أو تنظيمي، إلى أزمة الفكر ذاته، أو ما يمكن تسميته بـ»فكر الأزمة». فغياب الوضوح في المصطلح وتعقيد المفهوم، نابع من تجزئة المعارف وفصلها عن بعضها، ما يجعل أي محاولة لفهم الأزمات عبر منظور أحادي أو خطي، تصورًا مغلوطًا وغير مكتمل. في مواجهة الأزمة، يتضح أن العمى والخوف من اللايقين مرتبطان بطبيعة هذا التفكير الآلي، الذي يقيس الصيرورة البشرية بخطوط مستقيمة، متجاهلًا التعقيدات والارتباطات غير الخطية بين الأحداث.
وبالرغم من اللايقين، يرى موران أن الإنسان قادر على تطوير استراتيجيات مرنة، تعتمد على معلومات موثوقة ومعارف دقيقة، تسمح بمواجهة الأزمة، والتكيف مع المخاطر دون الانغماس في اليأس. فالأزمة، في آن واحد، تنتج الوضوح والعمى، المساءلة والبحث عن كبش فداء، الإبداع والخيال الرجعي؛ هي لحظة تتكشف فيها القوى المنقذة والربابين الغارقين، وهي اختبار لمقدرة الفكر البشري على الاحتواء والتأمل.
ويصل موران من خلال ذلك إلى إصلاح الفكر، في نصه الرائع حول «العودة إلى أرضنا»، حيث يوازن بين عظمة العقل البشري وضعفه، مستلهماً فكر باسكال الذي يرى أن قوة الإنسان لا يجب أن تحجب عن عيننا هشاشته، وأن نقاط القوة تحوي في طياتها ضعفًا هائلًا. فالسلطة المفتقرة إلى الوعي هي عجز، والسلطة المفتقرة إلى الضمير هي خراب للروح.
وفي جوهر الإصلاح، يطرح موران أن الفكر المهيمن يقوم على مفهوم عقلانية أحادية، تحصر الرؤية في عناصر معزولة عن سياقها، وتخلق تصورات مبسطة وجزئية. وبالتالي، فإن الثورة الفكرية المطلوبة ليست مجرد تعديل معرفي، بل ثورة أنموذجية، استبدال المبادئ المجزأة بمبادئ قادرة على التعرف على التناقضات المتكاملة، والتمييز بينها، والجمع بينها في رؤية شمولية. كما يؤكد موران على أن الإصلاح التربوي يجب أن يدرس مصادر الأخطاء وأوهام المعرفة، ويعيد إدراك أن المنفصل هو أيضًا متصل، والمستمر هو أيضًا منقطع، وأن المعرفة الحقيقية تتطلب رؤية الروابط غير الظاهرة بين الأشياء، والأحداث، والبشر. هذا الأخير المتسم بالتناقض والقطبية، بشكل يبدو متناقضا، «فالإنسان هو في الوقت نفسه عاقل ومعتوه، صانع وأسطوري، اقتصادي تحركه الفائدة ولاعب مدفوع باللعب والأنشطة التطوعية»، إنه برأي موران «يمكن أن يوضع عقله في خدمة جنونه، كما هو الحال في الحرب والإبادة الجماعية. ويمكن أن توضع تقنيته في خدمة أساطيره من خلال تسليح حروبه الصليبية وجهاده، ومن خلال بناء معابد دياناته وتكريس أسطورة فتح العالم»، مستنتجا أن «الفرد البشري كائن غير مستقر ومتعدد الاستخدامات، يعيش على التناقضات، قادر على الأفضل والأسوأ معا، وعليه أن يتحكم باستمرار في عواطفه بواسطة عقله، وتدفئة عقله دائما من خلال شغفه».
الضمير المتيقظ واللايقين المدرك
في دعوته الشهيرة «لنستيقظ»، لا يكتفي إدغار موران بتوجيه خطاب وجداني أو تأملي للقراء، بل يقدّم لهم خارطة فكرية للوعي والمواجهة. إنه لا يتركنا في مواجهة المصير المجهول والخوف من المستقبل، دون أدوات نظرية ومنهجية تساعدنا على قراءة الواقع وفهمه. وفي الفصل المعنون «إيقاظ الضمائر»، يقتبس موران خوسيه أورتيغا إي غاساي قائلاً: «إننا لا نعرف ما يحدث لنا، وهذا بالضبط ما يحدث لنا»، ليضعنا مباشرة أمام مفارقة المعرفة الإنسانية: كيف نتصرف في عالم نحن جزء منه، لكنه يفلت من سيطرتنا وفهمنا؟
يتساءل موران عن قصور النظر الإنساني: هل هو محدود بطبيعته أمام ما يتجاوز اللحظة الفورية؟ أم أننا نعاني من تصورات مشوهة للواقع، تشوه فهمنا للتاريخ والحاضر؟ أم أن الأزمة تكمن في الفكر نفسه، في بنيته المجزأة والمحدودة، بحيث تُصبح المعرفة ذات طبيعة مشوشة، تُنتج شكوكًا مستمرة، وتولد سرنمة معممة تصرف الإنسان عن الواقع الفعلي؟
ويجيب موران، بطريقته الاعتيادية ، أن «الكثير من اليقينيات قد جرفت». فاللايقين بنظره ليس عيبًا، بل شرطًا للوعي. وفي المحيط المتلاطم من الأزمات البيئية، الاجتماعية، والسياسية، يصبح كل يقين سابق هشًا، ويصبح كل فهم جزئي، غير قادر على احتواء التعقيدات الكونية.
ومن هذا المنطلق، يطرح موران مجموعة من الأسئلة المفتوحة، التي تتجاوز حدود الكتابة التقليدية: كيف نفهم تاريخنا المعاصر بينما نكون نحن جزءًا من عملية تدمير بيئة كوكبنا، وتفكيك مجتمعاتنا؟ كيف نتصور التحوّل بين سباق نحو الموت وسباق نحو التحول الإنساني، وهل يمكن أن يكون كلاهما موجودًا في نفس الوقت؟
هذه التساؤلات، وفق موران، ليست مجرد تأملات نظرية، بل دعوة عملية لإعادة بناء الفكر الإنساني على أسس جديدة قادرة على مواجهة التعقيد والتشابك بين البيئي، والاجتماعي، والتقني، والسياسي.
كما ويتجه موران نحو فكر إيكولوجي شامل، يرى فيه أداة أساسية لتأسيس بنية تفكيرية جديدة. هذا الفكر الإيكولوجي لا يقتصر على حماية البيئة، بل يمتد ليشمل تصميم المدن والمجتمعات وفق منطق مستدام وشامل، يعتمد على الطاقة النظيفة، ويدعم النقل الجماعي والعام، ويخلق مناطق حضرية للمشاة، ويعيد النظر في الحوكمة البشرية الشاملة، بحيث تُدمج الحوكمة الحضرية والريفية، وتكون سياسة متكاملة للبشرية.
ويركز فيلسوفنا على ضرورة توسيع دائرة المشاركة في الحوكمة، تمثيل السلطات البلدية المنتخبة، والحكومة الوطنية، والمهن المؤهلة، وإشراك المجتمعات المحلية في صنع القرار. بهذا المعنى، تصبح إيكولوجيا الفكر والسياسة مترابطة، في فهم البيئة ومعالجة المشكلات الاجتماعية والسياسية ليستا عمليتين منفصلتين، بل مرتبطتان بجوهر الإنسان وعلاقاته مع الطبيعة والمجتمع.
إن روح هذا الفصل من الكتاب، في جوهره الفلسفي، هي الدعوة إلى إعادة تأسيس العقل والضمير البشري في مواجهة تعقيدات الحياة الحديثة. فالإيقاظ لا يعني مجرد الوعي بالكارثة، بل إعادة تشكيل الفكر، وتوسيع مداركنا، وإيجاد بدائل عملية، قادرة على تحويل الأزمة إلى فرصة للتجديد والتحوّل.
وفي هذا السياق، تصبح مدينة المستقبل، والمجتمع المستدام، والفكر المشارك، مرآة للإمكانية الإنسانية: كيف يمكن للوعي الجماعي أن يوازن بين القوة والرحمة، بين المعرفة والعمل، بين الطبيعة والمجتمع، وبين الأخلاقي والسياسي.
يدعونا موران إلى تفكير متكامل، شمولية معرفية، ورؤية إيكولوجية أخلاقية، تجعلنا نواجه أزمة اللايقين بالوعي، والأزمة البيئية والاجتماعية بالتخطيط، والأزمة الفكرية بثورة أنموذجية في التفكير. إنه لا يكتفي بوصف الأزمة، بل يقدم مسارًا فلسفيًا عمليًا للخروج من الظلام، نحو مجتمع أكثر حكمة وعدلاً وإنسانية.
خاتمة
حين نغلق الكتاب، لا نغلق الصفحة الأخيرة، بل نفتح أكثر من باب على عالم من الأسئلة: كيف يمكن للوعي الفردي أن يصبح قوة جماعية؟ كيف يمكن أن نحتوي التناقضات بين القوة والرحمة، بين المعرفة والخيال، بين البيئي والاجتماعي؟ ما هو ثمن اللايقين، وما هي حدود الإمكانات الإنسانية في عصر يزداد فيه التعقيد كل يوم؟
موران لا يقدم إجابات جاهزة، بل أدوات للتأمل والتحليل والتفسير، ليصبح كل قارئ في موقع مؤسس للمعنى، في مواجهة المخاطر، وفي بناء عالم ممكن ومستدام. كل أزمة، كل تحدٍ، كل أزمة بيئية أو اجتماعية، هي دعوة لتوسيع المدارك، وإعادة النظر في مفهوم الإنسان والمجتمع والتاريخ.
في هذا السياق، تصبح الخاتمة مساحة مفتوحة للتأويل والفكر الحر، حيث لا نهاية للرحلة المعرفية، بل استمرار المواجهة مع اللايقين، والتأمل في الممكنات، ومحاولة رسم خريطة للعقل والضمير والمجتمع في عالم متغير بلا توقف.
*» لنستيقظ» إدغار موران ، ترجمة المنتصر الحملي ـ منشورات دار صفحة7 السعودية، ط1 2022 (119 صفحة)