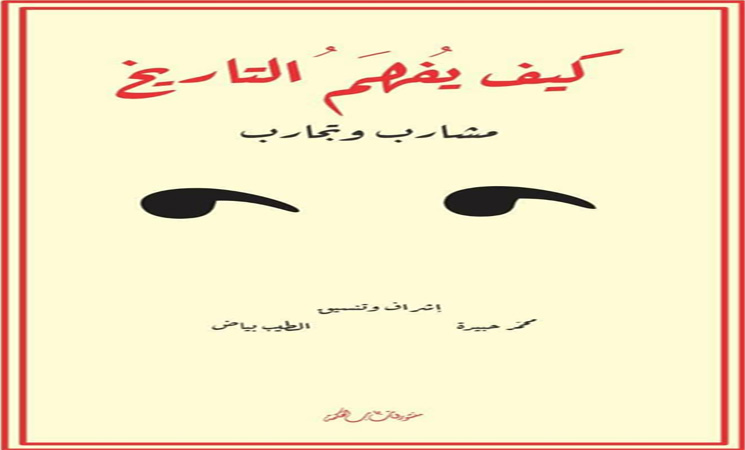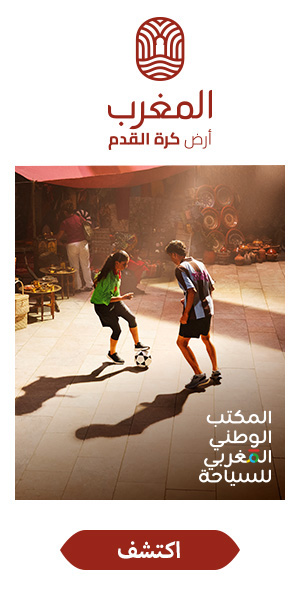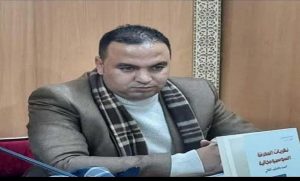
شفشاون روح إيبيرية تسكن الفضاء، واللقاء فيها تاريخي بامتياز، بين جيلين يتصلان بنَسب منهجي ونفَس تجديدي، وتسري بينهما روح استملاك تجديد أوراش الكتابة التاريخية، وتعميق النظر في قضايا وأسئلة المنهج والكتابة… الموعد هام من خلال الورقة الافتتاحية التي صاغت التصور العام، والحضور وازن بمشاركة أسماء راكمت أبحاثا جد معتبرة في مدارات الكتابة التاريخية المغربية، والرهان أكبر من خلال مد جسور التواصل بين أجيال البحث، وفق ما تقتضيه أخلاقيات البحث الأكاديمي.
قَدر ميدان التاريخ وفق المداخلة الافتتاحية للمؤرخ محمد حبيدة، أستاذ التاريخ الاجتماعي بجامعة ابن طفيل في القنيطرة أن يعود إلى نقطة البدء، وأن يسعى إلى تحصين ميدانه ويدافع عن مكتسباته الشرعية، وتلك خصوصية لا نجد نظيرا لها في العلوم القريبة من التاريخ. سؤال التحصين تاريخي كما يتتبع حبيدة، طُرح مع رانكه في «قواعد البحث التاريخي»، وأعيد مع المؤرخ الوسيطي باتريك بوشيرون في كتابه «ما يستطيعه التاريخ»…
هكذا، يظهر ميدان التاريخ كما لو أنه حائط قصير، ميدان سهل الاختراق، حقل يجذب إليه الاهتمام، وأيضا حقل لتنازع الخطابات.
يقترح علينا المؤرخ حبيدة في هذا السياق، أن نعود إلى قراءة الافتتاحيات التحريرية للمجلات المرجعية مثل المجلة التاريخية الألمانية لسنة 1859 والمجلة التاريخية الفرنسية الذي كان يشرف عليها غابريل مونو، وافتتاحية الحوليات لسنة 1929 للتأكد من هذه القضية، قضية الدفاع عن ميدان التاريخ ومكتسباته.
منذ سبعينات القرن الماضي عادت النقاشات الصاخبة إلى ميدان التاريخ، وعادت معها الأسئلة حول «كيف يكتب التاريخ» 1971 من خلال ما كتبه بول فاين، وحول صنعة المؤرخ أو «العملية التاريخية» مع مشيل دوسرتو، «والزمن والسرد» وأيضا في «التاريخ والذاكرة والنسيان» مع بول ريكور…وفي كل عودة، كانت الكتابة التاريخية ترتهن بثلاثة موجهات أساسية: الموقع الاجتماعي أولا، الأرشيف ثانيا، والكتابة ثالثا…وهي مراحل كما يقول بول ريكور غير منفصلة عن بعضها، لأنها لحظات منهجية متداخلة تُيَسِّر الانتقال نحو كتابة التاريخ برؤية تفسيرية أو التاريخ كمشروع للتفسير. لا يتحقق عمليا التفسير من دون فرضية جديدة، من دون عمق إشكالي، من دون رؤية خصبة للزمن ومعالجة منفتحة على تراكمات أخرى ومزاوجة بين المادة المصدرية والمناهج.
القضية في عُمقها قضية ابتكار كما تتأسس على ذلك فرضية المؤرخ حبيدة. ابتكار لموضوع ورغبة في توليد سرد جديد وإحياء قديم ومنحه قُبلة للحياة. الابتكار في حد ذاته إحالة على الموقع الاجتماعي والسياسي والمؤسساتي الذي تمارس من داخله العملية التاريخية، إذ خارج رهانات الحاضر وحساسيات الفاعلين لا معنى أصلا للعودة إلى الماضي…الغرض من ذلك، الوصول إلى بناء ما يُسميه بول ريكور بالحِبكة المقنعة أو الحِبكة المفهومة. في الآن نفسه، يجدد الباحثون باستمرار طرح أسئلة المنهج والكتابة، الحدود وأسئلة التلقي كلما شعروا بالاختناق المنهجي، ويُلح بعضهم على تناول الكتابة التاريخية من زاوية الجمع بين صرامة البحث ولغة الكتابة. القضية في الأساس قضية منهج وكتابة، قضية إحساس وروح، قضية عاطفة وتَفهم قبل أن تكون قضية محاكمة وتحامل أو تصفية حسابات.
الأرشيف مأزق، والذهنيات واحدة وبطيئة التحول، وفي سياقنا المغربي فقهية بالأساس. إذا اقتصر البحث التاريخي على الأرشيف فإنه بذلك يرسم حدوداً لا يستطيع تجاوزها، وحينئذٍ يُشبه عمل المؤرخ عمل المنجمي الذي يقيم في باطن الأرض لأن الوثائق مهما تعددت لا تصنع تاريخا، ولا تقدم كتابة، حيث لا تُقدم سوى إرهاصات لفهم الماضي على حد تعبير أندري بورغيير في مقالة رائعة له تحت عنوان «الأنثربولوجيا التاريخية» ضمن العمل الضخم الذي أشرف عليه جاك لوغوف «التاريخ الجديد».
تحاصر الوثائق تفكير المؤرخ وتسجنه في قوالب. هنا، نلتقي مع المؤرخ الفرنسي مارك بلوك في كتاب الرائع Apologie pour l’histoire في طرح القضية بالقول: «الوثائق إما أن تتفوق على المؤرخ، أو يتفوق المؤرخ على الوثائق». كلما اقتصرت الكتابة التاريخية على العمل الوثائقي، كلما حكمت على نفسها بأن تظل في المستوى التوصيفي دون أن تكون لها القدرة على الوصول إلى التفسير والتأويل والتركيب. المستوى الأخير أفق وتطلع، لأنه يسمح بتحقق الفهم في قضايا تخص البِنية، الطبقة، العقلية، الإحساس والتمثل…
التاريخ أيضاً كتابة وتحرير، لغة ومفاهيم، وعمل أدبي من أجل توليد نص جديد على حساب نص قديم على النحو الذي يدافع عنه كل من بول فاين وميشيل دوسرتو وهايدن وايت وايفان جابلونكا…
تُشبه الكتابة في التاريخ عمل الإخراج في السينما La mise en scène de recit. القاسم المشترك بينهما ، العمل على إعادة الحياة للموتى. لقد تنبه دوسرتو إلى هذه المسألة بعمق، ودعا إلى إخراج الموتى من القبور واستعادة الوظيفة الرمزية. بهذا، يرتقي السرد إلى ركح العملية، ويصير حلقة مُهيكلة في العملية الإسطوغرافية من خلال ارتباطه بالقارئ وما يتطلبه من جهد في الاقناع، وبالوثيقة وما تحتويه من نقائص.
بالنهاية، علينا أن نجدد السير في الاتجاه الذي رسمه بول ريكور حينما اعتبر التاريخ إبستيمولوجيا مختلطة. ليست الكتابة تقنية وفقط، تعمد إلى عملية تجميع المصادر ووضع الإحالات ووضع الفهرس مع التصميم…قد يكون هذا العمل يدخل ضمن بناء تحتي أولي، لكنه لا ينتج نصا، بل اللانص Le non-texte، موضوع في الاختصاص، لا روح له ولا لغة. يقترح علينا المؤرخ عبد الأحد السبتي من أجل تجاوز الانحباس، ضرورة استشكال النصوص وممارسة النقد الداخلي «محلي- محلي» والخارجي «محلي-خارجي».
بهذا الاقتضاء، يحاصرنا سؤال: لماذا استمر كتاب المتوسط والعالم المتوسطي لفرناند بروديل حيًّا رغم بُعد المسافة عنه؟ الجواب لأن الكتاب منح للبحر الأبيض المتوسط روحا وشخصية وهوية؛ بحر يولد ويكبر ويشيخ مثل أي إنسان. ونفس الأمر، بالنسبة لكتاب «مدارات حزينة» للأنثربولوجي كلود ليفي ستراوس.
في مداخلة ثانية للمؤرخ الطيب بياض بعنوان: «اتجاهات تجديدية في الكتابات التاريخية»، وهو بالمناسبة أستاذ للتاريخ الاقتصادي في جامعة عبد المالك السعدي في تطوان، كان المنحى يسير في اتجاه إنتاج أوراش تطبيقية انطلاقاً من إعادة التذكير بمقومات الكتابة التاريخية: الجماعة العلمية، البنيات والهياكل، وجدلية المحلي/ الكوني…
يقترح بياض ضرورة تقريب التجارب التجديدية الكونية من ميدان التاريخ المحلي، ويدعو إلى تحقق الاشتباك داخل مجتمع البحث برؤى وتقاطعات جديدة ومقاييس مختلفة…يتعلق الأمر، بتوجه ينطلق من معاينات لأبحاث جامعية، ويتساءل بعين الشك لا الارتضاء مثل يدفعنا إلى ذلك ابن خلدون: هل كتبنا تاريخا اقتصاديا أم تاريخ أنشطة اقتصادية؟ هل كتبنا تاريخ الزمن الراهن أم قضايا تاريخية راهنة؟ واضح أن هذه الأسئلة تعيد إلى دائرة الضوء تقييم المنجز المتحقق، وتفتح مسالك جديدة في مسارات التفكير التاريخي والكتابة التاريخية، وتدفع إلى إعادة الحفر الإسطوغرافي. وجب في الآن نفسه إقامة حوار هادئ مع الأجناس القريبة من التاريخ، وطرح الإشكالات التاريخية التي تحمل نَفساً تجديديا من قبيل ما طرحه المؤرخ الأمريكي جاكسون تورنر: ليس الساحل الأطلسي ما يُعبر عن هذا الوطن، بل الغرب العظيم.