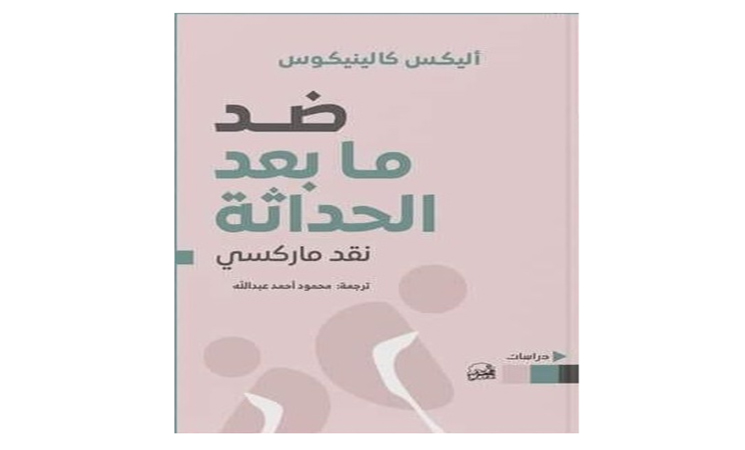تعتبر تجربة “الغربة والاغتراب” أحد الموضوعات المركزية التي ساهمت بشكل لافت ومؤثر في نمو الحدث الدرامي، وإغناء المتن الحكائي لرواية “صهيل جسد” لمؤلفها عبد الجليل ولد حموية والصادرة عن “الراصد الوطني للنشر والقراءة” في طبعتها الأولى مارس 2017.
بدأت أولى معالم تجربة الغربة والاغتراب تتشكل في سماء النص الروائي حين وجد بطل الرواية ومحور أحداثها “عبدو الزبلبولي” نفسه غير معترف به من محيطه الأسري، وتحديدا من طرف الوالد. هذا الأخير لم يستسغ إطلاقا ممارسات ابنه الطفولية ولا سيما مغامراته الجنسية المنحرفة والمتمثلة في مضاجعة الحيوانات أو ما يعرف علميا ب”الزوفيليا”، واقع تزامن مع مرحلة فارقة من حياة البطل السيكوفيزيولوجية ألا وهي سن المراهقة حيث يبلغ مستوى الوعي بالليبيدو ذروته القصوى مع ما يصاحب ذلك من رغبة بيولوجية ملحة في تفجير هذه الطاقة الجنسية وتفريغها في أفق تحقيق إشباع جنسي ظل حبيس الخيال.
إجراءات الأب الخاطئة من قبيل تعريض عبدو الزبلبولي لعقاب جسدي ونفسي قاس بغية تقويم سلوكياته الشاذة باءت جميعها بالفشل. هذا المعطى دفع بالزبلبولي إلى إشهار ورقة التمرد والكره في وجه والده والذي ما فتئ أن استسلم للأمر الواقع معتبرا ابنه حالة ميؤوسا منها. النظرة الدونية، الاستهجان، الإقصاء والتهميش المصحوبان بالتشهير والوصم الاجتماعي إضافة إلى استعمال ألقاب قدحية من قبيل “بوبهايم” و”أم الكافر بالله” كلها أساليب ووسائل وظفت بطرق مختلفة من طرف سكان القرية من أجل ضبط عبدو الزبلبولي اجتماعيا ، وإرغامه على تمثل قيم وعادات وأعراف محيطه الاجتماعي المحلي والتلاءم معها.
تعاطي المحيط الأسري(الوالد) والاجتماعي(سكان القرية) السلبي مع تصرفات عبدو الزبلبولي جعله يعيش غربة داخلية حادة مصحوبة بعزلة اجتماعية كبيرة أججت مشاعر الاغتراب المرير داخل ذاته المهمشة “شباب القرية يتجنبون مجالستي وكلما اقتربت من جمع يتشتت كأنني كلب أجرب” ما اعتبره الزبلبولي إجحافا في حق ذاته المتفردة الباحثة عن الانعتاق من رحم مجتمع متناقض يهوى النمطية، ويرفض الاعتراف بالاختلاف، بل ويفرض عزلة على كل من سولت له نفسه ذلك ” عشت عزلة كبيرة حاملا بين كتفي كل أخطاء القرية.” الغربة والاغتراب الذي فرضه سكان القرية على الزبلبولي كجزاء على تفرده أو بالأحرى تمرده أعقبته لاحقا محاولات يائسة في رحاب الجامعة لاستقطابه من قبل الرفاق والإخوان عندما سعوا لاستمالته فكريا وعقديا كل بطرقه ووسائله الخاصة، غير أن حادث القبلة أفشل هذه العملية بل كاد ينجم عن اتحاد غير مسبوق بين أتباع التيارين المتناحرين؛ الماركسية والإسلام وذلك لما أرادوا محاكمته جماهيريا لولا تدخل رشيد الذي استعان به الكاتب لمنح بطله الرئيسي(عبدو الزبلبولي) حياة ورقية جديدة، مؤجلا بذلك نهايته المحتومة.
الوضع الاجتماعي والمادي المضطرب، والآفاق المستقبلية المجهولة، حتم على الزبلبولي البحث عن فضاء أرحب لنيل حريته وتحقيق إنسانيته المؤجلة “الوطن ليس حيث ولدت، بل حيث شعرت بإنسانيتك” فجاء تبني قرار الهجرة نحو بلاد العم سام وتحديدا ولاية سان فرانسيسكو رغم صعوبته. قرار اعتبره في الوهلة الأولى بمثابة تذكرة خلاص أبدي من جحيم المعاناة، خلاص من مجتمع منافق صمم على قهره، ومن وطن تنكر له فعاش منفيا بين أحضانه ” قطعت آلاف الأميال عاريا من وطن لا يعترف بي إلا خلال حملاته الانتخابية، إلى عراء وطن آخر يحفه الأمل في التغير.”
توظيف الكاتب لثنائية من الشخوص مثل “كريستين والزبلبولي” ثم “خالد وخوليو” ف “مايلي وإيميليا” أعطى للأحداث نفسا سرديا مشحونا بجدال فكري راهن (المثلية الجنسية)، كما شكل عاملا مساعدا للزبلبولي في تخطي غربته المكانية الموحشة واغترابه النفسي المزمن الذي ازداد توترا مع اصطدامه بمتغيرات بلاد المهجر السوسيوثقافية والحضارية الصارخة، فما كاد يستوعب مسألة الشذوذ الجنسي (واقعة مضاجعة كريستين) حتى فوجئ برفضه من وظيفة العمل كحارس أمن بإحدى الشركات بناء على قرار أحد أعضاء لجنة التوظيف الذي ارتكز في ذلك على مبررات عرقية وعقدية صرفة باعتباره (الزبلبولي)عربيا مسلما عبر ظلمات الأطلسي للانسلاخ من جلد هوية مشبوهة ” وددت لو كانت لدي القدرة على إنكار هويتي…” هذا الموقف العنصري المكتمل الأركان لم يكن أسوأ من تعامل المؤسسة الدينية التي التجأ إليها الزبلبولي طمعا في مساعدة أجهضت بسبب هواجس وشكوك إمام المسجد من انتمائه لتنظيمات إرهابية أو صهيونية.
لقد أزمت الظروف المعاكسة أوضاع الزبلبولي على كافة الأصعدة “اختلطت علي الأحاسيس والمشاعر، لم أعد أعرفني” ليقتنع على ضوئها بحتمية التكيف مع متطلبات واقعه الجديد من خلال التخلص من رواسب ذاته القديمة التي باتت تنتصب عائقا أمام تحقيق آماله وطموحاته “لا بد أن أتعايش مع الوضع هنا… سأتخلص من تلك المشاعر التي ترهقني دائما بالرغم من صعوبة الأمر” حيث خلص في نهاية المطاف إلى شرعنة كل ممارسة تضمن نجاح الفرد في كسب معركة الوجود “نعم سأستغل جسدي أيضا للنجاة.” فما أسدته كريستين من احتضان جسدي ونفسي، وما قدمه خالد من عون مادي رغم مصدره المشبوه (الجريمة المنظمة) لم يكن كافيا لصرف الزبلبولي عن الاحتياج المتأجج والحنين الجارف لحضن الأم وحب زوهرة اللامشروط، كما أن اليقظة المتأخرة لضميره المحتضر أسفرت عن إعادة البهجة والأمل في حياة أفضل لكل من العجوز الأسيوية وأم خالد، يقظة أتت بعد أن استنزف عبدو الزبلبولي مخزون الأمل في التغير “الغربة ليست أرض عجائب وسماؤها لا تمطر ذهبا” ليقرر الانتحار واضعا بذلك حدا لمسلسل الشؤم ومحنة الغربة والاغتراب الذي عاش تفاصيلهما القاهرة منذ شهقة وعيه الأولى.
من خلال كل ما سبق، يتضح أن ثيمة “الغربة والاغتراب” لعبت دورا محوريا في بناء النص الروائي، فنيا بإضفاء التشويق والإثارة على أحداثه، وفكريا من خلال بلورة وإثارة نقاش جاد حول قضايا اجتماعية وإنسانية شائكة كان مجرد محاولة التفكير فيها أمرا محظورا، هكذا إذن توفق الكاتب إلى حد بعيد في منح الرواية طابعا إبداعيا خالصا، وقيمة أدبية مستحقة ستسهم بلا شك في زعزعة استقرار هياكل معبد النمطية والتنميط، وستقض مضجع سدنته ومريديه على حد سواء.
تجربة الغربة والاغتراب في رواية «صهيل جسد»
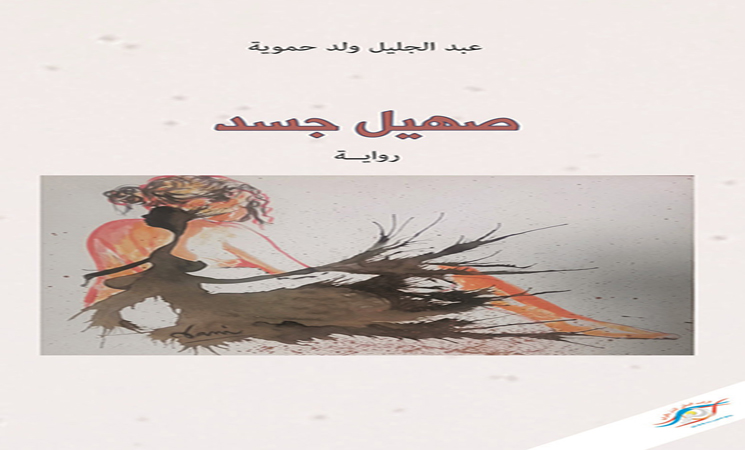
بتاريخ : 20/09/2018