حين يشتكي الغربُ من أفول النقد، ماذا عنّا نحن؟
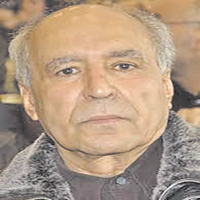
أحمد المديني
موضوعُ الفكر الفلسفي بصفة عامة، هو طرح السؤال، والبحثُ بواسطة التفكير، وتحريكُ السواكن، عن أجوبة لِما ينتابُ الإنسان من قلق ووساوس، تبدأ مما يتعالى في الغيب، ثم من ذاته، وتمتد إلى المحيط ثم الوجود حين يتمّ الوعي به في كُليةٍ مركبة. وكما أن البحث العلمي تواصلَ متطوراً ليقدم الحلولَ لما واجهته البشرية أمام مصاعب الطبيعة، وللتغلب على أمراضه وعجزه وعوائقه ولتحسين عيشه فوق كوكب الأرض، كذلك التفكير الفلسفي تعددت وتنوعت قضاياه بتوالي الحقب، وما انفكت وساوس الإنسان تتضاعف لم تقدم لها الأديان كل اليقين. ذلك أنه لا توجد في مضمار هذا التفكير أجوبةٌ كما لا سقف للأسئلة. هكذا، فالمنعطفات الكبرى التي مر منها الفكر الإنساني في العصر الحديث، بمسمّيات مختلفة الحداثة إحداها، مع نسبية دلالة هذا المفهوم وتاريخيته من مجتمع غربي إلى آخر، لم تَكفِ، بل تنتقل من أزمة إلى أزمات تفاقمت خلال وبعد الحرب العالمية الثانية، وتبلورت في فلسفة ما بعد الحداثة، نقضت المفاهيم السابقة عليها وجددت مساءلاتها في ضوء متغيرات العصر.
لكن يبدو أن فكرة ومبدأ النقد في الإنتاج الفكري والمناخ السياسي الإيديولوجي ومجال الإعلام قد أصابهما الضمور، إن لم يكونا في أفول، حسب مريم ريفو دالونس، في بحثها الأخير بعنوان» أفول النقد»(لوسوي، 2022)، إذ بينما تشكّل مسارُ الفكر الغربي الحديث من صيرورة نقده فإنه يجتاز اليوم امتحانا صعباً بل محنةَ انتهائه إلى المسلمات والتصنيفات الجاهزة والاختزال في شعارات، فكأنما لم توجد المدارس الفلسفية والتيارات المجددة في العلوم الإنسانية التي وضعت قطائع جذرية وكان سلاح النقد وبوصلته أداتها وهاديها دائما. إنه مفهوم يُحيل بدءاً إلى وضعٍ صعب وحرج، وهو مِحكُّ فحص حقيقةٍ ما أو فكرةٍ بإخضاعِها لمقاييسَ معينةٍ بُغية اختبار صلاحيتها وحدودها، وفي الفرنسية تنحدر (أزمة) و(نقد) من جذر لغوي واحد، ولهذا الأخير قيمة إيجابية عندما يقود بعد البحث والاختبار إلى مخرج وإعادة النظر. أما الأزمة فتصبح خطيرة، حسب حنا أرندت، إذا نحن أجبنا عنها بأفكار جاهزة.
نتساءل مع ريفو دالونس، ما هي المفاهيم التي نقرأ بها واقعنا، ونحلله، ونعمد إلى نقده، وما هي مصادرها ومرجعياتها؟ تلاحظ هي وبوسع المتابع اليقظ في فرنسا أن ينتبه إلى سيادة حالة من الالتباس الذهني واللغوي والثقافي تتمثل في نوع من التحريف المفاهيمي يلحق مصطلحات وبراديغمات جوهرية بمثابة إشكاليات ومناهج تحليل، مثل: تفكيك، هوية، استقلال ذاتي، سيادة.. كذلك حين يجري النقاش حول كلمات محفلية أثارت جدلا واسعا من قبيل: wokisme و Islamogauchisme و le grand remplacement (الإبدال الكبير). ومن تابع النقاش حولها لا شك يستغرب للابتسار والاختزالية لمعانيها ومراميها خاصة في ميدان الإعلام بما نشر مفاهيم مغلوطة ومحرّفة عن أصلها ومحيطها الذي نبتت فيه جرّت إلى جدل عقيم.
لعل مصطلح déconstruction (تفكيك) من أكثر الرّطانات شيوعاً الآن في الحقل السياسي وعلى ألسنة المحللين والخبراء ومفكري منابر الإعلام، كلما تفوه أحدهم إلا واستهل خطابه بضرورة التفكيك. لقد تراجع النقد إذن إلى الوراء وكأنه تركة بالية، وتسمع رئيس الجمهورية نفسه يدعو إلى «تفكيك» تاريخ فرنسا إذا أريد حقا مناهضة الميز والعنصرية، ليُرمَى من طرف خصومه في اليمين المتطرف بأنه يقوّض الأسس الحضارية للبلاد ويسترخِص الهويةَ التاريخية والثقافية الفرنسية. حتى إن وزير التعليم السابق جان ميشيل بلانكي دفع بالمصطلح في الاستعمال أبعد داعياً في مناظرة كبرى نظمت بالسوربون(7ـ8/01/2022) حول موضوع:» تفكيك العلوم والثقافة»؛ دعا إلى (تفكيك التفكيك) والبحث، كما قال، عن لقاح قادر على البرء من الأفكار والمناهج المختصرة في(النظرية الفرنسية) التي أشاعها التفكيكيون الفرنسيون المصدرة وراء المحيط، أمريكا، يعني مشيل فوكو، ودولوز، وجاك دريدا. هذا الأخير بالذات الذي باسمه يقع خلط حابل مفهومه بنابل معناه ومنهجه الأصليين، ليس في فرنسا وحدها بل في محافل جامعية وثقافية أخرى، فيعمّ التباس أنه يعني التدمير العام لكل القيم والأفكار المترابطة بنت الحقبة ما بعد الحداثية، وتارة، لمساءلة المسلمات والمستنسخات الرائجة، بينما تُماهي جهاتٍ مخاصمة التفكيك بالتخريب الشامل ورفض القواعد. أما دريدا فجاء مصطلحه، كما تحدده ريفو دالونس، في سياق ورهان مرتبطين بدقة بتاريخ الفلسفة، وأنه يجب فهمه لا بمعنى تذويب وتدمير، ولكن «بتحليل البنيات المتراكمة التي تشكل العنصر الخطابي الفلسفي، عبر اللغة، والثقافة الغربية، ومجموع ما يحدد انتماءنا إلى تاريخ الفلسفة».
هذا المفهوم وغيره انتُزع من سياقه، وتم تحريف معناه بمسوّغات سياسية ولفرض أقانيم تسويقية ومُسخِّرة وأحادية البعد، تشلّ التفكير في عمق وتحجز النقد بين قوسين هو والنخبة يفترض أن تنهض به وبوعيها يعمل، على العكس من هذا هو في غروب، وربما يكون له لون شبيه بالظلمة السابقة على نزول الظلام، تلك التي عند هيغل جميع الأبقار تُرى رماديةً فيها، فيما يجد بودلير في قصيدته» غروب الصباح» صورتَها في الشعاع الذي يعلن طلوع النهار. ليس الغرب بعيداً عنا، ورغم أن مصاعب واقعنا، وإشكاليات مجتمعنا لا حاجة لتعدادها ما تزال في الحدود الدنيا في الميادين والحاجات الأساس لمتطلبات شعب وحقوقه ومطامحه، إلا أن عندنا نخبة، نُخباً، شبه مستنسخة من الغربية العليا، وتستعير نماذجها ورطانتها إن هي فتحت فاها خارج عيادة الأسنان، هي معنيةٌ بالشكل، لا المضمون، خذ الثقافة، تتحدث لك عن الصناعات الثقافية وتصرف النظر عن المحتوى وسؤال ماذا ولمن. كذلك في الاقتصاد ترطن بالعولمة والتبادل الحر والمردودية، وتشقشق بآخر ما في معاجم ومنتديات التسيير والبورصة.
في الجامعات والمناظرات والحلقات الدراسية لم يعد السؤال الإشكالي للثقافة في مجتمع محدد بظروف ومحكوم بظروف وأجياله متطلعة إلى آفاق واعدة، هو الموضوع. أصبحت النظريةُ والمنهجُ والحجاجُ وبلاغةُ الخطاب أهم من الخطاب نفسه. لا شك أن النقد كان وسيبقى مرتبطاً بوعي اجتماعي، أي طبقي، بمشروع للتنوير شاملٍ لجميع الميادين، فما هو هذا المشروع، بالمفرد والجمع، الذي نملكه نحن في المغرب، نحن العرب، نحن من كانوا يسمون بلدان العالم الثالث، يجرّنا اليوم قطار المخططات واللجان والمؤسسات والبيروقراطية والنخبوية الفوقية وحتى رقاعة محدثي النعمة وصفاقة المرتدين على ماضيهم مقابل صفقات؟ حين يوجد شعب يقظ، مُحبٌّ لوطنه، وأعطى ألف برهان، وحاجاته تملأ الدنيا صراخا وصورا، فينبغي أن لا نخسره، ونرجع إليه الثقة بأنه يستحق العيش هنا بحق وكرامة، أو سنخسر المستقبل، أيّ هول!
الكاتب : أحمد المديني - بتاريخ : 18/01/2023


