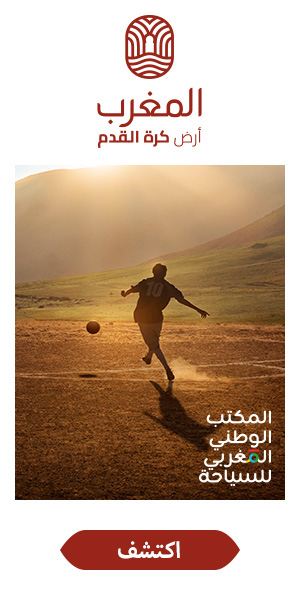الشعبوية والأنترنيت

مصطفى خلال
تستعمل الشعبوية في ترويج «أفكارها» لتعبئة الجموع في الشارع التنظيم المباشر ، لكنها تُسْنِدُ سلوكَها اليوم باللجوء إلى عالم الأنترنيت.
وإذا كنا نسلم اليوم بأن جميع الناس في العالم مربوطين بشبكات الفضاء الأزرق فإن هذا له ارتباط بالاستعمال المتيسر والذي أصبح متاحا للجميع، من السياسي إلى المثقف إلى الإنسان العادي إلى المجرم. أي أن لا سلطة اليوم يمكنها أن تقف حائلا دون هذا الاستعمال. وهو ما يعني أن (السلطة) لا تملك القدرة على التحكم في هذا الربط، إلا إذا أرادت قطعه نهائيا، وفي هذا الجانب لا يزال لـ(السلطة) كل إمكانيات التدخل. غير أن هذا القطع لا يمكن أن يمر دون أن تكون له انعكاسات خطيرة على سمعتها في الأوساط العالمية، مما يلحق بها أضرارا وخيمة قد تؤدي حتى إلى المعاداة العالمية لها. فالأفراد المربوطون بالأنترنيت بفضل أجهزة الاتصال والتواصل التكنولوجية التي لا شرط يوجد من أجل الحصول عليها، يبقون مجرد أفراد يبدون معزولين في الظاهر، منزوين في عزلتهم القاهرة التي يفرضها عليهم التفاعل اللا- منقطع في عالم الأنترنيت، لكنهم سرعان ما يتحولون إلى جماعة، ثم إلى جموع، ثم إلى هدير شعبي صاخب في حالات خاصة تتعلق بسلوكات السلطة تجاه عينة أو عينات منهم.
كل المجتمعات البشرية، بفعل عوامل مختلفة غير أنها متقاربة في اختلافها، نقول كل المجتمعات تحتاج (من الحاجة) إلى التعبير عن غضبها بخصوص قضية أو وضع أو تطلع، أو المطالبة بمطلب محدد.
كانت الكنيسة بالنسبة للغرب، والجماعات الدينية بالنسبة للعالم الإسلامي، هي من يستقبل هذا الغضب ويؤطره ويختزنه. فالتاريخ القديم والأقل قدما للكنيسة يحفظ الأدوار التي كانت تقوم بها الكنيسة إما في استقبال الغضب الشعبي، أو في تأطيره، أو الالتفاف عليه، أو تحريفه عن الطريق التي كان يسير فيها. وحين انتهى دور الكنيسة في هذا المضمار قام اليسار بكل حساسياته بهذه الوظيفة، ولم يعجز عن أدائها إلا في الزمن الجاري بفعل ضعفه الذي تغذيه انقساماته الفئوية، والتي تجد تفسيرا لها في الصراعات المصلحية لنخبه.. واندماجها في الاختيارات الليبرالية. وفي العالم الإسلامي الأقدم والقديم والحديث كانت الجماعات التي توظف الدين في السياسة هي من يستقبل ويؤطر ويوظف لمصلحة قادتها المادية الغضب الشعبي. لقد عايشنا في تونس وفي المغرب كمثالين ليس للحصر، كيف استحوذ الإسلاميون على هذا الغضب ووظفوه لمصلحتهم الفئوية، ولاستراتيجيتهم الهادفة إلى التحكم في المجتمع لذات المصالح، ولا تمييز في هذا الشأن المخصوص بالنسبة لتياراتهم الأربعة: التيار الانتفاعي، والتيار ‘’التربوي››، والتيار الدعوي والتيار الإرهابي… جميعهم في العالم الإسلامي، يوظفون بقوة ونجاعة مدهشتين الأنترنيت وينهلون من الشعبوية في ممارستهم للسياسة كل آليات نشاطهم.
لقد انتقل هذا التوظيف من الأسلوب القديم في التواصل الذي غدا كلاسيكيا ومتجاوزا، إلى أسلوب فرضته التكنولوجية الحديثة مُدعَمة بالأنترنيت، وبكل ما خلقه هذا الأنترنيت من منصات تجمعها وسائل التواصل الاجتماعي.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بخصوص الغضب الشعبي الذي يبحث لنفسه عن حلول لمشاكله، التي قد تكون سياسية أو قد تكون اجتماعية، وهو: هل تقدم الشعبوية حلولا لمشاكل المجتمع؟
إنه إذا كان هناك شيء يجمع الشعبويات في العالم، فهو أنها حركات معارضة للسلطة وللنخب خارج السلطة، أي أنها في العمق تعارض المجتمع كله وهويته التعددية مقترحة عليه ال (لا- شيء). ولذلك تراها تبقى تمارس المعارضة حتى وإن صعدت إلى الحكم. ولقد خبر بلدان ينتميان إلى العالم العربي الإسلامي هذه الحال، هما المغرب وتونس. فأبرزت تجربة هذين البلدين أن الشعبوية الإسلامية ليست فقط عاجزة عن تقديم حلول لمشاكل المجتمع بل إنها تخلق حالات غير مسبوقة من الإحباط لدى طبقات المجتمع المتوسطة والشعبية معا…وذلك بسبب من تضخم (أناها) وبسبب الدوخة الفكرية والسياسية المصابة بها أصلا، وبسبب من حرص نخبها المفرط على خدمة مصالحها النفعية الخاصة والأنانية. في تونس قادت تجربتها إلى عودة استبداد الحاكم الفرداني الذي يرى في نفسه المُخَلِص ذا القدرة الاستثنائية على النيابة على الشعب، وفي المغرب قادت إلى عودة اليمين الذي ليس يمينا على الحقيقة إذ لا يعي العالم والتاريخ إلا من خلال خدمة ليس الرأسمالية، والتي مهما يكن فإن لها بعض الإيجابيات الاجتماعية، بل فقط من خلال خدمة رأسماليته الفردانية القائمة على النهج الأناني الاستحواذي.
ذلك هو الجواب الوحيد على السؤال المطروح.
الكاتب : مصطفى خلال - بتاريخ : 19/04/2022