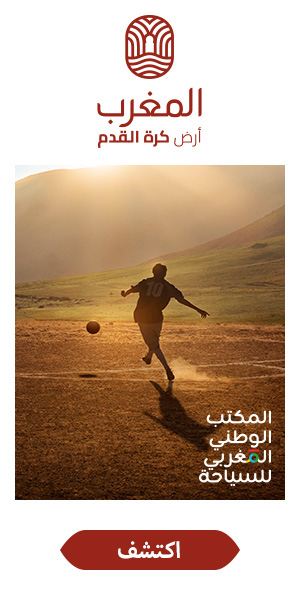عن مثقفين عادوا إلى اختصاصاتهم سالمين غانمين

أحمد المديني
تحصيلُ حاصل أن الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة جمْع متنافرٌ من المعارف، لم تتكون وتتراكم تِباعاً وبانتظام بما يُظهر أنساقَها بينةً ومفاهيمها دقيقةً وأفكارَها منتظمةً في سياقات محددة. أغلبها مقتطفات من الثقافات الغربية الحديثة التي هي نتاج تاريخ معرفي متواتر وصراع فكري وتلاقُح مذاهب ضمن دينامية حركات اجتماعية وثورة صناعية واقتصادية، لذلك هي مطبوعةٌ بالتناسق، وقابلةٌ للفهم والتأويل في إطارها التاريخي، وبخطوط التطور والتجديد الذي انتظمت فيهما أمكن تشكّل ثقافة المدنيّة وفلسفةُ وتعبيراتُ الحداثة ثم الحداثات، مع حصول القطيعة المعرفية الحاسمة في مفاصلها. لذلك، فإن المعارف المصنفة فيها، أيضا، محددةٌ بمناهجَ ومصطلحاتَ ومفاهيم، وتيارات، يعرف من يقتحم أيّ حقل أين يضع قدمه والأدوات التي يستعمل، مستمدة من تاريخ أفكار ومنسجمة مع محيط، فإذا هي ارتقت إلى صعيد التجريد غدت محسوسة، إن مبادئ العدالة والحق والحرية وهي مثلٌ عليا موجودةٌ في الواقع وتبلورت في ظروفه ويمكنك تحسّسها في معيشك وتمتحنها وليست حلما ولا يوتوبيا.
ينسى ويغفل الذين يتساءلون عن اضطراب حركة الفكر العربي وتعثره في مسار التقدم هذه الخلفية، بعضهم يعمّقها بمواصلة الانتقاء فكأن تحقيق التقدم والتنوير وسيادة العقلانية مائدةٌ يتناول منها ما يشاء، وليس برنامجا يتحتم استيعابُه في كليته لا تجزيئُه وإخضاعُه للتراضي كيفما اتفق، لذا ترانا لا متقدمين وشبه متخلفين، محافظين ورجعين وتقدميين إلى الأقصى، تعشّش فينا الازدواجية فكراً وسلوكا حد تناقض مفرط، ولا عجب يصل على المستوى الفردي إلى عُصاب الانفصام، فكيف إذا أصبح المجتمع كله في انفصام، ما بالك تجد من يفلسفه بسذاجة لا تطاق، بمصالحة شكلية بين زوجين ينتميان إلى حقلين معرفيين مختلفين/ الأصالة والمعاصرة، لأن منطق التفكير الجدلي عندهم يمثل القطيعة التي يهابون ويكشف ثقوب القواقع التي بداخلها ويفكرون، أخطر منه تُسحَبُ الأرض من تحت أقدامهم، وهكذا الأفضل لديهم أن تسود الثنائيات، وهذه بدورها تُلغى، وفي بلدان تدبَّجُ في دساتيرها ويزقزق سياسيوها بلفظ الديموقراطية والتعدد، يراد لإرادة واحدة أن تصبح الحَكَم، والصوت الواحد وبعده لا أحد، أو شكليا مؤسسات وهيئات ليكثر الصدى ويتلاشى في المدى، فيحق عندئذ سماع الحسرة من فيروز في أغنيتها الشجيِّة(مشوار): «ما في حدا لا تندهي ما في حدا. عتم وطريق وطير طاير عالهدا. شو بابُن مسكّر والعشب غطّى الدّراج. شو قولكُن صاروا صدى؟»
في بعض ما أكتب أحاول أن أحرك هذا الـ «حدا» الجامد فينا، وأن أدقّ جدران الخزّان، اقتداءً بغسان كنفاني لمّا استنفر واستنكر في روايته الأثر» رجال في الشمس» ليَلاّ يموت المحبوسون فيه عطشا وهم في الطريق الصحراوي، أمس كان الفلسطينيون وحدهم في هذا الطريق، مازالوا، وصرنا نحن العرب جميعا محشورين ومحجوزين تختنق أنفاسنا وحناجرنا تلتهب عطشا ، لا صوت يخرج منها يصيح، ولا أيدٍ تمتد لتدقّ جدران الخزان. سأترك المغلوبين على أمرهم، الكادحين من كنا معشر الكتاب في المغرب منذ انخراطنا في اليقظة الوطنية نكتب من وحي همومهم، والسياسيين يناضلون، أو يدّعون، من أجلهم. سأترك المنشغلين بأعباء الحياة ولهم فيها أهواء، ولا يجهرون فيها بالادعاء. كما لن أنشغل بمن قرروا بدراية وتصميم أن لا يضيعوا وقتهم بالمرافعة ـ انتبهوا لم أقل الكفاح كي لا أتعرض للاستهزاء ـ عن صداع وبؤس الدهماء، ولا شأن لي بالتائبين كان الله في عونهم، أشفق عليهم وفي الوقت أنا من مكاسبهم براء. أترك هؤلاء خلفي يكفي ما عندي من أعداء.
أحب أن أتوجه إلى من يسمون بـ (المثقفين) وهم نفر من بشر عجيب، دخيل على البلدان العربية والإفريقية وبيئاتها من حيث التسمية والمفهوم والوظيفة، وتلقفنا الإسم، كما ذكرت أعلاه، شأن كثير أمور، وربما لا حرج علينا إذا التبس المعنى وأضعنا العنوان، عنوان بيتنا الكبير الذي كنا نسكنه نحن(مثقفي) وكتاب أمس، وصرنا غرباء في مدرجات وقاعات تضجُّ بعناوين الحجاج وتحليل الخطاب، ولا نعرف حجاجَها وتحليلها ينصبّ على أي خطاب، أم المهم أن يكتمل وراء المنصات للكلام نِصاب، ويتلقى أصحابُه ممن يعلمون الأجر والثواب. معروف أن الكلمة غربية المنشأ، ولدت في ظرف تاريخي فرنسي حول قضية دريفوس الشهيرة (بدءا من 1894 إلى 1906) وتبلور حولها موقف عدد من الفنانين والكتاب والجامعيين يطالبون في عريضة بمراجعة الحكم الجائر الذي نزل بحق الضابط اليهودي دريفوس بتهمة الخيانة. من هذا الوعي والموقف السياسي في صورته زاد إشعاع انبثاق وضع المثقف بعد الجمهورية الثالثة، التي أقرت قوانين تخص الصحافة والتعليم والديموقراطية البرلمانية وعجّلت باحترافية السياسة، بما ساهم في تقسيم العمل بين العلم والسياسة والصحافة، بينما كان الفرد منذ عهد الأنوار يمارس هذه الأنشطة ثلاثتها، وبذا فإن المثقف، حسب جيرار نواريير، في كتابه «الحقيقة حول سلطة المثقفين» (2010)، هو «شخصية خلقتها وعممتها الصحافة الباريسية لملء الفراغ الناجم عن الفصل بين الوظائف». بمعنى أنه الاختصاصي الذي يخرج عن ميدان اختصاصه ليوجد في الفضاء العام. من هنا جذر تعريف سارتر للمثقف في محاضرة له في جامعة طوكيو (1966) ونشرت في كتابه «دفاعا عن المثقفين» (1972) وهو في قلب اعتناقه للوجودية الملتزمة ولفكرة الالتزام؛ بأنه الشخص الذي «ينشغل بما لا يعنيه» Celui qui se mêle de ce qui ne le regarde pas، وهذا ما حصل للنخبة الأكاديمية الفرنسية حين خرج بعضها عن مجاله وندّد بحكم المحكمة العسكرية ضد دريفوس. إنما لا بد أن نضيف بأن تعريف سارتر يذهب أبعد نحو ما يتبع التزام المثقفين؟
يضيق المجال للتوسع في الفكرة الماركسية عن هوية المثقف والتزاماته، وحسبي استعارة معناها بالإشارة إلى أن فقهاء المغرب رواد الحركة الوطنية قد اعتنقوها وبها قادوا الإصلاح، وكذلك أدباء ومفكري مرحلة الاستقلال الأولى، فما بالنا اليوم نكاد نطلّق كل مفهوم؟ ويصبح «مثقفونا» مجرد آلات للخدمة والاستعمال والخطاب الأجوف؟ «وإنا إن شاء لله لمهتدون».
الكاتب : أحمد المديني - بتاريخ : 06/04/2022