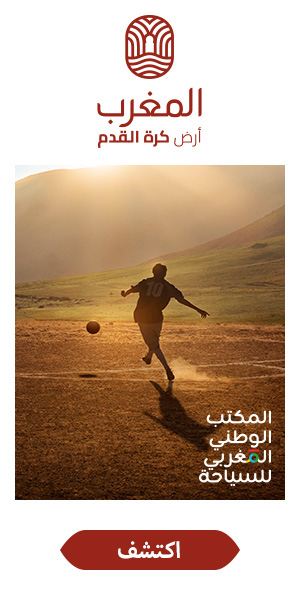أأنت في الرباط.. أم ضيّعتَ في الأوهام عمرَك؟!
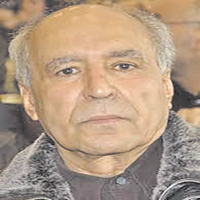
أحمد المديني
ثمّة مدنٌ متراميةُ الأطراف. مدنٌ متماديةٌ في الاتساع. شاسعةٌ فلا مزيد. كلما ضربتَ فيها لم تكسبها، وضيّعت نفسك فيها. خسِرتَها وإيّاك. المدينة اسمٌ لمكان، لأمكنة، لكن يحتاج إلى أن يتحدد ويتعيّن، أولاً. وإلا فنحن إنما نتحدث عن شيء ما مفترض أو مطلق، والمطلق هلامه ليس وجود له مادي هو المدى. كما أن المدينة غير موجودة سلفا، أو بقرار. إنها تتأسس. تُبنى بالتدريج. تحدث بفعل العمران، وهو اثنان: البناء المادي، ما يُجهّز السكنى للسكان، ويرسم خرائط توزيع إقاماتهم والمرافق العامة لتسيير شؤونهم وخدمة المصالح كمراكز السلطة الإدارية والأسواق وفضاءات العيش المشترك إلخ؛ والعمران البشري، حدد ابن خلدون أسسَه وأفاض في تعريفه بناء على قواعد حياة زمانه، ثم واصل اللاحقون ما أطلق عليه مبحث علم الاجتماع، من العلوم الإنسانية، في السّياق الذي نهضت فيه المدنية الحديثة ثم العصرية.
المدن القديمة، منها العربية الإسلامية، وُجدت وخضعت لثقافة زمنها، وشروطها الاقتصادية وتكويناتها السياسية وأوضاعها المجتمعية، وهذه جلّها عَصَف بها الزمن بعد أن هوت أنظمة الحكم والبنيات التي نشأت في إطارها ومحدداتها، وتفسّخت أحوالُها باتت هياكل طللية حِسّا ومعنى. لا يتيسر هنا أن نُعنى بالأسباب، بقدر ما نميل إلى رصد النتائج والظواهر الناجمة عنها. بعضها الآن جزء من تراثنا. هكذا، نجد ولاياتنا والمصالح البلدية تقسم مدننا إلى اثنين: قديمة وحديثة، أي إلى ووفق زمنين: الماضي والحاضر. السّياح الذين يزورون بلادنا يأتون من حاضرهم ليتفرّجوا على(أعجوبة) ماضينا بدهشتهم تذهل تراهم يتعجبون كأننا معرض لكائنات حيوانات أسطورية قروسطوية. إنه(الآخر) العجائبي الذي ذهب الغربي المستعمر إلى أقاصي القارات وأعماق الأدغال وقمم الجمال لينتهكه وليغتصب أرضه وعرضه، وفي كتبهم دوّنوا بصفاقة لا نظير لها أنهم» يكتشفون»!. هكذا، فإن مدننا القديمة رغم أنها ماتت أو طويلة الاحتضار، يعود الزائر الأجنبي ليُحْييها في كل نظرة منه، ليكتشفها، ولا يتعب من اكتشافنا نحن معها. أما القابعون منا بين المدينة القديمة والثانية الحديثة، فإنهم في وضعية لا يحسدون عليها، نحن الجيل القديم خاصة (وهذه تكاد تكون سُبّة على ألسنة بعض الحَدث النزق) لأننا نملك الوعي بهذا الانفصام، الوقوع في الما ـ بين. أذكانا المصالحون المتفذلكون بزوج (الأصالة والمعاصرة) وهم، بالطبع، ملفِقون لأن القطبَين على طرفَي نقيض، وتتوهم التعايش بينهما هو لتأبيد هيمنة ثقافة وعمران إلى زوال؛ وهذه إحدى الورطات الكبرى للفكر العربي.
المدينة الحديثة أكبر منا. هائلة، جديدة ولا تكف تتجدد. أنشأتها المدينة الغربية صورا مصغرة لها في بلداننا (miniatures) في البداية لسكنى الجاليات الاستعمارية بمرافق حكمهم وأواصرهم الاجتماعية وبعلائقهم التبادلية، مفصولين وبمنأى عنا نحن الأهالي (les indigènes) كنا نذهب إليها خانعين خَدما أو تابعين، ومنا من ألحق أبناءه بمدارسها ليستخِلفوا في الأرض من بعدهم وكثير منه كان. حين حصلنا على استقلالاتنا، على عِلاّتها، ورثناها بطرق شتى، فانتقلنا إليها وشوّهنا أغلبها. لماذا؟ حدث هذا من بين أسباب أخرى لأننا نقلنا إليها بداوة راسخة، وإما تَمدّنَّا قِشْرِياًّ مع رواسب عيش مدننا القديمة التي تنقرض. ثم استفحل الأمر، فانطلقنا نبني زعماً ما سميناه مُدنا حديثة على غرار المدينة الغربية (العمران المادي) بأعتى الأشكال وأشوَهِها، وحتى بلطف ممكن وصولا إلى السكن اللائق الهجين؛ بيد أن العمران البشري لا يُبنى. إنه ثقافة وتربية ومسلسل تراكم حضاري، وهذا يحتاج إلى الزمن، والزمن لا يرحم. الذين يطرحون إشكالية الهوية بيننا وتؤرّقهم، حبذا لو بدؤوا من العمران، من المدينة، معماراً ومفهوماً وتاريخاً وإنساناً، ليصلوا إلى أن عندنا بعد تلك القديمة التراثية والمحتضرة مدنا حديثة أو ما يُشبهها ولكن تفتقد إنسانَها وهذا مشروعُ المدنية الحديثة.
عندي رغبة لأطرح مسألة الكتابة الأدبية بالذات، على هذا المنوال، من هذا التصور. أدرك سلفا أنه طرح يحتاج إلى تأليف قد أنجزه أعلم يحتاج إلى عُدّة ونظر، والأصعب فيه أنه سيُغضِب، خاصة من تصوروا أنهم تجاوزوا السابقين ـ فهكذا يتكلمون بلا حيطة وبدون تواضع ـ وأتوا بعدهم بجديد فريد، ألا ليت شعري لو أدركناه معهم لفزنا إذن فوزا عظيما. هيهات، فقد تساءلت بيني ونفسي لماذا يتعثر الجديد الأدبي في العمق لا الشكل والحلة، ولا نجد إلا نادرا تعبيراتٍ محْدَثة أصيلة تمثل الأجيال العربية الحاضرة على مستوى خيالها، ولغتها، وأفكارها، وأحلامها مع مطامحها بله وأوهامها. أقصد نماذج وتصورات وتصويرات لتكن مُشبعة بالقديم الضّرع الأول من لم يشرب منه لا يعرف ما الحليب، لكن تأتي مجددةً فعلا لا متحايلةً على القديم تُكرّره تُقلِّده بصيغ مخاتلةٍ تُراوح في نظامه وهو مؤصَّلٌ بروحه. خلاصتي، أنه لا يمكن وجود تجديد حقيقي في مجتمعات راكدة. مجتمعاتنا، بلداننا، رغم ما ترتقي فيه على صعيد النمو والبنيات التحتية وشكليات التدبير وما إليه، هي مستعارة ومكرّرة، وهي قامعةٌ ومتسلطةٌ مشدودة إلى جذور القِدم، والتجديدُ عماده الحرية، فهل نملك هذه الحرية؟
جاءني هذا الكلام التقطته من وقت عابر وأنا جالس أشرب شايا وقيتة الغروب في باحة مقهى بالرباط، كلما حللت بها. والرباط مدينة عربية أندلسية بمعنى الكلمة. عتيقة حديثة. تراث وحاضر يتجدد، وهي تدأب اليوم لاستعادة مجدها ـ أنا لا أعرفه، انتبهوا أن الحديث يدور دائما عن استعادة مجد مفقود، وهذه هي النوستالجيا البائسة معها الزمن توقف! ـ باركها اسم وليد» مدينة الأنوار» وهي خُلسة إلى عاصمة الأنوار التي في المتروبول بقرينة المصابيح الوضّاءة تشعشع في كل مكان، لأن باريس في الأصل سُميت كذلك لما أضاءتها المصابيح. والمهم أن الرباط تحاول أن تنهض من موات.
أشرب شايي وهي تتنفس من بشرتي هادئة فاترة، أرى عينيها بين صحو ونعاس كأنها غافية وتتلكأ في القيام بين غُنج وكسل ودلال، لتُعطاك أخيرا بسماح. مدينة مبسوطة على كفّ اليد. وإذا استثنيت أنها عاصمة المملكة ومقر الحكومة التي لن يتاح لك أن ترى وزراءها مثل خلق الله يمشون في الأسواق، فهي بلا أسرار، بلا تجاعيد، مهذبة لا تعرف الغضب أو هو صراخ عابر، تنام باكرا ولا تنتظر شيئا ..أقمت فيها وقتا ولا أعرف كيف تورّطت، يخيّل إلي أننا جميعا مورّطون في المدينة بطريقة ما ولا سبيل إلى الخلاص إلا بأن نخوض الطريق الصحيح إليها، وهذا افتراض ليس إلا، إذ في الغالب في ما يخصني أخوض في طريق الأوهام وهو الوحيد الذي يمشي فيه الكاتب بوضوح ولذلك لا يصلح للهداية وتولّي الحكم، فأيّ ضلال هذا!
الكاتب : أحمد المديني - بتاريخ : 15/06/2022