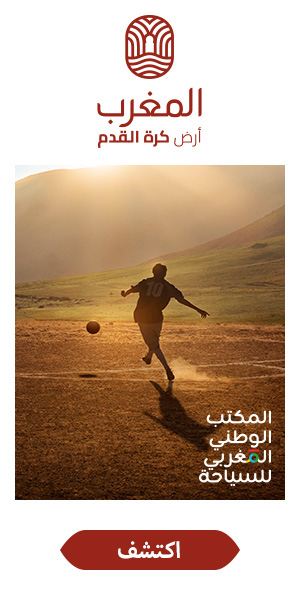نقد الشمولية في رواية «ثرثرة فوق النيل»

مصطفى خُلَالْ
هي الترجمة الفرنسية لرواية (ثرثرة فوق النيل) dérives sur le Nil للروائي المصري الكبير نجيب محفوظ، جائزة نوبل للآداب في العام 1988. أنجز الترجمة الفرنسية (فرانس ماير)، لدار النشر الشهيرة غاليمار، في العام 1991، أي عقودا طويلة بعد نشرها في موطنها الأصلي، مصر حيث صدرت في العام 1966 بالقاهرة ثم في دار القلم البيروتية.
أنيس هو الشخصية الرئيسية في الرواية، وحديثه على طول السرد هو ما يجعل القارئ يطلع على تفاصيل حيوات الشخصيات الأخرى. وهم جميعهم مثقفون من الطبقة المتوسطة، فيهم الكاتب والصحفي والمحامي والموظفون الحكوميون والفنان، الى آخر ممثلي الطبقة المتوسطة.
تبدأ الحكاية بتقديم موظف وزارة الصحة، أنيس، تقريرا الى مديره على رأس المصلحة التي يشتغل فيها، دون أن ينتبه الى أن القلم الذي كتب به التقرير هو قلم نفد مداده، لم ينتبه أنيس للأمر لأنه كان في غيبوبة تامة بفعل أثر الحشيش على دماغه وغيابه عن الوعي. وهو ما جعل مديره يغضب من سلوكه فيوبخه متهما إياه بأنه كتب التقرير وهو مُخَدًر.
ما أن ينتهي أنيس من الشغل حتى يسرع كل يوم مهرولا للحاق بعوامة رابضة بمياه نهر النيل. فيها يلتقي مع صحبه، أولئك يجمعهم تدخين نرجيلة الحشيش، مفضلين الغياب التام عن الوعي، والمناقشات التي لا تنتهي، يعرضون فيها مشاكلهم من كل نوع، وهمومهم، ويأسهم، وضياعهم، وانهزاميتهم، وتذمرهم من كل مظاهر الواقع التي لا يكفيهم السخرية منها، والهروب من الواقع بالعربدة ‹›والتحشش›› الذي لا يجدون في غيره أي لذة ترتبط بالحياة الاجتماعية.
والحقيقة أن العوامة الرابضة فوق مياه النيل، إنما تمثل فئات الطبقة المتوسطة، وخاصة من تصنفهم التحاليل المادية في خانة البورجوازية الصغرى في المجتمع المصري في العهد الناصري تحديدا. أما العوامة كفضاء فتمثل الساكنة المصرية. لقد سمتها جماعة أنيس بسخرية دالة «المملكة»، مثلما منحت الجماعة لكل واحد وظيفة في هذه المملكة. أحدهم سمته ملك المملكة، وآخر منحته وظيفة إمبراطور المملكة، وثالث وزيرها في العدل ورابع يدبر الشؤون العسكرية للمملكة. وفي إحدى المرات الماجنة وجدت الجماعة نفسها وقد استهلكت مبكرا كل مخزونها من الحشيش وهو ما سيجعل أفرادها يفيقون على الوعي الذي لم يألفوه، وأغضبهم أن يقضوا ليلتهم بدون حشيش الى أن فاجأهم أنيس بإظهار قطعة حشيش كان يخبئها لحسابه الخاص، قطعة حشيش ستنقذهم من هَمِ الوعي والفطنة التي يكرهانهما. فرح أفراد الجماعة فرحا عظيما ، وهتفوا باسم أنيس، بل حملوه على الأكتاف وهم يتصايحون باسمه، وهكذا منحوه وظيفة صاحب النعم في المملكة التي لا تسعد إلا وهي غائبة عن الوعي. وفي لحظة من هذه الهستيريا السعيدة بفضل «نعمة» الحشيش المانح نعمة فقدان الوعي السعيد والمُسْعِد، وأنيس على الأكتاف تشحذ مخيلته ذاتها شحذا فتقوم بحركة استرجاع طويل للماضي، لعقود من الزمن خلت، استرجع فيها أنيس لحظات حمله على الأكتاف من طرف الجموع المتظاهرة ضد الاستعمار الانجليزي وضد الملك في مملكة مصر، وهي ترقص غبطة بشجاعة أنيس ومقاومته للاستبداد الانجليزي المتحالف مع استبداد الملك المصري. ومع هذا الاسترجاع البطولي لماضيه، يدخل أنيس في مونولوج باطني مع ذاته، متفكرا هائما في ملكوت التاريخ والفلسفة والميتافيزيقا وتساؤلات كبرى حول معنى الوجود والعدم والغاية من كل هذه الحياة المختنقة بالاستبداد. وفي لحظة أخرى يخترق باب العوامة سارحا متأملا في مياه النيل، متسائلا عن كيفية استقامة الحاكم بأمر لله، متسائلا عن انتحاره أو غيابه في قمة جبل احتجاجا على أمر هام وهو: كيف لا تخضع الطبيعة لسلطاته، أليس هو الحاكم بأمر لله، بل أليس هو نفسه إلها. هكذا ينتهي الأمر بأنيس بالتساؤل حول الكيفية التي يتعامل بها ساكنو هذا النهر العظيم من الشعب المصري، ويحار في أمر أشد خطورة قائلا إنه لا يعجب لعبادة الشعب لكل هؤلاء الآلهة من الفراعنة الى اليوم، بل إنه يعجب خاصة لحال هؤلاء الآلهة من الفراعنة إلى المستبدين الحاليين، يعجب كيف صدق هؤلاء الآلهة أنهم آلهة.
لقد ناقشت فتاة من المعجبات استقدمها أحد أفراد مملكة العوامة، ناقشت الجماعة…فقد كانت النساء جزءا من عالم الجماعة الخاص مثلما كانت أخلاق الجنس المتحرر والخيانات الزوجية من الطرفين وفي الاتجاهين، سلوكا معهودا في أخلاقيات الجماعة، عنوانا على انحلالها، بل على انحلال طبقتهم ككل ، في المجتمع…ناقشتهم حين لاحظت أنهم لا يخافون من البوليس وهم يقتنون الحشيش بكل تلك المقادير الهائلة، ويفعلون ما يريدون في العوامة وبكامل الحرية. لكن جاءها رد يقول إنهم يخافون من الجميع، من الإنجليز، ومن الأمريكيين، ومن الجيش ومن البوليس، ومن كل السلطات، ومن كثرة ما نخاف صرنا في حالة لا – خوف. والحق أنه تعبير من الجماعة بأنهم أناس زائدون، لا قيمة لهم، والحكومة غير معنية بهم أصلا. وهي لحظة في الرواية قوية للغاية تفسر قدرا إنسانيا رهيبا يتلخص في العدمية والتخلص من كل مسؤولية، والسقوط في عوالم السخرية والاستهزاء بالشأن العام. أين راحت روحهم الثورية التي عاشوها في شبابهم. حين جاءت «الثورة» – الثورة الناصرية، لم ينطفئ نفس ذلك الحماس الوطني، لكن الفكر الشمولي سرعان ما سيطر فتقلص ذات الحماس ثم خبا مثلما خبا كل شيء ، فمات فيهم الانسان الذي كان يسم الروح والعقل والوجدان.
سألني صديق فرنسي، شاعر، هو جان ودرناك، أنه كان يعتقد قبل قراءته لترجمة (ثرثرة فوق النيل)، أن نجيب محفوظ كان ناصريا. لكنه لاحظ أن هذه الرواية الفلسفية العميقة الدلالات الغنية بالرموز، هي وإن كانت نقدا للاستبداد عموما، فهي نقد لاذع للعهد الناصري في الستينات.
كدت أقول له إن محفوظ ليبرالي النزعة وفدي الميول، تعددي التوجه، معليا من شأو الحرية، لكنه صُدم هو الآخر، ثم أدركت أن الموضوع شائك، يستدعي تاريخا بالكامل، بل وكتابا بل كتبا. والرواية مع هذا تنطق بنزعة وجودية مبطنة.. وهو موضوع آخر ومعقد…تتضمنه أيضا «ثرثرة فوق النيل» لا تحتمله طبيعة موجز هذا المقال..
الكاتب : مصطفى خُلَالْ - بتاريخ : 01/02/2022