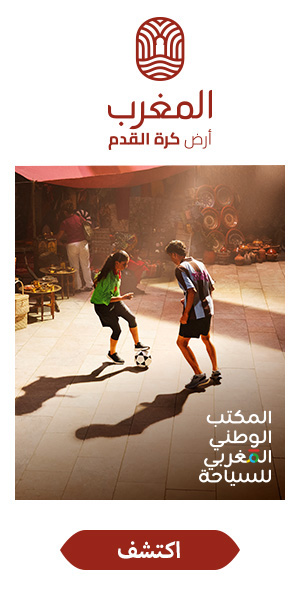الاحتجاج بين الحق والعنف

عبد السلام المساوي
1 – الاحتقان الاجتماعي
وحركات الاحتجاج
تعتبر حركات الاحتجاج شكلا من أشكال التعبير الاجتماعي الذي تنظمه القوانين الجاري بها العمل في المجتمعات الحديثة. وبطبيعة الحال، فإن كل الحركات الاحتجاجية ليست متماثلة في أساليبها وفِي زخمها واتساعها وشعاراتها وسياق انطلاقها الموضوعي والذاتي.
فقد يتخذ الاحتجاج شكل عرائض ومذكرات تندد بممارسات وتطالب بإصلاح أوضاع والتصدي لاختلالات إدارية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها.
كما قد يتخذ شكل تحركات داخل المؤسسات التمثيلية المنتخبة تقودها معارضات سياسية بغاية دفع السلطات التنفيذية إلى أخذ مطالب هذه الفئة الاجتماعية أو تلك بعين الاعتبار، في قراراتها ومشاريعها التنموية العامة، أو دفع هذه المؤسسة المنتخبة، وطنيا أو جهويا أو محليا، إلى سن تشريعات أو إطلاق مشاريع ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للمواطنين عامة أو بالنسبة لساكنة منطقة بعينها.
وقد يتخذ الاحتجاج شكلا جماهيريا، يكون الشارع مسرحا له، من خلال وقفات واعتصامات ومظاهرات ترمي إلى لفت أنظار الحكومة أو الدولة إلى خطورة استمرار وضع ما دون معالجة. وكثيرا ما تترافق تلك الاحتجاجات الجماهيرية بملف مطلبي محدد المعالم وواضح الأهداف، القريبة والبعيدة. الأمر الذي يعني أن الاحتجاج هو بغاية التفاوض حول دفتر المطالب بين مؤسسات الدولة المعنية وبين قيادات الحركة الجماهيرية. وتأتي حركات الإضراب القطاعي أو الوطني بقيادة النقابات في مقدمة هذه الاحتجاجات.
غير أن هناك حالات أخرى، يتم فيها تجاوز الأطر المنظمة للنقابات، خاصة عندما يتعلق الأمر بحدث، ما، يكون بمثابة المفجر المباشر أو غير المباشر للاحتجاج، نظرا لبلوغ الاحتقان الاجتماعي درجة عالية في أوساط اجتماعية بعينها ودون أن يكون ذلك عبر الطرق والأطر التنظيمية التقليدية، وإنما عبر انطلاق حركات جماهيرية عفوية، هي بمثابة رد فعل غاضب حول الحدث، ثم ما تلبث أن تأخذ أشكالا منظمة، إلى هذا الحد أو ذاك، سواء تولى هذه المهمة عدد من القوى السياسية أو النقابية المنظمة أو تولتها قيادات يفرزها الحراك الاجتماعي ذاته، خاصة إذا طال أمده ولم يتم حسم مصيره عند انطلاقه بواسطة تلبية المطالب المرفوعة أو بعضها أو تدخلت عوامل جديدة فرضت على الاحتجاج الانتقال من ظرف الانطلاق التلقائي العفوي إلى مرحلة التنظيم الفعلي والتي تتسم بمزيد من التعقيد ليس بالضرورة من سمات الاحتجاج التلقائي العفوي.
وغالبا ما يتم الخروج، هنا، من دائرة المطالب الأولية التلقائية إلى بلورة برنامج مطلبي محدد المعالم وواضح السقوف العليا والدنيا.
وليس غريبا، في هذه الحالة، أن يتكيف سلوك السلطة السياسية ومؤسساتها المعنية مع هذا التطور، على اعتبار أن تجاهله قد يؤدي إلى مزيد من الراديكالية في مطالب المحتجين. وقد تصل إلى درجة يستحيل فيها على الدولة الاستجابة الفورية لها أو حتى في الزمن المنظور الأمر الذي قد يتسبب في نوع من المواجهات الكبرى بدل اعتماد أساليب التفاوض المتعارف عليها في كل حالات تعامل السلطة الطبيعي مع الاحتجاجات ذات البعد المطلبي الاجتماعي الواضح.
ومما لا شك فيه، أن الحركة الجماهيرية المؤطرة بمقتضيات الدستور والمحترمة للقوانين المعتمدة من حيث جوهرها انطلاقا من مبادئ الحرية والديمقراطية هي حركة ديمقراطية بالتعريف. ولن يغير من هذا الجوهر ما قد يشوبها من بعض التجاوزات في السلوك، لهذا السبب أو ذاك، ما دامت محتفظة بما هو جوهري فيها وهو الدفاع عن مصالح أوسع الفئات الممكنة والتعبير عن مطالبها ضمن الأطر الشرعية والقانونية. كما أن ضمان الدولة والسلطة السياسية الحق في التعبير والاحتجاج الاجتماعي والسياسي السلمي بمختلف تمظهراته ومجالاته، والحرص على احترام روح الدستور هو الدليل القاطع على أنها سلطة تدرك مسؤولياتها في حماية الحريات الفردية والجماعية والالتزام بالمبادئ الديمقراطية التي ينبغي أن تظل السائدة في علاقاتها بمختلف فئات وقوى المجتمع، بما في ذلك تلك التي تناوئ بعضا من سياساتها أو جلها. وليس ليغير من هذا الحقيقة، هنا أيضا، حدوث بعض الاحتكاك أو التجاوز أو حتى بعض الشطط في استعمال السلطة هنا أو هناك ما دام هذا ليس هو الاتجاه العام للسلطة وإنما هي أعمال فردية يعاقب عليها القانون كلما قام الدليل على حدوثها.
بل إن لجوء السلطة إلى إعمال القانون لمواجهة تجاوزات الحركة الجماهيرية وخروجها من نطاق الاحتجاج المشروع لدخول دوائر المساس بالأمن الفردي أو الجماعي ليس ليغير من طبيعة السلطة والزج بها في دوائر العداء للمجتمع والشعب.
نخلص هنا إلى أمرين:
أولا، أن طبيعة الاحتجاج ومجاله وشعاراته وأهدافه ومدى ارتباطه بقضايا الحقوق والمطالب المشروعة في مختلف المجالات هو الذي يضفي عليه طابعه الديمقراطي حيث لا يعتد بهوامش التجاوز الذي قد يحصل على هذا المستوى أو ذاك من ممارسة هذا الحق
ثانيا، أن طبيعة تعاطي السلطات العمومية بمختلف أجهزتها مع الاحتجاج ينبغي أن تكون متطابقة مع طبيعة الاحتجاج على اعتبار أنها هي المدعوة إلى التعاطي مع قضاياه، لإيجاد حلول ملائمة لها تضمن الحقوق المشروعة في ظل احترام مقتضيات الدستور والقانون وهو سلوك ذو اتجاهين وليس أحادي الاتجاه. إذ بقدر ما ينبغي فيه الحرص على عدم ترك الحبل على غارب من يقومون بتجاوزات لا يسمح بها القانون داخل الحركة الجماهيرية بقدر ما ينبغي الحرص أكثر على عدم ترك الحبل على غارب من يمارسون الشطط في استعمال السلطة. لأنه إذا كان السلوك الأول يفتح المجال امام الانزلاق إلى نوع من تعميم الفوضى وإخراج الاحتجاج عن مساره الطبيعي، فإن السلوك الثاني غالبا ما يؤجج الاحتقان والتوتر ويساهم في تعميق فقدان الثقة بين الحركة الجماهيرية وبين السلطة وأجهزتها التي هي المعنية بالسهر على إيجاد الحلول وليس المساهمة في تأزيم الأوضاع.
هل هذه حالة مثالية مستحيلة التجسيد على أرض الواقع؟ ليس هناك من جواب جاهز وقاطع على مثل هذا السؤال. لكنه ليس بالإمكان التعاطي مع حركات الاحتجاج باعتبارها حركات ذات بعد ديمقراطي إلا ضمن هذا التطلع المثالي. وهذه القاعدة هي التي تسري على من يحمل مطالب ملموسة، كما على من هو مطالب بالنظر فيها بالنظر لموقعه في هذه المعادلة الدقيقة من علاقات القوة المادية والمعنوية .
2 – السؤالان: من صاحب المبادرة ؟ وما دلالة التوقيت ؟
في كل المعارك النضالية التي أجد نفسي مدعوا لها، لا أكتفي بتفحص شرعية موضوع المعركة…بل أطرح بالضرورة سؤالين :
من صاحب المبادرة ؟ وما دلالة التوقيت ؟
لا أستطيع التغاضي عن ذلك…
صدقا، ليس في الأمر من جهتي أي تذاكي أو تعالم…ولا هو بأعراض بارنويا موسوسة..
لكن أنا متأكد – بالتجربة المتكررة وبدروس التاريخ – أن المعارك لا تتحدد فقط بشعاراتها، وفي غير ما مرة كأن الناس حطب معارك لا تعنيهم – هذا إن لم تكن ضد مصالحهم – فقط لأنهم لم يهتموا للمحرك المجيش في علاقة بالتوقيت ( مثالان فاقعان: حقوق الإنسان كما استعملتها الدول الغربية في صراعات مصالح استراتيجية ضد دول بعينها…وما سمي بالربيع العربي)…
القاعدة الاحتراسية هذه، أحاول أن التزم بها دوما…فما بالك أن تعلق الأمر بوسائط التواصل الاجتماعي، حيث الظلام الدامس والذباب والكتائب التي لا وجه لها…
ما زلت، لحد الآن، مقتنع أن الساحة الحقيقية لاستواء فضاء عمومي حقيقي هو الفضاء الواقعي بفاعليه المكشوفي الوجوه، المعروفي الهوية، حيث يتوفر حد أدنى من المسؤولية
أما وسائط الاتصال الاجتماعية فاستعمالها الحميد في نظري يقتصر على التنوير بمعناه العام: توفير المعارف والمعلومات والمعطيات التي تسمح لكل فرد أن يكون قناعته.. أما أن تتحول إلى محددة لأجندة الصراع السياسي والاجتماعي والقيمي، فمجرد حطب بليل.. وذاك في أحسن الأحوال .
يفترض في وسائل التواصل الاجتماعي أن تلعب دورا في تعريف الناس بعدد من القضايا لم تكن وسائل الإعلام التقليدية تغطيها إلا ما ندر. خاصة أن سرعة التواصل التي تميزها تجعل منها أداة فعالة في نقل المعلومة ونشرها على أوسع نطاق وفي اللحظة ذاتها.
وإذا كأنت وسائل التواصل الاجتماعي تلعب فعلا هذا الدور في البلدان المتقدمة، فإنها تقوم بالعكس، في الأغلب الأعم، في بلداننا المتخلفة. حيث أصبحت أداة للدجل والكذب الصراح والافتراءات على الأشخاص وعلى المؤسسات على حد سواء إلى درجة تحولت معها إلى أدوات للتضليل والتعمية باسم الإثارة هنا وتحقيق السبق الإعلامي الزائف هناك .
وللأسف الشديد فهناك من يعتبر نشر الأخبار الكاذبة تعبيرا عن الرأي، وهناك من يرى في الافتراء على المؤسسات والأشخاص مجرد إثارة ولفت للانتباه، وكأننا عدنا إلى زمن قانون الغاب حيث يحق كل شيء لكل من استطاع إليه سبيلا خارج كل أخلاق وموضوعية واحترام للإنسان بما هو كذلك.
3 – العمل السياسي المنظم في مواجهة الفوضى والمجهول
إن السياسة لم تنته وأن دور الأحزاب ضروري لإنجاح المشروع الديموقراطي الحداثي الذي تنشده بلادنا، باعتبار الأحزاب ركيزة أساسية للنظام الديموقراطي، ولا يمكن أن نتصور أي تحول ديموقراطي أو ديموقراطية بدون أحزاب، فالديموقراطية كما تحققت في العالم هي ديموقراطية الأحزاب السياسية، من هنا لا يمكن أن نؤسس ونبني مشروعا تنمويا ديموقراطيا بالتشكيك في دور الأحزاب وتبخيس فعاليتها، أو بمحاولة تجوزها أو إلغائها…
هناك الآن، وقبله، تحامل على الأحزاب وبالذات الأحزاب الديموقراطية وفي طليعتها الاتحاد الاشتراكي. ولا يستبعد أن يكون الهدف هو خلق الفراغ، والفراغ أقتل من القمع، فالقمع يمكن أن يكون مجرد فترة وتمر، ويمكن أن يصيب الوهن مرتكبه، أما الفراغ فهو يقتل القريحة ويستمر مفعوله عدة أحقاب…
كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن موت الأحزاب السياسية الوطنية الديمقراطية المغربية. ولا تخلو صفحات بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من «مقاربات» وتصريحات لبعض الأشخاص من نعي الأحزاب. بل إن عددا من الذين ينتمون إلى « اليوتوب « يعتبر نفسه مؤثرا، أو في أوساط لا انتماء لها بشكل تنظيمي مباشر وإن أمكن تصنيفها ضمن الذين يعتقدون أن الحقيقة وتصريحاتهم شيء واحد بالتمام والكمال، وهي بالتالي، فوق كل نقد كيفما كان شكله ومضمونه.
ليس هذا الحديث وليد سياق اليوم، وإنما هو استئناف لحديث قديم نسبيا، تعلو نبرته من حين لآخر بحسب طبيعة المواسم السياسية في بلادنا.
وبالفعل فإن متابعة وسائل الإعلام المختلفة ومحاولة رصد تصريحات عدد من «الشخصيات « «السياسية» و « الإعلامية « يكفي ليوضح إلى أي درجة طغى هذا النوع من الأحاديث على أوساط اجتماعية وسياسية تحاول تعميمها على سائر أوساط المجتمع في عملية شبه منظمة لتبخيس العمل السياسي والنيل من مختلف القوى ذات التوجهات الوطنية الديمقراطية الإصلاحية الحداثية.
فهل رفض مثل هذه الأحاديث الناعية للأحزاب السياسية رفض للنقد السياسي؟ الجواب بالنفي بالتأكيد. لأن كل عمل سياسي قابل للنقد لإبراز إيجابياته وتحديد سلبياته إذ غاية النقد رصد الإيجابيات لتعزيزها والبناء عليها، والوقوف على السلبيات بهدف تجاوزها وتدبير شؤون الممارسة بما يضمن عدم تكرارها.
والعمل السياسي الذي يهمنا هو من فعل المؤسسات السياسية الحزبية أو التي تسهر على تدبير الشأن العام. وهي مؤسسات يسري عليها، حكما، ما يسري على العمل السياسي الذي تنتجه سلبا وإيجابا.
يمكن، من حيث المبدأ وقبل ولوج عملية نقد الممارسة السياسية والهيئات التي تصدر عنها، اعتبار أن العمل السياسي المنظم والتعامل مع المؤسسات التي تنتجه في مختلف المجالات هو مرحلة متقدمة على ما قبلها من عمل سياسي غفل، لا يربطه أدنى رابط بأي مؤسسة تنظيمية حزبية أو غيرها من التنظيمات داخل المجتمع المعني.
هناك إذن فرق نوعي بين العمل السياسي الغفل وبين العمل السياسي المنظم. ولن أتردد في ترجيح كفة الثاني على كفة الأول من حيث المبدأ، وقبل الدخول في أي عملية نقدية. غير أن الأمر الواقع قد يفرض نفسه على المحلل السياسي، إذ يجد نفسه في وضعيات ما من حالات الممارسة الفعلية أمام العمل الغفل أو العفوي، وعليه بالتالي، إخضاعه لعملية النقد للتمييز فيه بين ما يندرج ضمن إيجابيات الممارسة وما ليس إلا عنصرا من عناصرها السلبية.
ماذا يعني ترجيح كفة العمل المنظم في سياقنا هذا؟ إنه يعني أساسا اعتباره بمثابة القاعدة التي تبنى عليها التصورات والمواقف مقارنة بالعمل الغفل الذي يشكل استثناء بكل المقاييس، حتى في الوقت الذي تترتب عنه نتائج موضوعية وذاتية ذات التأثير الأكبر على المؤسسات التي تترجم العمل المنظم وتفرض عليها أخذ مستجداتها بعين الاعتبار. ذلك أن تجاهل تلك النتائج، بدعوى كونها ناجمة عمل ممارسة تلقائية غير منظمة، يلغي من دائرة اهتمام الفاعل السياسي البعد الإبداعي في تلك الممارسة، ولا يجعلها تتطور بالتالي بما يجعلها تستوعب مستجداتها بل إنها قد تحكم بذلك على نفسها بالتراجع والضعف الذي قد ينتهي بها إلى التفكك والاندثار.
وفِي المقابل، فإن اعتماد نتائج الممارسة العفوية أساسا لنبذ العمل المنظم بدعوى تجاوز الأطر التقليدية للممارسة أو بذريعة أن الأحداث قد تجاوزت المؤسسات ومختلف أشكال التنظيم السياسي في قيادة الأحداث، هو الطريق الأقصر إلى الانتصار لنوع من الفوضى العامة التي لن يجني منها المجتمع غير مزيد من المتاعب الملازمة لمختلف أنواع الممارسة العفوية التي لا تحدها ضوابط ولا تعرف حتى مجرد تخوم على طول مسافاتها واتساع مساحاتها.
أنها متاعب قراءة الواقع بمختلف معطياته الموضوعية والذاتية، ومتاعب في تحديد الأهداف وتدقيق المطالب وبلورة شعارات المرحلة من طبيعة واقعها وليس من نسج خيال هذا الفكر الفوضوي، وفي كل هذا إعدام فعلي لإيجابيات الممارسة المنظمة وأطرها ومواجهة المجهول بأسلحة وهمية إلا أنها شديدة التدمير .
4 – كل خرق للقانون عنف
كل خرق للقانون عنف، سواء صدر عن الفرد أو عن الجماعة. مواجهة عنف الفرد أبسط من مواجهة عنف الجماعة، ذلك أن الفرد قد يرتدع بإكراه مادي أو معنوي، مثل الحبس والغرامة، أو بهما معًا، في حين أن تعقيدات انخراط الجماعة في خرق القانون تحول دون تعميم شكل واحد من الإكراه المادي أو المعنوي، إذ يقتضي التمييز في الجماعة بين المحرض والمنفذ بين المتعمد والمغرر به. وينبغي مقابلة كل واحد من هذين الصنفين بما يتناسب مع حالته، في لحظة ارتكاب الجنحة أو الجريمة، ضمن رؤية شاملة تستحضر المجتمع برمته، ولا تركز على من صدر عنه الخرق فحسب، كما هو الحال عندما يتعلق الأمر بالفرد.
وفي الحالتين معًا. فإن خرق القانون هو اعتداء على المجتمع، بوعي أو دون وعي. وليس من حق المجتمع التصدي للخرق فحسب، بل إنه واجب من الواجبات التي تضطلع بها الدولة، باعتبارها التعبير عن الإرادة العامة.
إن المسألة لا تتعلق بالعمل على درء كل انحراف نحو فتنة أو ما يشبهها فقط، بل يعود أيضًا إلى ضرورة قراءة خرق الجماعة للقانون في مختلف أبعاده، الأنية وبعيدة المدى، حتى تأتي المعالجة متوافقة مع الصالح العام الذي يظل الموجه الرئيسي للذي يسن القوانين والذي يطبقها على حد سواء.
وهذا يعني أن خرق القانون الهادف إلى إحداث الفوضى والتمرد على ما يمثله من مؤسسات بشكل مباشر أو غير مباشر، يستدعي مقاربة تدرك هذا البعد، وتعمل على تطويقه وردعه، بما يتناسب مع خطورته على المجتمع برمته.
تثار عادة بعض التحفظات لدى جماعات تنظر إلى المجتمع وقضاياه من زاوية حقوق الإنسان الفرد، معتبرة أن على القيمين على إنفاذ القوانين التقيد بمقتضيات العهود والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وهذا أمر لا خلاف حوله، من حيث المبدأ، غير أن حصر كل قضايا المجتمع والنظر إليها من هذه الزاوية يقع في نوع من الاختزال المخل بضرورات حماية المجتمع ككل، من مضاعفات الإمعان في خرق القانون تحت أي مبرر كان.
لا جدال في أن مواجهة خرق القانون ليست اعتباطية، بل منظمة بالقانون، وليس بإمكان أي كان أن يتجاهله تحت أي ذريعة كانت. غير أن البون شاسع بين الهفوات التي تحدث عرضًا وبشكل جزئي، وبين الممارسات المنهجية المقصودة التي تضع القانون على الرف لتحكيم المزاجية أو ما شابه ذلك في التعامل مع من يقدمون على خرق القوانين.
قد شكلت مسألة احترام حقوق الإنسان خلال الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها المغرب للوقاية من انتشار وباء كورونا المستجد موضوعًا للجدل بين عدد من النشطاء الحقوقيين، انطلاقًا من معاينة تصرفات بعض رجال السلطة خلال أدائهم لمهامهم في السهر على احترام إجراءات الحجر الصحي. وإذا كانت بعض الممارسات، التي تظل استثنائية إلى أبعد الحدود، غير مقبولة من وجهة النظر الحقوقية والقانونية أيضًا، فإنها لا ينبغي أن تتحول إلى الشجرة التي تحجب الغابة، لأن في ذلك إضرارًا بالمجتمع وسلامته على مختلف المستويات.
إن الاستثناء غير المقبول لا ينبغي تحميله دلالات أكثر من الدلالة التي يحملها باعتباره تصرفًا فرديًا معزولًا واستثنائيًا يخضع للتقييم من هذا المنظور، ليس فقط من قبل المنظمات الحقوقية، وإنما أيضًا من قبل الدولة ومؤسساتها المختصة. وبالتالي، فإن كل تأويل مغرض في هذا المجال لا يعدو أن يكون محاولة من محاولات جعل شجرة الفعل الاستثنائي المعزول حاجبًا لغابة الجهود الجبارة التي تبذلها الجهات المختصة في سبيل احترام القانون الذي تم سنّه من أجل حماية المواطنين دون استثناء من عدوى الوباء.
قد يتم التركيز، كما فعل البعض، لما تبين له أن الاتجاه العام السائد في البلاد هو دعم الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا السياق، على أن الغاية من إبداء ملاحظاته، حول هذه الممارسة أو تلك، هي التنبيه إلى عدم الوقوع في انزلاقات منافية لمقتضيات القوانين والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان، حتى في الظروف الاستثنائية التي تواجه الدولة مثل ما هو عليه الأمر في وقت كورونا. غير أن ما يندرج في سياق التنبيه المشروع يصبح مصدر تساؤلات مقلقة عندما يتخذ منحى تبخيس جهود الدولة ومؤسساتها، حيث تتحول تلك الملاحظات إلى مطية لتبرير إحياء خطاب سلبي تجاوزته الأحداث والممارسات الفعلية لمختلف المؤسسات الساهرة على تطبيق القانون على العموم.
ينطلق البعض من أن كل تعنيف يصدر عن القوات العمومية مدان، في حد ذاته، دون الانتباه أن فلسفة ردع المخالفين تقوم على المزاوجة بين بيداغوجية التحسيس والإقناع وبين كل أشكال التعنيف المشروعة بطبيعة الحال، والتي تؤطرها القوانين الصريحة الواضحة ولا تخضع لأي اعتبارات أخرى.
وعلى سبيل التذكير، فإن القانون عندما يتحدث عن الإكراه البدني ويمارسه فهو يتحدث بالذات عن ممارسة عنفه المشروع في مواجهة من يتجرأ على ارتكاب جنح وجرائم تخضع لأحكامه. وهذا يعني أن اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية أو المقيدة لها، من سجن وغيره، ليس إلا شكلًا من أشكال هذا العنف الذي تواجه به الدولة العنف الممارس من قبل المخالفين.
ويبدو لي أن الموقف المنتقد أو المشكك الذي عبر عنه بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان من الاعتقالات التي طالت المخالفين لإجراءات الحجر الصحي زمن كورونا يذكرنا بسابقة عرفها المغرب في السنوات الأولى لعهد الملك محمد السادس، ذلك أن من صدرت عنهم تلك المواقف على تنوع أطيافهم قد صدروا، عن جوهر واحد، على الرغم مما يبدو من التباين الفكري والأيديولوجي بينهم.
فقد تزامن أول عهد الملك محمد السادس مع تعميق التوجه الرسمي نحو الانفتاح السياسي والتخفيف من أجواء الاحتقان في المجتمع المغربي أيا كأنت دواعيها وأسبابها فتم إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين عبر إجراءات العفو الملكي، وهو عفو ثمنته مختلف القوى الحية في بلادنا حيث رأت فيه بادرة تؤكد حرص العهد الجديد على توسيع مجالات الحرية وترسيخ نهج جديد في التعامل مع مختلف فئات الشعب المغربي. غير أن الأعمال الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء أساسًا بتاريخ 16 ماي 2003 أدت إلى اعتقال أعداد كبيرة من الأوساط الإسلامية المتطرفة التي أنتمى إليها أو تعاطف معها الإرهابيون وخاصة السلفية الجهادية أو المقاتلة. فكان أن حاولت أوساط تلك الجهات، ومن يتعاطف معها الزعيق بنظرية المؤامرة التي تعرضت لها. وبدأت تشكك حتى في حقيقة العمليات الإرهابية محاولة الربط العبثي بل والبئيس بين إطلاق سراح المعتقلين عبر العفو الملكي وبين موجة الاعتقالات التي عرفها ما بعد العمليات الإرهابية في الدار البيضاء، في إيحاء غريب بأن إطلاق سراح المعتقلين لم يكن في الأصل إلا بغاية إفراغ السجون لتستقبل المعتقلين الجدد من التنظيمات الإسلامية التي تتعرض لمؤامرة مزعومة.
وهو على وجه التقريب ما فعله وقت كورونا من حاولوا الربط بين إطلاق سراح المعتقلين ( أكثر من خمسة آلاف معتقل) لظروف إنسانية في زمن الوباء، كما جاء في بلاغ العفو الملكي، وبين النظر إلى المعتقلين الجدد جراء خرق القانون، ذلك أن أصحاب هذه المواقف لا يقومون إلا بمحاولة التشكيك في نوايا الدولة بخصوص تخفيف السجون من واقع الاكتظاظ الذي تعيشه كما فعل ” أسلافهم”.
ولا يغير في شيء من هذا حرص البعض على القول: إن عدم شمول قرار العفو لمعتقلي أحداث حراك الريف هو الذي يدعو إلى طرح التساؤلات حول النوايا.
لقد آن أوان الخروج من منطق نظرية المؤامرة الذي يعبر عن نفسه بأشكال مختلفة عند كل المحطات الكبرى التي تجتازها البلاد، لإعطاء الأحداث الملموسة ما تستحق من اهتمام، والقطع مع منطق البحث عن الأسباب والدواعي الخفية التي لن تقنع أحدا في تفسير تلك الأحداث، بمن في ذلك من يرفعون عقيرتهم بالصراخ خوفًا من مؤامرات يعرفون جيدًا أن لا علاقة لها مع ما يجري في الواقع.
الكاتب : عبد السلام المساوي - بتاريخ : 08/10/2025