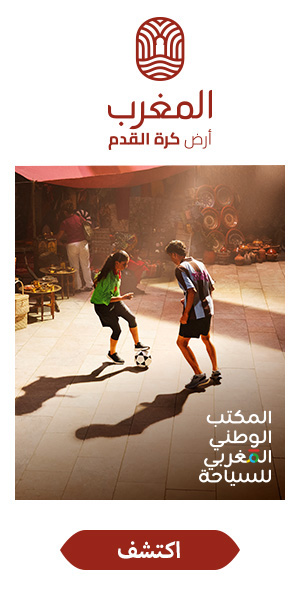التسلط الإداري داخل المؤسسات المنتخبة: بين انتهاك مبادئ الحكامة وتعزيز العنف الرمزي

سعيد الخطابي (*)
يعتبر التسلط الإداري داخل المؤسسات المنتخبة أحد أخطر الظواهر التي تهدد الممارسة الديمقراطية، حيث تتحول هذه المؤسسات، التي يُفترض أن تكون فضاءات للحوار والتدبير المشترك، إلى ساحات للهيمنة والإقصاء وتصفية الحسابات السياسية. هذه الممارسات لا تتنافى فقط مع مبادئ الحكامة الجيدة، بل تؤدي إلى تعزيز العنف الإداري الرمزي، الذي يقصي كل المخالفين ويفرض منطق السلطة المطلقة، ما يجعل المؤسسات المنتخبة أقرب إلى أنظمة الحكم الشمولية منها إلى مؤسسات ديمقراطية.
واعتبارًا لكون الحكامة الجيدة تعد ركيزة أساسية لضمان نزاهة القرار السياسي داخل المؤسسات المنتخبة، حيث تقوم على مبادئ الشفافية، والمساءلة، والعدالة، والتشاركية، فإن احترام هذه المبادئ يجعل المؤسسات قادرة على تلبية حاجيات المواطنين بعيدًا عن أي تحكم أو هيمنة. غير أن غياب هذا الالتزام يؤدي إلى احتكار السلطة من قبل بعض الرؤساء الذين يستغلون مناصبهم لتعزيز نفوذهم، سواء من خلال رفض منح التفرغ للمنتخبين المخالفين لهم، أو عرقلة مشاريعهم، أو حتى تهميشهم داخل اللجان والهيئات التقريرية.
رفض منح التفرغ: نموذج التسلط الإداري
في الحسيمة
في هذا السياق، يبرز المثال الصارخ لما حدث في الحسيمة، حيث رفض أحد الرؤساء الموافقة على طلب التفرغ لمهام رئاسة جماعة محلية أخرى، في خطوة تعكس بوضوح كيف يُستخدم العنف الإداري الرمزي كأداة للإقصاء السياسي. مثل هذه القرارات، التي تفتقر إلى أي مبرر قانوني واضح، تؤكد أن بعض المسؤولين داخل المجالس المنتخبة يستغلون مواقعهم لفرض الهيمنة والتحكم في مسار المؤسسات، بدلًا من احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية.
وفي ظل هذا الوضع، تصبح المسؤولية السياسية عاملًا حاسمًا في الحد من الشطط في استعمال السلطة. فكل مسؤول داخل مؤسسة منتخبة يجب أن يكون خاضعًا للمساءلة، سواء من طرف زملائه المنتخبين أو من قبل المواطنين والجهات الرقابية. لكن عندما يغيب الإحساس بالمسؤولية، يتحول الرئيس إلى متحكم مطلق في القرار، مستغلًا بعض الثغرات الإدارية والقانونية لقمع الأصوات المعارضة. وهذا ما يفتح الباب أمام ممارسات شمولية تعيد إنتاج نماذج الحكم التسلطي، حيث لا مجال للرأي المخالف، ويصبح المجلس أداة لإضفاء الشرعية الشكلية على قرارات الرئيس.
من أخطر تجليات هذا التسلط تحويل المؤسسات المنتخبة إلى أدوات إقصائية، حيث يتم عزل المخالفين وإبعادهم عن دوائر التأثير، مما يؤدي إلى وأد التعددية السياسية داخل المؤسسة. هذا الأسلوب يرسخ فكرًا ستالينيًا قائمًا على احتكار السلطة، وفرض رؤية واحدة، ونبذ كل توجه معارض، وهو ما يتعارض مع جوهر الديمقراطية التي تقوم على الاختلاف والتنوع والتداول السلمي على المسؤوليات. والمثير في الأمر أن هذه الممارسات لا تأخذ شكل قمع مباشر، بل تُمارَس عبر ما يسمى بالعنف الإداري الرمزي، حيث يتم استغلال الآليات القانونية والإدارية لفرض الهيمنة وإخضاع الآخرين.
هذا العنف الرمزي يظهر في صور متعددة، كرفض منح التفرغ دون مبرر قانوني، أو استبعاد بعض الأعضاء من اللجان المهمة، أو اتخاذ قرارات تضر بمصالح فئة معينة داخل المجلس، أو حتى توظيف الإدارة بشكل انتقائي لخدمة أجندات سياسية معينة. هذه الممارسات تجعل المنتخبين المعارضين في وضعية ضعف، وتحد من قدرتهم على القيام بدورهم الرقابي والتدبيري، مما يؤدي في النهاية إلى هيمنة طرف واحد على كل مفاصل القرار.
ولأجل التصدي لهذه الظاهرة، يتطلب الأمر تفعيل آليات قانونية ومؤسساتية تضمن التوازن داخل المجالس المنتخبة. وأحد أهم هذه الآليات هو اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرارات التعسفية، سواء تعلق الأمر برفض منح التفرغ أو اتخاذ قرارات إقصائية دون سند قانوني. لكن هذه الآلية تبقى غير فعالة إذا لم يكن هناك وعي قانوني لدى المنتخبين، يتيح لهم الدفاع عن حقوقهم واستعمال القانون لمواجهة الشطط في استعمال السلطة.
وإلى جانب القضاء، يعدّ تعزيز ثقافة المساءلة داخل المؤسسات المنتخبة أمرا حاسما في التصدي لمثل هذه الممارسات. فلا يمكن السماح لرئيس مجلس بأن يتصرف وكأنه حاكم مطلق، دون أن يخضع لرقابة زملائه المنتخبين أو للرأي العام. وهنا تبرز أهمية تفعيل دور لجان المراقبة الداخلية، وتعزيز شفافية اتخاذ القرارات، وفتح المجال أمام النقاشات العمومية التي تكشف أي تجاوز أو استغلال للسلطة.
كما لا يمكن أيضا إغفال الدور الفاعل للمجتمع المدني والإعلام في فضح هذه التجاوزات، عبر تسليط الضوء على الاختلالات الإدارية داخل المؤسسات المنتخبة، مما يضع الرؤساء المتسلطين تحت الضغط، ويدفعهم إلى التراجع عن بعض الممارسات التي قد تثير الرأي العام ضدهم. فعندما يكون هناك وعي جماعي بضرورة احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية، يصبح من الصعب تمرير قرارات تعسفية دون محاسبة.
ومن هذا المنطلق، نشير إلى أن القانون التنظيمي 113.14 للجماعات المحلية وضع ضوابط واضحة لمنع التسلط الإداري داخل الجماعات، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في ضعف تطبيق هذه القوانين وعدم تفعيل آليات المساءلة بالشكل المطلوب. لذلك، فإن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب إذكاء الوعي القانوني لدى المنتخبين، إلى جانب ترافعات مدنية مستمرة وضغط إعلامي لضمان احترام مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية.
وعلى هذا الأساس لا يمكن بناء وإرساء قواعد ديمقراطية حقيقية إذا ظلت المؤسسات المنتخبة خاضعة لمنطق التحكم والإقصاء. فهي ليست ملكا للرؤساء، بل هي فضاءات يجب أن تضمن تعددية الآراء، والتداول على المسؤوليات، وخدمة المصلحة العامة. ولذلك، فإن مواجهة التسلط الإداري والشطط في استعمال السلطة داخل المجالس المنتخبة يعدّ ضرورة قانونية، ومعركة من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة، حتى لا تتحول هذه المجالس إلى أداة لإعادة إنتاج أنظمة الهيمنة في غطاء ديمقراطي مزيف.
(*) الكاتب الإقليمي للحزب بالحسيمة
عضو المجلس الوطني للحزب
الكاتب : سعيد الخطابي (*) - بتاريخ : 21/03/2025