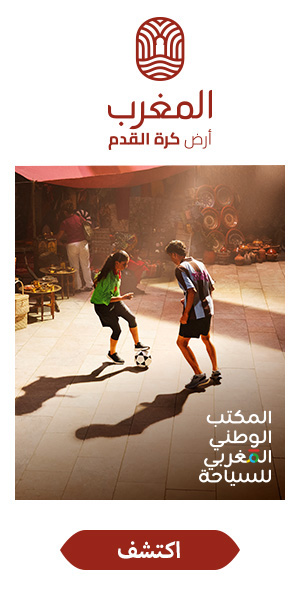المدرسة كمصنع لإنتاج الطاعة.. قراءة نقدية لدور المنظومة التربوية في إبعاد الشباب عن السياسة

الدكتور عبد الإله طلوع (*)
منذ نشأتها الحديثة، ظلت المدرسة أداة مركزية في تشكيل الأفراد وتوجيههم نحو ما يُسمى بـ»المواطن الصالح»، غير أن خلف هذا الشعار البراق، تستبطن المؤسسة التربوية وظيفة خفية تتجاوز حدود التعلم والتثقيف، لتتحول إلى جهاز أيديولوجي يُعيد إنتاج الخضوع والطاعة، ويُقوّض النزعة النقدية لدى الناشئة، خاصة في علاقتهم بالشأن السياسي.
إن المدرسة لا تشتغل فقط على مستوى المعرفة، بل أيضًا على مستوى تشكيل الوعي، ولا يكفي أن تُعلّم، بل تُطبع وتُهذّب وتُخضع، في تماهٍ مع منطق الدولة التي تتوخى ضبط المجال الرمزي، بدءًا من عقول الأطفال.
كما بين لويس ألتوسير، فإن المدرسة تمثل أحد «الأجهزة الأيديولوجية للدولة»، حيث يتم تمرير السلطة من خلال برامج تبدو محايدة، لكنها تُعيد إنتاج شروط استمرار النظام القائم.
فالبرامج والمقررات تُعيد قولبة التمثلات، وتُكرّس في المتعلم قيم الانضباط، التسليم، واحترام السلطة دون مساءلتها.
وبعيدًا عن التحليل النظري، يظهر هذا التوجه جليًا في المدرسة المغربية، حيث يتم تغييب التربية السياسية والمواطِنية، ويتم اختزال الشأن العام في دروس نظرية جامدة، تفقد بسرعة قيمتها التطبيقية، وتحول السياسة إلى كيان بعيد، مبهم، وخطير أحيانًا.
يتخرج آلاف التلاميذ سنويًا دون أن يمتلكوا الحد الأدنى من أدوات التفكير النقدي أو فهم النسق السياسي والمؤسساتي، بل يُرسَّخ لديهم تصور ضمني أن السياسة شأن المفسدين والانتهازيين، وأن الخلاص فردي لا جماعي، فلا تُعلّم المدرسة التلاميذ كيف يناقشون/ بل كيف يصمتون، لا كيف يُحلّلون/ بل كيف يُعيدون إنتاج نفس الإجابة، لا كيف يُبادرون،/بل كيف ينتظرون، بهذا المعنى، لا تعلّم المدرسة الطاعة فقط، بل تُجرّم كل انشغال نقدي، وتُشيطن الفعل السياسي عبر غرس ثقافة الخوف أو اللامبالاة.
وتُسهم في هذا التصور عوامل متعددة؛ من غياب فضاءات التعبير داخل المؤسسات التعليمية، إلى التعامل مع النقاش السياسي كتجاوز غير مرغوب فيه.
كما يُمنع التلميذ من طرح الأسئلة السياسية، ويُقابل ذلك إما بالصمت المطبق، أو التحذير من «الخوض في أمور أكبر من سنه».
وهكذا، تصبح المدرسة فضاءً يُشبه ساحة تدريب صامت، يتم فيه ترويض الناشئة على الطاعة بدل المبادرة، وعلى التلقي بدل الفعل، وعلى الحياد القسري بدل المشاركة.
ولا يختلف الأمر كثيرًا في الجامعة، التي تتحول بدورها إلى امتداد لمنطق التنميط ذاته فعوض أن تكون فضاءً للتعدد، تصبح الجامعة مجالًا لإنتاج التقنيين لا المواطنين، يُشجَّع فيه التخصص الضيق، وتُهمَّش فيه الفلسفة، والعلوم السياسية، والفكر النقدي. وتُقمع أحيانًا التنظيمات الطلابية باسم الحفاظ على «الاستقرار»، فتُغتال المبادرة السياسية في مهدها.
لكن، هل نحن أمام قدر محتوم؟ ألا يُمكن للمدرسة أن تتحول إلى فضاء للتحرر بدل الترويض؟ ما نحتاجه ليس فقط إصلاحًا للمناهج، بل إعادة صياغة فلسفة المدرسة ذاتها، فالمدرسة تُعلّم كيف نفكر/ لا ماذا نفكر، مدرسة تُحرّر / ولا تُدجّن، مدرسة تُدرّب التلميذ على الاختلاف، والتساؤل، والتجريب، والربط بين المعارف وواقعه الاجتماعي والسياسي.
انطلاقا من ما سبق فلا بد من إدماج التربية السياسية في مراحل مبكرة، لا كدروس نظرية بل كممارسات ميدانية، عبر محاكاة المجالس التمثيلية، وتنظيم المنتديات، وتشجيع النقاش العمومي داخل الفصول الدراسية، ولا بد أن يُكوّن الأستاذ تكوينًا عميقًا في علوم التربية، يضعه في موقع الميسر لا الحارس، المُحفّز لا الرقيب، فكل مشروع مجتمعي يُراهن على بناء وعي ديمقراطي دون تجديد المدرسة، هو مشروع مبتور.
إنه من العبث أن ننتظر من شباب تم تلقينهم لسنوات طويلة أن السياسة «لعبة قذرة»، أن يتحولوا فجأة إلى فاعلين ملتزمين ومواطنين مسؤولين.
إن من ينشأ على الطاعة لن يثور، ومن لم يُدرَّب على السؤال لن يصنع الجواب.
ولذلك، فإن المعركة من أجل تحرير السياسة تمر أولًا من تحرير المدرسة من عقدة الحياد، ومن منطق الضبط، ومن الخوف من المعنى.
(*)باحث في العلوم السياسية وقضايا الشباب
الكاتب : الدكتور عبد الإله طلوع (*) - بتاريخ : 23/05/2025