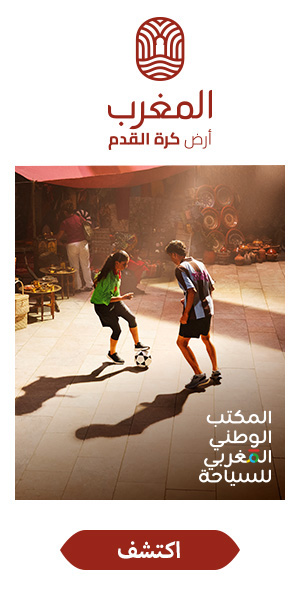من قنديل إلى تندوف: نهاية سرديات السلاح وبداية التحول السياسي

بقلم: د. كمال الهشومي(*)
حين خرج مظلوم عبدي، القائد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية، في 2023 ليصرّح أن «زمن الحروب الدائمة باسم الهوية انتهى، وأن الكرد بحاجة إلى شراكات جديدة وليس إلى جبهات جديدة»، لم يكن الأمر مجرد تصريح عابر. كانت تلك إشارة مبكرة إلى تحوّل فكري واستراتيجي داخل البنية العميقة لحركة كردية عانت لعقود من الحصار، والتجريم، والحروب بالوكالة.
وفي هذا الشهر (ماي 2025)، أعلن حزب العمال الكردستاني (PKK)، أحد أقدم التنظيمات المسلحة في الشرق الأوسط، عن مبادرة لحل نفسه، مُنهياً بذلك أكثر من 40 عامًا من الصراع الدموي مع الدولة التركية. إعلانٌ جاء بعد تآكل الحاضنة الشعبية، وانسداد الأفق الإقليمي، وتحوّل الدعم الدولي إلى ضغط دبلوماسي من أجل إقفال ملفات النزاع المفتوح.
لكن بعيدًا عن السياق التركي – الكردي، تطرح هذه الخطوة سؤالًا كبيرًا على ضفاف شمال إفريقيا:
هل حان الوقت لأن تعيد جبهة البوليساريو الانفصالية النظر في مسارها، وتُقدِم على مبادرة جريئة وشجاعة مشابهة، تُنهي بها نصف قرن من الجمود والانفصال عن واقع دولي ومغاربي تغير جذريًا؟
السياق المقارن: تشابه المسارات، اختلاف المصائر
تأسس PKKسنة 1978 بقيادة عبد الله أوجلان، على خلفية يسارية ماركسية، وأعلن الكفاح المسلح في 1984. وقد تحوّل إلى قوة رمزية للنضال الكردي في تركيا، لكنه تورّط في أعمال عنف وارتُكب باسمه تجاوزات، ما أدى إلى تصنيفه كتنظيم إرهابي لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. في المقابل، تأسست جبهة البوليساريو في سبعينيات القرن الماضي بدعم مباشر من النظام الجزائري، وتحت مظلة الحرب الباردة، وخاضت نزاعًا مسلحًا ضد المغرب حتى وقف إطلاق النار سنة 1991 برعاية أممية. ومنذ ذلك الحين، ظلت ترفض مقترح الحكم الذاتي، رغم أنه يمثل في عرف الدبلوماسية الدولية «حلاً سياسيًا واقعيًا وجدّيًا» (كما ورد في قرارات مجلس الأمن منذ 2007).لكن الفارق الجوهري هو أن حزب العمال، رغم ما ارتُكب باسمه، ظل يتحرك ضمن هامش نسبي من القرار الذاتي، بينما ظلت البوليساريو رهينة البنية العسكرية والسياسية الجزائرية، حيث تتحكم الأجهزة الأمنية في حركتها وتوجهاتها وحتى في قياداتها.
ويمكن الإشارة إلى التقاطعات بين حزب العمال الكردستاني والبوليساريو من جوانب عديدة أولها الطابع المسلح والانفصالي حيث أن كلا الطرفين تبنّى في بداياته الكفاح المسلح وسعى إلى الانفصال عن دولة قائمة: الكردي عن تركيا، والبوليساريو عن المغرب. كما اعتمد الطرفان على العمل العسكري كأداة للضغط السياسي، مع فترات من التفاوض والتراجع والعودة إلى السلاح. ثم ثانيا الاحتضان الإقليمي والدولي؛ حيث اعتمد حزب العمال الكردستاني على دعم سوري- إيراني في مراحل معينة، ثم على الولايات المتحدة الأمريكية في شمال سوريا. أما البوليساريو فهي تعتمد بشكل رئيسي على الدعم السياسي واللوجستي من الجزائر، وتستند إلى بعض المواقف المتعاطفة من أطراف محدودة في إفريقيا وأساسا جنوب إفريقيا وبعض الدول من أمريكية اللاتينية التي تحن إلى عهد الثورات والحركات التحررية الأصيلة والموروثة منذ عهود ولت وتجوزت ومنها من صحح الوضع وتراجع عن دعها والاعتراف بها.
أما بخصوص الإشكالات المطروحة فكل من التنظيمين يعاني من أزمات قيادة، تحولات جيلية، وتآكل الخطاب الإيديولوجي. ثم تزايد أصوات داخلية تنادي بإعادة تقييم المسار، خاصة بعد طول أمد النزاع وفشل الرهانات الانفصالية في تحقيق اختراقات حاسمة. كما يمكن الإشارة أيضا إلى الاختلافات البنيوية التي المتمثلة أساسا في درجة الاستقلالية في القرار؛ حيث إن PKK يمتلك هامشًا أكبر من الاستقلالية في اتخاذ القرار، رغم ارتباطه بالبيئة الإقليمية، ويبدو أن قراره الأخير نابع من تحليل استراتيجي داخلي.أما جبهة البوليساريو فهي تمثل ذراع وظيفية في الاستراتيجية الجزائرية الثابتة ضد المغرب، مما يجعل قرارها غير سيادي ومشروطًا بإرادة السلطة العسكرية والأمنية الجزائرية. ثم مسألة الاعتراف الدولي بالحل المقترح، فالقضية الكردية لا تزال غير محسومة على مستوى القانون الدولي، لكن الحلول التفاوضية بدأت تحظى بالقبول.أما في حالة الصحراء، فإن مقترح الحكم الذاتي المغربي يحظى بدعم دولي واسع، وهو ما يُعزز موقع المغرب ويدفع نحو التسوية في إطار الوحدة الترابية، مقابل ضعف أوراق ودفوعات البوليساريو. وصنيعتها الجزائر.
تحولات النظام الدولي ومآلات الحركات الانفصالية: من روجافا إلى العيون
بعد عقدٍ كامل من الفوضى الإقليمية الناتجة عما سُمي بـ»الربيع العربي»، وما تبعه من انهيارات في البُنى السيادية في عدد من الدول، تبلورت ملامح جديدة للنظام الدولي، لا تقوم على تشجيع تفكيك الدول أو دعم النزعات الانفصالية، بل على العكس، باتت الأولويات الجيوسياسية للقوى الكبرى ترتكز على دعم سيادة الدول المركزية وترسيخ استقرارها الداخلي، خصوصًا في وجه التهديدات العابرة للحدود: كالإرهاب، التجار في البشر، الهجرة غير النظامية، وتفشي الفوضى المسلحة.
في هذا السياق، تبرز تجربة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، المعروفة بـ»روجافا»، كنموذج حيّ على حدود الممكن والممنوع في النظام الدولي الجديد. فقد أُنشئ هذا الكيان بحكم الأمر الواقع في مناطق تمتدّ على أجزاء من الحسكة والرقة وحلب ودير الزور، بتركيبة سكانية متعددة الأعراق (كرد، عرب، سريان، آشوريون، تركمان، أرمن، شيشان ويزيديون)، وكانت تدار من قِبل قوات سوريا الديمقراطية بدعم أمريكي-غربي محدود، لكنها لم تحظَ بأي اعتراف دولي رسمي، ولا حتى من داعميها، وتم النظر إليها كحالة مؤقتة ضمن ترتيبات أمنية ظرفية. بل إن الموقف الأمريكي نفسه ظل حذرًا من ترسيخ نموذج يمكن أن يُفسّر كتشجيع للانفصال، خصوصًا في ظل رفض تركيا لهذا الكيان، واعتباره تهديدًا مباشرًا لوحدتها الترابية.
هذا التحول في المزاج الدولي انعكس بوضوح في تعاطي المجتمع الدولي مع قضية الصحراء المغربية. فالمجتمع الدولي – منذ 2007-لم يعد يتحدث عن «تقرير مصير تقليدي»، بل يدفع نحو حل سياسي واقعي، توافقي ومستدام، وهو ما مثّله مقترح الحكم الذاتي المغربي الذي وُصف في قرارات مجلس الأمن المتعاقبة بأنه «جدي وذي مصداقية».
بالتوازي مع هذا، تحولت الاستراتيجية المغربية من منطق الدفاع إلى الهجوم الدبلوماسي النشط، باعتماد منطق «التغيير» عوض «التدبير» حيث كثّف المغرب حضوره في المؤسسات الإقليمية والدولية، وباشر سياسة انفتاح استباقي على القارة الإفريقية، وأعاد تشكيل تحالفاته الأوروبية. وقد تُوّج هذا التحول باعتراف متزايد بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، من طرف دول كبرى مثل فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، إلى جانب دعم واسع من دول أوروبا الشرقية والبلقان، وموقف أمريكي حاسم تم التعبير عنه بشكل صريح في ديسمبر 2020، حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عهدته الأولى اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء، وهو الموقف الذي لم يتم التراجع عنه وتم التأكيد عليه في عهدته الثانية الحالية، وهو ما أكده كاتب الدولة في الخارجية الأمريكية في أبريل 2025، قبيل إحاطة المبعوث الأممي الخاص ستيفان ديمستورا أمام مجلس الأمن.
أما على مستوى الواقع الميداني، فقد فشلت جبهة البوليساريو في بناء نموذج مدني أو مؤسساتي بديل داخل المخيمات، وظلّت بنيتها تفتقر إلى الشرعية الديمقراطية، وتعاني من الانغلاق الإيديولوجي والعجز عن استيعاب تطلعات الأجيال الجديدة.في المقابل، شهدت الأقاليم الجنوبية المغربية طفرة غير مسبوقة في البنيات التحتية، والولوج إلى التعليم العالي، وجذب الاستثمار الوطني والدولي، بالإضافة إلى ترسيخ الجهوية المتقدمة كمقاربة تنموية وكحكامة واقعية. وهو ما أفضى إلى تغيير جوهري في معادلة الصراع؛من نزاع على السيادة إلى منافسة بين مشروعين؛ أحدهما قائم وفعّال، والآخر نظري ومجمد.
في ضوء كل ذلك، بات واضحًا أن الحركات الانفصالية التي لم تطوّر خطابها، ولم تواكب التحولات الدولية والإقليمية، محكوم عليها بالعزلة وفقدان المبادرة.وهو ما تعكس حقيقة وضعية جبهة البوليساريو اليوم في هذا الوضع بالضبط؛ بين خطاب متجاوز، وعزلة دبلوماسية، وجيل جديد لا يرى في «الجمهورية» سوى وعد مؤجل لا مستقبل له.
أصوات داخلية تنادي بالتغيير: حين تتكلم الهوامش بما يعجز عنه المركز
لم تعد الانشقاقات داخل جبهة البوليساريو ظواهر معزولة أو طارئة. بل أصبحت مؤشراً بنيويًا على أزمة التمثيلية والشرعية السياسية داخل القيادة التقليدية للجبهة الانفصالية، التي تستمر في تبني خطاب تجاوزته التحولات الإقليمية والدولية.
أبرز من جسّد هذا التحول كان مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام السابق لما يسمى بشرطة الجبهة، والذي أعلن، عقب زيارته إلى العيون سنة 2010، اقتناعه التام بمقترح الحكم الذاتي المغربي، معتبراً أنه «حل واقعي يُنهي معاناة الصحراويين ويجنبهم مزيدًا من التشتت واللجوء». لم تتسامح قيادة البوليساريو مع هذا الموقف، بل تم اعتقاله وتعذيبه ثم نفيه، في سلوك يُكذب كل ادعاءاتها بشأن الديمقراطية الداخلية وحرية التعبير.
لكن مصطفى سلمى لم يكن سوى نقطة في مسار متصاعد من النقد والانشقاق، حيث ظهرت منذ أوائل 2004 حركة «خط الشهيد»، كتيار معارض داخل الجبهة نفسها، يرفع راية «الشرعية التاريخية» ويطالب بتجديد القيادة، ووقف الفساد السياسي والمالي، والقبول بمقترحات التسوية الجادة، وعلى رأسها مقترح الحكم الذاتي.وقد نشرت هذه الحركة عدة بيانات لاذعة تتهم قيادة الجبهة بالارتهان الكامل للأجهزة الأمنية الجزائرية، وتغييب إرادة الصحراويين في المخيمات. بل في أحد بياناتها سنة 2017، وصفت قيادة الجبهة بأنها «سلطة مفروضة بالقوة، تحتكر القرار وتمنع أي نقاش جدي حول الحلول الممكنة».
وفي مقابلة أجريت في نواكشوط سنة 2022 مع أحد المنسقين السابقين في «خط الشهيد»، صرّح قائلاً:
«لقد تحوّلت الجبهة من حركة تحرير إلى جهاز بيروقراطي منفصل عن واقع الصحراويين… استمرار الحرب ليس خياراً وطنياً، بل أجندة مفروضة من فوق. الحل لن يأتي من تندوف، بل من الرباط.»
ما يلفت الانتباه في هذه التحولات أن النقد لم يعد يأتي من خصوم خارجيين، بل من مناضلين قدامى، شاركوا في الكفاح وفي بناء البنية التنظيمية للجبهة، ثم اكتشفوا زيف الشعارات وعبثية الاستمرار في حرب لا أفق لها. هذا ما يعطي تلك الانشقاقات قيمة رمزية عالية، ويجعلها مرشحة للتوسع، خصوصاً في ظل تراجع الدعم الخارجي وازدياد الشعور بالخذلان في أوساط الشباب الصحراوي بالمخيمات.
وتؤكد شهادات ميدانية نقلتها منظمات حقوقية دولية، مثل «هيومنرايتسووتش» و»مراسلون بلا حدود»، أن المخيمات تشهد تضييقًا على الحريات، ومراقبة لصيقة لكل الأصوات المنتقدة، بما في ذلك شباب من أبناء القيادات السابقة.هذه الديناميات تؤشر إلى أن البنية السياسية للجبهة الانفصالية تعاني من تصلب تاريخي، وتعجز عن مواكبة التحولات داخل مجتمع صحراوي بات أكثر وعيًا وتطلعًا لمستقبل خارج الجغرافيا المغلقة، وخارج الوصاية السياسية.
هل تملك الجبهة هامشًا للمبادرة؟
السؤال مشروع، والجواب معقّد بطبيعته. فبينما تملك بعض الحركات الانفصالية – كما في حالة حزب العمال الكردستاني – قدرًا من السيادة في اتخاذ القرار، تبقى جبهة البوليساريو محاصرة ضمن شبكة معقّدة من التوجيه والتحكم الجزائري، السياسي والعسكري والأمني. فالقرار الاستراتيجي للجبهة، خصوصًا ما يتعلق بمستقبل النزاع، لا يُصنع في الرابوني، بل في دوائر النفوذ العميقة بالجزائر العاصمة. هذه الحقيقة ليست مجرد تحليل سياسي، بل يثبتها المسار التفاوضي المعطّل منذ عقود، حيث لم تُبدِ البوليساريو أي استعداد لمقاربة حلول خارج الخط الأحمر الذي ترسمه الأجهزة الجزائرية.
فالجزائر – من منظور استراتيجي – لم تتخلّ يوماً عن استخدام النزاع في الصحراء كأداة جيواستراتيجية لإرباك الدور الإقليمي للمغرب، والتحكم في مخرجات توازن القوى بشمال إفريقيا والساحل. وهي لا تُخفي هذا التوظيف؛ من تصريحات الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة سنة 2001 أمام قمة هافانا، إلى المواقف المعلنة الأخيرة في مجلس السلم والأمن الإفريقي التي تُصرّ على إعادة طرح المسألة في المحافل الإقليمية رغم ميثاق الأمم المتحدة الذي يحصر الملف في يد مجلس الأمن.
لكن، هل هذا الارتهان المطلق إلى الخارج يُغلق الباب تمامًا أمام أي تحول داخلي في بنية الجبهة؟ الجواب التاريخي طبعا هو لا.
فلقد علمنا التاريخ، والتاريخ كما قال الفيلسوف الألماني فيخته هو «محكمة العقل الكوني»، أن السيرورات السياسية وإن عانت من البطء أو التزييف، لا تلبث أن تعود إلى منطقها الطبيعي. فـالحقيقة، والعدالة، والتطور، وإن تمت إعاقتها، لها منطقها الخاص الذي ينتصر في النهاية، مدفوعًا بتراكم الوعي الجمعي، وتحولات الجيل، وتقلبات الجغرافيا السياسية.ومن هذا المنطلق، فإن التحول لن يأتي من القمة المفروضة، بل من القاعدة الاجتماعية والرمزية للجبهة نفسها.إذا ما بدأ هذا التحول من الشتات الصحراوي، ومن كفاءات نشأت في الداخل المغربي، أو في أوربا، وراكمت تجربة مؤسساتية ومدنية حديثة، ورفضت البقاء رهينة لخطاب جامد لا يُفضي إلا إلى التكلس، فقد نشهد تصدّعًا متزايدًا في مركز القرار التقليدي للجبهة.
أكثر من ذلك، الحاضنة المدنية في مخيمات تندوف، التي تعيش منذ سنوات على وقع الإحباط، والتهميش، وغياب الأفق، مرشحة لأن تتحول إلى بيئة ضغط داخلي، تفرض على القيادة إما الانفتاح أو التفكك. خاصة وأن الجيل الجديد من الصحراويين لم يعد يرى في فكرة «التحرير المسلح» أفقًا قابلًا للتحقق، بل إرثًا عبئًا يؤجل الحياة ويؤبد اللجوء.
ولذلك، فإن إمكانية بروز بدائل تمثيلية جديدة، من خارج عباءة القيادة الانفصالية التاريخية، ليست ضربًا من الخيال، بل احتمالًا واقعيًا تعززه مؤشرات ملموسة: من تصاعد الحركات النقدية مثل «خط الشهيد»، إلى تنامي المبادرات الفردية التي تنادي بالحوار والانخراط في مقترح الحكم الذاتي المغربي، ضمن مشروع تنموي حقيقي.
التحول في نهاية المطاف ليس قرارًا فوقيًا فقط، بل صيرورة اجتماعية وفكرية تتغذى من التناقض بين الواقع والخطاب، وبين ما يُروَّج وما يُعاش.وفي حالة البوليساريو، فإن هذا التناقض بلغ أقصاه. وما تبقى هو الزمن، ككفيل موضوعي بتحريك عجلة التاريخ نحو المصالحة، الواقعية، والانتماء إلى مشروع وطني جامع لا يقصي أحدًا، ولا يبني على أوهام الماضي.
المصالحة ليست هزيمة… بل أعلى درجات الشجاعة السياسية
ما أقدمت عليه قيادة حزب العمال الكردستاني ليس هروبًا من الهزيمة، وليس خضوعًا أو استسلامًا كما قد يتصور البعض، بل هو فعل سياسي ناضج، دعوة إلى السلام بنَفَس جديد، وانخراط واعٍ في سُنن التاريخ الكبرى التي علمتنا أن كل حرب، مهما طالت، لا بد لها من مخرج سياسي شجاع.
إنها لحظة تحوّل من منطق البندقية إلى منطق المؤسسات، من الصراع على الأرض إلى الاستثمار في الإنسان، من الجغرافيا المغلقة إلى الفضاء المدني الرحب.
في هذا السياق، ما تحتاجه جبهة البوليساريو ليس التشبث بوهم «تقرير المصير الكلاسيكي» الذي تجاوزه الزمن، بل إعادة تعريف الذات الصحراوية كجزء فاعل من المشروع الوطني المغربي، في إطار حكم ذاتي موسّع، وتمثيل ديمقراطي حقيقي، وتنمية بشرية مستدامة، وانتماء سياسي لا يقصي أحدًا.
لقد أطلق المغرب في الأقاليم الصحراوية نموذجًا تنمويًا طموحًا، قائمًا على البنيات التحتية، والمشاريع الاستثمارية، والمشاركة المحلية، والعدالة المجالية. وهو ورش مفتوح لا يُقصي من يريد أن يكون جزءًا من الحل. بل إن هذا المشروع يشكل فرصة نادرة لتحقيق مصالحة تاريخية بين أبناء الوطن الواحد، بعيدًا عن الاستقطاب الإيديولوجي أو الحسابات الجيوسياسية الضيقة.
وإذا كان للتاريخ دروس لا تنضب، فإن من أبرزها أن الانفصال لا يصنع دولة، بل يصنع عزلة. وأن الانتماء لا يكون بالجغرافيا وحدها، بل بـــالقرار السياسي الشجاع، الذي يختار العقل بدل التعصب، المستقبل بدل الماضي، والمصالحة بدل القطيعة.
المصالحة ليست هزيمة، بل أسمى أشكال القوة الهادئة، حين تملك الجماعات الشجاعة الكافية لتغادر ماضيها بشرف، وتنخرط في الحاضر بذكاء، وتبني المستقبل دون عقدة أو إنكار.
وتلك هي بداية الدولة، وبداية المواطنة، وبداية التاريخ الحقيقي.
(*)أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال
جامعة محمد الخامس- الرباط
الكاتب : بقلم: د. كمال الهشومي(*) - بتاريخ : 17/05/2025