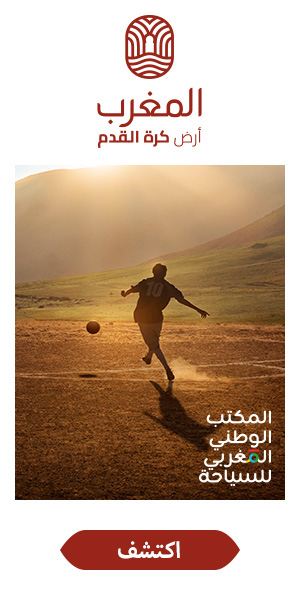بلاغ الأغلبية: حكومة في مغرب «حليبي»!

عبد الحميد جماهري hamidjmahri@yahoo.fr
تقديم لا علاقة له بما يليه:
الدولة التي نحلم بها هي دولة الحق والقانون.
ولا يمكن أن نتصور الحق بدون قانون، لأن القانون هو الذي يحمي السلامة وهو ضامنها. والأمن هو أولى الحقوق، بل أولى الحريات.
لم يكن الحق أبدا رديفا للتخريب. وأول ما يتعرض للتخريب مشروعية الاحتجاج نفسه.
ولا كان التعبير الحر صنوا للخراب.
لهذا يبقى العنف المشروع حقا ثابتا للدولة، محكوما بما يتم التوافق عليه بين مكونات الأمة.
نقول هذا حتى توضع الأمور في نصابها ويُفهم الموقف من الأغلبية فهما صائبا.
1 ـ في البياض الحكومي:
لست أدري من نصح أغلبية الحكومة بتلك المشهدية التي رافقت إصدار بلاغها، مشهدية تحيل على الاستجمام والبياض الرخو كما في فيلم «بيضاء الثلج»، أكثر منها إحالة على الجدية ودقة ما يقع وبعنف وحضوره.
الأبيض هو مجموع كل الألوان، الطيف السياسي في الفيزياء الحكومية. الأبيض لون الصمت، لون الفراغ. الأبيض أيضا يحيلنا إلى أن الحكومة توجد في «كوكب حليبي».
2 ـ في الخلط بين الأدوار والأوضاع
إذا كانت الأغلبية الحاكمة قد اختارت الصورة، بدون كثير من النجاح، فإنها لم تختر أيضا بنجاح الصوت الذي يناسب المرحلة.
لقد تعمدت خلط الأدوار: بين الحامل السياسي للمؤسسات (وهي هنا الأحزاب) والحامل المؤسساتي للسياسة (أي الجهاز التنفيذي). إنه خلط بين الأحزاب المشكلة للأغلبية وبين الحكومة.
ولعل الكثيرين يتساءلون عن هذا الخروج ومعناه:
هل هو تعويم لمؤسسة الحكومة في هلام الأغلبية؟
هل هو الجواب «التواصلي» على حساب المسؤولية الدستورية للجهاز؟
هل هو تعويم لرئيس الحكومة في جلباب رئيس الأغلبية؟
كل هذه الأسئلة وأجوبتها ممكنة.
ولعل الأهم أن رئيس الحكومة، الذي خرج قبل الاحتجاج بوضعه الاعتباري السياسي كشريك دستوري في القرار وفي تدبير جزء من مؤسسات الدولة، خروج الفاتحين الفرحانين، قد أضاع فرصة من ذهب في توطيد وضعه الاعتباري كرئيس حكومة له مؤسسته قائمة الذات، تم اختياره على أساس اقتراع سياسي وتجسيد للسيادة الشعبية. وهو مطالب بالتوجه إلى المواطنين المغاربة، ولا أحد يعوضه في دوره: لا أغلبيته وأحزابها، ولا أدواته التواصلية، بل ربما حتى حزبه نفسه.
3 ـ البلاغ وإخراجه:
البلاغ وما رافقه من إخراج، يعطينا الانطباع، حتى لا نقول اليقين، بأن الهم الأساس هو البحث عن توحيد كلمة الأغلبية، حتى لا يخرج أي أحد من هذا المأزق خاسرا وشركاؤه رابحين. كما يشي بأن «الحْفِير» المغربي كأنه تم تنشيطه، وهو ذلك المبدأ المعروف: «تتعشى بيه قبل ما يتعشى بيك».
لقد حُشرت الرؤوس المسيرة للحكومة: وزراء وقادة، وحضر اللقاء عدد من المسؤولين والقيادات السياسية من الأحزاب الثلاثة. كما لو أن المثل الشعبي: «دير راسك بين الريوس وعيط يا قطاع الريوس» هو الذي يتحكم في هذا «الاحتشاد» الكبير.
إذ يتضح من خلال النص أن الحكومة تعمل بهذا الشعار فعليا، من خلال تجاوز مطالب الاحتجاجات الشبابية نفسها. المحتجون رفعوا شعار الصحة والتعليم ومحاربة الفساد. والحكومة تقول: «ما شفتو والو، كاين مواصلة المد الإصلاحي الكبير في قطاعي الصحة والتعليم، علاوة على تعزيز الاستثمار العمومي والخاص بما يوفر فرص الشغل، دون إغفال البرامج المرتبطة بالسكن، وتمكين الشباب، ومواجهة الإجهاد المائي، وإصلاح منظومة العدالة».
وهي بلاغة لا تقف عند الأزل، بل تعني بأن قطاعي الصحة والتعليم (التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية) لا يمكنهما أن يدفعا الثمن لوحدهما، بل لا بد من ضم الأحزاب الأخرى. مثلا: الأصالة والمعاصرة من باب المسؤولية عن الشغل والسكن وتمكين الشباب وإصلاح منظومة العدالة، أو الاستقلال من خلال مشكلة الماء.
إنه بلاغ لإعلان الوحدة والتضامن الحكومي، لكي لا يدفع حزب واحد الثمن لوحده.
وقد كان الخروج البَعدي في اليوم الموالي لزعيمة البام، فاطمة الزهراء المنصوري، التي يبدو أنها أصرت على «التمييز» في بلاغها ووضع بعض المسافة عن خطاب التوحيد والتحرير. قالت إن الشبيبة لا تخيف، وإننا فشلنا في التسيير، ولا بأس من سقوط الحكومة كااااع.
4 – في الحوار المؤسساتي
وغير المؤسساتي:
دعا البلاغ إلى الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية. وإذا كنا نفهم كيف يُدار الحوار داخل المؤسسات، فإننا لا ندري كيف سيخاض في الفضاءات العمومية مع المحتجين.
بالنسبة للحوار المؤسساتي، لم تثبت الحكومة، التي تحملها الأغلبية، أي جدارة خاصة في تدبيره، بعدما استولت على كل الفضاءات المؤسساتية وأصبح فيها صوت واحد لا غير: هو صوت الأغلبية، إذ تم تفقير الحوار السياسي برمته.
بل يمكننا أن نتساءل، ومع الفاعلين كلهم: هل الأغلبية التي تملك أكثر من مريحة من المنتخبين والمسؤولين الترابيين، قد تابعناها في الحوار العمومي يوما؟ أبدا. في قضايا كانت محط تناحر مجتمعي حاد غابت كليا، بدون إنجاز.
وهذه محاكمة العجز من داخلها نفسها.
علاوة على أنه لا يمكن أن تتحدث في السياسة بعد قتلها. والغريب أننا نتابع كيف تحتضر السياسة في بلادنا بعد موتها.
وعليه، فإن الحديث عن الحوار المؤسساتي يطرح نقيضه: ألم يتم قتله؟ ألم يتم تكريس الاختلال المؤسساتي لفائدة آلات التصويت والاستعلاء والعجرفة (عندنا 5 ملايين صوت)؟
5 – في منطق التراكمات والإشكالات
المنظومة الصحية تعرف إشكالات متراكمة منذ عقود. لا رأي لنا بعد التشديد على ما تحقق في عهد محمد السادس، والذي كثيرا ما تنساه الحكومة نفسها (ما زلنا نذكر كيف أن ناطقا شابا قال لنا: بأن الحكومة ما لقات والو ملي جا السي عزيز).
كما أن الأغلبية تأسست على ادعاء مشروعية مزدوجة:
كفاءات تقنية: حوّلت أصحابها إلى «خبراء مقاولين»، حولوا الخبرة التقنية إلى سوق ورأسمال وصفقات، بدل الخبراء المناضلين الذين تفتخر بهم الأحزاب عادة.
الشرعية السياسية: لكنها لم تخرج إلا بعد أن أخرجتها «مجموعة سائلة»، من قبيل الجيل الغاضب نفسه.
ما زالت الأغلبية تتحدث بمنطق «السياسات العمومية التي ترتبط بالمديين المتوسط والطويل»، في الوقت الذي كانت وما زالت الحالة تستوجب الاستعجال والتفاعل في وقته بأفكار ندية تخاطب المعنيين.
المطلوب هو «الزلزال السياسي»، الذي يكشف نظام التدبير والحكم كما حدث في ملف الحسيمة.
الكاتب : عبد الحميد جماهري hamidjmahri@yahoo.fr - بتاريخ : 02/10/2025