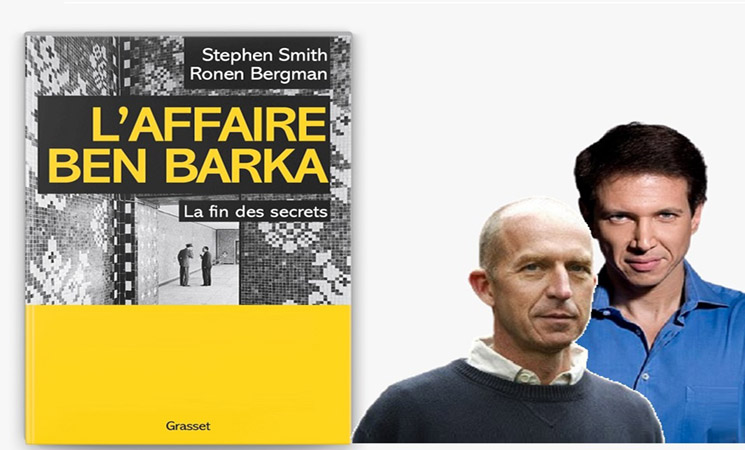في ديوانه الشعري الجديد Reniements يقدم الكاتب والشاعر والإعلامي سعيد عاهد تجربة شعرية متميزة على مستوى مسيرته الإبداعية، تجربة تحاور الإنكار والحنين، وقد كانت موضوعا لعدة أوراق نقدية بمدينة الجديدة التي شهدت مؤخرا حفل تقديم وتوقيع عمله الشعري الجديد.
يستدعي عاهد في هذا العمل آفاقا جمالية ولغة شعرية قوية تتقاطع وتبرز من خلالها الذاكرة الشعرية العالمية بفعل تأثر الشاعر بنصوص كبار الشعراء خاصة الشعر الفرنسي…
ولأن قاموس الشعر، حسب سعيد عاهد، كنز مهدد بالنفاد ، فإن الأعمال الشعرية للشاعر تبقى قليلة مقارنة باشتغاله على الترجمة التي أسس من خلالها مسارا متميزا …
في هذا الحوار، يفتح لنا المبدع سعيد عاهد نافذة مضيئة للحديث عن ديوانه الجديد والاقتراب من نفسه الشعري…النفس الذي لولاه لكان العالم الداخلي والخارجي نهرا من اليأس والملل حسب الشاعر.
– كيف تنظر لعملك الشعري الجديد ضمن سلسلة منشوراتك الشعرية الثلاثة السابقة والصادرة بالفرنسية؟
– يأتي هذا الديوان الصادر ضمن منشورات بيت الشعر في المغرب سنة 2024، بعد ثلاث تجارب سابقة هي «Un semblant de (dé)raison «، المنشور سنة 1994، و»Rien… ou presque»، 2001 و»Résidus d’un autoportrait»، 2015. وتلاحظين أن المسافة الزمنية الفاصلة بين تاريخ صدوره وتاريخ نشر الديوان السابق له جد طويلة، وظفتها لاختبار لغتي الشعرية ومساءلة بنية قصيدتي، والبحث عن أفق جمالي يتجاوز الآفاق المطروقة في الدواوين السابقة. وهو، في اعتقادي، لا يشكل قطيعة مع سابقيه ولا إنكارا لها، بل محاولة سبر مغايرة للذات الشعرية التي تسكنني، للنفَس الشعري الذي لولاه لكان العالم الداخلي والخارجي نهرا من اليأس والملل والرتابة القاتلة. وقد جربت ضمن قصائده تمرين مساءلة الذاكرة شعريا، ذاكرة الطفل الذي كنته، والفضاءات حيث تلقن الحياة، وبعض الشخوص الذين رافقوا مرحلة طفولته أو مراحل لاحقة، مثلما سعيت إلى إعمال بعض التأمل في قضايا الهوية والانتماء.
– ما هي مكانة الشعر في حياة الكاتب سعيد عاهد المهتم كثيرا بالترجمة والتاريخ المغربي: «الفتان بوحمارة: محكيات من سيرة الروگي بوحمارة لصحفيين وكتاب غربيين معاصرين له» و»الجريمة والعقاب في مغرب القرن 16» عى سبيل المثال؟
– علاقتي بالكتابة متعددة المسالك والخانات، أنتقل، كرحالة محترف، بين المقال الصحفي والنص الإبداعي والنقدي، مع حط الرحال كثيرا في حقل الترجمة، ترجمة المؤلفات التاريخية والسردية، وذلك باللغتين العربية والفرنسية. وإذا كان إنتاجي في جميع هذه المجالات يمتطي صهوة اللسانين معا، فإنه لا يتشيع في جنس الشعر إلا للغة موليير، هكذا، تلقائيا بدون سبق إصرار ولا تخطيط. صدفة ربما، لأنني بدأت كتابته وأنا صحفي في جريدة «ليبراسيون» الصادرة بالفرنسية، كمسعى للتحرر من لغة الصحافة وإكراهاتها. أجل، فمن المطلوب في لغة الصحفي، على مستوى صياغة الخبر والقصة الصحفية والتقرير، توظيف كلمات دقيقة المعنى لا تتيح مجالا للبس، ومصطلحات إجرائية وشفافة، وأوصاف محايدة على الأقل إن لم تكن موضوعية، مع الالتزام بالاقتضاب وإيلاء الأولوية للأهم على حساب ما يليه أهمية وعلى حساب ما هو في عداد التفاصيل (قاعدة الهرم المقلوب)، وكبح جماح المخيلة للاكتفاء برصد الحدث الواقع على أرض الواقع بدون زيادة، بل ربما بنقصان (ضغط الحيز المخصص للخبر المعالج بناء على تقدير أهميته وأولويته). بينما لغة الشعر تجيز للأديب ما لا يجوز للصحفي. تتيح له المتح من قاموس ملتبس الدلالة. تخليص الكلمات مما تدل عليه حصريا. عتق الجمل من أبوية سيبويه المتسلطة، وطهرانية الأكاديمية الفرنسية المستبدة، وكليانية مجاميع الألسن الحية والمنقرضة. منح المفردات عضوا جنسيا كما قال رولان بارت. مغازلة الكلام المكتوب ومداعبته حتى يتميز ويتفرد ويتسامى، متخلصا من قيود تداوله اليومي والصحفي، وسابحا في أمواج المخيلة المنفلتة من وقع واقع صاحبها المعيش.
-هل العمل الإعلامي والمسؤولية داخل الجريدة حررتك ككاتب وشاعر أساسا للاشتغال على مشروعك الإبداعي؟
– إحالتي على التقاعد الوظيفي (هل يتقاعد الصحفي فعلا؟) هي التي حررتني من مستلزمات احترام توقيت العمل، وإلزامية تحرير بعض المواد الإعلامية تحت الطلب والتنقل يوميا إلى مقر الجريدة. ما وفر لي الوقت الكافي لإنجاز ما أختاره وأريده شخصيا في مجالي الإبداع والترجمة. وقد ورثت من مرحلة كوفيد العصيبة، التي تلت تقاعدي مباشرة، سلوكا لم أعد أزيغ عنه: الجلوس أمام الحاسوب للكتابة أو القراءة أربع ساعات في اليوم على الأقل. صرت، بمعنى من المعاني، مستخدَما لدى نفسي، أنا العامل ورب العمل. ومع ذلك، أظل مقلا في كتابة الشعر ونشره، مقارنة منع إنتاجي في حقل الترجمة (كتابان على الأقل سنويا). أعتبر قاموس الشعر كنزا مهددا بالنفاد، لذا أحافظ عليها وأحفظها من التبذير والاستهلاك المجاني بدون ضرورة قصوى تفرض الاغتراف منها.
– هل ما يفكر به الناقد هو نفسه ما فكرت به كشاعر؟ أم أن النص بعد نشره يصبح نصا آخر لا علاقة له بالكاتب؟
– فعلا، وأنت تقدم على نشر نصوصك الشعرية تمنحها حياة أخرى منعتقة من ذاتك، تنقل ملكيتها إلى القارئ المفترض وتضعها بطواعية على طاولة التشريح الحر للنقاد والمهتمين بالمنجز الإبداعي. وبالنسبة لعملي الشعري الأخير، فالمقاربات النقدية لمتنه، التي أنجزت لحد الآن، كشفت لي عن مفاتيح لقراءته لم أخطط لها مسبقا، بل لم أستحضرها قبلا خلال كتابته. وعلى سبيل المثال، فالشاعر والمترجم نور الدين الزويتني قاربه من بوابة «بنية الإنكار والحنين»، التي هي، وفق قراءته النقدية، «بنية بالفعل، تتوزع قصائد الديوان وذات الشاعر في العمق، ولا أعني هنا الذات اليومية بل الذات الشاعرة التي تتحكم عن بعد في الذات اليومية حتى دون وعي من الشاعر نفسه.» وتجدر الإشارة إلى أنني أجدني عاجزا تماما عن ترجمة نصوصي الشعرية من الفرنسية إلى العربية، رغم كوني مترجما. لذا، فحين يُطلب مني مثلا قراءة نصوصي معربة في بعض التظاهرات الثقافية، أضطر إلى اللجوء إلى صديق من الأصدقاء لطلب خدمة الترجمة منه.