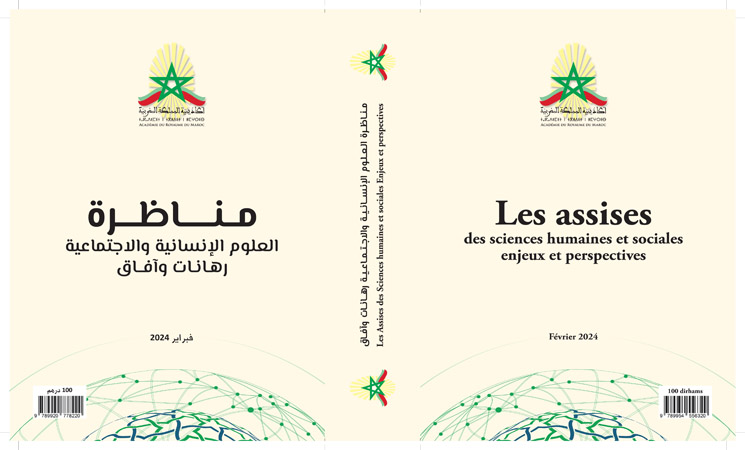التربية المركبة في دائرة الاجتماع العربي
«…هُناكَ حَيْثُ يَنْمو الخَطر يَنْمو أَيْضا ما يُنْقِذ…»
هولدرين
1 – التركيب بوصفه بلازما فكر إدغار موران
إذا كنا سنقرأ إدغار موران وفق جُذاذيات النسق النقدي المتداولة في اجتماعيات الفكر الانساني، أنذاك يمكن أن تنفلت منا تفاصيل كثيرة في توصيف ما يسمى ب «الأزمة الأخلاقية المعاصرة»…وحده موران، من يُعلمنا جرأة الإبحار خارج محيط اليقينيات، ويجعلنا نتنقل بشكل دائم بين الأنساق والتخوم، ونربط شظايا المعارف الانسانية من أجل كشف وهم الحقيقة. الدرس الموراني من حيث تشكله المعرفي حلقة مفتوحة على قضايا حساسة ترهن مستقبل البشرية، يشتبك مع الإبستمولوجيات (الدراسة الفلسفية للعلوم) ويقف عند الأنثروبولوجيا (الدراسات الانسانية)، وعبرهما، يدفع نحو تأسيس النقد الذاتي (الكتارسيس).
يتسلح الدرس الموراني بكفاية التركيب التي تخضع كل شيء للمساءلة الدائمة. بالنهاية درس يتأسس على شرطية اللاطمئنان، اللايقين، وعدم المهادنة مع الفكر الخاضع للإجماع البشري. هكذا، يحدث موران في كتابه المعنون بـ «المنهج» ثقبا كبيرا في وعاء الفكر الإنساني حينما يثور على الادعاءات الكلاسيكية التي تركن إلى منطق الاستسهال في تأسيس الأخلاق والتربية. ويستعيض عنها بالدعوة إلى تجديد مصادر الأخلاق في الحياة، والتسلح بالفكر المركب كمدخل للولوج إلى المستقبل.
يحذر موران من تداعيات المستقبل: مسلسل ارتكاسي منذور للأزمات، تفكك قوى اليسار، طغيان عقيدة الربح، إمكانية ظهور كوارث بيولوجية جديدة، تزايد مسلسل التدهور الإيكولوجي، وصعود متواصل للهويات المتقاتلة…
حسب موران، لا يمكننا أن نلج المستقبل من دون رؤية جماعية، من دون ميثاق سياسي جديد، من دون إعادة النظر في علاقتنا بالنظام العام للأشياء بالمعنى الأنثربولوجي. يقول موران: «…الأرض كوكب فضائي تدفعه ثلاثة محركات متآزرة: العلم، التقنية والاقتصاد، من غير أن يقودها ربان حكيم مقتدر…»
في كتابه الأخير «لنغير الطريق» الصادر عام 2020 يظهر موران كمفكر عابر للتخصصات ينطلق من التاريخ وينتهي بالأنثروبولوجيا وعلم النفس والبيولوجيا…ومن حيث المنهج، تتبدى جدلية الفكر المركب (التشابه والاختلاف)، ويظهر جليا الاحساس بعمق الذات، وبعمق الانتماء إلى الجماعة الانسانية. للأسف، نُظر إلى فكر موران صاحب كتاب «المنهج» نظرة إدانة، واتهم بعدم الكفاءة والاقتدار.
يفرض موران علينا التسلح بالمنهج الكلي الذي يقرأ منجزه على ضوء تاريخانيته وسياقه. يشتكي دوما موران في كل حواراته الأخيرة من سوء الفهم، الحاصل عند قراءة منجزه الأنثربولوجي الأصلي، وحتى المترجم. وسوء الفهم يستتبعه بالضرورة مشكل التعاطي مع عطائه في الاجتماع الإنساني. قارئ اليوم، واقع تحت سلطة الاستعجال في الحكم، وما يتبع ذلك من سوء هضم.
نحن هنا إزاء جُهد علمي يواكب فترات التحول الفكري الكبرى في الاجتماع الانساني. وعبر هذا الجهد العلمي يلتقي القارئ مع نصوص كثيفة المعنى، تتجنب الحشو، وتقتصد في التبيين، وتراهن على قارئ متسلح بتاريخ الأفكار، إن من وجهة نظر فلسفية، أو من وجهة نظر فلسفية. الحاصل، مثلما يطرح المفكر إدريس هاني «ثمة خيبة أمل إزاء الرصيد الفلسفي والأنثروبولوجي في ما يخص إعادة تأسيس العلوم على أساس العدالة التي تنسج تلاقحا بين المناهج واللغات…». تظل المشكلة دوما عند موران مشكلة منهج، المنهج الذي يسمح بالكشف عن المنطق الذي يفكر فيه الإنسان في ذاته وفي غيره. وحدها هذه الرؤية تدفع نحو التفكير في صياغة ميتودولوجيا محلية تنأى بنفسها عن منطق الثنائيات وإيديولوجيا القطائع.
2 – إبستيمولوجيا التركيب épistémologie de la complexité:
اشتهر موران بصفة رجل الفكر المركب pensée complexe والتركيب بالعبارة اللاتينية complexus عند موران يكاد يكون بلازما ناسجة لخلايا أفكاره في الفلسفة والأنثروبولوجيا والتربية…مفهوم مهيكل ومحوري ينسج مكونات لا متجانسة يصعب الفصل. التركيب الموراني هو في الأساس مفارقة الواحد والمتعدد في نفس الوقت…ونسيج من الأحداث والأفعال والتفاعلات والارتدادات والتحديدات والصدف التي تكوّن عالمنا الظاهراني. جِماع خليط مبهم من الفوضى والالتباس واللايقين…و»التربية المركّبة» التي يؤسس لها موران يجب أن تفهم بدلالة «أنثروبولوجية « تنزّل «الإنساني» في قلب رؤيتنا للعالم، بل في قلب أرض- وطن terre – patrie، في قلب مجتمع المستقبل.
تأتي أفكاره مشبعة بالتركيب complexité في شأن ذلك يبوح:»…لم أستطع أبدا طيلة حياتي الخضوع لمعرفة مجزأة، ولم أقدر أبدا على عزل موضوع بحث عن سياقه، عمّا سبقه، عن صيرورته. كنت أطمح دوما إلى فكر متعدّد الأبعاد. ولم أستطع أبدا حذف التناقض الداخلي. كنت أشعر دائما أن حقائق عميقة، مضادّة لبعضها البعض هي متكاملة لديّ مع كونها متضادّة. ولم أشأ أبدا تعسّفا اختزال اللايقين والالتباس. ومنذ أولى كتبي، جابهت التركيب، الذي أضحى القاسم المشترك بين أعمال كثيرة مختلفة بدت لكثير مشتّتة. غير أنّ كلمة تركيب لم تجل بخاطري، وقد كان لابدّ أن يحدث هذا حوالي نهاية سنوات 1960 …». يرافع موران عن ضرورة خلق فكر قادر على الوصل وهدم الكرونوزفيات اليقينية بدمج عنصر مفتاح هو «الحواري» le dialogique. وبذلك/ تنشأ «التربية المركّبة» بالذات، التي تعلمنا مسألة «الفهم « وخاصّة «الفهم بين البشر». ذلك انّه من مظاهر « أزمة التربية» في نظر «موران» بل أزمة « الحضارة» المعاصرة هو شيوع» اللافهم» الذي يغذي الحروب والدمار والتطرف. نصادف عند موران بشأن ذلك القول التالي: «…إنّ إصلاح المعرفة والفكر رهين إصلاح التربية، الذي هو رهين إصلاح المعرفة والفكر. إنّ إعادة إنشاء التربية رهين إعادة إنشاء الفهم الذي هو بدوره رهين إعادة إنشاء الإيروس، الذي هو رهين إعادة إنشاء العلاقات الإنسانية والتي هي رهينة إصلاح التربية..».. بهذا، «التربية المركّبة « عملية استنهاض شمولية تدرج ضمن تصور تركيبي يصل المعارف بالتعلمات، المعارف بالرغبات، الانفعالات بالسياقات…تنزيلا لهذه الرؤية، يحدد موران سبع معارف ضرورية لتربية مستقبلية:
عمى المعرفة: الخطأ والوهم؛
مبادئ المعرفة الدقيقة؛
تعليم الوضع الإنساني؛
تعليم الهويّة الترابية؛
مجابهة ضروب اللايقين؛
تعليم الفهم؛
إيتيقا الجنس البشري.
يلح موران دوما على ضرورة الاحتراس والتهيب في ترحيل المناهج والبرامج، ويدعو إلى وضع مسافة في التحليل في تحقيق الاستيعابية وتقويض مفارقة الغرابة. ليس المشكل أن نفكر بأدوات الغرب، بله المشكل أن نفكر بهواجسه وأحاسيسه. وتحقيق المسافة هو في حد ذاته ثورة على الذات قبل أن تكون عودة إلى الذات (مفهوم الغرابة- المعايشة…).
منهج موران يعمد إلى إعادة تفسير وربط المعارف المشتتة، وصياغة طريقة من اجل معالجة التشابكات، حيث كل جواب على مشكل مهم، يظل رهين ربط المعارف المشتتة، وتجزيئ المعارف يمنع من رؤية الروابط المتداخلة. معرفة الكائن البشري تفترض ربط العلوم الاجتماعية والبيولوجية وحتى الكوسومولوجية بما أننا نتكون من مادة فيزيائية. حسب موران، يتحدد جوهر الإنسان بثلاثة أبعاد مترابطة: النوع، المجتمع، والفرد.
3 – التربية في الاجتماع العربي: تساؤلات ومفارقات
في سياق الاجتماع العربي، لا يزال حديث التربية والتكوين حابلا بالأسئلة الحارقة، مُفجرا لأسئلة الولادة والصيرورة والمآل، راسما لأسئلة المدخلات والعمليات والمخرجات، بمقتضى الاستعارة التي يمكن أن نأخذها من شبكة تحليل النظم في حقل الاقتصاد…مثلما لا يزال في حاجة إلى توظيف مكثف لتقنيات السينما والتصوير من أجل ممارسة التشخيص وتوقع سيناريوهات التدخل: تقنية الاسترجاع (الفلاش باك)، تقنية الاستباق (فلاش فوروارد) وتقنية التناص (التعالق مع النصوص الكبرى)…منشأ هذا الاستحضار المنهجي كون الناس أحيانا لا يريدون سماع الحقيقة، لأنهم لا يريدون رؤية أوهامهم تتحطم…وهي الرؤية الهلامية التي غطت على كل تصوراتنا لقضايا التربية والتكوين. ألم يقل هيراقلطيس إن «…الحقيقة أهم من الأشخاص…»؟
في كل اللحظات الفارقة لا مفر من العودة إلى قضية التعليم، كادت ابروسيا أن تغور فتصبح نسيا منسيا على إثر هزيمة 1812، فأطلق فيلسوفها فيخته صرخته الشهيرة: «…فقدنا كل شيء، ولم يبق لنا إلا التربية…»، غارت اليابان في سباتها حين تهددها الغرب عام 1945، فأيقن حكامها ألا مندوحة من الأخذ بأسباب التحديث عن طريق التربية…والأمثلة لا تعد ولا تحصى لأمم راهنت على الثورة التربوية كشرطية للتغيير.
لم يستطع العقل العربي على مدار تاريخانيته التربوية أن يؤسس لفكر تربوي أصيل، عاكس للخصوصية، ومنفتح على انشغالات الكونية…بفكر جديد يتوسل بالنقد المتعدد الأبعاد، ويستعيض به عن الخطابات الحماسية، يُسائل اللحظات والمنعطفات الكبرى باستمرار دون مواربة…لم يقترب العقل العربي عبر تاريخانيته أيضا من المسألة التربوية فكرا ومنهجا، تنظيرا وتأصيلا، قطيعة وبناء، هدما وإعادة بناء…من شأن هذا الطرح أن يربط بين سؤال التربية في مشتملاته الكبرى بالمجال الاجتماعي الحاضن؛ بما هو مجال لإنتاج آليات السلطة والنفوذ بالتوصيف السياسي، ومجال لتوزيع الرموز بالمعنى السوسيو- أنثربولوجي، وتوزيع الفوائد والثروات بالتحديد الاقتصادي، ومجال لإنتاج التراتبات والتبادلات بالتدقيق السوسيولوجي…
ظل هذا الخطاب في عموميته، كما يدافع عن ذلك سوسيولوجي التربية مصطفى محسن، يجتر على نحو مكرر في أدبياته الكبرى، تمحوره حول مقاربتين:
– المقاربة البيداغوجية : التي تركز على قضايا التعليم والتعلم، وتنشغل بتدريسية المواد وإشكالية بناء الوضعيات الديداكتيكية وتقويمها…هذه المقاربة البيداغوجية رغم وجاهتها العملية وإجرائيتها الميدانية، إلا أنها مالت نحو الانزلاق المعيب، وصارت بيداغَجوية pédagogiste دون أن تُعنى بتطوير آليات التعليم والتعلم وبهاجس تجديد الأسئلة وتكيفها مع السياق العام الحامل للمعنى.
– المقاربة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية النقدية : وهي مقاربة عكست ضمن أدبياتها بؤس الخطاب وخيبة أمل زادت من تأزيم الواقع المدرسي…مقاربة نضحت بتراكم المشاكل وتعثر مشاريع الاصلاح وفقدان البوصلة الموجهة…بدورها انزلقت نحو مقاربة سياسية بوليميكية…إلى الحد الذي صرنا أمام طقوس الاصلاح le cérémonial des reformes كنعت يستعار من بيير بورديو، بقدر ما يتكرر، بقدر ما يفقد الاصلاح معناه ويغرقه في الابتذال(حسن أوريد، من أجل ثورة ثقافية بالمغرب، توسنا، الطبعة الأولى، 2018، ص 8).
الحديث عن أزمة المدرسة في عموم العالم العربي هو في الأصل تجن مبالغ عليها، وتغييب بقصد أو بدونه للإطار العام الحاضن للعلاقات والأنساق والرموز…بأي معنى يجب أن نفهم هذه الأزمة؟ حين نسحب مفهوم الأزمة على واقع المدرسة العربية فإننا نكون أمام مقاس غير دقيق، شفاف ومطاط؛ وغير ناظم لعناصر التحليل. الأزمة بالتوصيف التربوي قد تُحيل عند البعض إلى أن نسقا ما كان يشتغل بطريقة عادية، ووفق آليات محددة، ضمنت فاعلية ما في الزمن، وفجأة توقفت بفعل عامل ما أو عوامل، فحدث اضطراب قاد بالنهاية نحو حدوث أزمة…فهل يصدق هذا التحديد ههنا؟
الحق أن أصحاب هذا الرأي يميلون إلى القول بأن خطاب الأزمة خطاب محايث للمدرسة منذ النشأة…يجب انتقاد كل المنظورات التبسيطية والاختزالية التي ترمي إلى خنق الأزمة في جانب دون استدعاء باقي الجوانب الأخرى في الفهم والتفسير…يجب أن ننأى عن الخطاب الذي يروج عن قصد أو دونه اختزاليته للأزمة في جوانب لوجستيكية أو معرفية أو تكوينية…قد تكون هي الجزء، لكنها ليست الأزمة التي يراد الحديث عنها.
الحذر هو أن نعمد إلى اختزال خطاب الأزمة في جوانب تقنية ضيقة، فنكون بذلك أمام اختزال معيب، يؤدي وظيفة وغاية معينة للبعض، ويصرف النظر عن القضية الأساس. فمهما ارتقينا في التحليل، يظل التعليم شأنا اجتماعيا يخفي وراءه صراعا سياسيا بين مالكي وسائل الانتاج والإكراه، فإما تعليم يقود للتحرر وكسر القيود، وإما تعليم يقود نحو الاستعباد…والحال أننا أمام أزمة بنيوية نسقية، شمولية ومركبة، يتعلق الأمر بأزمة مجتمع بكامله، وليست أزمة قطاعية…أزمة الإنسان بألف لام التعريف، أزمة مجتمع لا يزال لم يستدمج بعد المشروع التربوي في رؤيته الاجتماعية الشاملة…أزمة منطلق المرتبطة بلحظة الاستقلالات القُطرية، وما حملت معه من شعارات وطنية وقومية حالمة، وعكسته من صراعات بين النخب وتضارب في برامج الحركات الوطنية، وإشكالية الانتقال من دولة الاستعمار إلى دولة الاستقلال…من هنا يمكن الحكم أن المدرسة التي نتكلم عنها هي مدرسة هجينة ولدت بإعاقة خلقية…ما راكم من عمق الأزمة أن المدرسة لم تستطع أن تواكب عنف التحولات الكبرى التي طرأت على المجتمع، فظلت سجينة تصورها الرومانسي، لصيقة بالمحافظة أكثر من التغيير…يحق للبعض أن يقول ما دامت الأزمة مركبة، فبالضرورة حلها مركب وغير مجزأ، هي في الأساس جزء من أزمة اجتماعية شمولية، وجزء من تعثر المشروع المجتمعي الشمولي.
راكمت الممارسة التربوية على امتداد العالم العربي من محيطه إلى خليجه العديد من تجارب الفشل، بعضها يعود إلى تشكل تقليد تربوي، يمتح من أن كل الخطابات والتوصيفات التي نعتمدها منطلقا للحكم على الخطاب والممارسة تعود إلى مراكز القرار والسلطة والنفوذ في العالم…صحيح أنها تقارير ذات بعد تشخيصي هام، لكنها تصدر من رؤية معينة، وتعكس في مطوياتها معايير خاصة…يمكن اعتمادها كأدوات إرشاد وتوجيه، وليس بالضرورة تشخيصات دقيقة…
ثمة حاجة إلى إنتاج خطاب تربوي محلي، يقف عند الأعطاب، ويصف الأدواء؛ مثلما ثمة حاجة ههنا إلى مغربة التوصيف، والنأي عن البرامج الاصلاحية المُملاة والمستوردة، من يتتبع مآلات برنامج التقويم الهيكلي خلال ثمانينيات القرن الماضي يصل إلى عمق هذه الفكرة؟
خطاب الأزمة في الأساس تشخيص مُبكر وتفكير في حل، الأول محلي، والثاني كوني. الدعوة ههنا موجهة إلى مراكز بحوث التنمية لبلورة مشاريع التدخل، للتفكير بعمق في بحوث حول المتابعة والتقويم…مشاريع الاصلاح ظلت في مجملها معاقة، غير عاكسة لنبض وتحولات مجتمع المعرفة لاعتبارات سياسية معروفة…كشف نظام العولمة هشاشة الأنظمة التربوية العربية، وأزال حجاب الهيبة عما تبقى من وقار مستور، مثلما فرضت العولمة والنظام العالمي الجديد معايير جديدة، لم تستطع المدرسة أن تنتجها.
وحتى إذا ما أردنا أن نتحدث عن مسألة النجاح أو الإنجاح على الأصح، أوَ لا يستضمر في النهاية حقيقة الإخفاق التربوي؟ أوَ لا يحمل في ذاته بذور الإخفاق السياسي والمجتمعي؟ أوَ ليس هروبا من مواجهة الحقيقة ومداراة للهزيمة الجمعية؟ فكم من نجاح هو في الأصل فشل، وكم من فشل تحول إلى نجاح…الأرقام بالنهاية لا تغير الواقع، ولا تحجب حجم الانحدار. ألم يسبق لإدغار موران أن قال في كتابه Au péril des idées …» تظل الكراسي ممتلئة وهي فارغة…»، كما يظل النجاح بلا أفق، أقصد هنا التوجيه، التوجيه الاستثماري وليس التوجيه المبني على بيداغوجيا التربية على الاختيار…حيث الكل يبحث عن الخروج من النفق، من المحرقة، ولا أحد ينتبه إلى الاختلاف. في اللحظة التي تستعر فيها جذوة الأسئلة الحارقة، يصير التفكير في أزمة المعنى الإنساني الموسوم بالتطرف والانغلاق، أوَ ليس انغلاق المعرفة يقود بالضرورة نحو انغلاق الواقع مثلما يقول إدغار موران.
ثمة حاجة راهنة إلى تجذير خطاب الأزمة، إلى اعتبار أزمة المدرسة هي في الأصل أزمة غياب فلسفة اجتماعية موجهة للمجتمع المغربي، فلسفة لها منظور واضح لطبيعة الإنسان والفرد والمواطن، فلسفة قادرة على طرح سؤال الأولويات، هل نريد تكوين قوى بشرية للسوق؟ ضمن أي رؤية اقتصادية؟ هل نريد تكوين مواطن بمواصفات سوسيو- سياسية كونية؟ ضمن أي رؤية حضارية؟
لنتأمل مفهوم الانسان في علاقته بالمدرسة. ظلت الوثائق الموجهة للفعل التربوي تنتج أفكارا على قدر كبير من الأهمية، لكنها نظريات مأخوذة من خطابات تربوية شائعة…نتحدث عن أفكار هلامية، ضبابية، غير واضحة وعامة…الخلاصة استطاع العالم الثالث أن ينتج أروع الوثائق التربوية، وأروع الدساتير السياسية، لكنه لم ينتج لا تنمية ولا حداثة ولا ديموقراطية…هذه الفكرة هي التي توصل إليها الأستاذ جميل السالمي في كتاب يحمل عنوان: Le Maroc: Planification sans développement
مفهوم الإنسان ضاع في ثنايا غياب الارادة السياسية للفاعل السياسي وصراعات النخب حول المنافع والتموضعات السياسية…فتوسعت القطيعة بين المدرسة والمجتمع، وصار النظام التربوي يشتغل في فراغ عن المجتمع، وفي غياب الروابط بينهما…مثلما فشلت المدارس الموازية les écoles parelles في كسب رهان تخليق الحياة العامة، وتبئير قيم الحداثة والديموقراطية…فصرنا أمام مناهج دراسية جافة غير مواكبة لنبض مجتمع المعرفة، كما صارت المدرسة والجامعة مؤسستين منتجتين للإقصاء الاجتماعي…بدوره الحقل الثقافي تغذت أعطابه من أزمة المدرسة، والمدرسة تتغذى من هيمنة الآليات الاجتماعية الشائعة مثل الرشوة والفساد والمحسوبية والزبونية…
جنوح العولمة نحو الرقمنة بلور بشكل جلي الهوة التربوية، بين من يملك وسائط التشبيك المعلوماتي، وبين من ينحصر في عتاده المألوف…جائحة كورونا عرت عن هذا الواقع، وطرحت بقوة سؤال العدالة الرقمية والانصاف المعلوماتي…لم تعد مدرسة اليوم قادرة على أن تكون مدرسة الفرح école de joie، صارت تتبدى كمدرسة معزولة، منفرة، طاردة، راسمة للإقصاء، بين من كُتب عليهم أن يبقوا تحت، ومن قدر لهم أن يلعبوا أدوار النخب…
يجنح البعض إلى القول بموت المدرسة زمن السوشيال الميديا، في جانب منه حقيقة، وفي جانب آخر مجانب للصواب، بل فقط يمكن الحديث عن تراجع المكانة الرمزية…الموت هنا التشييع، والتشييع موقف عدمي لا ينبئ بفجوة أمل. والحال أننا لم نوفق فقط في أن نجعل مشروعنا التربوي نواة صلبة للمشروع المجتمعي؛ كما لم ننجح في أن نحول المشروع التربوي مُوجها للمشروع المجتمعي…
4 – التربية المركبة: انتظارات مؤجلة
لربما لا يزال التاريخ يمنحنا شرف المناورة والتجريب، لكن في إطار زمني ضيق ومحدود…الثورات الكبرى التي رَحُبَت بها المنطقة العربية في الأساس ثورة من أجل المدرسة وللمدرسة، وإن لم تصدح بها الحناجر كفاية…المدرسة البستانية التي تسقي الجميع بلا إقصاء، المدرسة التي توحد الأكابر والأصاغر في فضاء واحد…فإذا لم نستطع أن نحقق أي تحول ديموقراطي فاعل ومنتج وفق شروطنا الذاتية، فلأننا صرفنا النظر عن سياستنا التربوية…عن السياسة التربوية التي كان بإمكانها أن تنتج إنسانا جديدا، بفكر جديد، ومجتمع جديد لمستقبل جديد…نحن في حاجة إلى رؤية جماعية، طموح جماعي متوافق عليه…لا ضير أن نضل، لا ضير أن نخطئ، لكن علينا أن نوقف هذا الانحدار، علينا أن ننقذ كتيبة الخراب العربية من موت سريري مرتقب…علينا كما يقول محمد شفيق «…أن نسعى إلى بناء الانسان، والإنسان لا يمكنه أن يبني حضارات ما لم يسع جادا لبناء نفسه بنفسه. والبناء بناء الإنسان خاصة عملية شاقة طويلة لا تفيد في القيام بها الحَماسات العابرة، ولا الاعتداد بالنفس، وإن كان يريد أن يظهر بمظهر الثقة بالنفس، ألا يمكن أن ننظر في الطرائق التي صنع بها غيرنا ذلك الجبار القوي الغاشم الظالم نفسه منذ ما يقرب من مائتي سنة، قبل أن ننظر في الوسائل التي شيد بها المصانع والمنشآت الضخمة، واخترع بها العتاد الحربي هناك؟ ألا يمكننا أن ننظر إلى ذلك في برودة، في غير انبهار ولا انزعاج، متوخين من الموجبات، ناقدين السالبات لا من وجهة نظر المقدس للماضي، لكن من وجهة نظر المستفسر للمستقبل.
مراجع:
شفيق محمد، من أجل مغارب مغاربية بالأولوية، إصدارات مركز طارق بن زياد، سنة 2000، ص 229-230.
موران إدغار، تربية المستقبل: المعارف السبع الضرورية لتربية المستقبل، ترجمة محمد منير الحجوجي وعزيز لزرق، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2006.
موران إدغار، ثقافة أوروبا وبربريتها، ترجمة محمد الهلالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 2011.
موران إدغار، الفكر والمستقبل: مدخل إلى الفكر المركب، ترجمة أحمد القصوار ومنير الحجوجي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء.