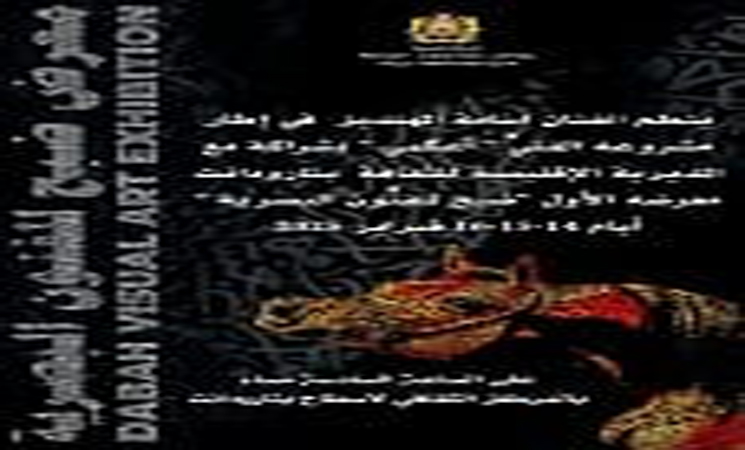ما يميز أفلام سليمان، الذي لمع نجمه عالمياً قبل أن يبرز فلسطينياً وعربياً، أنها تدور في قوالب الكوميديا السوداء، التي تحمل في أعماقها الألم لكنها في الوقت ذاته تسعى إلى بث الأمل.
«انطلاقاتنا يجب أن يكون فيها شعرنا مع السينما التي تتأثر بالشعر لكي نبقي على الأمل ومكان رحب نعيش فيه»، هكذا يقول سليمان. مضيفاً «السلطة تصر على أن تنظر إلى الساعة وهي تمشي إلى الأمام لكن إذا أصريت أن تتطلع إلى الزمن الأفقي وتعيش حالة من المتعة والحلم، فهذه هي الحالة التي أوصلتني إلى أن أعمل في السينما».
هكذا إذاً، من الكادر القاتم والمعتم لأحوال الفلسطينيين يُحيك سليمان الأمل الذي يتمسّك به على رغم الخيبات والخسارات التي امتدت أكثر من 60 عاماً.الأسئلة الوجوديةحملت أفلامه نقداً لاذعاً وتصويراً لمعظم تفاصيل الناس، ما يشير إلى أن السينما بالنسبة لسليمان أصبحت مكاناً للبحث عن الذات وفضاءً يطلق فيه أسئلته الوجودية التي تدور حول زمانه ومكانه، وهذا ما سمح لأفلامه أن تشق طريقها نحو منصات التتويج في معظم المهرجانات الدولية.
وبحسب النقاد أحدث سليمان نقلة نوعية في السينما العربية من خلال اتباعه أسلوباً ولغة سينمائية جديدين ابتعد فيهما عن لغة الخطابة واللهجة الثورية في سرد القضية الفلسطينية.
لم يكن حضور سليمان السينمائي عابراً، وإنما أثار الجدل في العالم العرب، كونه يقدم «القضية الفلسطينية» بما في من جراح وآلام بقالب كوميدي من خلال أسلوبه الخاص، فيما اعتبر هو السينما حيّزه الخاص لولادة الأمل الذي يعول عليه لتغيير الوضع السائد.
عزا النقاد تشكيل أسلوب سليمان الخاص من طريقة عيشه وتنقله بين عوالم المنفى، فهو الذي تنقل بين مدينته الأم الناصرة، ولندن، وفرنسا، ونيويورك التي كانت له ملجأ من جحيم الاحتلال وعاش فيها أكثر من 14 عاماً، وكان لها تأثيراً كبيراً في بلورة رؤيته السينمائية، وعمق فيها قراءاته في الفلسفة والسينما والأدب، كما أسهمت المدينة في تأثره بمخرجين عالميين.
وعلى رغم أنه واقعي، ويعي جيداً أنه لا يمكن اختصار الألم الفلسطيني الذي يمتد لأكثر من 60 عاماً، إلا أن ثلاثيته التي بدأها في «سجل اختفاء» (1996) وتبعها في «يد إلهية»، الحائز جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي (2002)، ثم «الزمن الباقي» (2009)؛ حاولت أن توجز هذه المرحلة، وأن تنطق بأمل الإنسان الفلسطيني رغم اتساع مساحة الصمت في أغلبية مشاهد أفلامه التي ترصد يوميات المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال.في 1996 أخرج إيليا سليمان «سجل اختفاء»، الذي شكل باكورة أفلامه الروائية الطويلة، وفي 2002 أثار فيلمه «يد إلهية»، جدلاً واسعاً، بعد رفض ترشيحه لجائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي، لكن الفيلم حصد ثلاث جوائز. اثنتان في مهرجان كان السينمائي، وواحدة في روما. وشاركت في إنتاج الفيلم أربعة دول، هي، ألمانيا، وفلسطين، والمغرب، وفرنسا.وفي 2009 رشح فيلمه «الزمن الباقي سيرة الغائب الحاضر» لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي. وهو عبارة عن سيرة ذاتية، يشارك إيليا بدوره فيها، قصة الحياة اليومية لأسرة فلسطينية منذ عام 1948، حتى اليوم، وهموم أجيال من الفلسطينيين، وفيه الكثير من الأغنيات والكثير من الصمت.
وفي أجندته السينمائية، محاولة أولى عام 1990، حين أخرج فيلمه الأول «مقدمة لنهاية جدال»، الحائز جائزة أفضل فيلم تجريبي في مهرجان أطلنطا السينمائي في العام ذاته.
المواربة الشعرية حد الاختفاء
ربما لا يمكن سؤال المخرج الفلسطيني ايليا سليمان عن سر اختفائه – سينمائياً – إذ اكتفى حتى اللحظة بإخراج ثلاثة أفلام روائية طويلة ( سجل اختفاء 1996 ) – ( يد إلهية 2002 ) – ( الزمن الباقي 2009).
كما أنه ليس سهلاً المرور من أمام موهبته الكبيرة دون ملاحظة مثل هذا الغياب بشيء من اللوم لتأخره في انجاز مشاريع أفلامه الأخرى، الأفلام التي لا تأتي بالطبع على حساب النوع الذي يعرف كيف يتحسسه ويشمه إن جاز التعبير، وبخاصة أن سليمان قد حجز لنفسه مكانة مرموقة في عالم الفن السابع من خلال هذه الأفلام دون أن يحتاج لترويسات أخرى من عوالم غير عوالم السينما.
لقد ظل ايليا سليمان مخلصاً لموهبته، ومخلصاً للسينما دون تقديم ادعاءات في هذا الصدد، وان كانت السينما تفتقده، ويفتقده عشاقها.
ماذا لدينا في
«الزمن الباقي»؟
الفيلم هو زمن فلسطيني بامتياز. ويمكن اعتبار الزمن الغائب فيه هو سلاح السخرية من الذات أولاً ما يعني أنه زمن مركب، فيه انشداد نحو السلاح الذي يلجأ إليه المخرج الفلسطيني ايليا سليمان من زوايا « المواربة الشعرية المهملة». ربما تكون زوايا بسيطة وعادية ولاتدّعي التعقيد في آلية سردها، وهنا تتجلى الصعوبة في الإمساك بأطرافها. فالدخول سينمائياً من هذه الزوايا التي لاشقوق فيها، أصعب بكثير على «المعلم» من الزوايا الصارمة والمقطعة بشكل هندسي حاد التقاطيع.
السائق الإسرائيلي يضع في سيارته حقيبة المسافر القادم إلى مطار اللد، وهو سيشعل محركها في اللحظة التي ستهب فيها عاصفة مطرية هوجاء. عاصفة لم تتحدث عنها التوراة كما سيخبر السائق، وهذا ما يدفعه للخوض في «ملاسنة « لغوية مع نفسه هي أقرب إلى الهذر منها إلى اللغة المفهومة، وهي تأخذ منحى هذيانياً مفروضاً عليه بقوة السيناريو تجعل منه غريباً بالكامل عن أرض ليست هي أرضه في نهاية المطاف. أرض لايعرف من أسرارها شيئاً. حتى العاصفة المطرية الشديدة تبدو وكأنها غريبة عليه، وأن من يحركها في الواقع ليس إلا «شبح» ايليا سليمان المتكوم في المقعد الخلفي من السيارة. وهو هنا يظل على ملامحه الشبحية الخارجة من البعد البؤري للعدسة السينمائية دون اكتراث بالمزاعم التوراتية التي تدفع السائق إلى التكلم مع صاحب له عبر جهاز الراديو بمايشبه الهلوسة، وافتراض أنه كائن فضائي يفرض عليه الشبح الأرضي قوانين اللعبة دون أن ينبس ببنت شفة. وكأنه يريد الاتكاء على ذاكرته الشخصية، وربما ذاكرة أبيه ليقول رواية الحاضر الغائب مجتمعة فيه. ينجح الشبح بدفع السائق ليتوقف بذريعة العاصفة دون أن يطلب إليه ذلك. والسائق يلتزم جانب الطريق، ليس لأنه ضلّ طريقه، بل لأن التوراة نفسها لم تحسم أمرها، وبالتالي يصبح خط سير الرحلة أمراً مشكوكاً فيه، ما عليه إذاً سوى الاستسلام للذة النوم كما سنرى في المشهد الأخير، لأن الفلسطيني هنا هو من سيتحكم بالأحداث، فلا يعود طارئاً عليها. هو من سيبدأ الرحلة وينهيها، وما على السائق سوى الاستسلام للشبح وهو يجيء على روايته مفصلة عبر تواريخ محددة.
في اللحظات التي تلي العاصفة، سوف يذهب ايليا سليمان إلى مشاغله مع الزمن بمستوياته المتعددة، ويبدأ حكايته حين تهاجم العصابات الصهيونية بلدة فؤاد سليمان عام 1948، وسيكون على الأب أن يعيد من جديد صوغ الرواية كلها من وجهة نظر الحاضر الغائب. الابن الذي يورط أباه في الأحداث، سيفرض عليه أن يحاول إنقاذ جريح مع قريب له. هذا الحدث سيغير من حياة الأب فؤاد، إذ سيلقى القبض عليه، وسيقوم أحد العملاء الملثمين بالتدليل عليه بوصفه مقاوماً وصانع أسلحة في ورشة خاصة به. الأب والأم والأخت سيغادرون إلى عمان، وسيلقى بفؤاد من فوق جدار عال بالقرب من كرم الزيتون. لكننا سنشاهده عبر قطع في الأحداث وقد تزوج، وأنجب الولد الذي سيكون عليه أن يتعلم في مدرسة إسرائيلية وينشد النشيد الإسرائيلي ويشتم أميركا الامبريالية في آن معاً.
لا يستعير ايليا ذاكرته الساخرة من غبطة العائلة التي كوَّنها الأب فؤاد في غفلة عن قوانين الاحتلال وقد بقي له من بعد فعلته الجلوس في المقهى نفسه مع الصحاب، والسجائر ذاتها، ومرض الرئتين، وفحص الضغط يومياً بانتظام، وبالطبع هواية صيد السمك والاستماع إلى شتائم جاره السكير الذي يهدد على الدوام بحرق نفسه، وهما هوايتان توغلان في كشف جهل الآخر بالأرض التي يقيم عليها، فإغارة الدورية الإسرائيلية ثلاث مرات على الشاطئ نفسه وسؤال أفرادها عن «هويات» الصيادين الصديقين (فؤاد وشبيه أبيه)، وعما إذا لم يكن هناك في الناصرة بحر لممارستهما هذه الهواية، أو سحر الهواية الذي يعصف بالزمن الزنخ وهو يفشل في الإطباق على المكان الذي يقيمان فيه، إذ يظهر الفلسطيني هنا متحكماً به من خلال سخرية مرة لا يطيقها الإسرائيلي. فهاهو الشاب الذي يتكلم بالهاتف النقال يراوغ سبطانة مدفع دبابة إسرائيلية ترصده في كل حركة من حركاته، حتى يكاد يتحول الأمر إلى لعبة، فما إن يتوقف الشاب متعمداً حتى يتوقف المدفع معه، فيما هو لا يفعل شيئاً أكثر من إلقاء كيس قمامة في الحاوية القريبة من بيته. بالمقابل سوف يترتب على الفلسطيني الذي يقصد باحة المدرسة وقد تحولت إلى معتقل إداري فيه أسرى فلسطينيون مدنيون أن يقف بطريقة ممسرحة ويعيد قراءة نشيد عبد الرحيم محمود. يذكرنا بـ «سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى / فإما حياة تسرّ الصديق وإما ممات يغيظ العدا» قبل أن يطلق النار على رأسه بطريقة فيها الكثير من القدرة على إغاظة الأعداء في مشهد مركب فيه الكثير من التأويلات النقدية لواقع أدبي بحاجة إلى إعادة فك وتركيب قد لاتستهوي الغرباء أبداً.
لن يتوقف ايليا سليمان في سرده سيرة الحاضر الغائب عند حدود التعليم، فهو لا يقصده في فيلمه، وهو لا يريد أن يعلم أحداً أية أشياء تتعلق بالزمن أو الموروث الفلسطيني. فهنا الملل يطال أيضاً الصحاب الثلاثة، وهم قاعدون في مقهى يراقبون هذه الأشياء في تحولاتها الكبرى. فمن جندي جيش الإنقاذ في متاهته، إلى الشاب الذي يمتهن الصفير في غدوه ورواحه من أمامهم، حتى يجيء اليوم الذي ينسى فيه أن يقوم بفعله هذا، ما يدعوهم لسؤاله عن « إشاراته»، فيفاجئهم بصفيره موسيقى انيو ميركوني من أحد أكثر أفلام سيرجيو ليوني شهرة في عالم السباغيتي ويسترن، وهي إشارات كثيرة تحمل أكثر من تفسير. ربما بعضها مرده إلى شغف ايليا سليمان كما هو واضح بالسينما الأميركية كضامن لإيقاع فيلمه. فحتى اختياره لصالح البكري (الأب فؤاد) يكشف عن ولع خفي ببعض إرث هذه السينما. ففؤاد يحمل في قسمات وجهه تعبيرات بول نيومان وجيمس دين في تسريحة شعره، وبعض ملامح روبرت ريدفورد في (شبابهم)، فيما يذكر دخول ايليا سليمان ليلعب دوره في الفيلم بأسلوب باستر كيتن، الكوميدي المتفجع بالعالم على طريقته، ربما على مصيره الشخصي، وربما على مصائر الآخرين الهالكين لامحالة. لكن مايلفت في الأداء هو ضياع بوصلة الاتجاه الذي يحدد سلوك البطل، وهذا أكثر مما هو متوقع، فباستر كيتن كوميدي من نوع خاص، كان يفتت الواقع من حوله ويرده إلى صرامة في التقاطيع وحدة في درجة الالتباس التي كان يثيرها في أفلامه خلال عشرينيات القرن الماضي.
هنا يستعير ايليا سليمان بداهة الأسلوب، ويلجأ إلى صرامة موازية في الأداء بأكثر مما هو متوقع في كادرات هندسية متقنة أقل ما فيها أنها تكشف عن أبعاد عاطفية للأرواح المستخدمة في الفيلم. فالغناء يهيمن فيه، حتى الغراموفون الذي يسرقه الأعداء لايقدم لهم سوى أغنية «أنا قلبي دليلي» لليلى مراد. هم يسرقون كل شيء من حول الحاضر الغائب، فيما يقوم الشبح، وفي الخلف دائما بتعزيز خطوط روايته الرئيسية الساخرة إلى حد أن الضحية يمكنها أن تقيم احتفالاتها بطريقتها دون أن يردعها مكبر الصوت معلناً ضرورة التزام البيوت بسبب حظر التجوال، ويمكنها بالطبع أن تقتاد الجلاد الذي لا يعرف طريقه. ووحده سليمان صاحب الرواية الأكثر جدلاً في السينما الفلسطينية الجديدة يعرف كيف يتجاوز الجدار باستخدام زانة القفز العالي في مشهد رفيع سيقيم في الذاكرة السينمائية العالمية طويلاً.
«الزمن الباقي»، زمنٌ باقٍ على سطح السليوليد لايفارق صرامة صاحبه في الأداء. لا يعرف الحياد أو الملل، وهو يتنقل على شاكلة منح عاطفية لاتحتاج إلى أذونٍ من أحد. ففي الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل للاحتفال بعيدها الستين، تدير الأم ظهرها للألعاب النارية التي تطلق في الاحتفالات. يمكن للفلسطيني دون سائر الخلق أن يدير ظهره، ويحرك قدمه طرباً على وقع أغنية فيروزية بعد أن طال قعوده استجابة منه لحالة عاطفية فاقدة. يمكنه أن يدير ظهره أو يشيح بوجهه عن صورة يراد لها أن تكون في الخلف مبهرة، ويريد الشبح منها تعزيز روايته الأصلية عن المكان، بما يتناقض مع الخرافة التوراتية التي لم تنجح في تبصر عاصفة قادمة إليه، عندها سيبدأ ايليا سليمان من جديد فيلمه وسينهيه عندها، عندما يختار السائق كما أسلفنا النوم ملجأً له قبل أن تفرزه الحالة السينمائية إلى تيه بغيض يجبره الفلسطيني على أن يحلم به. فما بين الزمن المركب الذي تنقل فيه سليمان ببراعة سوف يغلق على السائق وهو يغط في غيبوبته العميقة يبحث فيها عن بقايا حكاية توراتية مسمومة لم يكن ممكناً لها في يوم من الأيام أن تدعي معرفة بالأرض التي تنتشر عليها انتشار عاصفة هوجاء. الشبح الفلسطيني المقيم في الخلفية خارج البعد البؤري المحيط للعدسة السينمائية، لا يوضح صورته، لا ينقيها، ومع ذلك شوائب الرواية واضحة ونقية وصافية تماماً.
كيف تصل العالمية بثلاثة أفلام فقط
أثار المخرج الفلسطيني إيليا سليمان من بداية مشواره في الأفلام الروائية الطويلة، جدلًا مصحوبًا باهتمام النقاد والجمهور، محققًا رواجًا عاليًا، وجوائز مهمة عربيًا وعالميًا، ومع أن إنتاجه من الأفلام الطويلة بقي محدودًا، فقد صار سليمان اسمًا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بأي حديث عن السينما الفلسطينية. هنا نعرض موجزًا عن سيرة الرجل، التي قوّمها بثلاثة أفلام طويلة، حازت على ما ذكر أعلاه من احتفاء ونجاح.
ولد المخرج الفلسطيني في الناصرة عام 1960، وعاش عمره متنقلًا بين مدينته الأم وبين منافيه المتعددة، إثر مضايقات إسرائيلية عدة تعرض لها منذ بدايات شبابه، وقد نضجت وتبلورت تجربته في السينما من خلال هذا التنقل، مخرجًا مجموعة من الأفلام الوثائقية أو القصيرة، من بداية التسعينيات، وحائزًا على مجموعة من الجوائز مثل جائزة مهرجان أطلنطا السينمائي. وقد أسست هذه التجربة على ما يبدو، لمشواره الذي بدأ مع الأفلام الروائية الطويلة، التي نعرض هنا أبرزها.
سجل اختفاء (1996)
من تأليف وإخراج سليمان، وتمثيله. يعرض الفيلم سيرة اختفاء العربي الفلسطيني في إسرائيل، من خلال قصة مخرج فلسطيني، يعود إلى بلده المحتلة، بعد توقيع اتفاق السلام مع منظمة التحرير. يركز العمل الذي يبدو سيرة شخصية للمخرج والمؤلف، على رصد التغيرات التي يواجهها البطل في قسمي الفيلم، فتدور أحداث القسم الأول في الناصرة، بينما ينتقل القسم الثاني إلى القدس. يشير الفيلم إلى مظاهر اختفاء الفلسطيني في دولة ليست له.
وبتقنية تكررت كثيرًا في أفلامه اللاحقة، يغلب الصمت فيها على الحوار، يظهر سليمان مشاهد مصورة مكثفة ومحملة بدلالات رمزية عالية، تتحمل كثيرًا من التأويل. يبدو العمل ساخطًا في مشاهد عدة على خطوة منظمة التحرير التي عززت هذا الاختفاء إثر توقيعها على التسوية السياسية المرحلية البائسة في سبتمبر 1993.
أثار العمل الذي حاز على الجائزة الأولى في مهرجان فينيسا للأفلام، نقاشات كثيرة، وسخطًا في الأوساط الفنية، العربية والفلسطينية، إذ كان ممولًا بالأساس من الحكومة الإسرائيلية. وبرر المخرج هذا التمويل، بأحقيته كإنسان فلسطيني حاصل على المواطنة الإسرائيلية وإن كانت ناقصة، بالحصول على تمويل، فهو على حد وصفه يدفع الضرائب ويقدم التزامات مجبرًا للدولة. وقد شهدت الساحة السينمائية في فلسطين حالات مشابهة ثار الجدل حول تلقيها تمويل من جهات رسمية إسرائيلية، لكن وكالعادة في النقاشات الفلسطينية الحساسة والمتطلبة للخفة والبراعة يضيع الجوهر في التناكف والتحزب على حساب السؤال المؤسس للحالة برمتها.
يد إلهية (2001)
من إنتاج مشترك فلسطيني فرنسي ألماني، تعرض قصة الفيلم تجربة حب بين فلسطيني من القدس وفتاة فلسطينية من رام الله. في سياق تظل الحدود والحواجز فيه مانعًا للقاء. ومع أن القصة تبدو للوهلة الأولى نمطية جدًا، إلا أن شيئًا في الفيلم لا تنطبق عليه هذه الصفة، فعادة المخرج معروفة في تهميش دور القصة، مقابل الدور المركزي الذي يعطيه للمشهد نفسه، أي للصورة الصامتة والكاميرا الثابتة التي لا تتحرك كثيرًا أو لا تتحرك بالمرة، أو الدور المركزي الذي يعطيه للحوار على قلة وجوده، وللكوميديا السوداء. فلا يعتمد الفيلم على القصة الرئيسية، بقدر ما يعتمد على يوميات وقصص فرعية.
حصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان، واحد من أهم تظاهرات السينما العالمية، إضافة إلى حصوله على مجموعة أخرى من الجوائز العالمية، مثل جائزة سكرين عن أفضل فيلم أجنبي، وترشحه لأخرى مثل جائزة السعفة الذهبية عن أفضل فيلم غير أوروبي.
الزمن الباقي: تاريخ الحاضر الغائب (2009)
يبدو هذا العمل أكثر أعمال إيليا سليمان التي كانت على صلة وشيجة بسيرته الشخصية والعائلية، مع أن هذه السيرة ظهرت في معظم أعماله. فيؤرخ العمل من خلال شخصية الأب فؤاد، لمقاومة الفلسطينيين لمشروع تأسيس الدولة الإسرائيلية قبل النكبة، قبل بدئه في عرض التحولات الحاسمة التي طورت مسار وحياة الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم بعد تأسس دولة الاستعمار.
ويستلهم الفيلم اسمه من أحد القوانين الإسرائيلية التي صنفت الفلسطينيين الباقين، الذين لم يكن معظمهم مواطنين أول الأمر، والذين سلبت أراضيهم بحجة الغياب. تظهر في الفيلم متلازمة المقاومة والتنازل، عارضًا صورة جديدة تبين التنازلات التي أجبر الفلسطيني على تقديمها نتيجة بقائه في أرضه وفي الدولة الجديدة، لا كخيانة، ولكنها شروط البقاء القاسية، فيخرج المقاومة والتعايش من كونهما ثنائية دائمة، ومن الأحكام السياسية الأخلاقية التي أخذت مطولًا عن الفلسطينيين الذين حافظوا على وجودهم في أرضهم بعد التهجير.
يستمر الفيلم مع شخصية إيليا نفسه، وأحداث متواصلة من التاريخ الفلسطيني، حتى الانتفاضة الثانية، في تواصل بدا تأكيدًا على استمرار القضية والخسارة، خسارة ظهرت أكثر تجلياتها في نهاية الفيلم، مع مشهد العجوز التي تجلس على شرفة في رام الله، مستمعة لأغنية نجاة الصغيرة؛ «أنا بعشق البحر».