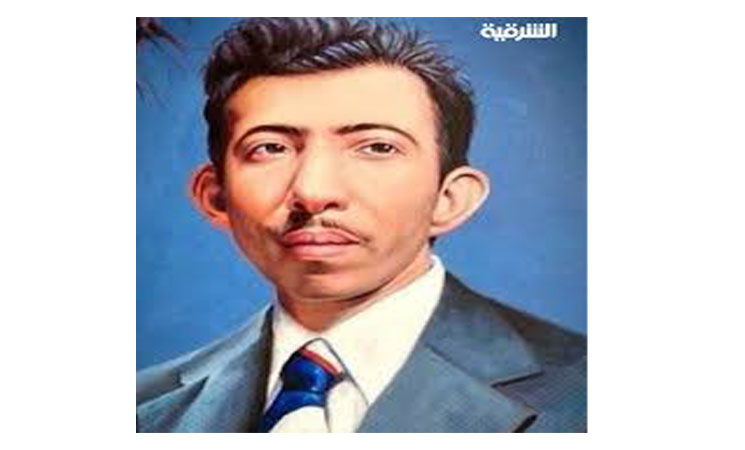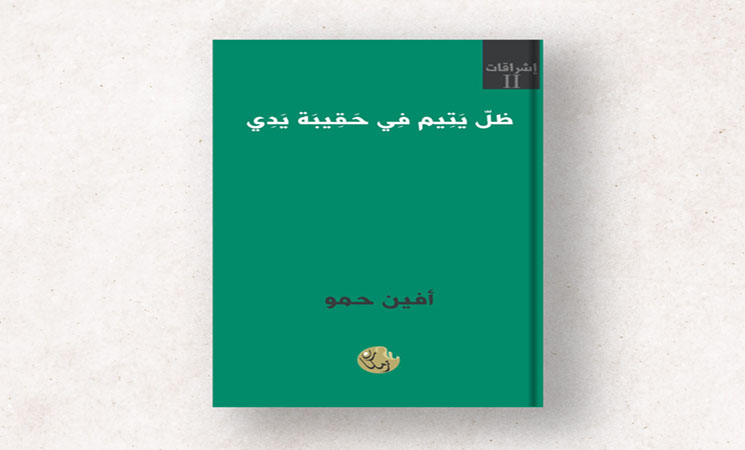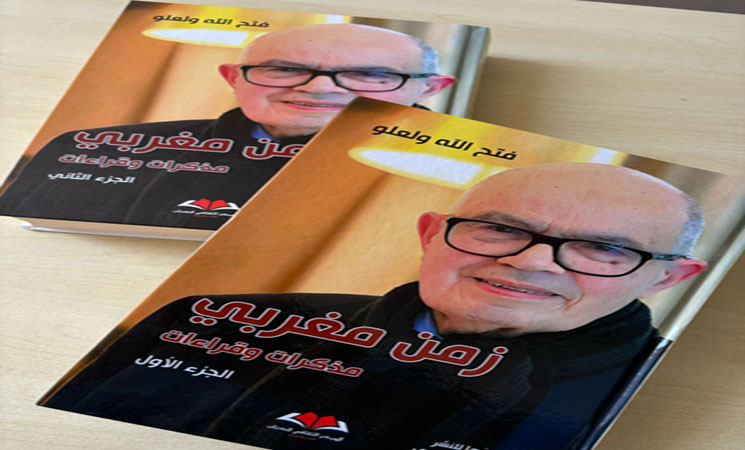في عمل أدبي يرقى إلى مستوى الوثيقة الإنسانية والتاريخية، يقدم الأستاذ إدريس الكريني روايته «طفولة بلا مطر»، صادرة عن المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش، الطبعة الأولى لسنة 2023، لا كسردٍ لماض شخصي فحسب، بل كاستعادةٍ لجوهر زمنٍ مضى، حافلٍ بالبساطة والمعاناة في آنٍ معاً. يصرّح الكاتب في المقدمة: «لم أجد صعوبة كبيرة في استحضار الكثير من اللحظات الماتعة وحتى القاسية منها، لكونها ظلت منقوشة بذاكرتي، ومدونة في جزء منها ضمن مذكرات طفولية، كنت حريصا على كتابتها في حينه بلغة بريئة لا تخلو من انفعال (ص 5). هذا التصريح يضع القارئ أمام عتبة نصية واضحة: إنها رحلة في دهاليز الذاكرة، حيث يمتزج الشخصي بالجماعي، والوجداني بالموضوعي، لتتشكل لوحة سيرية تعكس طفولة في ظلّ ظروف قاسية، لكنها لم تخل من الشغب والجمال والمقاومة.
العنوان بوصفه عتبة دلالية: نبوءة وجودية
لا يكتسب عنوان «طفولة بلا مطر» دلالته من بعده المناخي المباشر فحسب، بل يتعداه ليكون نبوءة وجودية وإنسانية. «الطفولة» هي رمز البراءة والخصوبة والنماء، بينما «بلا مطر» هو نفيٌ لهذا النماء، وحكم بالجفاف على هذه المرحلة الحساسة. هذا التضاد بين المفهومين يخلق إحساساً بالحرمان منذ اللحظة الأولى، ليس الحرمان المادي فقط، بل الحرمان العاطفي والروحي أيضا. الجفاف هنا متعدد الأبعاد: جفاف الأرض، وجفاف الفرص، وجفاف المشاعر أحيانا في مواجهة قسوة الحياة. إنه عنوان يشي بصراع مركزي ستدور حوله فصول الرواية كلها: صراع الحياة ضد عوامل القحط والاندثار.
الغلاف والفضاء البصري: صورة مرآة للمعنى
يعمل الغلاف الأمامي للرواية كنسيج بصري مكثف يعزز دلالات العنوان. فالصورة الفوتوغرافية التي تُرجّح أن تكون لمدينة فاس، تقدم مشهداً متناقضا: منازل حديثة في حي شعبي، وصومعة شامخة ترمز لثبات القيم الدينية والروحية وسط تغير الحياة. غروب الشمس في الأفق يشير إلى الأفول وزوال مرحلة، مما يربط بصرياً مع «الطفولة» التي تشير إلى ماضٍ آفل.
أما التفاصيل الأكثر دقة، فهي التي تحمل الرسالة الجوهرية: الحائط الآيل للسقوط يرمز للهشاشة وبنى اجتماعية آخذة في التآكل. والأرض المشققة القاحلة هي التجسيد المباشر للجفاف الذي يناسب العنوان. ومع ذلك، تبقى نباتات التين والقصب التي مازالت تقاوم الجفاف بمثابة بصيص أمل، وإشارة إلى قدرة الحياة على الصمود رغم كل شيء، وهي نفسها إرادة الطفل/ الراوي ومجتمعه على المقاومة. الصورة الباهتة على الغلاف الخلفي، المسبوقة بمقتطف من المقدمة، تعيد التأكيد على طبيعة العمل كـ «لحظة بوح بين الدفء والصدمة»، وكأن الذاكرة نفسها باهتة لكنها حاضرة بقوة.
بنية الرواية وتنظيمها الداخلي: بين الأكاديمي والحكائي
تنطلق بنية الرواية من هيكل واضح (مقدمة + 24 فصلا) يعكس التنظيم الأكاديمي للكاتب كأستاذ جامعي، لكنه يمتلئ بروح السرد الحكائي. العناوين الرئيسية المكتوبة بخط مضغوط، والمتبوعة باقتباسات من فلاسفة وأدباء من مختلف الثقافات (نجيب محفوظ، نيوتن، كونفشيوس، محمود درويش، بوب مارلي…)، ليست مجرد زينة، بل هي إضاءات فكرية تضع التجربة الشخصية في حوار مع تجارب إنسانية عالمية.
هذا التنظيم، إلى جانب نظام الهوامش العلمي الذي يشرح المفردات العامية (الخرجات يعني النزاهة، ص34) والمصطلحات (الصوفية، ص43) والأحداث التاريخية (فيلق الجنيرال كورو، ص 57 و58) والأعلام المحليين (الشاعر محمد غدو، ص61) والمواقع الأثرية (الحافة وشقة كويرة، ص69)، يحول السيرة الذاتية من مجرد حكاية إلى وثيقة أنثروبولوجية واجتماعية. إنه أسلوب يخلق توازنا جميلا بين الذاتي والموضوعي، بين دفء الذاكرة وبرودة التحليل العلمي.
الثيمات المركزية: نسيج الذاكرة المعقد
1. الجفاف كحالة وجودية
هي الثيمة المحورية التي تنساب عبر جميع الفصول. الجفاف ليس مجرد ظاهرة مناخية، بل هو محنة يومية تعيد تشكيل حياة المجتمع بأسره. يبدأ القلق عندما جفت الكثير من العيون القريبة بالقرية (ص32)، مما يدفع الناس إلى اقتناء حمار لجلبه من عين العصر(ص34). وتصل المحنة ذروتها الرمزية بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة بكل مساجد المغرب(ص33). حكمة العجوز الطاعن في السن الذي يجلس على قارعة الطريق قائلاً: لن تمطر حتى نعود للطريق(ص33)، تضع المسؤولية على عاتق المجتمع نفسه، مؤكدة أن سبب المعاناة ليس الطبيعة إنما الإنسان (هامش، ص41).
2. الذاكرة والحنين: استعادة الوطن الداخلي
الحنين هو الوقود الذي يحرك السرد. فهو ليس مجرد اشتياق عاطفي، بل هو حاجة وجودية لفهم الذات من خلال جذورها. يعترف الراوي: أشعر بحنين جارف إلى قريتي بأحيائها ودكاكينها البسيطة(ص80)، ويسأل نفسه: ألم يحن الوقت بعد للالتفات إلى تلك الذكريات المتراكمة التي تغمرني من حين إلى آخر(ص5). هذا الحنين لا يقتصر على المكان (فاس، زرهون، جبل زلاغ، بني عمار)، بل يمتد ليشمل طقوس الطفولة وشغبها.
3. الشغب والدعابة: مقاومة بالفرح
وسط أجواء الجفاف والمعاناة، تبرز الطرائف والشغب كآلية مقاومة نفسية. ذكريات اللعب بـكرة بلاستيكية يتقاسم الأطفال ثمنها، وكيف كانت تسقط في عرصة مجاورة… فيقوم صاحبها بتمزيقها بالسكين (ص56)، تحول الإحباط إلى لحظة طفولية مضحكة. مغامرة تسلق شجرة التين والفتاة الوردية التي صعدت بسرعة إلى الشجرة ثم صرخت في وجهي: ضع الإناء على الأرض وانصرف، لينتهي الأمر بسقوط التين على رأسه، تخلق خليطا من الشعور بالأسى والرغبة العارمة في ضحك هستيري(ص60). حتى الإحراج البريء بين الأصدقاء، كسؤال سعيد لصديقه أمام النساء: هل أنجزت التمارين؟ ليأتي الرد بحنق: موعدنا غدا في المدرسة(ص56)، كلها تفاصيل تثري النص وتؤكد أن الحياة تستمر رغم الصعوبات.
4. الهجرة والاغتراب: البحث عن واحة جديدة
تمثل الهجرة، سواء من القرية إلى المدينة أو من المغرب إلى فرنسا، ملمحا آخر من ملامح البحث عن مطر بديل. عودة الأب من فرنسا تكون لحظة فارقة: فجأة تراءى لي شخص لم أصدق في بداية الأمر أنه أبي (ص15). هذه العودة تحمل معها علامات عالم جديد، مثل التلفاز الذي شرح له الأب كيفية تشغيله من خلال محول كهربائي خارجي(ص24). الرحيل من القرية إلى المدينة (فاس) يمثل هجرة قسرية داخلية، تترك وراءها عالما بسيطا لتستقبل عالما معقدا يوصف بـ قلق المدينة.
5. الموت والفقد: الظل الدائم
يحضر الموت كحقيقة قاسية في هذه الطفولة، ليس كحدث بيولوجي فقط، بل كفقدان للبراءة والأمان. عنوان الفصل السادس «الرحيل»، والمقتطف المرفق به لمحمود درويش»الموت لا يوجع الموتى، الموت يوجع الأحياء»، يلخص هذا البعد. الموت هنا هو رفيق الجفاف، النتيجة الطبيعية للحياة القاسية.
6. الدراسة والتعلم: النافذة إلى عالم أوسع
تمثل المدرسة والمعرفة منفذا للخلاص. بداية المشوار في المسجد الذي لم يتبق منه إلا قاعة للدرس ثم الانطلاق إلى قاعة كانت تعج بضجيج الأطفال(ص8)، وحرص الأم على إلباسه الزي الذي عادة ما ألبسه في أيام العيد (ص17) استعدادا للذهاب إلى المدرسة، كلها إشارات إلى قدسية هذا المسار. حتى الانشغال بالدراسة كان يصل إلى حد الشرود، حيث كنت شاردا حينما أشار إلينا الفقيه بالانصراف (ص8).
الأبعاد الجمالية والفكرية: لغة بين البراءة والوعي
تتميز لغة الكريني بقدرتها على الجمع بين براءة الطفل الذي دون المذكرات بلغة بريئة لا تخلو من انفعال، ووعي الباحث الأكاديمي الذي يحلل ويشرح. هذا الانزياح بين ضميري «أنا» الطفل و»أنا» الراوي البالغ يخلق عمقا نفسيا ملموسا. استخدام الهوامش ليس تقنيا فحسب، بل هو جمالي أيضا، لأنه يكسر حدة السرد الخطي ويقدم للقارئ طبقات متعددة من القراءة.
الاستعانة بالاقتباسات العالمية عند كل عتبة فصلية يوسع من أفق النص، ويجعل من طفولة في قرية مغربية جزءا من القصة الإنسانية الكبرى حول المعاناة، المقاومة، الحب، والمعرفة.
خاتمة: الطفولة كمرآة لإنسان جافّ ومُقاوم
في طفولة بلا مطر، لا يقدم لنا إدريس الكريني مجرد ذكريات شخصية، بل يقدم تشريحا لروح جيل عاش على هشاشة الأرض ووعود الهجرة، لكنه لم يفقد قدرته على المقاومة. الطفولة هنا هي المرآة التي تعكس إنسانا تشكل في أحضان الجفاف، فتعلم كيف يكون صلبا كشجرة التين التي تقاوم العطش، وحساسا كالأرض المشققة التي تنتظر قطرة مطر.
هذا العمل هو أكثر من سيرة ذاتية؛ إنه سيرة لمكان وزمان، لواحة الذاكرة في صحراء النسيان. إنه إثبات أن أقسى الطفولات يمكن أن تنتج أجمل الحكايات، وأن «المطر» الحقيقي قد لا يكون ذلك الذي ينزل من السماء، بل ذلك الذي نستخرجه من أعماق ذاكرتنا وإصرارنا على الحياة.
* أستاذ باحث