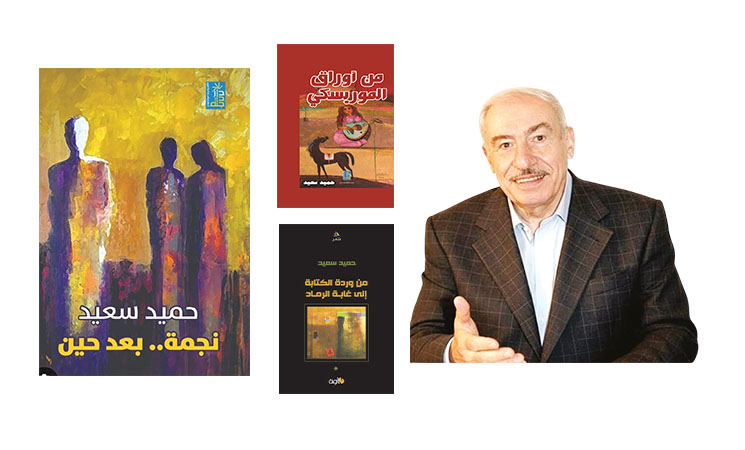لا غرو في كون الثقافة المغربية، رغم عمْرها القصير، فقد عرفت انعطافات تختلف باختلاف السياقات والمعطيات السياسية والاجتماعية،التي تركت آثارها في النتاج الثقافي المغربي، وبَصَمَتْهُ بِالجِدّة، ومنحتْ إيّاه روحا جديدة، ونَفَسا قويا مجْلاه ما خلّفهُ لنا الآباء الثقافيون كأجيال مهووسة بالإبداع وكمجتمع بها يشقّ طريقه صوب معانقة المستقبل، من تراكمات في شتى المجالات المعرفية، وهذا دليل على أن الحياة الثقافية عرفت سيرورة تنماز بالإبدالات والمغايرة أولا، وثانيا بالتنوع الإبداعي والفكري، وثالثا بالانغماس في السؤال الثقافي المحرّض على الخَلْق والابتداع، إضافة إلى أن المثقّف المغربي كان مرتبطا بالمؤسسة السياسية التي لعبت أدوارا طلائعية في ترسيخ منظومة فكرية حداثية تستجيب للحظة التاريخية والحضارية. بعبارة أخرى إن الثقافة المغربية، منذ منتصف الستينيات، كان اختيارها الأول والأخير الانتصار للفكر العقلاني المتنور، الذي شكّل وعيا عامّا لدى شريحة من المجتمع المغربي، وقد خاض المثقف المغربي رهانات الحداثة من بابها الواسع، رغم وجود مثبطات تحُول دون قيامه بالدور المنوط به المتمثّل في إشاعة ثقافة متنورة، ومع ذلك استطاعت الطليعة المثقّفة أن تشيع على الأقل، فكرا لا يهادن بقدر ما يطرح الأسئلة المتعلقة ب: ما الذي نريده ثقافيا؟ وما السّبُل الكفيلة لتحقيق الغاية المتوخاة من الممارسة الثقافية؟ وهل بإمكان الثقافة أن تؤثر في مجتمع مقيّدٍ بأغلال المحافظة والانتساب إلى الماضي؟ أسئلة نابعة من حرقة المثقف تجاه واقع متخلّف، هذا المثقف الحالم بمجتمع معطاء و أكثر حركية وفعّالية، وإيمانا بضرورة الإسهام في تشييد الحضارة الإنسانية والتأثير فيها.
والحقيقة تقال إن المغرب الثقافي أنجب خيرة المثقفين، الذين أسهموا في إغناء الفكر والنقد والإبداع العربي بطروحاتهم وإضافاتهم، التي شكّلتْ ولاتزال تشكّل موئلا لكل مثقف عربي. والسبب في ذلك مردّه- في اعتقادنا- إلى جدّية الأفكار المطروحة وجدواها في الحياة العربية، وجدارتها العلمية والعميقة، ذلك أن المثقف المغربي – على مَرّ الحقب التاريخية – اتّسم بنبوغه وعبقريته الفريدين، ولعلّ أمثال عبد الله ابراهيم وعلال الفاسي وعبد الله كنون والمختار السوسي وعبد الله العروي ومحمد عابد الجابري وعلي أومليل والمهدي المنجرة، تعبير جليّ عن قيمة الثقافة المغربية في ما تأتي به من أفكار وطروحات تتصف بالعمق والأصالة ، هذه الثقافة الداحضة للقولة المسكوكة «بضاعتنا ردّت إلينا»، تزخر بإبداع متميّز وفريد في جلّ المجالات الإبداعية، جعل المثقف المغربي جديرا بالالتفات إليه والعناية بما ينتجه من أفكار وتصوّرات نلمس فيها الاجتهاد والسبق في غالب الأحيان.
فمسار الثقافة – عبر التاريخ الإنساني- لا يثبت على حال، بل إن التحوّل والتغيّر سمة حتمية وموضوعية،الأمر الذي يفرض ضرورة مسايرة المثقف لهذه الإبدالات والإنصات إليها بالتأمل والتدبّر ، حتّى يتشكّل الوعي بما يجري في المجتمع من تحلحل على كافة المستويات، ويستوعب درس التاريخ الذي يظلّ في حاجة إلى سبْر كنهه وجوهره، لأن الوعي التاريخي يشرَع أفقا أمام المثقف لإعادة قراءة صيرورة المجتمعات ومن ثمّ الحضارات. فإذا كان السؤال الثقافي الذي كان مطروحا يتمثّل في الكيفية التي بمُكْنها تغيير وتحديث البنى الذهنية للمجتمع، والتي تُخرج هذا الأخير من حال التخلف إلى حال الحداثة والعقلانية، لذا وجدنا المثقف المغربي ينخرط في القضايا السياسية والاجتماعية في سياق سياسي وتاريخي واجتماعي معيّن، فإن الثقافة المغربية، اليوم، وفي ظل الألفية الثالثة، التي قوّضت الطروحات الماضية ذات النزعة الإيديولوجية والحمولات القومية، ببناء ثقافة جديدة متعلقة بسؤال التنمية والرقمنة وعالم السيبرنطيقا القائم على المعلوميات والتقنية كأسلوب حياة، ممّا يحتّم على هذا المثقف أن يُلبي نداء العصر، بالإسهام الفعّال في إضاءة هذا الالتباس الحاصل بين الحياة في الماضي، والذهاب بالتحديث إلى أقصاه، لبناء الإنسان الذي يشكّل عصَب كل تطور وتقدّم. فالتحدّي الذي يواجه المثقف المغربي يتمثّل في ضرورة التفكير في أنجع السبل للتّماهي مع هذه التغيّرات الرّهيبة التي مسّت بنية المجتمع مما نتج عنها أزمة حقيقية في القيم والهوية ففقد الإنسان البوصلة، وغدا تائها ومستلبا بفعل تعدّد الوسائط، الأمر الذي يفرض على المثقف الحقيقي، الحامل لمشروع ثقافي حداثي أن يبذل قصارى الجهد في الدفاع عن قيم الإنسان السامية، قيم المساواة والعدل، والحرية في التفكير والاعتقاد، لأن ما نلاحظه، اليوم، هو هذه الارتكاسة إلى الماضي كإجابة مضلّلة وواهية للإنسان. وخلاص من واقع التفاهة، الذي يشهد هزّة نكوصية وارتدادية إلى الماضي، الذي يشكّل، في اعتقاد أعداء العقل، الحلّ الوحيد والأوحد للخروج من حالة الانتظار التي دامت لقرون، لكن الحقيقة أن كون الذات عاجزة، بل تعيش الانفصام القهري بين الرغبة في التحديث وإرادة العودة إلى النّبع الأول، فكانت نتائجه متجلية في تخلف مجال التعليم، ومن ثمّ انتكاسة في التفكير وإقصاء العقل، وفي الفشل في خلق مدينة عربية بالمواصفات المعهودة حيث الترييف عنوان كل مدينة عربية، وفي انتكاسة واضحة المعالم في السياسة، فكان الالتباس والتردّد والفشل الذريع من سمات المرحلة الحالية، فلا وجود لمشروع مجتمعي قادر على مواكبة التحولات ومسايرة جموح العولمة ، تخلف في كل شيء، فَبَاتَ الإنسان فاقدا لهويته وكينونته، هذه الأخيرة التي تمّ تشويهها وافتقادها، بالارتماء في هوية الآخر الذي يعتبر الفرد أساس مدنيته وحضارته ، في المقابل نجد تغييبا تامّا للفرد يعكس بوضوح أزمة إرادة لدى الدولة ، وقد أتمادى في التوصيف لأقول إن الإنسان العربي كائن ممسوخ مشوّه، بدون ملامح، وبدون مستقبل.
فهذا الوضع المشين لوجودنا وهويتنا والحائل دون التفكير في مصيرنا، يفرض على المثقف الخروج من التقوقع حول الذات، والعمل على الإسهام في مناقشة قضايا المجتمع بكل شفافية ووضوح، لأن العيش بعيدا عن نبْض الواقع كانت له نتائج وخيمة على مصير المجتمع، فالتفكير الجدّي في مشروع ثقافي كفيل بتجاوز الأعطاب والاختلالات التي تعتور بنى المجتمع ، مشروع يعطي الأولوية للإنسان.
ويجعل أسئلة الحاضر ملتصقة بالإبدالات الجامحة التي شهدها العالم لاستشراف المستقبل، فهروبه – أي المثقف – جعلته خارج التاريخ ولحظته الحضارية، نظرا لتملُّصه من مَهمّاته التي وُجِدَ من أجلها، على اعتبار أنه العقل الذي يُفكّر في المجتمع ويناضل من أجله، فغيابه يؤدي إلى تغييب الفرد من دورة الوجود، وتحويله إلى كائن مشلول الإرادة والعقل. فالثقافة تسهم في تحقيق كينونة الفرد، وبها نتخطى كل المعوقات التي تتحوّل إلى سدّ منيع للوصول إلى الغد، ولن يتأتى ذلك إلا بإعادة قراءة الماضي قراءة منتجة وفاعلة، لكن أن نظل تحت جبّته، فهذا ملمح من ملامح تخلفنا وارتكاستنا الحضارية التي تحدّ من إرادة الإنسان.
غير أن أكبر عائق يواجه سيرورة الفعل الثقافي يتمثّل في كون الماضي مازالت مفعوليته وآثاره قائمة ومنغرسة في بنية العقل العربي، وتزيد في تأزيم ومحنة الثقافة. ففي ظل غياب ممارسة ثقافية حقيقية منبنية على أسس متينة وثوابت تشكّل عصَب البناء، لا يمكن للمجتمع أن تكون له الفاعلية في تثوير الفكر، وإخراج العقل من الجمود والتكلّس. وما نعيشه، اليوم، من عودة إلى ثقافة الطبيعة حيث اللاعقل والانفعال والتوتر صورة من الصور السلبية لهذه العودة، وفي هذا السياق نشير إلى هذا الإسفاف بالعقل وبالثقافة، وصولا إلى التغييب القسري للفرد من المشروع المجتمعي، ومن حياة الثقافة، دليل ساطع على أن ثمّة انحطاطا حضاريا يمرّ منه الإنسان العربي،أفقده إنسانيته، وعرّضه لأقبح تهجين وأسوأ وضع لا يحسد عليه.
فالخراب والتدمير والتهجير، وتغيير الخرائط وفرض سياسات اجتماعية واقتصادية وسياسية لا تمتّ بصِلة لما أنتجته فلسفة الأنوار ، من أبلغ مظاهر الارتكاس الحضاري. ولا غرابة في هذه الوضعية مادام نظام التسطيح هو العِقد الناظم لمنظومة تنتصر لثقافة التسليع والتبضيع والتّسفيه. فالأزمة القيميّة هي نتيجة حتمية لسياسة تعليمية ترسّخ الضحالة ، والاحتذاء والتقليد والمحاكاة ، مما أصاب الإنسان والعقل بعاهات الشللية والاتكالية، ولابد من القول إن ماتعيشه المجتمعات العربية من تردٍّ في الذوق، ومن تقهقر في الإنتاجية، ومن مظاهر العنف، ومن غياب الكفاءات الجديرة بتحمّل المسؤولية التدبيرية والتسييرية كفيل بأن هذا المستقبل في كفّ عفريت. هو واقع يطرح على المثقف أكثر من سؤال، من قبيل:
– ما السبيل الأنجع للخروج من هذا الوضع المأزوم؟
– وكيف لنا أن نتخلّص من تبعات عولمة تميت في الإنسان الجدوى من وجوده؟
– هل الثقافة تمتلك القدرة على مجابهة هذه الانتكاسة على مستوى القيم؟
أسئلة تحتّم على المثقف مقاربتها وفق رؤية واضحة، وتصور عميق ينظر إلى الثقافة كآلية من بين الآليات الكفيلة بإنقاذ المجتمع من ضلال اللامعنى، غير أن الأمر لا يقتصر على المثقف وحده، بل على الدولة أن تتحمّل مسؤوليتها، في هذا السياق، بوضع خطة ناجعة في جعل الثقافة همّا جماعيا،أي مشروعا مجتمعيا، انطلاقا من محددات استراتيجية، أساسها الثقافة وغاياتها الثقافة، بعبارة واضحة على الدولة أن تختار طريق العقل، الذي بإمكانه خلق إنسان يكون أكثر فاعلية وإنتاجية، ومساهما في تنمية المجتمع والوطن، وأن تعمل جادّة على التشجيع على المعرفة السلاح القادم لمواجهة التطرّف بكل أشكاله المختلفة .فالمجتمعات التي تغيّب الثقافة تفقد هويتها، وتكون فاشلة في فرض وجودها الحضاري ذي البعد الإنساني. فالهوية الحقيقية ليست هي الانغماس في حياة الاستهلاك والسقوط في فخاخ تكنولوجية تكرّس الاستلاب والعبودية، وإنما هي التي بمقدورها أن ترفع التحدّي في وجه كل المعيقات والعراقيل، ولن يتمّ ذلك إلا بالعمل على محاربة كل المظاهر السلبية،بنهج العقل كوسيلة من الوسائل الممكنة التي تنقذ الإنسانية من الغرق في الدموية المميتة، والعودة إلى النظام الغابوي المتوحش، في حين بالثقافة العقلانية نستطيع التغلّب على ما يعيق الإرادات، ويكبح جموح الإنسان في ارتياد آفاق الخلق والإبداع، ويقتل روح الابتكار والتجديد. وامتلاك ناصية التفكير والنقد لن يأتي إلا باعتماد تصور عقلاني لأية ممارسة ثقافية، فالثقافة التي تعتمد على العقل تخلق إنسانا مفكّرا وناقدا، وليس منتقدا، فالنقد ينبني على أدوات منطقية ومفاهيم دقيقة منبعها الفكر ، في حين أن الانتقاد فهو انفعالي يغيّب فيه العقل وتحضر العاطفة كأساس، لذا من واجب الدولة بمؤسساتها التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية العمل على بلورة مشروع ثقافي عموده الفقري العقل المنتِج والمخصّب للأفكار وللأشياء، وأعمدته العقلانية المتنورة التي تزكّي المنطق والتعمّق في الوجود، ومقصديته الإنسان المنطلَق والمبتغى، على أساس أن الثقافة، بمعنى النتاج العقلي، بإمكانه إحداث دينامية خلّاقة تنقذ الإنسان من جاهلية جديدة، جاهلية الإقصاء والتهميش، جاهلية الظلم والاستبداد، جاهلية تؤمن بالقمع والقتل، جاهلية تجدّد جلدها في ظل التقهقر الحضاري، وتستأسد على عقول مقيمة في الماضي، وبعيدة كل البعد عن الحاضر، وفاقدة للمستقبل، جاهلية الألفية الثالثة التي تبيع الأوهام وتقصي العقل، وتحوّل الإنسان إلى سلعة. وما الاحتفاء بالاستهلاك، في عالمنا المتقدّم تخلّفا وجهلا وأمية، إلا تعبير عن الأزمة الضاربة أطنابها فيه، أزمة الانتصار لكل ماهو تافه وضحل، وسبب هذه الجاهليات العمل على تفريخ ثقافة سطحية ضحلة، تناصر السطح وتنبذ العميق.
إن قضية الثقافة قضية جماعية، يتحمّلها الجميع بدون استثناء، لأنها السبيل الأنجع للتخلّص من مظاهر الإسفاف والانحطاط، والقضاء على التخلف الذي يعمّ البلاد والعباد، وتلك طامّة عظمى ستزيد الأوضاع تأزّما، والإنسان جهالة، والمجتمع ضحالة، والحياة جحيما سيصطلي بنيرانه الجميع، لهذا على المثقف العمل على إضاءة عتمات الواقع بتكريس ثقافة العقل، وزرع بذور الأمل في عقول الأفراد، بوساطة العلم والمعرفة والانفتاح على ثقافة الآخر بما يخدم المجتمع والفرد، ويسهم في الرقي الحضاري، أما الانبهار به عبر التقليد والمحاكاة فالمآل معروف ومعلوم.
التّحدّي الثّقافي

الكاتب : صالح لبريني
بتاريخ : 21/02/2020