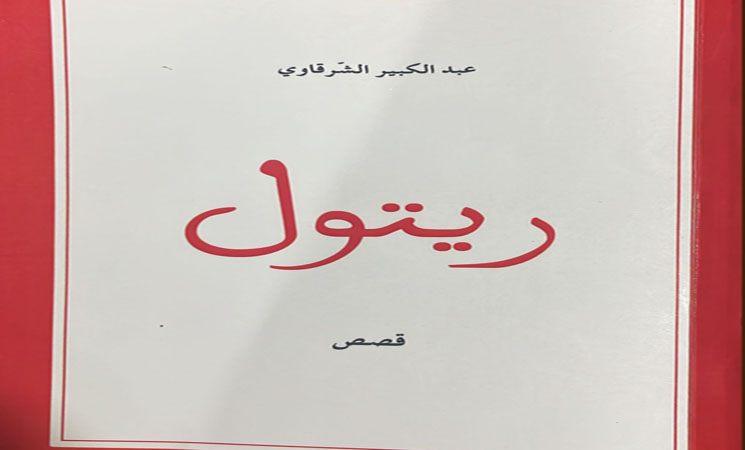« كان هناك طالب قديم ، وهو الآن زميل، قد قال لي يوما «عليك أن تتوقف عن الكتابة عن الرجاء والوداد». في الحقيقة لم يسبق لي أن كتبت عن هذين الفريقين لكنه اختار هذه العبارة ليبلغني أن عليّ أن أكتب عن قضايا أكثر جدية. والحقيقة إن هذا الاختيار في الكتابة هو كيفية في الجواب عن ردود فعل من مثل هذا النوع ، كما أنه موقف تجاه الفلسفة عينها .»
عبد السلام بنعبد العالي
« فإن كان علي أن الخص كل ما قمت به لحد الآن، فإني سأقول إنني حاولت أن أحدد ماهية «مجتمع الفرجة»، هذا هو شاغلي الأهم، وهذا الهم في اعتقادي لم يكن متيسرا تحقيقه إلا باعتماد زوايا نظر متنوعة تعمل على تبين الأشكال المختلفة التي يتخذها إنتاج اللامعنى في مجتمعاتنا. «
عبد السلام بنعبد العالي
«La bêtise n›est jamais celle d›autrui, mais l›objet d›une question proprement transcendantale»
Gilles Deleuze
ابتداء وجب أن أقول، إننا هنا كلنا، في اعتقادي، في وضع مفارق من جهتين، الجهة الأولى أننا بصدد الحديث عن «الأعمال الكاملة»- لحد اليوم- لمفكر كان كل ما كتبه ضد فكرة «الأعمال الكاملة»؛ ضد منطق التجميع والأرشفة والتخزين، ومن جهة ثانية نحن هنا لنحتفي بمفكر يجسد عمليا كل ما يناهض ثقافة الاحتفاء، إذ هو نفسه كتب ذات مرة عن «أعراس المثقفين» وعن «برزاتهم»، وعما يغلب عليها من روح المحاباة والتودد الشكليين، وهذا ليس عنده مجرد حكم مرسل أو انعكاس لنزوع زهدي شخصي، بل هو تجسيد لقناعات فلسفية ترتقي عنده لمستوى المبدأ، فالفلاسفة صنفان على الأقل، الجيولوجيون العموديون الذين يؤسسون ويبحثون عن الجذور عموديا، والأفقيون الجغرافيون الذين يبحثون، على مستوى القشرة، عن امتدادات هذا الذي يُزعم أن له أساسا وجذرا، والقشرة «أعمق الأشياء» كما قال يوما بول فاليري، الصنف الأول يمثله أساتذة «العقائد»، الذين يشيّدون المدارس وينتجون «خلاصات» يعتبرونها حقائق سامية، والصنف الثاني يمثله الجينيالوجيون الذين يفضحون الصدف «غير السامية» التي جعلت هذه الحقائق ممكنة أصلا؛ الصنف الأول يناسب الأساتذة «الدكاترة» الذين يملؤون الكراسي والمكاتب بربطات عنقهم وسحناتهم الجادة محاطين بالحواريين الأوفياء، والنوع الثاني يناسب أسماء تعبر كالظلال، خفية، دون أتباع ولا هالة ولا «جدية» حتى، إذ أنهم لا يحتاجون لعبيد حتى يستشعرون قيمتهم : «لا أحب أن أُقاد ولا أن أقود» قال نيتشه مرة؛ وواضح أن الأستاذ بنعبد العالي هو أحد وجوه الصنف الثاني، أحد أعضاء قبيلة الفلاسفة الرحل، الذين لا يستمرئون كراسي أو مكاتب، ولا تقف دونهم وعشق الظعن مناصب ولا «تكريمات»، لأنهم ربما فهموا أن الشكل الوحيد لحياة الفكر هو تحرّره من كل قيد أو وهم بما فيه أوهام «سلطة الفكر» نفسها : «الفكر لا يبدأ فعلا إلا عندما يفهم ألا سلطة للفكر أصلا» قال دولوز مرة.
غير أن هذا التقابل الذي نقترح، لا ينبغي أن يخدعنا بأن نفهم منه مثلا أننا نقابل فيه بين «الجدية» واللاجدية، أو بين العقلانية واللاعقلانية، بل يتعلق بأن نقابل بين من يثق في صورة تقليدية، وربما دينية، عن معنى المفكر ودوره، وبين مفكرين، ربما من فرط عقلانيتهم، يترقّون ليجعلوا من مفاهيم «الجدية» و»العقلانية» نفسها موضوعا للنظر العقلي والفلسفي، حينها تتولّد لدينا أسئلة فريدة وفاتنة : فما الجدية في الفلسفة أصلا ؟ وهل يكفي أن نفترض الجدية والعقلانية فينا حتى نبلغها ؟ إذا ارتقينا إلى هذا المستوى، سنفهم أن الجدية والعقلانية لا تكونا في فعل «فعلا» إلا عند مفكر لا يأخذ نفسه بجدية؛ مفكر لا يسقط في ما يسميه سارتر ب :la mauvaise fois ، حين يصف في أحد نصوصه إلى أي درجة يبدو نادل المقهى مضحكا وهو «يلعب» دور نادل المقهى بجد ويصدقه ويتماهى معه؛ الجدية الحق في الفكر حينها لن تكون مجسدة في من «يلعب دور» الأستاذ ويتماهى معه، بل ستتحول لتصير هواية السذاجة والتعلّم الدائم، التعلم الذي يكون غاية ووضعا دائما وليس مجرد «طريق» ظرفي نحو «العلم» والأستاذية : faire l’idiot » « ، هذه هي مهمة الفلاسفة الحقيقيين ، ضدا على «faire le professeur « التي كانت دائما هواية العقائديين؛ سقراط الساخر ضدا على أفلاطون الخطيب؛ الجدية بهذا المعنى تصير رهانا عمليا، تصير في الكتابة مثلا وليس في الهالة الشخصية، فوحدها الكتابة تهم، وأما الأشخاص فأحوال منذورة للعدم ليس إلا. بهذا المعنى فنحن هنا أمام مفكر جدي «فعلا»، فنحن أمام رجل درّس وترجم وألف وناقش آلاف الصفحات، أي أننا أمام مفكر لو كان من الصنف الأول لحسُن عنده أن نصفه بالموسوعي، لولا أن صفة الموسوعية هذه لا توافق أبدا مفكرا من مثل بنعبد العالي، لهذا فإن كان ولا بد أن نصف هذا التنوع والغنى ونصنف صاحبه فلنقل عنه بالأولى إنه مفكر دفع رباعي، أو مفكر ( vélo tout terrain ) vtt بلغة الدراجيين التي يحبّها، وهو الدرّاجي القديم؛ مفكر بسبب من ترحاليته يقتحم كل مرة أرضا جديدة بكرا، ليرى ويعاين و»يتعلّم» بما أن التعلّم عنده، كما قلنا، هو «الوضع» الدائم للمفكر، في هذا المستوى يصير وصف الموسوعية منقصة، فالفيلسوف ليس من يعرف كثيرا، بل هو من لا يعرف إلا ما ينبغي ويجب، فالتفكير حرفة و»عمل باليد والدماغ» ، ومن هذه الزاوية تغدو «الثقافة العامة» سبّة، فلا فائض معرفة عند الفيلسوف ليعطيه، لا معلومات زائدة، وحتى وإن كان فإنها ستحضر بشكل ضمني نستشفه نحن، وليس في صورة زينة استعراضية، فأناقة الفيلسوف أناقة كيفية وليست كمية؛ بل ربما أن كلمة الفيلسوف نفسها سيصير معترضا عليها هنا إن أخذناها بالمعنى الشائع اليوم مع «فلاسفة» التلفاز الذين يقدمون مهنتهم، باعتبارها «الحديث في كل شيء وعن أي شيء»؛ حينها سيصير الأفضل ربما عند الأستاذ بنعبد العالي أن نسميه بالكاتب، أو «المحاول» essayiste ، فهو إلى مونتنيي صاحب المقالات أقرب منه لكانط صاحب العمارات.
إذا أخذنا الفكر بهذا المعنى والكتابة بهذا المفهوم، ماذا تصير مهمة الفيلسوف الفعلية إذن ؟
عوض التركيب والبناء تصير بيانا للفواصل، وعوض التنسيق، بيانا للمفارقات؛ الفيلسوف هنا سيصير ذلك الذي يبيّن لنا الفروق ويكشف لنا عن المفارقات في ما نراه نحن متسقا ومتناغما، لهذا كان عبد السلام بنعبد العالي، وهذا هو الوصف الأقرب إليه عندي، مفكر الفروق والمفارقات، ولعل العلة في ذلك كله قد أتته من كونه جمع لسنوات بين تدريس الفلسفة والرياضيات، ومعلوم أن الولع بالمفارقة وفنونها هو الجامع بين المعرفتين.
وتمثيلا لهذا الأمر، أعرض هنا قضيتين اثنتين تجسدها هذه النصوص التي نحن بصدد الحديث عنها، الأولى تتعلق بنوع العلاقة التي يبنيها بنعبد العالي مع تاريخ الفلسفة، والثانية تتعلق بطبيعة «الموقف العملي» الذي تؤسس له، وإن شئنا لغة مباشرة قلنا نوع الموقف السياسي الذي تقدمه.
اشتغل الأستاذ بنعبد العالي، في بدايات ما كتب خصوصا، بتاريخ الفلسفة ، وقد بدا هذا واضحا في رسالته الجامعية الفارقة «أسس الفكر الفلسفي المعاصر»، لكنه بعد ذلك خرج – أكاد أقول- من هذا التاريخ، ليتوجّه نحو ما قد نصطلح عليه مجازا ب»اليومي»، وما قد أسميه تواطؤا ب»الحياة»، بيد أن هذا الخروج كان خروجا مفارقا، إذ لا ينبغي أن نفهمه بمعنى التخلي والطرح جانبا، بل العكس تماما، فالخروج المقصود هنا هو الذي لا يكون ممكنا إلا بالتغلغل بأقصى ما يكون في تاريخ الفلسفة عينه، إلى درجة تمكّن من خلق «المسافة» معه، بل إن هذه المسافة عينها هي التي تصير ممكّنة، لوحدها، من هذا «الخروج»، وهذا تصور يتعارض رأسا مع من يفهم الفلسفة باعتبارها حديثا «شخصيا» لا إلزامات أو ضوابط معرفية تحكمه، فيستمرئ حديث «الخارج» وهو لم يدخل أصلا، كما أنها تضاد نهج من يعتبر أن دور الفلسفة هو أن يكتب كتبا عن كتب، و أن يكرر معلومات مدرسية عن قضايا «مدرسية» . الخروج هنا يصير مهمة صعبة جدا، لأنه يشترط أن يتحول التاريخ إلى أداة فعل، الخروج هنا معناه أن يتحول تاريخ الفلسفة ومفاهيمه وأفكاره إلى مجموعة وسائل عمل، أي أن يصير علبة وصندوق براغي وملاقط، فيصير الفيلسوف عاملا وحرفيا كما تقدم، وتصير الفلسفة اصطناعا اكتشافا للمساحات وفتحا للممكنات وليس تكرارا لتراثيات، الأمر إذن لا يعني أبدا الانقطاع عن تاريخ الفلسفة، بل يعني خلقا لتصور جديد عن وظيفة هذا التاريخ، تصور يصير فيه هذا التاريخ سندا وتكئة للخروج «به منه»، وهذا أصعب من التأريخ العادي الذي قد يتحول في كثير من الأحيان إلى سبب عنّة وإخصاء فكري، فالأهم هو إمكانيات توظيف الأفكار وليس تكرارها؛ لهذا فنحن نجد أن النصوص التي ينشرها بنعبد العالي لا تحضر كمعلومات للحفظ بل كـ»معادلات» للحل؛ الفكر يصير تمرينا والنص يصير «مسألة» puzzle ، الفلسفة هنا تتقدم كرياضيات فلسفية أي كحكاية بوليسية، حكاية المعيش واليومي نفسه في ألغازه المستترة ولعبة التنكر والكشف التي تأخذنا فيها، الفلسفة هنا اختراع لفكرة «عملية»؛ تصير انتصارا للمستقبل الذي يتحول إلى ماضي الماضي نفسه، فوحده المستقبل يهم : «تذكر المستقبل» جاء في التلموذ .
بيد أنه، وهنا أيضا، ينبغي أن نحتاط من سوء فهم خطير قد يعترضنا، من مثل أن نفهم تعلق الفلسفة بالحياة وباليومي باعتبارها رغبة في الاقتراب من الحس العام، تنحو في اتجاه الدعوة لما اصطلح عليه ب»إنزال» الفلسفة» إلى الشارع، فليت الأمر بهذه البساطة وهذه التفاهة حتى، الأمر أخطر من ذلك بكثير ، فالقضية ليست مجرد بحث عن شكل آخر لإنقاذ الفلسفة من إعلان موتها المزعوم، والذي ما فتئ يعاد، بتحويلها إلى خطاب إعلامي، ولا حتى رغبة في البيداغوجيا ، بل العكس تماما، فقد يكون فعلا الحديث عن «الهامبورغر» أقصر الطرق لفهم فكرة لهايدغر، أو الحديث عن كرة القدم أيسر السبل لفهم مسألة «الوجود والعدم»، ولكن هذا يكون بالعرَض وليس بالقصد، فالمسألة فلسفية خالصة، فتوجه الفلسفة نحو اليومي يحمل في عمقه معنى «فلسفيا» عن الفلسفة، معنى يعارض الإعلام ومنطقه في العمق، فإن كانت الفلسفة، كما ذكرنا ، ليست قضايا تعاد، بل طريقة في التفكير تنتج، فإن الموضوع يصير حينها ثانويا وغير ذي أهمية ، أي أنه يصير تمثيليا فقط، فالتفلسف، كما الفن، ليس مسألة موضوعات، بل مسألة طريقة في تناول الموضوعات، أيا كانت هذه الموضوعات. فإن كان الفن «ليس تصوير الأشياء الجميلة، بل التصوير الجميل لأشياء» قياسا على القول الشهير لكانط. فمن الممكن أن نقول مع بنعبد العالي إن الفكر ليس التفكير في أشياء عميقة، بل التفكير بشكل عميق في أشياء، أيا كانت هذه الأشياء، وهذا منطق موجه ضد الإعلام وضد حراس السمو الفلسفي الكلاسيكيين معا، فلهؤلاء يصير السؤال هو ما معنى السمو أصلا ؟ هل هناك أشياء أسمى من أشياء ؟ ألا نسقط حينها في تصور تراتبي عن العالم ؟ ألا نقع هنا ضحية لأكثر التصورات المانوية فجاجة؟ ولدعاة التصور الداعي لضرورة نزول الفلسفة للشارع، الإحراج يصير هو : النزول نحو ماذا ؟ أ وليست فكرة النزول عينها لا تكون ممكنة إلا على أساس افتراض تعال قبلي ؟
هنا نفهم مع الأستاذ بنعبد العالي أن الموقفين معا متشابهان، بل متطابقان، فمن يقول ينبغي أن ننزل يقول في الحقيقة نفس ما يقوله من يدعو للصعود، إذ كلاهما يسقط ضحية المنطق الذي يريد أن يحاربه، يسقط ضحية تصور ثيولوجي عن الفلسفة، كلا التصورين «نيكروفيليا» وكراهية للحياة مهما اختلفت التسميات، لهذا كله وجب التنبّه مرة أخرى إلى أننا إن كان ينبغي أن نفهم دعوة الأستاذ بنعبد العالي باعتبارها دعوة لفتح الفلسفة على معيشها، فلا ينبغي لنا خصوصا أن نفهم هذه الدعوة بنفس دلالة ما نسمعه اليوم من حديث المحتفين بالفلسفة في «الزنقة»، فهذه الدعوة لا تتميز عن سابقتها في شيء، فهذان معا وجها «يانوس» الواحد، فمن يريد أن يصعد أو من يريد أن ينزل كلاهما ينسى أن لا شيء أصلا لنصعد نحوه أو ننزل، إذ همّ الفلسفة كان دائما هو الحياة المتواطئة المحايثة، هذه الحياة خارج كل التراتبات، الحياة هذه التي ليست إلا هي، لا سوقية ولا سامية؛ الحياة : ثروتنا الأولى والأخيرة وربما الوحيدة.
من الناحية العملية ما الموقف السياسي الذي يترتب عن تصور مثل هذا يفكر في الحياة خارج التراتبات وخارج كل محاباة إعلامية وخارج كل جدية مصطنعة ؟
في اعتقادي إن سؤال الموقف نفسه يصير سؤالا خاطئا، أي إنه يصير هو نفسه موضع سؤال، فمن يبتغي البحث عن مواقف ثابتة في نصوص بنعبد العالي لن يجدها، لأن الثبات لا يستقيم مع فكر يؤمن بالحياة، فالثبات لا نجده إلا في فكر يفهم الموجود باعتباره استقرارا في سلم قيمي كما تقدم، والحال أننا هنا مع فكر، بدافع من إيمانه بالحياة، لا يبحث إلا عن الحركة، لهذا فالأولى لنا أن نبحث هنا عن انفتاحات وليس عن مواقف وسكنات، وإن كان ولا بد أن نصرّ على استحضار مفهوم الموقف، فسنقول إننا هنا مع موقف هو المواقف كلها ولا أحد منها، موقف مع كل المواقف وضدها في نفس الآن، بما فيها مواقفه هو ذاته؛ لهذا فإن أمل من يبحث عن السياسة بمعناها المباشر سيخيب في هذه النصوص : وما الفكر إن لم يكن سلسلة خيبات آمال ؟ السياسة مع الأستاذ بنعبد العالي لا تفهم باعتبارها تحزّبا بل باعتبارها مقاومة، على أن نفهم المقاومة هنا، وكما التعلّم سابقا، باعتبارها مقاومة لا تريد أية سلطة، المقاومة هنا، ومن ثمة السياسة، تصبح مواجهة لشيء أعمق من كل الإيديولوجيات ، إنها تصير مقاومة «للبهامة» la bêtise ، أي للبلادة والبلاهة والحمق، البهامة، هذا العدو الأكبر الذي من طبيعته أنه لا يتموقع في موقع خاص ولا يكون حكرا على شخص دون آخر، إنها ما يحيق بالجميع ويتربص بالجميع في كل حين، فتظهر عند من يعتقد أنه الأبعد عنها خصوصا، هنا لن يحضر الموقف السياسي la position إلا باعتباره «موقفا غير متوقّف» hyperposition فلا يبقى من المفيد أن يعارض المفكر طرفا ضد طرف، لأن الأهم يصير هو أن يخلق المسافة مع كل طرف ومع ذاته خصوصا؛ الموقف هنا كما يقول أحدهم لا يظل engagement ولا désengagement ، بل يصير dégagement، أي بحثا عن المسافة والمساحة والفرق .
وبعد، كيف نختم ؟
يقول الأديب الفرنسي الكبير فلوبير»la bêtise consiste a vouloir conclure « ، لهذا فمقاومة للبلادة والسخافة والحمق، ووفاء لهذه النصوص ولموقفها العملي المذكور، لن أبحث عن خاتمة، سأترك الحديث هكذا بالمسافة عينها التي ذكرنا، فليس من الضروري أن ننتهي، بل من قال إنه ينبغي أن ننتهي أصلا، كما قال الأستاذ بنعبد العالي مرة ؟
لنترك الأشياء كما هي في الحياة، طريقا لا أصول تحكمه ولا خط وصول نبلغه، لنترك حوارنا هكذا، حوارا لا متناهيا.