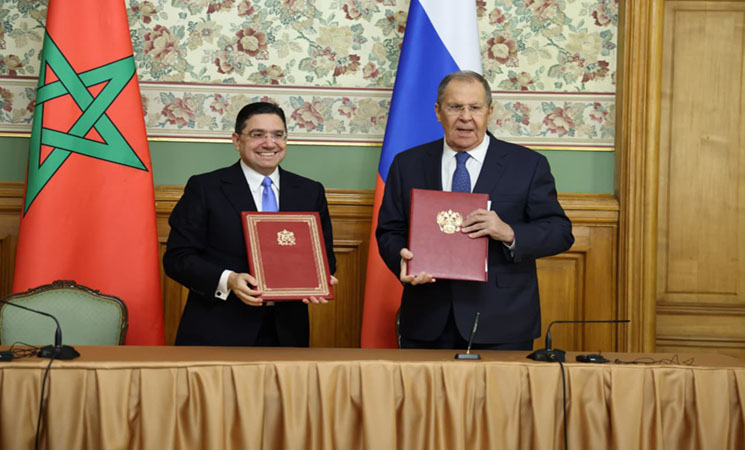ودعنا المناضل الكبير عبد الواحد الراضي، رجُل الدولة الذي ترك بصمات في الحياة السياسية والجمعوية، حيث كان من الرعيل الأول داخل مؤسسة البرلمان، الوحيد الذي انْتُخب وأُعيدَ انتخابُه منذ أول برلمان مُنْتَخَب سنة 1963 إلى اليوم. وهو أحد مؤسسي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959 والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1975، الذي سيُصبح كاتبَه الأول سنة 2008. رافَقَ عدداً من زعماء الحركة الوطنية والديموقراطية بينهم بالخصوص المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد. كما لَعِبَ دوراً مؤثراً في صياغَةِ مشروع التناوب. وكفاعل ورَجُلِ دولةٍ، عُيِّنَ وزيراً أكثر من مرة في عَهْدَيْ الملِكَيْن الحسن الثاني ومحمد السادس. شَغَل منصب رئيس مجلس النواب لأكثر من عشر سنوات، وترأس عدداً من المنظمات والمؤسسات البرلمانية الأورومتوسطية والإسلامية والمغاربية، قبل أن يُنْتَخبَ سنة 2011 رئيساً للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في علاقاتٍ مواظِبَةٍ لم تَنْقَطِع مع نساء ورجال وشباب منطقته، سيدي سليمان، بصفته البرلمانية.
نعيد بعضا من سيرته الذاتية التي أنجزها الزميل والكاتب حسن نجمي بعنوان ” المغرب الذي عشته ” عَبْرَ سَرْدِ رَجُلٍ ملتزم، يحكي هذا الكِتَابُ تَاريخَ المَغْربِ وتحولاته منذ ثلاثينيات القرن العشرين حتى المصادقة على دستور 2011 مروراً بالأحداث الكبرى والصراعات والتوترات التي عَرفَها المغرب المعاصر، والدور المتميز الخاص الذي لعِبَهُ الرَّجُل، خصوصاً على مستوى ترتيب العلاقة والحوار بين الملك الراحل الحسن الثاني واليسار المغربي بقيادة الراحل عبد الرحيم بوعبيد والأستاذ عبد الرحمن اليوسفي…
كان رؤساء فرق الأغلبية يدافعون دون تحفظ عن سياسة الحكومة والأطروحات والاختيارات الرسمية التي لم تكن دائماً موفَّقة. وكانوا جميعاً يكررون نفس الخطاب لتمجيد ودعم كل ما كانت تقوم به الحكومات المتعاقبة. فكان في خطابهم جانب مكرور يعطي الانطباع بلغة الخشب. وكانوا محْرَجين في التناقض الذي كانوا يعيشونه بين التعبير عن تأييدهم للحكومة في ما كانوا يعتبرونه إيجابياً، ودون تحميل المسؤولية لأحزابهم في كل ما كان يبدو لهم سلبياً. وبالنسبة إليَّ –وبكلِّ تواضُع- فقد كان لي الجانب الجميل، إذْ كنتُ الناطق الوحيد باسْمِ المعارضة فكنت أقدم خطابا نقدياً على أَسَاسِ معرفةٍ متَمكِّنةٍ بالملفات التي كُنَّا نناقشها. فكنت أركز على مكامن الضعف في السياسة الحكومية واختياراتها والإِجراءات التي كانت تقوم بها، والتي كانت في أَغلبها تَخْدُمُ مصالح المحظوظين وتُعَقِّد شروط الحياة المأزومة التي كانت تعيشها الطبقات الشعبية.
كنتُ أُنَدِّد بقوة وحزم بحالات الظلم الكثيرة وعدم احترام حقوق الإنسان، ودونما سقوطٍ في الشعبوية، لكن في التصاق مع الواقع اليومي للمغاربة. كانت تتم محاكمة الحكومة وأغلبيتها في كل مرة.
يومئذ كنت لا أزال أدخن فأستعمل الغليون (pipe) حتى أثناء تلك البرامج الإِذاعية والتلفزيونية. كنت أدوِّنُ الملاحظات والغليون في فمي، في حالة من الهدوء والسكينة بينما كان زملائي في السجال يتدخلون، مما كان يساعدني على التركيز وإِعداد ردودي وعباراتي. وانتهى الأمر بعموم المواطنين، خصوصاً في الأوساط الشعبية، إلى أن أطلقوا عَلَيَّ اسم «مُولْ البِّيبَّا». ومن ثَمَّ، ما إِن كان يتم الإعلان عن هذا البرنامج أو ذلك والأَسماء المشاركة حتى يتنَادَى الكثيرون، «اليوم، غادي يْكُونْ مُولْ البِّيبَّا»! وأذْكُر أن جريدتنا «المحرر» نَشَرَتْ آنذاك مقالةً عن هذا الجانب.
كنتُ أغتنم هذه البرامج لأكرر باستمرار وعن قصد اسم حزبي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) لأُسَجِّلَ بوضوح انتمائي، ولأؤكد بقوة حضورنا كحزب مشروع يتمتع بكل أسباب الشرعية الكاملة، وذلك لأَمْحُوَّ حالات الخوف والمضاعَفَات التي تبقت في ذاكرة الكثيرين من المحاكمات والملاحقات والمتابعات وصُوَر المَنْع التي عَانَى منها حزبُنَا ومناضلونا خلال سبعة عشر سنة. وكان لهذه البرامج أَثَر مُحرِّر إِلى حَدٍّ على المواطنين الذين لم يكونوا معتادين على متابعة ومشاهدة الاتحاديين في الإِذاعة والتلفزيون وسَمَاع وجهة نَظَرِهِم وحُجَجِهم كمعارضين عبر الأَثير وعلى الشاشات الصغيرة.
وفي اليوم الموالي، كانت المناقشات تخضع للتحليل في الإِدارات والمقاهي والمنتديات المختلفة، ولم يكن هناك، في الواقع، سوى الحديث عن تدخلاتنا. في النهاية، كان الرأي العام الوطني يُبدي التجاوب مع حججنا كمعارضة تمتلك خطاباً قَوِيّاً ومنسجماً.
ولم ينتظر رجال السلطة آنذاك كثيراً للقيام برد الفعل، فسرعان ما عَبَّرتْ تقارير عمال الأَقاليم والمكلفين بالمصالح الأمنية بجميع أصنافها، عن عدم الارتياح للنقاشات الإِذاعية والتلفزيونية، فقد اعْتَبَرَتْها نقاشات في غير صالح الحكومة ومن شأنها إِثارة الفتنة. وإذن فإن هذه المحاولة لإعطاء إمكانية إعلامية في الإذاعة وللأحزاب، خصوصاً المعارضة، أُقْبِرتْ في مهدها، رغم أن هذه البرامج كانت تُنْقَلُ وتُبَثُّ بشكل غير مباشر وتخضع للرقابة القَبْلية. وكانت السلطات المحلية والإقليمية تُلحُّ في إبداء هذا الموقف وتُعَبِّر بوضوح عنْ أنها لن تتحمل المسؤولية في ما قد يحدث نتيجة لذلك.
*
في هذا المناخ من غَضِّ الطَّرْف النِّسْبي، ونظرا لِشَعْبية الاتحاد الاشتراكي، اغتنم الحزب هذه الفرصة لمواصلة مجهوداتِهِ لتحسين وتقوية التنظيمات الاتحادية، وفتح العديد من الفروع الجديدة، في الكثير من المدن والمناطق برغم الصعوبات والحواجز التي كانت تضعها السلطات المحلية. ولكنَّنا هذه المرة، كنا نتوفر على وسائل الاعتراض عن طريق أعضاء الفريق البرلماني. بمعنى لم تعد الأوضاع هي نفسها التي كانت سائدة خلال سنوات حالة الاستثناء الطويلة.
وهكذا، استأنفنا أَنْشِطَتَنا وإشعاعنا الحزبي والقيام بعمل واسع من التفسير والتكوين والتأطير، وفي الوقت نفسه كنا نحاول أن نعكس بكل ما نمتلكه همومَ وانشغالاتِ وحاجياتِ المواطنين في جميع الواجهات، سواء في البرلمان وفي مختلف المجالس المنتخبة وكافة الجبهات الاجتماعية والثقافية والإِعلامية.
إِن حزباً اشتراكياً جديراً بهذا الاسم لا يمكنه أن يظل بدون أن يكون له امتداد في صفوف الطبقة العاملة. وهو سؤال طرحناه على أنفسنا غداة القطيعة مع التيار النقابي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية في يوليوز 1972، ولكن مرحلة القمع الطويلة والقاسية التي عاشها حزبنا منذُئذٍ لم تتح لنا أن نعيد تنظيم مناضلينا النقابيين الذين كانوا موجودين داخل الاتحاد المغربي للشغل في انتظار أيام أفضل. وهكذا، شكلنا داخل اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي لجنة عمالية وطنية تشرف على مختلف القطاعات العمالية الاتحادية.
واستجابةً لإِلحاحاتِ المناضلين النقابيين، وانسجاماً مع سيرورة التصحيح التاريخي لمسار الحركة النقابية المغربية التي شهدت لحظة الانحراف، دعم الاتحاد الاشتراكي مشروع إِنشاء مركزية نقابية جديدة، وهي التي سيُطلق عليها اسم الكونفدرالية الديموقراطية للشغل (CDT). وإِذن، على رأس أهداف اللجنة العمالية كان تحقيق هذا الهدف الأَساس، وقد تحقق بنجاح.
عَاوَدَ الاتحاد الاشتراكي انتعاشه من جديد عقب مؤتمره الاستثنائي، وذلك بإِعادة تأسيس منظمته الشبابية (الشبيبة الاتحادية) وتنظيم القطاع النسائي الاتحادي وعدة قطاعات مِهَنية على المستوى الوطني والمحلي مثل قطاعات المحامين والأَطباء والمهندسين والتجار الصغار والمتوسطين. وهو الجهد الذي تُوِّج بتأسيس الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في 25-26 نونبر 1978. لقد كانت لحظة ذروة في تاريخ الاتحاد الاشتراكي.
وكان خصوم حزبنا بالمرصاد. فأَمام هذا المدّ، والحماسة الخلاَّقة، والالتحام القوي مع عمقنا الشعبي وامتداداتها المجتمعية، امتدتْ أَيادي الغدر الآثمة لتغتال قائداً اتحادياً كبيراً، أخانا المناضل الشهم عمر بنجلون (1935-1975).
وعلمتُ بخبر اغتيال شهيدنا عمر بنجلون مساء ذلك اليوم (18 دجنبر 1975)، عَبْر مكالمة هاتفية من أخي وصديقي المرحوم عبد الرحمن القادري، وكنتُ في مقر الحزب بشارع الحسن الثاني في الرباط. ولم أستطع تصديق هذا الخبر المروع، لاسيما أنني قبل ذلك بأسبوع فقط كنا معاً في نفْس المقر نرتّب لأنشطة الحزب ومشاريعه الخاصة بالقضايا التنظيمية.
يومَها ردَّدَ الاتحاديون والاتحاديات ومعهم قوى اليسار والقوى المجتمعية الحية: «الإرهابُ لا يُرهِبُنَا والقمع لا يفنينا، وقافلة التحرير سَتَشُق طريقها بإِصرار». وهي العبارة التي صَدَحَ به المرحوم غداة توصله بطَرْدٍ بريدي مُفَخَّخ. كما كانت «مانْشِيتْ» بارزاً على صدر الصفحات الأولى لصحافتنا، وعلى شفاه الجماهير التي حملت نعش الشهيد إِلى مثْوَاه الأخير في مقبرة الشهداء في الدار البيضاء، ولا تزال حيّةً كالشِّعَار يذَكِّر الجميع بِشَرَفِ الاستشهاد وعَار الجريمة.
سنة بعد إِنشاء الكونفدرالية، قرر قطاعان من القطاعات العمالية الحيوية هما قطاع التعليم وقطاع الصحة العمومية خوضَ إِضرابٍ وطني مطلبي، في أبريل 1979، أرادت الكونفدرالية، وبقليلٍ من الاستعجال دون شك، أن تعطي البرهان –خلافاً لمنافسيها وبالخصوص الاتحاد المغربي للشغل- بأَنها مركزية نقابية مناضلة وليست بيروقراطية، وأنها تُعطي هذا البرهان في الميدان.
فكرتُ آنذاك، بعد بضعة أشهر على إنشائها، بأن على الكونفدرالية أن تنتظر إلى أن تتقَوَّى أكثر قبل أن تنخرط في أي معركة، لكنْ حَدثَ ما حدث.
وهكذا، جاءت حملة قمع شرسة في أَعقاب ذلك، تبعتها اعتقالات ومحاكمات وأحكام ثقيلة. والأسوأ، كان قرار السلطات بطرد مئات من رجال ونساء التعليم والصحة من وظائفهم مع سوء المعاملة بالنسبة للبعض إلى أقصى حالات التعذيب بالنسبة للبعض.
المنازعات الاجتماعية والمواجهات السياسية التي رافقت ذلك بكل ما كانت تتضمنه من قَهْر لم توقف نشاط الحزب، لكنها أبطأت المَدَّ الذي كان يلاحظه الجميع. ذلك، أننا انشغلنا بتنظيم حملة تضامن ودعم للمناضلين النقابيين المطرودين والمعتقلين وعائلاتهم. ومن ثم عدنا من جديد إلى المربع الأول، إلى نقطة البداية، دورة (المطالبة مقابل القمع) تستأنف نفسها مرة أخرى. وكانت هذه المواجهة أول مواجهة بعد إنهاء حالة الاستثناء مع استئناف بعض مظاهرها.
من الآن فصاعداً ستأتي كل سنة بطابعها السياسي المأساوي من المعاناة المادية والمعنوية. ولم تكن أزمة 1979 قد انتهت حتى حَلَّت أزمة 1980، السنة التي ستؤسس للأزمة التي كانت تلوح معالمها وستنفجر في السنة الموالية 1981.
في شهر ماي 1980، أعلن الملك عن تعديلين دستوريَيْن، أحدهما في 23 ماي والآخر في 30 ماي. وكان على الاتحاد الاشتراكي أن يحدد موقفاً من الاستفتاءَيْن معاً. ففيما يخص الاستفتاء الأول، الذي كان يتعلق بتعديلَيْن: الأول كان يهم رئاسة مجلس الوصاية التي سيُعْهَد بها –بمقتضى التعديل- إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى بدلاً من «أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى إبنه طِبْق الترتيب والشروط السابقة الذِّكْر» (النص – الفصل 20)، والآخر كان يهم تخفيض سن الرشد لسن بلوغ الملك من 18 إِلى 16 سنة (الفصل 21) ليُصبح بمقتضى التعديل: «يُعْتَبَر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عُمْرِه، وإِلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور».