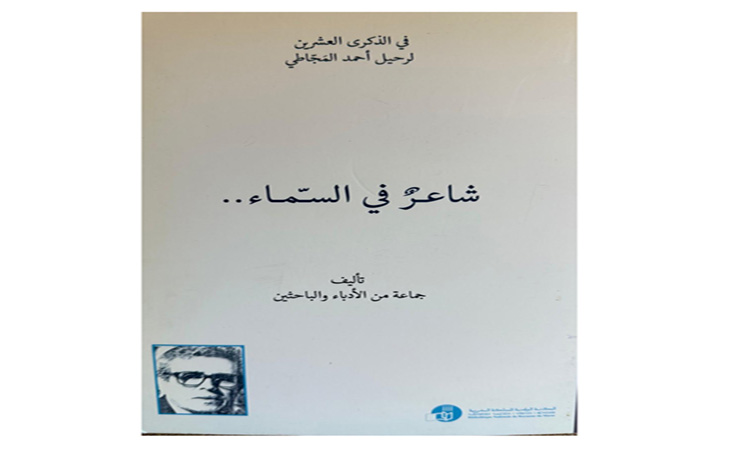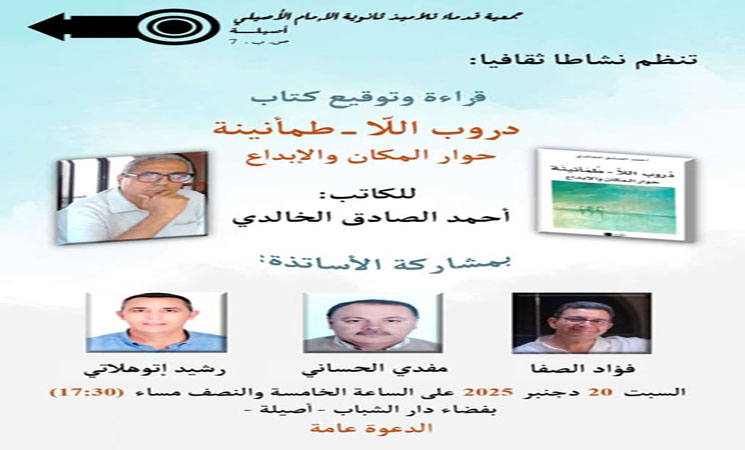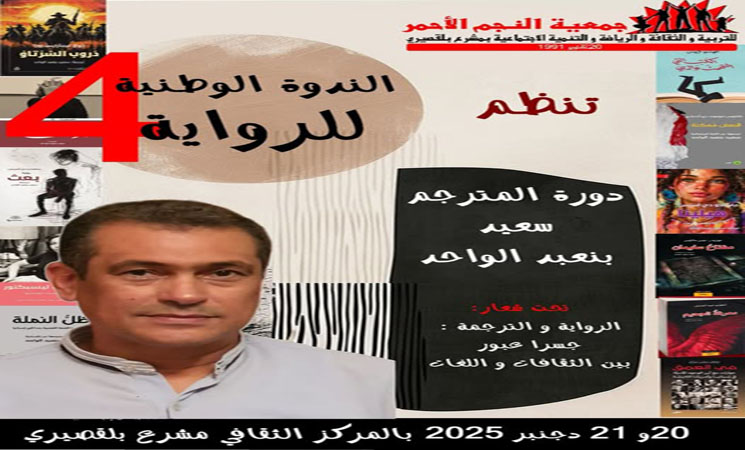في الشعر المغربي الحديث والمعاصر تختلف البِنيَة الشعريّة للقصيدة المغربيّة من مرحلة تاريخيّة إلى أخرى. فقد عرفت مرحلة السبعينات والثمانينات مرحلة جديدة من أساليب التعبير الشعري ببناء لُغوي، وصُوَر شعريّة جديدة، وفتح آفاق مختلفة للنص الشعري بتغيُّر البيئة الاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة، مع مشهد شعري جديد على مستوى القصيدة والإنتاج الشعري، بالإضافة إلى ما عرفته هذه المرحلة من دراسات جديدة عن الشعر المغربي. فالشعر المغربي الحديث يسعى إلى استكشاف آفاق جديدة منفتحة على إثارة السؤال والدهشة.
والشاعر أحمد المجاطي (المعداوي) من أهم الشعراء المغاربة المعاصرين، ومن أهم الدارسين والمنظرين للشعر العربي. فكتابه «ظاهرة الشعر الحديث» من أهم الكتب المهتمّة بإيقاع الشعر العربي ككتاب «ظاهرة الشعر المعاصر» لنازك الملائكة، و»الشعر العربي المعاصر» لعز الدين إسماعيل، و»قضية الشعر الجديد» لمحمد النويهي. ولا يكتمل هذا الكتاب إلا بدراسة كتابه الثاني «أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث». الشاعر أحمد المجاطي عاشقٌ للشعر وللسؤال الشعري. وكتاب «شاعر من السماء» من تنسيق وإشراف الشاعر والروائي أحمد المديني من أهمّ الكتب التي اهتمت بشعره وإنتاجاته النقديّة.
وقد طرح المجاطي العديد من الأسئلة االمعرفية النقديّة عن أزمة الحداثة، والإيقاع الشعري، وشعريّة القصيدة، وغيرها. وديوانه الشعري «الفروسيّة» لم يخلص كذلك من همّ السؤال الشعري مُدركًا بأهمية السؤال في بناء المعنى وتأسيس المعرفة للوقوف على أسرار الحياة والكوْن. فهو يوغل بنا دائمًا إلى حقائق الأشياء وشعريتها. يقول في قصيدة «السقوط» من ديوان «الفروسية»:
تَلبَسُني الأشياءُ/ حينَ يرحلُ النَّهارْ/ تَلبَسُني شوارعُ المَدينَهْ/ أسكُنُ في قَرارةِ الكأسِ/ أُحيلُ شَبحي/مَرايا/ أرقصُ في مَمْلكةِ العَرايا/ أعشقُ كلَّ هاجِسٍ غُفلٍ/ وكلَّ نزوةٍ/ أميرَهْ/ أبحرُ في الهُنيهةِ الفَقيَرهْ/ أُصالحُ الكَائِنَ/ والمُمكنَ/ والمُحالْ/ خرجُ من دائرة الرَّفضِ/ ومن دائرةِ/ السؤالْ/ أُراقِبُ الأمطارْ/ تَجفُّ في الطَّوِيَّةِ/ الأمَّارَهْ تسعفني
الكأس ولا/ تسعفُني العِبارَهْ/ لكِنَّني أقولْ/ شَربتُ كأسي فاشْربِي/ أيتُها البِحارْ.
قصيدة «السقوط» هي قصيدة العلاقة بين الذات والأشياء. فقد أثار هايدغر التساؤل عن الشيء بطرق مختلفة. فالوجود عنده يتجلى من خلال اللغة. فلا يوجد هناك شيءٌ حينما تكون اللغة مفتقدة. فالكلمة هي التي تسمّي الشيء. لكن معادلة الأشياء عند المجاطي تنقلب حين تلبس الشاعر فيصبح غريبًا في مدينة غريبة «تَلبَسُني الأشياءُ». وحين يرحل النهار تلبسه شوارع المدينة. إنه نوع من شعر الرؤيا، بحيث يعبّر الشاعر عن رؤياه للحياة والوجود للتعبير عن تجربته الإنسانيّة. فكثيرًا ما كانت تمثل المدينة في هذه المرحلة الاغتراب والانكسار وهو ما نجده عند العديد من شعراء الحداثة الشعرية العربية. والمدن حاضرة بقوّة في ديوان « الفروسية». فهو رحلة وعبور وسفر من شاطئ طنجة، وتطوان، وفاس، والدار البيضاء، ومراكش، إلى سبتة وغرناطة وأسوار دمشق، والقدس وغيرها.
إن البحث عن الأشياء عند الشاعر لا يأتي إلاّ بالتصالح مع الذات والمستحيل، والخروج من دائرة الرّفض ومن دائرة السؤال. لكن الخروج من دائرة الرفض والسؤال يأتي للتمعّن أصلاً في الأشياء «وفي الأمطار التي تجفّ في الطويّة الأمّارة». إنه نوع من فلسفة الأشياء لمساءلة الإنسان والزمن والحياة والتّوْق إلى اللانهائي. «شَربتُ كأسي فاشْربِي/ أيتُها البِحارْ.»
فالكأس تسعفه ولا تسعفه العبارة في هذا العُري الوجودي الذي تعجز فيه اللغة عن التعبير. ومن الملاحظ أن حضور ضمير المتكلم في النص الشعري يجعل من النص مونولوجًا داخليًّا. والاستجابة للكأس بدل العبارة نوعٌ من الإحساس بالاستسلام لِما كانت تعرفه البيئة الثقافيّة المغربيّة من اضطرابات سياسيّة واجتماعيّة، منها الأحداث التي عرفها المغرب مرحلة الستينات كانتفاضة الدار البيضاء سنة 1965، وهزيمة 1967 على الصعيد العربي. وقد كان الشاعر يحسّ بنوعٍ من الحزن والضياع. يقول في «قصيدة الفروسيّة» التي تحمل عنوان الديوان:
سَحَائبُ مِن نَشوةِ الغُبارِ/ في السَّاحَهْ/ تَصفعُ وجهَ النَّجمِ/ أوْ تصوغُ أشباحَا/ من خَببٍ بطيءْ/ والخَيلُ تعلكُ المَدى/ تدكُّ ألواحَهْ/ بالشَّدِّ (عمامة) والمجدولِ (حمّالة الكمية) والكُمِّيّهْ (خنجر)/ والكَفُّ في معارِك الجَوادِ/ والْوجهُ الذي لاحَ/ من خَلَلِ الزِّحامْ/ وعُورةُ اللِّحامْ/ للرِّيحِ مَرْمِّيهْ،/ وتَنْتَشِى زُغرودهْ/ تهلُّ أَو تُضيءْ/ ويستفيقُ الثَّلجُ/ في أحشاءِ/ بارودَهْ.
لقصيدة المجاطي اهتمام كبير على مستوى التلقّي. ومع ذلك فهي تحتاج إلى المزيد من الدرس والقراءة. فصوره الشعريّة زاخرة بالمعاني والإيحاءات، ومنفتحة على السرد القصصي، وعلى مشاهد مسرحية، وعلى فنّ التشكيل. فقصيدة «الفروسية» مثلاً تجمع بين جمالية الصّوَر الشعرية والصُّوَر الشعرية البصرية. فهي بمثابة لوحةٍ جداريةٍ تمتاز بسعة التّخييل. فالسحاب، والغبار، والفرسان، والخيل، والنجم، والزغاريد تتّحد في كُتَل ضوئية تصفع وجه النجم لتشكّل ظلالاً متحرّكة لكثافة الغبار. فيتحوّل المكان إلى فضاء بصري حيّ امتلأ بالغبار. والغبار «سحائب من نشوة»، فهو ليس عابرًا بل كُتلة مهيمنة. وبين السماء والأرض تتشكّل الأشياء هي صورة «التبوريدة» في تراثنا الشعبي، الغنيةٌ بالألوان والزخارف البصرية كالخنجر، وحمّالة الكمية، والعمامة. والخيل ترسم بخطوطها حركة من خبب بطيء. وتعْلِك المدى كأنها تعيد تشكيل الأرض. إنها لحظة إطلاق البارود كضوء وثلج يذوب لحظة الانفجار. وتأتي الزغاريد كلحظة فرح جماعي. هكذا يعيد الشاعر صياغة طقس «التبوريدة» بلغة تجريدية تشكيلية من خطوط، وألوان، وظلال، وحركة.
لقد كُتب الكثير عن ديوان «الفروسية». لكن رغم كلّ ما كُتب عنه فهو يحتاج دائمًا إلى المزيد من الإبحار في عوالم المعداوي الشعريّة الخلاّقة. فقصيدته «ملصقات على ظهر المهراز» هي ملصقات بصريّة تشكيليّة في ثلاث ملصقات، أو بالأحرى ثلاث لوحات، وغيرها من القصائد.
إنّ قصيدة المجاطي كيان حيّ متفاعل لشاعر أثار العديد من الأسئلة في تفاعل بين الشعري والسردي والفنّي البصري. وقد امتازت بصُوَر شعريّة مرئيّة خلاّقة تحتاج لأكثر من قراءة وأكثر من تأويل.
1 – ديوان « الفروسية» صدر عام 1987 والتي كتبت قصائده ما بين 1962 و1977 ما عدا قصيدة «الحروف» التي كتبت عام 1985. وقاز بجائزة ابن زيدون للشعر التي يمنحها المعهد الإسباني العربي للثقافة بمدريد لأحسن ديوان بالعربية والإسبانية.