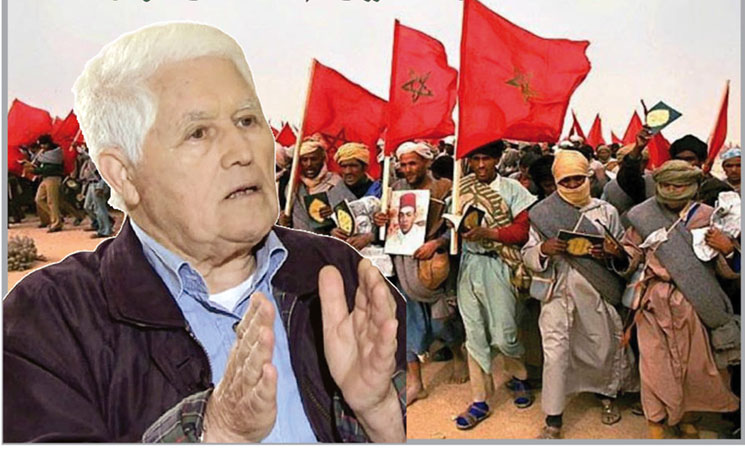تفرض الظرفية التاريخية التي يمر منها العالم ومنه العالم العربي، شروطًا جديدة يتعين على العمل الفكري أخذها بالحسبان والاعتبار. هناك، على الأقل، خمس معاينات يمكنها تحديد عملية التفكير في الفاعلين الذين يفرضون ذاتهم على الفهم ويحركون التساؤل:
ترتبط أول معاينة بالاختلالات التي تعرفها العلاقات الدولية. نشهد حروبًا جديدة غير متكافئة، خصوصًا بعد الحادي عشر من شتنبر 2001، مرورًا باحتلال العراق، وتفجير المنطقة العربية بعد 2011. وقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية أهم فاعل في هذه الأحداث، ولا تزال تصنعها من خلال مختلف الأحلاف التي تشكلها لمحاربة «عدو» غالبا ما تعمل هي على صناعته؛
تتمثل المعاينة الثانية في حركات العولمة الاقتصادية والتواصلية، على الرغم من التعثرات التي تشهدها بين الفينة والأخرى (الأزمة المالية في خريف 2008 وتداعياتها المستمرة إلى الآن). كل شيء يتعولم، لدرجة أن الدول لم تعد، وحدها، قادرة على احتكار «العنف الشرعي»، أو التحكم في الآلة الإنتاجية والمالية بشكل كامل؛
أما المعاينة الثالثة فتتجلى في بروز أوجه جديدة للضحية، الفردية والجماعية. وكأن الكل أصبح يتقدم إلى المجال العام في هيئة ضحية يطالب بالاعتراف بما تعرض له من اعتداء، أو ظلم، أو استبعاد.. الخ. ولعل صور الضحية اليوم تستدعي تفكيرًا جديدًا في ظاهرة العنف، أو بالأحرى في الآليات الجديدة التي بدأ العنف يعبر بها عن مضمونه الثقافي؛
وتتعلّق المعاينة الرابعة بالدور الاستراتيجي لوسائط الاتصال، وللموقع الاجتياحي للتلفزيون؛ فمن وسيلة اتصال أصبح، أكثر فأكثر، سلاحًا حربيًا يساعد على التموقع والتأثير، وأداة غذت التجليات الجديدة للسلطة تعبر عن ذاتها بواسطة الصور والأصوات. نفس الأمر ينطبق، بطرق مغايرة، على الأنترنت؛
أما المعاينة الخامسة فتتمثل في تداعيات الاهتزازات، ومختلف أشكال التحولات التي تمخضت عن الانتفاضات والحركات الاحتجاجية العربية، التي انطلقت منذ 2011 ولا تزال، ضد الاستبداد وسياسات إذلال الكائن، وما تمخّض عنها من حروب أهلية مسلحة زادت في تأجيجها تورّط قوى إقليمية ودولية، ومنحتها أبعادا بالغة المأساوية.
اعتبارا لذلك يفترض الحديث عن الثقافة أو الإشكاليات الثقافية الراهنة، اليوم، كثيرًا من الحذر والتواضع، بسبب التباس الخطابات وسرقة المبادئ وتشويهها. فالحديث عن القضايا الثقافية الحالية أو الآتية حديث إشكالي وغير برئ، يترجم حالات مختلفة من الغُمّة والقلق، ويتطلب يقظة خاصة في مواجهة مختلف أشكال اللايقين والتعقد التي تشهدها مختلف المجتمعات العربية، كما أنه يزج بالمرء في حالات من الخوف، جراء مختلف أسباب العنف والاقتلاع، والصعوبات التي تعترض السياسيين والنخب، الكبار وغير الكبار، على توقع أو تخيُّل المستقبل.
أولويات السياسة وسؤال الثقافة
في كتابه «التجريد التَنَبُّئِي» L’abstraction prophétique طرح الفنان»جورج ماتيو» جملة أسئلة أجدها تنطبق على وضعيتنا بحكم كونها تتميز بكثير من الراهنية.
ويمكن صياغة أسئلة «جورج ماتيو» كالتالي: ما هي الأولويات الحقيقية بالنسبة لدولة حديثة؟ هل هي الرفع من مستوى العيش وإيجاد العمل والشغل؟ هل هي العدل في الضرائب؟ هل هي ضرورة تحصيل النمو الاقتصادي، وضبط النظام والأمن؟ هل هي تنظيم وسائل الترفيه وإشعاع الثقافة؟ أم هي التعبير عن إرادة فعلية للإعلاء من شأن الإنسان؟
هل يتعين علينا أن ننتظر ترقية الإنسان تتحقق لِوَحْدِها أم علينا أن نستثمر كل الجهود من أجل انتصار الكينونة على المِلْكِية، وتغليب الكرامة الإنسانية على الغرائز البدائية؟ هل يجب علينا أن نُوجه الثقافة ونوفر شروط تنميتها، أم نترك الحرية للمصالح الخاصة والمالية لتخريب ما تبقى من إنسانية حقيقية؟
يُطرح هذا النمط من الأسئلة على كل مثقف وعلى كل سياسي يؤمن بضرورة إدماج الثقافة العصرية في أي مشروع نهضوي. قد يقال بأن هذه الأسئلة كافة تستدعي أجوبة ضرورية ومناسبة. وهذا بديهي. كما يمكن أن ينعت البعض هذه الأسئلة بكونها من النوع «التجريدي»، والطوباوي التي يتخيلها المثقفون الحالمون بمجتمع إنساني عادل. وهذا اتهام لا يمكن قبوله نظرا لقدرات الفكر والإبداع على التأثير في التاريخ وفي المجتمع؛ ولا سيما في المجتمعات التي عاينت المكتسبات التي جناها الناس من الفن والثقافة في حياتهم وعيشهم، فمصداقية كل سياسة ثقافية تتمثل في كونها تستمد عناصرها من عملية تأسيس فعلي لمقومات مادية، وفضاءات ثقافية تسمح بتفتح الإنسان وتوفر له شروط التعبير عن ملكاته وإبداعيته.
قد نسلم بأن لكل سياسة أولوياتها؛ لكن ألا نسمع أن الثقافة والفنون والمعارف تشكل «حاجات حيوية للإنسان»، ويتعين أن تكون على «المستوى الأول من اهتمامات الدولة»؟
معلوم أن أغلبية المثقفين العرب ركزواعلى أسئلة النهضة والتراث والحداثة، ودعت نخبة كبيرة منهم إلى الأخذ بمقومات الثقافة العصرية، التي تعطي الأولوية لحقوق الإنسان، والتربية على التفكير وعلى الحرية: حرية الضمير والتعبير والمبادرة، والابتكار، وعلى المسؤولية في السلوك قصد إقامة مجتمع سياسي يعتمد على التعاقد بين إرادات أفراد أحرار، لأن أي نهضة لا تتأتى بدون أسس ثقافية ورأسمال اجتماعي يمثل جُماع قيم وأخلاقيات ودراية تُكتسب ويتم نقلها بالتربية التي توفرها الأسرة، بالتعليم الذي تقدمه المدرسة والجامعة، وبرصيد القيم والسلوك في المجتمع، وقدرة المؤسسات على إنتاج النخب والكفاءات.
غير أن ما يشهده العالم العربي من ارتجاجات وانتفاضات وتغيرات في السياسة وفي الثقافة، ومن أسئلة حول طبيعة الدولة، وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية، ومن تحولات في وظائف الفكر، دفع بعدد كبير من المفكرين والباحثين إلى إعادة صياغة معرفية ونظرية لقضايا تهم السبل الأنجع لإعادة الاعتبار للإنسان، من خلال مراجعة لأساسيات الدولة التسلطية التي ارتكزت، بشكل مُعلن أو مُتستر، على مرجعيات تُشَرْعن للاستبداد ولعلاقات الراعي بالرعية، حتى وإن تظاهرت بعض أنظمتها بمواجهة الإسلام السياسي، والانفتاح على أسباب التحديث، أو دخلت في بهلوانيات انتخابية للتغطية على التسلط.
ولعل عقودًا من الوصاية على الذكاء، ومن الحِجر على الإرادة والحرية جعلت من مختلف الأنظمة السياسية العربية التي هيمنت عليها، في الغالب الأعم، أنظمة عسكرية، أو أولغارشية أصولية تصنع سُلطًا تَغوَّلت فيها الدولة حتى صارت في مواجهة مجتمع لا تجرؤ شرائحه على التعبير عن مطالبها، أو عن رغبتها في المشاركة السياسية، إلى أن انتفضت ساحات عربية عديدة في وجه سياسات الإذلال للمطالبة بالحق في أن تكون للناس حقوق وكرامة.
لذلك يشعر المرء، وهو يباشر الحديث عن «الفكر العربي والإشكاليات الثقافية الراهنة» بالأسى لِما بلغته درجات الاستخفاف بآدمية الإنسان، وتنامي الانتقاص من الذكاء والتفكير، والخوف من الحرية. لقد دخلت نزعات التشكيك في الفعل الثقافي ودعوات التكفير في فوضى غير مسبوقة، سواء ضد المفكرين والمثقفين، أو ضد المختلفين في الملّة والمذهب.
فكيف يمكن الحديث عن الثقافة والمعرفة والنقد أو «الحوار» الديني، أو المذهبي، أو السياسي، أو الفكري في مناخ التحريض باسم الدفاع عن الدين، وفي زمن النزوع الاستبدادي الجديد الذي أفرزته الاحتجاجات في بعض البلدان العربية؟
إن تراكمات الممارسات الاستبدادية، وسياسات منع التفكير والنقد والمشاركة والحرية، وما تمخض عن عمليات خلخلة الاستبداد في مسلسلات الانفتاح المتعرجّة، والمترددة، والعنيفة التي نشهد عليها في مختلف البلدان العربية، سمحت ببروز قوى وظواهر سياسية وثقافية تصرّ على ممارسة السياسة باسم الدين، أو تدبر شؤون الوطن بخلفيات يحكمها منطق المذهب، أو الطائفة، أو «الحزب الأغلبي». ويحصل ذلك في سياق عام يتميز بنقص كبير في المعرفة النافعة والثقافة العصرية. فضلا عن أن النظام التقليدي (القبلي، العشائري، النَّسَبي..) يواجه التغيير بمقاومة قوية حيث يربط البنيات الحديثة (الإدارية، الأخلاقية، والدينية..) مع التقليد تسويات غريبة من نوعها. بل إن الثقافة الحديثة تظهر، دوما، وكأنها انبعاث ما للتقليد؛ وهي مظاهر لا تكف تعيد إنتاج مقوماتها في مجالنا العربي.
نحن بإزاء «قلق وجودي»، بحكم أننا نعاني أعطابا كبرى ولا نعرف كيف نخرج منها أو نخفّف منها علينا، وهي أعطاب تتمثل أسبابها الرئيسة في الحرص المستدام على إذلال الكائن، بفعل تَجبُّر السلطة، والتطبيع مع الفساد، واستبعاد الثقافة العصرية والفكر النقدي.
النهضة بالتكنولوجيا أو النهضة بالثقافة
كيف يمكن مواجهة القضايا الثقافية، اليوم، أو مواجهة تمظهراتها المختلفة من دون استحضار جملة تحولات تهمّ كيفيات التفكير في مهام الفكر ذاته،علما بأن الفكر العربي المعاصر عمل، طيلة القرن العشرين، على الدعوة إلى نقد النماذج التكرارية التي تعيد إنتاج الماضي، وألح على الحاجة إلى بيئة حاضنة للإبداع، لكن، من مفارقات هذا الفكر أنه يواجه استقبال الجديد والحديث داخل بنيات يطغى عليها التقليد، المتمثل في الذهنيات، وفي التشكيلة الاجتماعية، وفي العلاقة بالمرأة، وبفوضى المدينة، وفي النقص الظاهر في الثقافة العصرية، وفي مختلف مظاهر مقاومة تلقّي الجديد.
واعتبارا لهذه المقدمات لا مناص من مواجهة أسئلة من نوع قد يبدو مغايرا:
كيف يمكن تصور تجديد النظر في القضايا الثقافية الراهنة من دون استحضار رهانات المعرفة النافعة، وبأوجه استثمار المعرفة لتغيير شروط الحياة لما هو أفضل؟ وماهي السياسات المناسبة لتوفير شروط دمقرطة المعرفة والثقافة، وخلق «عدالة معرفية»، مع خلخلة أنماط الممارسات الثقافية المسيطرة ذات المضامين السحرية؟
لقد أمسى من قبيل البديهي القول إن الاستثمار في المعرفة وفي الثقافة، إذا حصل ضمن تصور نهضوي يمتلك مقومات وأبعادا تاريخية، ينتج عنه الارتقاء بالإنسان وتحسين أحواله وتأمين كرامته. فالنهضة لا تتحقق بالتكنولوجيا فقط، باعتبار أن هذه الأخيرة يمكن اقتناؤها بالمال واستعمالها بالتكوين والتدريب. المشكلة تتمثل، بالأساس، في تحضير رأسمال بشري قادر على المبادرة والالتزام، وفي إنتاج أشخاص قادرين على الإبداع في الإنسانيات وفي الثقافة التي اعتمادا عليهما يمكن بناء الإنسان نفسه. من هنا أهمية الوعي برهانات الثورة الرقمية وتباين المواقف إزاءها؛ وسواء كنا متحمسين لها وللذكاء الابتكاري الاستثنائي الذي سمحت بتفجيره، أو كنا قلقين من سطوتها ومن مخاطر الإدمان عليها ومن مظاهر الاستلاب التي تنتجها، فإن هذه الثورة التي هزت جميع المرجعيات والتراتبيات تساهم، بشكل غير مسبوق، في دمقرطة المعارف وتوفير المعلومة، كيفما كانت طبيعتها، لأكبر عدد ممكن من الناس.
ثم هل يمكن الحديث عن الثقافة بدون استحضار أو إعادة الاعتبار لقيم كبرى مثل الحرية والمساواة والعدالة والكرامة؟ وما هي الفرص المتاحة، أو التي يمكن خلقها، لمحاصرة «›ذهنية» متجذرة تشوش، دائما، أو تمنع الثقافة العصرية من التوطين، وتعرقل شروط الاستفادة من إبداعاتها؟
هذه بعض الأسئلة التي توحي بتضمنها لبعض عناصر الجواب، لكن لا يظهر أنه بالإمكان تفاديها في كل حديث عن الثقافة. وهي على كل حال أسئلة تحضر، باستمرار، كلما تجددت المناقشة حول الموضوع في التاريخ المعاصر لبلداننا.
سوف لن أتعرض للمسألة الثقافية من زاوية ضرورة وضع أسس لاقتصاديات الثقافة، أو للصناعات الثقافية، أو للسياسات العمومية المتعلقة بحقول ووسائل التعبير المتنوعة، من كتاب، ومسرح وسينما، في علاقاتها بسياسات الإعلام والشباب والرياضة، وأماكن العيش في المجال العام، أو لضرورات إدماج المضامين الثقافية في التعليم، أو قضايا المدينة والمرأة…سوف لن أعود إلى ما أصبح من قبيل البديهيات.
ما أود الاقتراب منه سوف يقتصر على تناول مفاهيم قد تبدو مجردة لكنها، في ظني، تشكل البنية التحتية لكل ممارسة أو حركية ثقافية متجددة ومنتجة، والمتمثلة في مفاهيم الحرية، والاعتراف والكرامة.
في الحرية
شغلت مشكلة الحرية الفكر العربي الحديث والمعاصر منذ رفاعة الطهطاوي إلى عبد الله العروي، مرورا بكبار الليبراليين العرب، إلى من انخرط في الحركة الحقوقية من جل التيارات والحساسيات الفكرية والإيديولوجية. سعى الفكر العربي طيلة قرن ونصف إلى استنبات، أو على الأقل إلى إقامة تبادل مُنتج مع قيم الحداثة، ومنها قيمة الحرية، غير أن هذه المحاولات واجهتها مقاومات متنوعة المصادر والمصالح، مقاومات متجذرة في اللاوعي الجمعي، ذات طبيعة ذهنية، سياسية، اجتماعية واقتصادية، ينخرط عدد من الفاعلين والوكلاء النشطين على تعبئة الرأسمال الديني في تقوية هذه المقاومات.
وقد بقيت فكرة الحرية رهينة اعتبارات إيديولوجية، كما يلاحظ أغلب الباحثين في الفكر العربي المعاصر؛ إذ يعتبر عبد الله العروي أن ليبراليا مثل أحمد لطفي السيد حمل فهما « ما قبل ليبراليا» للحرية. لقد منح أهمية حاسمة للعامل السياسي ولإصلاح نظام الدولة، ورأى أن «واجب تحرير الإنسان من السحر يمكنه أن ينتظر، لكن من المستعجل الحد من سلطة الحاكم بواسطة البرلمان». ويخلص العروي إلى أنه إذا «كانت الحرية شعارا، مفهوما أو تجربة، فيتيعن التمييز بين التجربة وطريقة التعبير عنها». لذلك فالحرية، سواء في الزمن الليبرالي أو في غيره من أزمنة العرب، ليس سوى مجرد شعار، لأن مفهومها لم يكن واضحا ولا متجذرا في الأذهان أو مُحَقَّقا في الواقع، والأنكى أن يكون مترجما في سلوكات. والسبب؟ هنا يلتقي العديد من مفكرينا، ومنهم عبد الله العروي وناصيف نصار في إرجاع السبب إلى غياب الاستيعاب المعرفي والتاريخي لمفهوم الحرية.
لا شك أن أسبابا عديدة حاسمة ساهمت في حشر مسألة الحرية، والنزعة الليبرالية بالأخص، في مأزق؛ منها إنشاء الدولة الصهيونية، المُؤَسسة على إيديولوجيا دينية وحربية، والانقلابات العسكرية التي شهدها العالم العربي منذ خمسينات القرن الماضي، وهزيمة يونيو 1967، والصعود المدوي للتطرف الديني المسنود سياسيا وماديا. على الرغم من ذلك واعتبارا لما يجري أمامنا من استخفاف بالكائن واعتداءات على الحريات، أعتبر أن قضية الحرية ليست فقط قضية سياسية أو قضية معرفية وتاريخية، وإنما هي في طليعة القضايا الثقافية.
تُعرّف الحرية بكونها تلك القدرة التي تميز الكائن العاقل،وتسعفه فيالقيام بأفعال تعبّر عن إرادته هو، من دون وصاية أو ضغط خارجي أو خضوع لأي شكل من أشكال الاستعباد، أو الارتهان لسلطة استبدادية.
لقد قال الفيلسوف سبينوزا في كتابه»رسالة في اللاهوت والسياسة»: «لو كان من السهل السيطرة على الأذهان مثلما يمكن السيطرة على الألسِنة، لما وجَدَت أية حكومة نفسها في خطر، ولما احتاجت أية سلطة لاستعمال العنف،ولعاش كل فرد وفقًا لهوى الحُكام… ولكن الأمور لا تجري على هذا النحو…».
لا شك في أن نصّا بهذه الكثافة الفكرية لا يزال يطرح علينا أكثر من سؤال، اليوم، حول حالة حرية التفكير والإبداع، وأدوار مختلف السلط في ممارسة أو الميل إلى ممارسة الوصاية على الألسن والأذهان، باعتبار أن الحِجْر على الأفكار والصور، كان ولا يزال، من أعقد الإجراءات التي يمكن لسلطة ما اتخاذها.
والحال أن الخطابات التي تدعو إلى الحرية لا حصر لها، وقد تُثَبَّت في المقتضيات الدستورية للبلدان العربية؛ بل إن كل الأنظمة، حتى أكثرها تسلّطية، تدّعي حمايتها وتمثيل قيمها؛ في الوقت الذي نفاجأ فيه، باستمرار، بإجراءات وقرارات تنتهك مبدأ الحرية وتدوس عليه بمصادرة الأعمال الفنية والإبداعية، وتقيد الحرية وتصادرها باسم قوانين خصوصية وتحت ذرائع وتبريرات متنوعة؛ تارة باسم حماية الدين والأخلاق، أو بمحاصرة خطر المس بالحياء العام، وتارة أخرى بدعوى ضغط التيارات المحافظة في مجتمعاتنا. كما أن المبدع قد يضطر، أمام مختلف تمظهرات المراقبة والوصاية، إلى ممارسة رقابة ذاتية على أفكاره وصوره لكيلا يعرضها للمنع أو التضييق، أو التشويش على مآلها التواصلي.
وهكذا تحضر الرقابة في عوالم الإبداع بطرق متنوعة، وتفرض الوصاية على حرية التعبير بشتى الذرائع والمستندات، غير أنه من مفارقات الرقابة أنه غالبا ما تُحصّل على ما يخالف هدفها؛ ذلك أنها كلما قررت ممارسة فعل حجز العمل الإبداعي ومنعه من النشر أو التوزيع، كلما كان ذلك سببا في شهرته ودفع الناس إلى البحث عنه حتى ولو كان غير ذي قيمة مضمونية أو جمالية، لا سيما بفضل ما توفره الوسائل الرقمية اليوم.
ولكيلا ندخل في عملية تبيان «أنواع» الحرية، ومجالاتها، يمكن القول بالإجمال بأن الحرية هي الوضعية التي يكون فيها شخص ما، مُبدعا كان أو غير مبدع، غير مُعرض لإكراه أو استعباد أو إقصاء يمارسه شخص أو سلطة قهرية. وتكون الحرية تجسيدا لإمكانية الإبداع استنادا إلى «إرادة» الشخص الخاصة، سواء كان ذلك في إطار اجتماعي أو سياسي أو ثقافي، لكن شريطة عدم تهديد حرية الآخرين أو المس العنيف بالأمن العام.
من هذا المنطلق اعتبر «أمارتيا صن» بأنه لابد من ربط الحريات ببناء القدرات وبقضية التنمية. فعالمنا يشهد مظاهر حرمان وفقر واستبعاد، والحال أن الهدف الأسمى للثقافة وللتنمية يتجلى في تجاوز هذه المظاهر والاعتراف بالحرية؛ وبفقدانها أو التضييق عليها تتقلص اختيارات الناس والشباب منهم بوجه أخص، وتتراجع إمكانيات المبادرة والمشاركة والعطاء.
فالحياة لا تختزل في قدرة الإنسان على توفير مدخول، وإنما تقاس بتقدير كرامة الإنسان وبجودة الحياة باعتبارهما مقياسي الحكم على بلد من البلدان.فإذا تمكنت الدولة من خلال سياساتها العمومية على الربط بين الحرية والكرامة والمساواة، بواسطة القوانين والمؤسسات، فإنها تشجع مواطنيها، ولاسيما الشباب والنساء، والمثقفين على تفجير قدراتهم والانخراط أكثر في المسارات المتنوعة للإبداع والفعل الثقافي.
معضلتنا أن مؤسسات التنشئة والفضاءات الثقافية ووسائط الاتصال نادرًا ما تهتم ببناء الذات وتحفز على الحرية والإبداع، أو تذكي الحس النقدي، أو تحث على المشاركة، بل إنها تعزز، على العكس من ذلك، لدى الناشئة والجمهور ( أو لدى المواطنين) حالات من التقبّل السلبي والعجز، وذلك بسبب غياب من آلية أهم آليات الزمن المعاصر المتمثلة في الاعتراف.
الحاجة الحيوية للاعتراف
تثبت الوقائع أن للحرية كُلفة لا بد من تقديمها لبناء الذات والجماعة القادرة على ترجمة الاعتراف بالحداثة والثقافة العصرية في أبعادها المجتمعية وليست النخبوية فقط، وعلى إطلاق ديناميكية ثقافية ومجتمعية منتجة، حقا، للأحداث وللرموز وللآثار.
من هنا الأهمية الحاسمة لقيم الاعتراف، فهو إلى جانب الثقة، يمثل أهم أسس الفكر العصري والنظر الحديث للإنسان والعمل والإبداع.
قد يقال: كيف يمكن استدعاء مفهوم تجريدي كالاعتراف ونحن بصدد معالجة قضايا الفكر العربي والإشكاليات الثقافية الراهنة؟
الاعتراف هو مجموع العلاقات أو المؤشرات التي بواسطتها تأخذ هوية الآخر بعين الاعتبار، يندرج ضمن سياق ثقافي يجعل منه حافزًا على العطاء والمبادرة،وآلية لإنتاج الرضا.
لقد سبق لهيغل أن طرح السؤال التالي : ماهي الرغبة الأساسية للإنسان؟ واعتبر أن الجواب البديهي هو أن يكون الإنسان سعيدًا بلا شك، ولكن كيف يمكنه بلوغ السعادة؟ في سياق جوابه لاحظ أن عملية بلوغ السعادة يحركها طموح عميق لدى الإنسان في علاقته بالإنسان، لأن كل واحد يريد أن يكون معترفًا به من طرف الآخرين بوصفه وعيًا بالذات. إلا أن تحقيق هذه الرغبة ليست مباشرة، وإنما تمرعبْر نضال يبذل كل واحد بواسطته المجهود الضروري لترجمة الاعتراف إلى إحساس بالرضا، والى أفعال وعلاقات.
الحاجة إلى الاعتراف، إذن، نتاج بناء اجتماعي يتحدد حسب البيئة، والنظرة إلى الإنسان، والثقافة السائدة. ويرى «دوركهايم» أن الإنسان الذي يقوم بواجبه يجني التعاطف والاعتبار والمحبة، التي يحملها عنه أقرانه، ويجد نوعًا من التعبير عن الارتياح الذي غالبا ما لا يعيره أي اهتمام، لكنه على العكس من ذلك، يدعمه ويرفع من شأنه. ذلك أن الشعور الذي يحمله المجتمع عنه يرفع من قيمة الشعور الذي يحمله عن نفسه. ويولد « التناغم الأخلاقي» مع الأقران والمعاصرين ثقة أكبر في الإنسان، وحماسة أكبر في العمل.
ولعل المجتمع الذي ينتظم ويشتغل بشكل سليم، وحسب قواعد قانونية وحقوق محترمة، يشجع الإنسان على إيجاد معنى للحياة، في حين أن مجتمعًا يواجه صعوبات في استنبات واحترام القانون، واستخفافًا بقيمة الإبداع والمعرفة، سيبقى يعاني من أسباب الخصاص والخلل، ومن التباسات الوعي بقيم الحياة.
لماذا يشكل الاعتراف مسألة مهمة بالنسبة للناس؟ ولماذا يشكل غيابه سببًا من أسباب الانهيار والتردي أو سببا يدفع الناس إلى الانخراط في مسار النضال من أجل انتزاعه وإقراره؟
يرى « شارل تايلور»، في مقاله الشهير «سياسة الاعتراف» (1992)، أن مطلب الاعتراف يرتقي إلى مستوى اعتباره «حاجة إنسانية حيوية».
وفي كتاباته حول الاعتراف، وانطلاقا من قراءة خاصة لهيغل، يعتبر «أكسيل هونيت» (2) أن الاعتراف يمثل حالة من ثلاثة أنواع من المواقف المتداخلة وهي: الحب، الاحترام، والاعتبار؛ غير أن أهمية هذه المواقف مُزدوَجة، إذ سيكون من الصعب، في نظره، إن لم يكن من المستحيل بالنسبة لفرد ما لم يعرف تجربة الاعتراف (أو يمكن أن يكون موضوع اعتراف) أن يحافظ أو يُنمّي مواقف إيجابية إزاء الذات، سواء على مستوى الثقة في الذات، أو احترام الذات أو اعتبارها. وبغياب هذه العلاقات الإيجابية يفتقد الفرد، بالقوة، الموارد السيكولوجية الضرورية لتحقيق الذات، ولتفتحه وتحريره باعتباره كائنًا إنسانيًا. فضلا عن أن الاعتراف، من جهة ثانية، يمثل أداة، إن لم يكن الأداة الحاسمة في الاندماج الاجتماعي.
الاعتراف، إذن، أداة أساسية لبناء هوية الأفراد، ومنحهم معنى وآلية لتنمية قدراتهم، وتحسين عيشهم،والارتقاء بوجودهم إلى مستوى الكرامة. كما أن الاعتراف سلوك بنَّاء ومعيار للحكم على عطاء الآخرين، وأسلوب للنهوض والتعبئة. يتعلق الأمر، بالنسبة لـ»أكسيل هونيت»، بتحريك مصادر التحفز في التجربة الشخصية للقيام بفعل جماعي ضد ما هو سيء وسلبي ونكوصي لصالح الاتجاهات والنزوعات الإيجابية في المؤسسات والمجتمع والحياة. لهذا السبب يتعين علينا البحث عن الأسباب العميقة للإذلال التي تنتج عن غياب الإقرار بانتظارات الاعتراف المتجذرة بعمق في الذات، والتي تصيب أكثر المناطق غورًا في الكائن الإنساني، أو تتولد عن مختلف «الأمراض الاجتماعية» التي ينتجها الاستبداد ومجتمع الاستهلاك.
في سياق الإلحاح على القيمة الحيوية للاعتراف، عملت «نانسي فريزر»، من جهتها، على إعادة الاعتبار لمفهوم العدالة الاجتماعية من منطلق استدعاء بعدين متكاملين هما: إعادة التوزيع والاعتراف، بحكم أنهما مقترنان بنوع من التعسف أو اللاعدالة، من قبيل اللاعدالة السوسيو- اقتصادية بسبب الاستغلال والإقصاء الاقتصادي والاجتماعي، أو اللاعدالة من نوع رمزي، على غرار السيطرة الثقافية من خلال فرض نماذج اجتماعية، حيث تتشابك هذه الأنواع من اللاعدالة وتتداخل بكيفيات مختلفة.
الاعتراف، إذن، من صميم الإبداع والثقافة الحديثة؛ وحين تقترن بالثقة فإنها تشكل مرتكزًا من مرتكزات الفكر العصري، ومن الفهم الحديث للمبادرة الاقتصادية، والعمل السياسي، والممارسة المعرفية والثقافية. وإذا كان الاعتراف يعني الثناء والإقرار بمعروفداخل التداول اللغوي العربي، ويمثل في اللاتينية مصطلحًا مُركبًا يفيد الإنتاج الدائم مع الآخرين،فالاعتراف نتاج بناء اجتماعي وسياق ثقافي، سيما حين يقوم الإنسان بإنجاز عمل يتطابق مع الأهداف التي لها قيمة اجتماعية.
الاعتراف حاجة «إنسانية حيوية»، ومورد سيكولوجي ضروري لإثبات الذات وتحررها بقدرما يشكل آلية للاندماج الاجتماعي. فكلما توسعت دائرة الإقرار بقيم الكفاءة والمبادرة والمشاركة بفضل وجود بيئة حاضنة ومحفزة، تعززت ثقافة الاعتراف وتوفرت شروط تقوية الرأسمال غير المادي للمجتمع.
لقد دخلت البشرية «براديغما» معرفيًا وتواصليًا يتجدد بكيفيات لا أحد قادر على توقّع تحولاته ومؤثراته، وغذت المعرفة والثقافة كالماء تخترق كل القنوات وتتخطى الأسلاك الشائكة، سواء تمّ نقلها، واستنبات مقوماتها، أو كانت نتاج إبداع، فهي تولّد:
– نوعا من الرضا الشخصي؛
– الإحساس بامتلاك «رأسمال» غير مادي بدل الارتكان إلى اجترار الخطابات وطمأنينة الأجوبة الجاهزة؛
– تمنح معنى للحياة وللذات وللعلاقات الاجتماعية؛
– تسمح بممارسة جديدة للحرية والثقة في الذات، وإنتاج أفكار جديدة، والنقد الذاتي، والتصريف المبدع للزمن.
ولعل التركيز على موضوعات الحرية والاعتراف والكرامة يعود إلى الحاجة إلى إعادة التفكير في وجود الإنسان العربي الذي نُزعت منه إنسانيته بفعل السحق الاجتماعي، والقهر السياسي، وسياسات الإذلال، وتكالب القوى الإقليمية والدولية. وإذا كان الاستبداد يبدع في طرق تدمير آدمية الإنسان، فإن الكرامة هي قدرة المقموع على العناد والمقاومة وعلى تغليب كفَّة الحياة على الموت، كما أنها، في نفس الآن، تعبير عن فقدان المستبد لكرامته متى مارس عنفه. ومعلوم أن تكامل شراسة الدولة الاستبدادية واللاعدالة الدولية أنتجا أسباب الانتهاكات المتوالية لكرامة العربي، مما جعلهاتترنح بفعل الاهتزازات المتنوعة المصادر والجهات التي تتعرض لها، سواء من الداخل أو من الخارج.
تندرج الحرية والعدالة والكرامة دوما ضمن سياق صراعي وتاريخ متراكم من جدلية الاستعباد التحرر لإثبات إنسية عربية؛ كما تشكل البنية التحتية الرئيسية لإطلاق مشروع ثقافي قادر على تعبئة الناشئة والشباب وكل فئات المجتمع، من خلال اختيارات تعمل على إدماج الثقافة، بكل مستنداتها ورافعاتها، في كافة السياسات العمومية.
هوامش
سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ترجمة وتقديم حسن حنفي، مراجعة فؤاد زكريا، مكتبة النافذة، الطبعة الثالثة 2005، ص:444 ـ 452.
Axel Honneth, La société du mépris. Vers une nouvelle théorie critique, Ed, La Découverte, Paris, 2008, P, 201
انظر، في هذا الإطار، الفصل الرابع من كتاب الزواوي بغورة، الاعتراف، من أجل مفهوم جديد للعدل، دراسة في الفلسفة الاجتماعية، دار الطليعة، بيروت، 2012