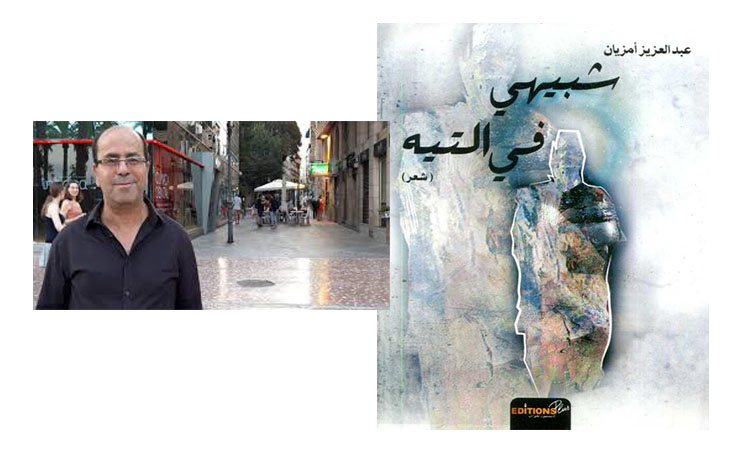ثمة دائما حاجةٌ ماسةٌ إلى مساحات إضافية من الإنصات، بما هي مساحة تفاعلية، تتشكل بموجبها بعض من ردود أفعالك الفكرية أو السيكولوجية، والتي تعتبر عاملا أساسيا في تحديد طبيعة حضورك أمام قول ما، ذاتٍ، أو حضورٍ آخرَ معززٍ هو أيضا باحتمالاته المتوقعة أو اللامتوقعة ، و التي قد تعود لها عملية الحسم في ما أنت مطالب عمليا بالانحياز إليه. فتوافر شرط الإنصات يفيد بالضرورة شرط َ تموضعِ الآخر، إما على مسافة فارقة من محيط الذات، أو مباشرة في قلب هذا المحيط ،و الحالتان معا، تحيلان على مستويين متباينين من مستويات التفاعل، أولهما بسيط، لا يتجاوز حدود تماس عابر، وثانيهما معزز بسلطته المؤثرة ضمنيا في هندسة خرائط وجودك. والجدير بالتنويه، أن طبيعة الإنصات الأول، تكون مطبوعة بحياديتها التي تظل الذات معها محتفظة بنسبة كبيرة من حريتها، حيث لن تكون مبادرة الاستجابة إلى مطلب الإنصات مشوبة، بأي إكراه أو واجب قد يلزمك بالتفاعل مع ما تردد على تلقيك من أصوات،باعتبارها أصواتا موجهة سلفا إلى أهدافٍ نائية عن أمكنة اهتمامك، حيث لن تكون بحال من الأحوال معنيا بما تتضمنه من رسائل وإشارات، يحدث في بعض الحالات الاستثنائية جدا،أن تتخذ شكل بلسم ثقافي أو إبداعي،قد تغني مردوديته عن ذلك الإنصات الوثيق الصلة بمساراتك اهتماماتك الأساسية. وخلافا لهذا الإنصات الملتبس، سواء من حيث حياديته، أو قوة اختراقه المداهم، فإن الإنصات الثاني غالبا ما يكون مقيما في قلب محيطك، ومصاحَبا بإكراه الواجب و الضرورة،إذ ليس لك أن تنسحب أو تنفصل عما أنت ملزم سلفا بالاندماج فيه،كما ليس لك أن تكون غائبا عما هو حاضر فيك،أي عمَّا أنت ملزم بالتفاعل معه، ضدا على اختياراتك المسبقة التي ليس لها سوى أن تحتجب قليلا أو كثيرا، كي تكون في نهاية المطاف وجها لوجه مع ما هو منتظر أو لا منتظر من هذا الإلزام.على هذا الأساس، يمكن اعتبار الإنصات عموما،أحد المسالك الأساسية المفضية بك إلى هناك،شئت أم لم تشأ،كي تحظى بالتواجد في ضيافة ذلك المكان المترع إما بدفء الوجود،أو ببرودته،والذي من المحتمل أن يكون منفَى قولٍ غريب،مسكون بأهواله،أو ملاذَ قول مألوف،و واعد ببوارقه،حيث أنت مطالب بالتموضع فيه ،بوصفه قولا منتميا إلى عمقٍ،أبدا لم تساورك فكرة التوجه إليه. إنها إذن،المسلمة التي لا يمكن أن تكون موضوع نفي،حيث ما مِن مكان،إلا ويستدعي حضور قولِ،ذاك هو جوهر العلاقة التزامنية والتكاملية في آن، القائمة بصورة طبيعية بين المكان وبين قوله،دون أن يستلزم ذلك حضور من يقول.أي ذلك الذي يظل حضوره محدودا في حيزه الافتراضي،كما هو الشأن بالنسبة للكائنات المقيمة في فردوسها المعلق فوق غيوم التمني،انسجاما مع إرادةِ متخيلٍ،مفتون بارتياد الأمكنة المحظورة على الأجساد المزهوة هي أيضا،بما تمارسه أقوالُها من سلط في مختلف مقامات المعيش وسياقاته.غير أن ما هو مؤكد حتما، عدم مطالبتك بأن تكون في كافة الأمكنة،حيث تتعدد وتتنوع منابر القول ومنصاته،بوصفه مطلبا مندرجا في باب الاستحالة الكبرى،مادام المكان مشروطا بلانهائي تشعباته وامتداداته،ليس فقط من حيث كونه كذلك،لكن من حيث كونه موضوع فعل،وموضوع كلام.وبالنظر إلى التتالي اللانهائي للأفعال وأقوالها،فالمكان لا يني يمارس تحولاته الأبدية،التي من شأنها أن تُعَدِّدَه وتُنوعه،بما يعني استحالة تعرف الإنصات المفرد على القول المتعدد مهما كان محايثا له، ومصدر الاستحالة،هو أن الجسد، جسدك أنت،أو أجساد المقيمين خارج ذاكرتك،محكومة كلها بقوانين إيقاعاتها الخاصة بها،أي بإكراهات أمكنة خاضعة لإكراهات الشبكة الوظيفية،التي أنت أحد خيوطها،والتي يتداخل فيها نسيج مختلف الاعتبارات الاجتماعية والمواصفات الثقافية،حيث يمارس الإنصات باستمرار مهام الرتق والفتق،من خلال احتفاظه بكل ما ينسجم مع قوانين الشبكة،و استبعادِه لما يتعارض مع آلية اشتغالها.إذ بين الاحتفاظ والاستبعاد،تتحدد طبيعة تفاعل الذات مع ذاتها،ومع محيطها.لهذا السبب تحديدا،تسعى الوسائط الحديثة،إلى الانتقام من عنف هذه الاستحالة،بتكريس ما يضع حدا لحتمية اشتغالها،من خلال التعميم السريع والخاطف،لأكبر قدر من المعلومات،والأقوال/الخطابات المقترنة بطوفان أحداثها ومواقفها،دون أن تفلح طبعا في تغطية القليل مما حدث،أو ما سيحدث.لكن و بالرغم من ذلك،ماذا لو كنتَ على علم قليلا،بما يجرى هناك في ذلك المكان،الذي بوسعك أن تكون فيه،حالما تقوم ببذل القليل من الجهد،أي باعتماد فِعْل المبارحة المؤقتة لِما أنت فيه ،و تكريس ما تيسر من الانتباه والإنصات،كي تبتعد قليلا عن أصوات القبيلة،التي هي جزء لا يتجزأ من أصوات الإلزام والضرورة.أيضا،ماذا لو انتقلت بإنصاتك إلى ذلك المكان الذي لن يكون بوسعك أبدا أن تكون فيه؟ مثلا،في قلب ذلك القمقم العالق بحنجرة الحكاية،أو داخل تلك الدكنة المتأرجحة خلف حد الشمس.
عموما،ثمة قول ينقال في غيابك،منتظرا حضورك فيه،يتوقع أن تتعرف عليه الآن،إنه بعض من ممتلكاتك المعرفية المؤجلة،التي لم تنتبه بعدُ إلى حضورها.فكل ما هو موجود،هو في نهاية المطاف مِلكٌ لخبرة الكائن،وخاصة منها خبرة الإنصات.إنه ينتظر منك أن تصغي إلى ما سيبوح لك به من حقائق،قد تمضي بك هي أيضا إلى أضدادهاأحلك مثلكان في المكان ال،بهدف تَدارُكِ النقصان الذي تعاني منه الكينونة، والناتج عن عدم التفكير في القول المنسي،و اللامفكر فيه،والذي يعتبر في حد ذاته إشكالا حقيقيا ،ناتجا عن عطب حتمي في عملية الإحاطة الشاملة بحقائق الأصوات/الأقوال،لذلك يعتبر استحضار تجارب الآخر،عاملا جدَّ أساسيٍّ في استعادة المنسي،باعتبار أن كل ذات تمتلك حدودها المرسومة في التعرف على فضاءات القول. وبالتالي،فإن التفاعل المحتمل بين الذوات،هو تفاعل بين المعارف والأقوال التي تَمَّ تحصيلها ضمن حدودها المتباعدة،المحتفظة بخصوصيات أقوالها،وخصوصيات ردود الأفعال الناتجة عن قوة الإنصات أو ترديه،وهو تفاعل أساسي،من أجل إغناء ذلك الحوار الذي تساعد شروطه الموضوعية على اكتشاف الأنحاء المنسية في الكون،أو بالأحرى الأنحاء الواقعة خارج مجال الإنصات بما هو فهم وإدراك.هنا تماما،يحضر شرط الاختصاص المندرج طبعا،ضمن خانة الاهتمامات التي تميل الذات المنصة إلى التلذذ بسماعها،في أفق توفير إضاءة كافيةٍ ترفع الالتباس عن ملامحها، لأن الصوت عموما ،هو مزيج من بنيات متعددة ومختلفة،يحتاج كل منها إلى مستويات متعددة ومتباينة،من مستويات الإنصات والتعرف،كما أن المقاربات المشتركة للبنيات المتعددة،يساهم في توسيع الوعي بهوية الصوت،و في استدراجه من منطقة المنسي واللآمفكر فيه، مع العلم أن التسييج الشامل،لما يمكن تسميته على سبيل المجاز بالحركة المنذرة بانفلاتها من محيط الدائرة،لا يتحقق بالضرورة ضمن ظرفية جاهزة ومعطاة ،ولكن من خلال منهجية التطوير التدريجي لإمكانية التعرف، وهي منهجية تقترن أيضا بالاستدراك المُنْصَبِّ على معالجة بنياتٍ،لم تَستنفد بعد إمكانياتها في البحث والتطوير. وتتمثل ضرورة الاستدراك، على العناصر المغفلة واللامفكر فيها ،في معالجتها لإشكالية انحسار القدرة على التفكير ، إما بسبب اندراج موضوعه في حكم المحظور، والمتعارض مع إملاءات قيم الواقع وأعرافه، كما لو أن الأمر يتعلق باعتذار أنيق عن غياب الرغبة في الرؤية والإنصات، وعن عجز الذات في اجتراح سبل جديدة للوجود ، أو بتبرير لبِقٍ لشكل من أشكال طمْس دواعي التناسي، التي يمكن أن تكون مبيتة.
إن مقاربة الأقوال والأصوات المنسية واللامفكر فيها،ينبغي أن تنطلق من قلب هذا المعطى، فالمنسي يقترن بإشكالياته الفكرية والاجتماعية، وانتفاء حضوره هنا، يفيد حضور العائق. لذلك، فالدلالة الضمنية للتطوير،هي الرفْعُ المستدامُ لحاجز انتفاءِ إمكانية التمثُّل والتعرف،بما هما إواليتان مركزيتان من إواليات الإنصات إلى القول ،و هو الدور الذي تضطلع به الحداثة الخلاقة،من خلال تنشيطها لمنهجية التفكير في المنسي عمدا ،وعن سبق إصرار،والمؤدي حتما إلى حالة مأساوية من الحرمان الفكري .مع العلم بأن وضعية المنسي عمدا،قد تكون مشتملة على إيجابياتها الاجتماعية أو السياسية في الأوساط التقليدية والمحافظة،مكتسبةً بذلك صفة ذريعة لإهمالٍ متعمَّد ، يشمل كل ما هو تنويري.
إن التفكير في المنسي واللآمفكر فيه، هو شان حضاري بامتياز، به تتجسد القدرة على الإنصات الدقيق للتفاصيل المركزية ،والكفيلة بإضاءة الأهم، والجوهري في معادلة كل شيء. و إذا كان الكلُّ شيءٍ يوحي بحضور ظل اللانهائي ،فإن ما يعنينا في السياق الذي نحن بصدده ،هو الكل الذي يتفاعل من أجل إنتاج لحظة معادِلة ،لها دورٌ معين في سياق محدد،باعتبار أن ‘‘الكلَّ شيء‘‘ هو مصدر الغموض الكوني، الذي نعتبره مؤقتا خارج اشتغال هذه المقاربة.
القول المشع في غياهب المنسي

الكاتب : رشيد المومني
بتاريخ : 05/01/2018