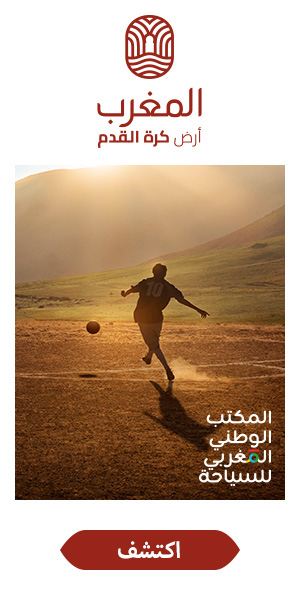النساء وأفق الدولة الاجتماعية الديمقراطية
في المغرب «لا حداثة بدون نساء، لا ديمقراطية بدون مواطنات كاملات الحقوق»
تطرح حقوق النساء في علاقتها بسيرورة بناء الدولة الاجتماعية الديمقراطية في المغرب تحديات جوهرية ترتبط بمستقبل التحول الديمقراطي وخيار التحديث المجتمعي.
إن مكانة النساء ووضعيتهن في المجتمع، وتمكينهن من المساواة المدنية والسياسية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز تمثيليتهن في مراكز القرار كلها قضايا مترابطة لا يمكن تجزيئها، لأنها تشكل شرطا أساسيا لأي مشروع يروم العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة/المندمجة . ومن هذا المنطلق، يصبح الدفاع عن قضايا النساء جزء لا يتجزأ من النقاش الوطني حول إعادة تشكيل العقد الاجتماعي وبناء دولة الحقوق والحريات.
لقد شكل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، منذ تأسيسه قوة تقدمية جعلت من الحقوق الإنسانية للنساء محورًا أساسيا في مشروعه المجتمعي، بل إن النضال من أجل المساواة والإنصاف السياسي والاجتماعي لم يكن مجرد شعار، بل كان خيارا استراتيجيا مرتبطا بالنضال من أجل الديمقراطية ودولة الحق والقانون، يستند إلى المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، وإلى اجتهادات فكرية وسياسية تستحضر الخصوصية المغربية.
واليوم وبعد تراكم الإصلاحات من مدونة الأسرة سنة 2004 إلى دستور 2011، ومع التحولات الراهنة التي يعرفها المجتمع، يطرح السؤال حول الأولويات والمطالب الملحة من أجل ضمان انتقال فعلي نحو المساواة الفعلية والديمقراطية الاجتماعية.
المسار التاريخي والمرجعي لقضية النساء في المشروع الاتحادي:
منذ تأسيس حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ظل الوعي قائما بأن قضية النساء ليست قضية فئوية أو هامشية، بل هي جزء من المشروع الديمقراطي الوطني الشامل، و اعتبر الحزب أن الديمقراطية والحداثة تقوم على إشراك فعلي للنساء في كل مستويات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومن هذا المنطلق انخرط في مواجهة محاولات الفكر المحافظ الذي كان يسعى إلى تكريس الإقصاء وإعادة إنتاج التراتبية بين الجنسين، كما عمل على تأصيل رؤية تقدمية حداثية تجعل من التمكين النسائي خيارا استراتيجيا مرتبطا بمسار بناء الدولة الحديثة، مستندا في ذلك على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان وعلى الاجتهادات الفكرية والسياسية التي تضع المساواة في صلب مشروع العدالة الاجتماعية.
لقد ارتبط التوجه الاتحادي بإيديولوجية الحزب، وبقناعاته المتعلقة بأن تحرر المجتمع لا يمكن أن يتحقق دون تحرر النساء، وأن التنمية لا يمكن أن تنجح إذا استمرت الفجوة قائمة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، لذلك لم يكن حضور قضايا النساء في خطاب الحزب مجرد بعد رمزي أو دعائي، بل كان اختيارا يعكس قناعة راسخة بأن النضال من أجل الديمقراطية يستحيل فصله عن النضال من أجل المساواة، وهو ما جعل الحزب دائما في مواجهة القوى التي حاولت احتكار الدين وتوظيفه من أجل تعطيل الإصلاحات أو تأبيد الوضع القائم، حيث اختار الاتحاد الاشتراكي أن يقف إلى جانب النساء في معركة المساواة والإنصاف السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
فمن هذ ا الإرث الوطني، يمتح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مشروعه المجتمعي، الذي يستمد عناصره التأسيسية من ضرورة تحديث البنيات والأنساق المجتمعية، في خط مواز لتقوية الدولة ومؤسساتها، فلا دمقرطة للدولة، دون دمقرطة موازية للمجتمع، ولا إصلاح ولا تحديث، إلا في إطار دولة اجتماعية قوية متضامنة.
ولذلك فقد أولى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ تأسيسه عناية خاصة لقضايا الأسرة والطفولة والمرأة، فاحتضن منظمات موازية للطفولة والشباب، وكان في طليعة الأحزاب التي أسست جناحا نسائيا، نسجت على منواله باقي الأحزاب سواء التقدمية أو المحافظة، من حيث هيكلته وطريقة اشتغاله.
ورافق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تجربة التناوب التوافقي بهذا القلق الوطني المشروع، الذي كان يعتبر أن الإصلاحات فيما يخص البنيات التحتية، وقضايا التشغيل والتعليم والصحة، ستكون نتائجها محدودة إذا استمر إقصاء النساء من مشاريع التنمية، التي فتحت وقتها.
ولقد فرض علينا وقتها أن نتصدى للنكوصية الصاعدة، التي حرفت النقاش حول الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، نحو محاولة خلق تقاطب مجتمعي يهدد التعايش، ويكون مقدمة لتهيئة التربة لمشاريع “دينية” على النقيض من الإسلام المغربي المعتدل، الذي ترعاه مؤسسة إمارة المؤمنين، التي توفر الأمن الروحي للمغاربة، وتحرسه.
ولذلك انخرط الاتحاد الاشتراكي في الدينامية الملكية، التي كان من ثمارها مدونة الأسرة، التي مثلت آنذاك ثورة هادئة، تعبد الطريق نحو الترسيم النهائي للمشروع الحداثي الديموقراطي في نسخته المغربية، التي تدمج العناصر التأسيسية للهوية المغربية في هذا الأفق المنفتح على العصر، وبسيرورة متدرجة وهادئة، تضمن لها الاستدامة.
مركزية المرأة والأسرة في المشروع الاتحادي: المدونة نموذجا
يمثل الإصلاح الكبير الذي عرفه المغرب سنة 2004 بإقرار مدونة الأسرة تتويجا لهذا المسار النضالي، فقد شكل الانتقال من قانون الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة نقطة تحول ومحطة فارقة في مسار تحديث المجتمع، إذ لم يكن الأمر مجرد تعديل قانوني أو اجتهاد فقهي محدود، بل كان بمثابة ثورة ثقافية هادئة أعادت الاعتبار لمكانة المرأة في التشريع الوطني، كما منحت للمؤسسة التشريعية المنتخبة حق المصادقة أو رفض مخرجات اللجنة الملكية، وهو ما أخرج القانون من دائرة المقدس المغلق إلى رحابة النقاش العمومي المفتوح، مؤكدا أن قضايا الأسرة لا تنفصل عن سيرورة الانتقال الديمقراطي.
لقد فتح هذا الإصلاح الأول الباب أمام ربط قضايا النساء بالمسار الديمقراطي العام، حيث تم تكريس القيم الكونية المرتبطة بحقوق الإنسان، و بقيم النسبية والعقلانية والتعدد في مقاربة النصوص القانونية، وتم الاعتراف بأن تحقيق العدالة لا يمكن أن يتم إلا من خلال إنصاف النساء وضمان حقوقهن داخل الأسرة والمجتمع، وبذلك لم تعد قضايا النساء في المغرب فقط قضية حقوقية، بل قضية مرتبطة بمستقبل الديمقراطية والتنمية، وهو ما يعكس انسجام المشروع الاتحادي مع روح التغيير التدريجي القائم على الإصلاح الهادئ والمتراكم الذي يجعل من المساواة ركيزة أساسية في بناء دولة اجتماعية حديثة. إن حقوق الأسرة، والطفل، والنساء، لا تنفصل عن مصفوفة الحقوق الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والتي لا يمكن أن تجد ترجمتها إلا داخل دولة ديموقراطية، بتوجهات اجتماعية، وأفق حداثي، ولذلك فإن معركة المساواة الشاملة تجد جذورها في بلادنا، من خلال إرث الكفاح الوطني، حيث التقت إرادة المغفور له محمد الخامس في الارتقاء بوضع النساء، مع البرنامج الإصلاحي الذي كانت تقترحه الحركة الوطنية آنذاك، من أجل التحرير وبناء الدولة معا.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعبر منظمته النسائية، ومناضلاته ومناضليه قد استوعب مبكرا أهمية أن تكون للأسرة مدونة قانونية، لا تكون فقط مرجعية للحسم في الخلافات المفترضة في أي علاقة زوجية، بل تكون حاملة لبذرة تأهيل المجتمع وتحصينه، من خلال هذه اللبنة الأساسية (الأسرة)، وهو ما تجسد في مطالباته بتغيير مدونة الأحوال الشخصية، منذ الربع الأخير من القرن الماضي، ولم يكن محركه سوى رفع كافة أشكال الحيف عن النساء، وقاوم حينذاك أشكالا من التكفير والتضليل، وكانت نساؤه في مقدمة هذه المعركة المجتمعية، التي انتهت بتعديلات جزئية في التسعينيات، لم ترض طموحاتنا، وإيماننا بأن المغرب كان مؤهلا يومها لجرعات تحديث أكبر.
ولقد رافق الاتحاد الاشتراكي هذه المرحلة بهاجسي الحرص على التطبيق الأمثل للمدونة، والسعي إلى تطويرها، تبعا للتطورات المجتمعية، وهو ما عبر عنه الحزب في محطات كثيرة، سواء البرامج الانتخابية، أو توصيات المؤتمرات، أو مقترحات القوانين، وغيرها، وأساسا من خلال المجهود الترافعي والتأطيري والنضالي لمنظمة النساء الاتحاديات، التي لم يتردد الحزب في دعم مطالبها، وأنشطتها المعبرة عن الخط العام والناظم للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، باعتباره حزبا لا تنفصل عنده قضايا الديموقراطية عن قضايا العدالة الاجتماعية، وفي القلب منها قضية المساواة بين النساء والرجال.
واليوم، يجد الاتحاد الاشتراكي نفسه مرة أخرى في التقاء موضوعي، ولا نبالغ إذا قلنا بأنه التقاء استراتيجي، مع الورش الملكي لتعديل مدونة الأسرة، لتكون أكثر إنصافا لكل مكونات الأسرة، ولتكون أكثر حماية للأمن والاستقرار الأسريين.
المرأة والإصلاح الدستوري في المشروع الاتحادي:
شكل دستور 2011 محطة مفصلية في مسار بناء الدولة الديمقراطية الحديثة في المغرب، حيث أقر مبادئ صريحة تؤكد المساواة الكاملة بين النساء والرجال في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كما نص في الفصل 19 على ضرورة تحقيق مبدأ المناصفة، وهو ما اعتبر حينها خطوة جريئة تعكس إرادة سياسية عليا في جعل المساواة قيمة دستورية ملزمة، ولم يقف الأمر عند التنصيص النظري بل تم إحداث هيئة دستورية خاصة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، في إشارة واضحة إلى الرغبة في الانتقال من المبادئ العامة إلى الآليات العملية الكفيلة بإعمال المساواة الفعلية.
لقد ألزم الدستور الجديد الدولة بتحقيق المساواة من خلال تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الولوج إلى الوظائف الإدارية العمومية والانتخابية، وهو ما نص عليه بوضوح الفصل 30 الذي يضمن لكل المواطنات والمواطنين حق التصويت والترشح للانتخابات بشروط متساوية، كما دعّم هذا التوجه الفصل 115 حين نص على تمثيلية وازنة للنساء في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو ما يعكس البعد المؤسساتي لمشاركة النساء في مراكز القرار. وقد مهدت هذه المقتضيات لإجراءات تشريعية وتنظيمية أعطت دفعة ملموسة لتمثيلية النساء داخل المؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا، مثل اعتماد لوائح مخصصة للنساء في الانتخابات التشريعية والمحلية، مما أدى إلى تطور عددي على مستوى التمثيلية السياسية للنساء.
ورغم هذا التقدم، فإن الممارسة السياسية أبانت عن فجوة كبيرة بين النصوص الدستورية و الواقع العملي، ففي انتخابات سنة 2021 ورغم تحقيق النساء لبعض التقدم في الولوج لمجلس النواب من خلال الحصول على ستة وتسعين مقعدا نيابيا، إلا أن حضورهن في مواقع القرار الاستراتيجي ظل محدودا، حيث غابت المناصفة عن تشكيل الحكومة، وبقيت المناصب الوزارية الأساسية حكرا على الرجال، كما استمرت المؤسسات المنتخبة في تكريس نوع من الهيمنة الذكورية التي تقلص من فرص النساء في التأثير الفعلي، وهو ما جعل حضورهن الكمي لا يترجم بالضرورة إلى حضور نوعي قادر على التأثير في السياسات العمومية.
إضافة إلى ذلك فإن القوانين المالية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية لم تدمج بعد مقاربة النوع الاجتماعي بالشكل الكافي، حيث تظل البرامج العمومية بعيدة عن تخصيص اعتمادات مالية واضحة لدعم المساواة بين الرجال والنساء، أو معالجة الفجوات الهيكلية بين الجنسين، الأمر الذي يبرز الحاجة الملحة إلى آليات تشريعية وتنظيمية أكثر جرأة، خصوصا وأن الفصل 31 يلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل والتعليم والحماية الاجتماعية، وهو ما يجعل تفعيل المناصفة ليس مجرد مطلب حقوقي بل التزاما دستوريا. لذلك فإن رفع نسبة مشاركة النساء في مناصب المسؤولية إلى المناصفة يعد خطوة ضرورية لترجمة روح الدستور إلى واقع ملموس، وضمان أن تكون المرأة طرفا فاعلا في صناعة القرار الوطني.
التحديات السياسية والثقافية أمام إعمال الإنصاف والمساواة:
يواجه إدماج النساء في المغرب تحديات سياسية مرتبطة بالمنظومة التمثيلية وصناعة القرار، فرغم المكاسب التي تحققت منذ إقرار مدونة الاسرة وتوسيع دائرة المشاركة النسائية عبر نظام الكوطا البرلمانية، إلا أن حضور النساء في مواقع المسؤولية ما زال محدودا، ويعكس اختلالا بنيويا في توزيع السلطة بين الجنسين، ذلك ان الثقافة السياسية السائدة ما زالت اسيرة منطق الهيمنة الذكورية، حيث ينظر الى المرأة باعتبارها فاعلا ثانويا، ما يجعل جهود تمكينها رهينة بإرادة حزبية غير مهيكلة او بمبادرات ظرفية مرتبطة بالضغط الدولي، وهنا يبرز موقف الاتحاد الاشتراكي الذي ظل مدافعا عن المناصفة وعن الحضور النسائي في مختلف المؤسسات.
أما على المستوى الثقافي، فما زال تمثل ادوار النساء في المجتمع محكوما بسلطة التقاليد والموروثات التي تكرس الثنائية بين المجال العام للرجال والمجال الخاص للنساء، هذه التصورات تضعف من قدرة المرأة على اقتحام مجالات الشأن العام وتكرس صورا نمطية تؤثر في ثقة النساء بأنفسهن وفي استعداد المجتمع لقبولهن كقائدات وصانعات قرار، كما ان الخطاب الديني والثقافي في بعض تجلياته يستعمل أحيانا لتبرير الإقصاء أو لإعادة إنتاج التبعية، ما يجعل المعركة الثقافية احدى الجبهات الحاسمة في مسار المساواة، وهو ما يدفع الاتحاد الاشتراكي الى التأكيد على ان النضال الثقافي والتربوي لا يقل اهمية عن النضال السياسي والتشريعي.
في المقابل، يبرز التحدي المؤسساتي المتمثل في ضعف السياسات العمومية الموجهة نحو تعزيز مشاركة النساء، ورغم وجود خطط حكومية واستراتيجيات وطنية، فان الإشكال يكمن في التطبيق، اذ غالبا ما يغيب التنسيق بين الفاعلين وتبقى المؤشرات الكمية للمشاركة غير مصحوبة بمؤشرات نوعية تلامس فعلا جوهر التمكين، ويؤدي هذا الوضع الى فجوة بين النصوص الدستورية التي تنص على المناصفة والمساواة وبين الواقع العملي الذي يكشف استمرار التفاوتات، وهنا ينبه الاتحاد الاشتراكي الى ضرورة ربط التخطيط الاستراتيجي القائم على النوع الاجتماعي بآليات التتبع والتقييم والمحاسبة حتى لا تبقى حقوق النساء حبرا على ورق.
من جهة اخرى، يرتبط نجاح ادماج النساء بتغيير عميق في الوعي الجمعي، وهو تحد ثقافي بقدر ما هو سياسي، فبناء مجتمع منصف يتطلب اصلاح المنظومة التعليمية والاعلامية بما يعزز قيم المساواة ويكسر الصور النمطية التي تلصق بالمرأة، كما ان الحركة النسائية مطالبة اليوم بتجديد ادواتها وخطابها لتوسيع قاعدة الالتفاف المجتمعي حول قضية المساواة بعيدا عن الطابع النخبوي، وهنا يظل الاتحاد الاشتراكي مقتنعا بان تمكين النساء في المغرب ليس مجرد ورش حقوقي، بل هو كذلك رهان حضاري يهم التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مسار التمكين النسائي
تشير الإحصائيات الرسمية لسنة 2024 إلى أن مشاركة النساء في سوق الشغل ما تزال ضعيفة بشكل كبير مقارنة بالرجال، حيث بلغ معدل النشاط الاقتصادي للنساء حوالي 19,1 في المائة فقط مقابل أكثر من 65 في المائة لدى الرجال، كما أن احتمال عدم النشاط يصل إلى 73 في المائة عند النساء مقابل 7,5 في المائة فقط عند الرجال، وهذه الأرقام تكشف أن الفجوة بين الجنسين لم تتقلص رغم مرور أكثر من عقد على إقرار دستور 2011 الذي نص صراحة على المساواة والمناصفة، وهو ما يضع أمام السياسات العمومية تحديات بنيوية في إدماج النساء في الدورة الاقتصادية الوطنية.
وإلى جانب ضعف المشاركة، تواجه النساء معدلات مرتفعة من البطالة، إذ وصل معدل البطالة في صفوفهن سنة 2024 إلى 19,4 في المائة مقابل معدل وطني بلغ 13,3 في المائة، مما يجعل النساء أكثر عرضة للهشاشة الاقتصادية، كما أن نسبة المقاولات التي تُدار من قبل نساء لا تتجاوز 15 في المائة من مجموع المقاولات الصغرى والمتوسطة، الأمر الذي يبرز محدودية وصول النساء إلى مواقع القيادة الاقتصادية، وصعوبة ولوجهن إلى التمويل والموارد الضرورية لتطوير مشاريعهن.
تتعمق هذه الفوارق أكثر عند النظر إلى التوزيع الجغرافي لمشاركة النساء في سوق الشغل، ففي جهة الشرق مثلا لا تتجاوز نسبة نشاط النساء 15,6 في المائة، بينما تصل في جهة الدار البيضاء سطات إلى حوالي 28 في المائة، ما يعكس تفاوتات مجالية صارخة تزيد من هشاشة النساء في المناطق الفقيرة والهامشية، وفي نفس الوقت تكشف أن الفرص الاقتصادية والتعليمية المتوفرة في المدن الكبرى لم تصل بعد إلى المناطق القروية التي تبقى فيها النساء عرضة للأمية والعمل غير المهيكل وضعف الخدمات الصحية والاجتماعية.
ولا يقتصر التحدي على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد إلى الجانب الاجتماعي والأمني، حيث لا تزال حوالي ثلث النساء يتعرضن لأشكال مختلفة من العنف المبني على النوع رغم وجود قوانين زجرية، كما أظهرت الكوارث الطبيعية مثل الزلزال والفيضانات محدودية إدماج مقاربة النوع في التدخلات الاستعجالية، إذ تحملت النساء في المناطق المنكوبة أعباء مضاعفة نتيجة غياب الرجال المهاجرين إلى المدن، ما أجبرهن على تدبير شؤون الأسرة والأرض معا في ظروف قاسية، وهو ما يؤكد أن غياب سياسات عمومية تراعي احتياجات النساء يزيد من هشاشة وضعهن ويعرقل مسار التمكين الشامل.
الأولويات المستقبلية ورؤية الاتحاد الاشتراكي
انطلاقا من مرجعيته الحقوقية والتقاطعية يضع حزب الاتحاد الاشتراكي قضية النساء في صلب مشروعه الديمقراطي كشرط لا مناص منه لإرساء دولة اجتماعية ديمقراطية، فالأولويات المرفوعة تهدف إلى ترجمة المبادئ الدستورية على أرض الواقع عبر اصلاحات تشريعية وإجرائية وميزانيات مخصصة وآليات تنفيذ ومتابعة، وذلك لضمان انتقال من المكاسب الكمية إلى المكاسب النوعية، التي تمكن المرأة مدنيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. وفي سعيه هذا يراهن على الأولويات التالية:
1/ إدماج منظور النوع الاجتماعي في الميزانيات والسياسات العمومية
يرى حزب الاتحاد الاشتراكي أن إدماج مقاربة النوع في التخطيط المالي والسياسات العمومية يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق المساواة الفعلية، فالميزانية ليست مجرد أرقام وإنما انعكاس لأولويات الدولة، وإذا لم تراعِ احتياجات النساء فإن الفجوة ستبقى قائمة، لذلك يقترح الحزب اعتماد ميزانيات تراعي النوع الاجتماعي على مستوى كل قطاع حكومي وجماعة ترابية، مع إجراء تقييمات دورية لتأثير السياسات على النساء والرجال، وضمان تخصيص اعتمادات واضحة لبرامج تشغيلية موجهة لتمكين النساء، وهو ما من شأنه أن يترجم المبادئ الدستورية إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنات.
2/ تخصيص دوائر انتخابية أو آليات تضمن ثلث المقاعد للنساء في البرلمان
يعتبر الاتحاد الاشتراكي أن حضور النساء في البرلمان والمؤسسات المنتخبة ما يزال دون المستوى المطلوب رغم التحسن النسبي في السنوات الأخيرة، ولذلك فهو يطالب بإقرار آليات انتخابية انتقالية تضمن على الأقل نسبة الثلث من المقاعد لصالح النساء، سواء عبر دوائر مخصصة أو كوطا حزبية ملزمة، لأن تحقيق المناصفة يحتاج إلى إجراءات إيجابية ترفع الحواجز البنيوية أمام مشاركة النساء، وتمكنهن من لعب دور مؤثر في صياغة السياسات العمومية ومراقبة العمل الحكومي والتشريعي، بما يعزز التمثيل النوعي ويضمن إدماج قضايا النساء في الأجندة الوطنية
3/ استعجالية إكمال ورش مراجعة مدونة الأسرة لتحقيق عدالة ومساواة أكبر
يشدد الحزب على أن مراجعة مدونة الأسرة باتت ضرورة مجتمعية وتشريعية من أجل ملاءمتها مع روح الدستور والاتفاقيات الدولية، ويركز بالخصوص على تجريم تزويج القاصرات باعتباره انتهاكا صارخا للطفولة، وعلى اعتماد الخبرة الجينية كوسيلة رسمية لإثبات النسب حماية لحقوق الأطفال، وعلى إلغاء نظام التعصيب الذي يميز ضد النساء في الإرث، إلى جانب إقرار مبدأ الولاية المشتركة على الأبناء بعد الطلاق بما يحفظ كرامة الأم ويضمن مصلحة الطفل، حيث تشكل هذه التعديلات مجتمعة ثورة هادئة في سبيل تحقيق العدالة الأسرية والمساواة بين الجنسين.
4/تطوير التشريعات لمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي
يعتبر الاتحاد الاشتراكي أن العنف الموجه ضد النساء يشكل عائقا رئيسيا أمام التمكين للنساء، لذلك يضع في أولوياته مراجعة القانون الجنائي وتوسيع نطاق التجريم ليشمل أشكال العنف الاقتصادي والرقمي والرمزي، مع توفير آليات حماية فعالة مثل الأوامر الاستعجالية والإيواء والمواكبة النفسية والقانونية، كما يدعو إلى إنشاء وحدات شرطية وقضائية مختصة وتوسيع شبكة مراكز الاستماع والدعم، لأن الردع القانوني وحده لا يكفي دون منظومة متكاملة تضمن الحماية والوقاية والتتبع، وهو ما من شأنه أن يقلل من نسب العنف ويعزز شعور النساء بالأمن والكرامة.
5/التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء وخاصة في القرى والمناطق الهشة
يضع الحزب التمكين الاقتصادي والاجتماعي في قلب استراتيجيته، إذ لا يمكن للنساء أن يحققن استقلاليتهن دون ولوج عادل إلى الشغل والموارد، لذلك يدعو إلى إطلاق برامج دعم وتمويل خاص بمقاولات النساء، وإلى تعميم التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل العاملات في القطاعات غير المهيكلة مثل الفلاحة وخدمات المنازل، كما يشدد على أهمية توفير خدمات الرعاية للأطفال وتوسيع فرص التعليم والتكوين للفتيات القرويات، فتمكين النساء اقتصاديا يعني الحد من فقر الأسر وتعزيز العدالة الاجتماعية، ويشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
6/ تعزيز المشاركة السياسية والقيادية للنساء داخل الحزب وفي المؤسسات
يرى الاتحاد الاشتراكي أن تعزيز حضور النساء في مواقع القيادة يجب أن يبدأ من الداخل، ولذلك يلتزم باعتماد قواعد تنظيمية داخلية تفرض تمثيلية نسائية وازنة في كل هياكله ومراتبه القيادية، كما يراهن على برامج للتدريب والتأهيل ورعاية الكفاءات النسائية الشابة من أجل إعداد جيل جديد من القياديات، ويؤكد أن تمكين النساء داخل الحزب سينعكس على حضورهن في الساحة الوطنية، فالمناصفة ليست مطلبا قانونيا فحسب، بل ثقافة تنظيمية وممارسة يومية تضمن للنساء موقعا طبيعيا في صناعة القرار السياسي.
7/ تعديل المنظومة القانونية مدخل أساسي لتحقيق العدالة للنساء
يرى الاتحاد الاشتراكي بـن تعديل المنظومات القانونية والأطر التشريعية مطلب أساسي لتحقيق العدالة الجنائية للنساء ، إذ لا يكفي القيام ببعض الرتوش /الإصلاحات الجزئية بل اعتماد تغيير شامل وجذري يشمل فلسفة وبنية ومنطوق ومقتضيات القانون، ليكون أكثر انسجاما مع الدستور والتزامات المغرب الدولية المتعلقة بحماية النساء من العنف والتمييز، من خلال وضع أسس تحقيق العدالة للنساء وعدم حجب منطق الواقع حيث تسود العديد من الممارسات التي يجب البحث لها عن أجوبة قانونية تضمن الكرامة ولا تتناقض مع حقوق الإنسان مثل العنف – الحريات الفردية – الإجهاض….
عناصر التأسيس للدولة الاجتماعية في العلاقة بمقاربة النوع الاجتماعي:
أولا: ولوجية النساء للشغل”
1/ القطاع الخاص:
باعنبار أن مدونة الشغل موضوحة على طاولة النقاش العمومي فيما يخص الإصلاحات القانونية المستعجلة، وباعتبار المرجعية الاجتماعية الديموقراطية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فإن تقديم رؤية الحزب لإصلاح مدونة الشغل على ضوء السعي إلى الإنصاف والمساواة، يظل هاجسا قائما.
يعتبر مبدأ المساواة ودفع كل أشكال التمييز جوهر مقاربة النوع وأساسه؛ لذلك، فقد لزم أن يتولى القانون حمايته. علما أن هذه الحماية، لا تقتصر فقط على الحقوق التي تشترك فيها المرأة والرجل معا ـ كونها حقوقا إنسانية عامة ــــــ وإنما تشمل أيضا الحقوق التي تتسم بالخصوصية المبنية على النوع والتي ترتبط بخصوصية طبيعة المرأة.
ولعل الحديث عن حق المرأة في العمل في الوقت الحالي قد يعتبر أمرا متجاوزا في ظل الاعتراف التشريعي الصريح بحقها في العمل، وكذا الضمانات الدستورية المؤكدة له، بالإضافة إلى المعطيات الواقعية التي تبرز حجم الحضور المتزايد للنساء في مختلف أشكال العمل.
وإذا كان وجود هذا الحق قائما في مدونة الشغل قبل صدور الدستور، فإن تزكيته دستوريا، مع مبادئ وأهداف أخرى، يفيد وجود نقلة نوعية لنموذج ديموقراطي، يعترف بالحق في الشغل كعنصر جوهري وأساسي في أي نظام.
ورغم حرص المشرع المغربي على تكريسه لمبدأ المساواة بين الجنسين خصوصا بعد مصادقة المغرب على الاتفاقية رقم 111 بتاريخ 27 مارس 1963، والتي لم يتم تبني مبادئها بشكل فعلي إلا بعد صدور مدونة الشغل سنة 2004 ـ من خلال ديباجتها التي أكدت على منع التمييز في مجال الشغل والتشغيل، ومن خلال مقتضيات المادة 9 ، وأيضا المادة 12 من مدونة الشغل التي نصت على عقوبات زجرية تجاه المشغل الذي يخالف هذا المقتضى المتعلق بالمساواة، إضافة إلى ما جاءت به المادة 36 من المدونة التي استبعدت العديد من المبررات التي يمكن أن تكون سببا في اتخاذ العقوبات التأديبية، ومن بينها نجد التمييز على أساس الجنس.
غير أنه وخلاف لما ذكر، فالواقع يقول غير ذلك. لأن المرأة الأجيرة لازالت تعيش التمييز وعدم المساواة فيما بينها وبين الرجل في الاستخدام. ودليل ذلك، ما أشار إليه تقرير منظمة العمل الدولية الذي أكد أنه ما بين سنة 2019 و2020 انخفض توظيف المرأة بنسبة 4,2% مقارنة مع الرجل الذي لم تتعد نسبة انخفاض توظيفه 3 في المئة.
أما على المستوى الوطني فقد تم تصنيف المغرب من خلال تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن البلدان المتأخرة في توظيف واستخدام النساء. وهو ما أكدته الإحصائيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط خلال سنة 2020، والتي اعتبرت أن مساهمة النساء في سوق الشغل لازالت ضعيفة، حيث بلغ معدل نشاط النساء 19,9% مقابل 70,4% لدى الرجال. لتبقى بذلك ثمان نساء من بين كل عشرة خارج سوق الشغل.
وتبعا لذلك يعتبر الاتحاد الاشتراكي أن تحقيق المساواة الفعلية مع الرجال في سوق الشغل غاية أولية، من أجل تطبيق المادة 11 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة تطبيقاً كاملاً، خصوصاً من خلال تقوية إجراءات التفتيش لمعاينة مدى احترام التشريع المتعلق بالشغل.
كما يدعو لاعتماد إجراءات ملائمة تهدف إلى إدماج مزيد من النساء في الأنشطة الاقتصادية وضمان حقوقهن في المساواة في المعاملة، والمساواة في الأجر بالنسبة لعمل ذي قيمة مساوية لقيمة عمل الرجل.
ويعتبر الحزب أن وضع برامج لمحاربة البطالة، يجب أن تستدمج منظور النوع، إن على مستوى التصور وتفعيل صيغ جديدة للإدماج (التشغيل – تكوين الشباب – قروض المقاولين الشباب)، أو على مستوى التكوين – الإدماج (التكوين بالتناوب – التكوين بالتعلم) ووضع استراتيجيات للإدماج لفائدة النساء الأكثر عرضة للبطالة.
كما يراهن على اعتماد استراتيجيات وبرامج تشجع على الرفع من كفاءات النساء في المقاولة العمومية والخاصة وفي الاقتصاد الاجتماعي التضامني (التكوين – التمويل – المواكبة – الخ).
مع التنصيص على مراجعة مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بالتحرش الجنسي بأماكن العمل بصفة خاصة، واتخاذ إجراءات للتأكد من أنه بإمكان الضحايا دون خوف من الانتقام، الولوج إلى لى سبل الطعن، وإلى تعويض ملائم للضرر.
2/ الوظيفة العمومية
لا يكفي في قطاع الوظيفة العمومية تقديم الاقتراحات أو حتى تعديل القوانين لتحقيق المساواة في مجال الوظيفة العمومية، بل لا بد من تعزيز ذلك بانخراط جميع الفاعلين في إطار سياسات عمومية واضحة المعالم، ومحددة للتدابير التي على المؤسسات المعنية اتخادها لتنزيل هذه السياسات وتفعيل التعديلات القانونية. والواقع أن أية سياسة لا يمكنها أن تنجح إلا بتظافر جهود الفاعلين بدء بالحكومة وانتهاء بالمؤسسات، حيث يجب تسطير خطة واضحة ببرامج محددة وصولا لأهداف مسطرة.
ومن هنا نرى في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية استعجالية التدابير التالية:
ا. إلزام أرباب العمل في القطاع العام بوضع وتنفيذ خطة عمل ” للمساواة المهنية”: والتب ويجب أن تتضمن لزوما تدابير بشأن منع ومعالجة الفوارق والتفاوتات في الأجور، والمزج بين المسارات المهنية والوظيفية، وكذا التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وأخيرا مكافحة العنف الجنسي والجنساني.
ب. تعزيز دور الفاعلين في الحوار الاجتماعي في مجال المساواة في الوظيفة العمومية: فالحوار الاجتماعي يعد رافعة أساسية في تعزيز المساواة بين النساء والرجال في الوظيفة العمومية، حيث تعتبر جميع الهيئات، من نقابات ولجان متساوية الأعضاء ولجان مراقبة شروط العمل إن وجدت وجميع الهيئات التي قد يتم وضعها في المستقبل والمكلفة بالقضايا الجماعية للموظفين، معنية وشريكة في تتبع وتنزيل مقاربة النوع ويجب العمل على انخراطها وفق برامج معينة تتلاءم مع مجال عملها، كما يجب تعزيز المشاركة المتساوية للمرأة والرجل في الحوار الاجتماعي، حيث يجب أن يكون هناك توازن في تشكيلة هيئات الحوار الاجتماعي بين الرجال والنساء.
ج. تعزيز التكوين والتواصل والتأطير في مجال المساواة: فلنشر وتعزيز سياسات المساواة المهنية، لا بد من تأطير الموظفين في هذا الإطار وتكوينهم بشكل مستمر في قضايا المساواة، والقضاء على الأحكام والأفكار الجاهزة والنمطية والوقاية من العنف الجنسي والجنساني، وعلى الإدارة أن تأخذ بعين الاعتبار عند تقييم أداء الموظف في سبيل ترقيته قيامه بهذه التكوينات.
ونفس الشئ بالنسبة للأطر والمسيرين عند تقييم أدائهم السنوي، حيث يجب اعتماد المبادرات التي قاموا بها في مجال تعزيز المساواة وتنفيذ خطة العمل في هذا الإطار، خصوصا فيما يتعلق بالمزج بين فرق العمل، والوقاية من التمييز خصوصا في مجال تخصيص المكافآت والمنح أو أي عنصر آخر مرتبط بالأجور، وكذا ما يتعلق بالتوزيع بين الحياة الأسرية والمهنية ومكافحة العنف والتحرش.
د.إدماج البعد النوعي في تخطيط وتفعيل برامج الميزانية: تشكل ميزانية النوع الاجتماعي مقاربة جديدة تشمل معرفة مدى تأثير توزيع المداخيل والاعتمادات المرصودة، على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق المساواة وتقليص الفوارق الاجتماعية. فالميزانية التي تدمج مقاربة النوع هي ميزانية تراعي المساهمة المختلفة للرجال والنساء بمختلف الشرائح التي ينتمون إليها؛ و تدرس آثار توزيع المداخيل والنفقات على الرجال والنساء ليس فقط على المدى القريب، بل على المدى المتوسط البعيد؛ تحرص على الاستجابة بشكل منصف للحاجيات الآنية للنساء والرجال من مختلف الشرائح السوسيو اقتصادية وكل الأوساط؛ وتسعى للتخفيف من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية المتواجدة بين هذه الشرائح وتفعيل مبدئي الإنصاف والمساواة من خلال تقوية المساواة بين الرجال والنشاء من خلال مراجعة السياسات المالية والاقتصادية.
ثانيا: ولوجية النساء للعدالة:
إن من أبرز الحقوق المكفولة للمرأة فيما يتصل بولوجها للعدالة، هي صلة الوصل التي قام بها المشرع على مستوى الحقوق الأساسية المرتبطة بالمحاكمة، بحيث لم يفرد لأي من الجنسين ضمانات خاصة بحقوقه فقط، بل ساوى بينهم في الحقوق الأساسية باعتبار أنها واحدة لا تتجزأ وإن استقلت بعضها بأحكام تفصيلية خاصة.
ومن هذا المنطلق تتحدد لنا الأهمية العملية للمساواة بين الرجل والمرأة على المستوى الإجرائي، فالتأثير الواقعي الذي يحدثه التوازن في الحقوق، يسهم لا محالة في ضمان حظوظ متساوية للإنصاف لكل من الجنسين، بل إن الأمر يستدعي حقيقة أن تكون الحماية مركزة ومكثفة للنساء، وذلك بالنظر للوضع الخاص التي تتميز به النساء وهيمنة الرجال على مستوى التوظيف في أجهزة العدالة.
ويمكن التمثيل لمعاناة النساء فيما يخص الولوج للعدالة، بمثال النساء ضحايا العنف.
وفي هذا الصدد، أكدت معطيات وزارة العدل، أنه خلال سنة 2018، تعرضت أزيد من 92 ألف مشتكية للعنف وتم الاستماع لحوالي 38 ألف فقط، بينما شمل البحث الاجتماعي الذي يضطلع بدور دراسة الشكاوى 609 حالة فقط. وفي سنة 2020 قامت خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم بتنظيم 51147 استقبالا و 20287 جلسة استماع، وقد ارتفع العدد سنة 2022 إلى 75240 شكاية مقدمة على المستوى الوطني.
وأشار التقرير السنوي للنيابة العامة إلى أن عدد قضايا العنف ضد النساء عرف ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2021، حيث بلغ عدد القضايا 23879 قضية بنسبة ارتفاع قدرها %31 مقارنة بسنة 2020.
قد يبدو للوهلة الأولى عند قراءة المعطيات أعلاه، أن ولوج المرأة للعدالة متاح بشكل يسهل معه جبر الضرر الذي قد يلحقها من جراء الاعتداءات التي قد تطالها، ولعل ارتفاع عدد الشكايات المقدمة من طرف النساء على مدار السنوات. لكن هل هذه الشكايات تأخذ مسارها العادي وتنتهي بمحاكمة المعتدي ومعاقبته، أم أن الأمر لا يتعدى مجرد تقديم الشكاية؟ وهل المرأة تستفيد من المساعدات الممكنة لولوج العدالة واستكمال إجراءاتها المطلوبة أم أنها تصطدم بمعيقات تمنعها من ذلك ؟
الحقيقة أن الواقع يجيبنا بتأكيد محدودية المرأة في الولوج للعدالة، فهنالك العديد من العقبات التي تحول دون تمكينها من حقها في الحماية القضائية، ومن أبرزها:
ـ عزوف المرأة أحيانا عن ممارسة حقها في التقاضي خوفا من نظرة المجتمع والمعيقات الثقافية السائدة ، خصوصا متى كانت الأضرار التي لحقت بها بسبب اعتداءات صادرة عن أحد أفراد أسرتها كالأب أو الأخ أو من طرف زوجها.
ـ قلة الوعي القانوني عند المرأة وعدم معرفتها لحقوقها، زيادة على عدم تمكنها من الإجراءات المسطرية والقانونية التي يتعين سلوكها عند الاعتداء عليها أو تعنيفها.
ـ بطء إجراءات التقاضي، وأحيانا عدم تناسب العقوبات المقررة من طرف القضاة مع خطورة الاعتداء والضرر الذي يلحق بالمرأة المعنفة والمعتدى عليها. وهو ما يحيلنا على إشكال آخر يتعلق بذكورية الجهاز القضائي على حساب النساء القاضيات. زد على ذلك أن وجود القاضيات ضمن جهاز القضاء يقتصر على البت والنظر في قضايا الأسرة والقضايا المدنية دون القضايا ذات الطبيعة الزجرية والجنحية إلا نادرا.
ـــ ارتفاع رسوم اللجوء إلى العدالة التي تعتبر مكلفة بالنسبة للمرأة المعتدى عليها، خصوصا التي لا تتوفر على مورد مالي. وضعف القدرات المالية عند فئة عريضة من النساء لتغطية رسوم المحاكم ودفع أتعاب المحامي، يشكل أحيانا سببا وعائقا أمامها فيمنعها من التوجه إلى الجهات القضائية المختصة من أجل حماية مصالحها وحقوقها. ومن بين الأسباب أيضا، والتي قد تمنع المرأة من تقديم الشكاية، وأحيانا تدفعها للتنازل عنها متى تقدمت بها أمام النيابة العامة، التبعية الاقتصادية للزوج بالنسبة للمرأة التي لا معيل لها والتي لا مورد ماليا لها خصوصا متى كانت أما. فخوفا من عدم وجود من يعيلها ويتكفل بها ماديا هي وأبناءها، فإنها تجد نفسها مضطرة لتحمل العنف وعدم التقدم بشكاية او التنازل عنها متى قامت بتقديمها
ـ معاناة المرأة من مشكلة إثبات العنف بمختلف أنواعه في شتى مراحل التكفل القضائي، بدءا من مرحلة البحوث التمهيدية، التي تنتهي في أغلب الأحيان بحفظ الشكاية من طرف النيابة العامة، بسبب عدم كفاية الأدلة، لأنه وفي غالب الأحوال لا تعتمد الضحية لإثبات العنف سوى على شهادة طبية فقط دون غيرها من وسائل الإثبات وهو ما يسهل الطعن فيه، خلافا لباقي وسائل الإثبات من قبيل شهادة الشهود مثلا..
: وحتى تتمكن المرأة من الولوج للعدالة نقترح التالي
ـ توسيع دائرة الإثبات بخصوص جرائم النوع؛
ـ تكريس مجانية المطالبة بالحق المدني في قضايا العنف ضد النساء؛
ـ تشديد العقوبة في حالة العود في جرائم العنف ضد النساء؛
ـ فتح إمكانية البت في الشكاية ضد العنف من طرف النيابة العامة دونما ضرورة تقديمها من طرف المعني بها المعنفة؛
ـ تكوين قضاة متخصصين في الميدان الأسري؛
ـ توفير أماكن لإيواء النساء المعنفات طيلة مرحلة التقاضي؛ والتكفل بهن طبيا متى كانت حالتهن تقتضي ذلك.
لذلك، نعتقد أن تمكين المرأة من الولج إلى العدالة، يقتضي قيام المشرع بإدخال مجموعة من الإجراءات التي قد تشمل، إذا لزم الأمر ذلك، تعديل وتغيير نصوص القانون بهدف ضمان تجريم أعمال العنف ضد المرأة، وإقرار إجراءات ملائمة للتحقيق والمتابعة، فالمرأة وقبل أن تلجأ إلى العدالة في حاجة إلى مقتضيات عادلة تمكنها من التمتع بحقوقها دونما تمييز أو عنف قد يمارس عليها من الرجل كان زوجا أو أبا أو زميلا أو مسؤولا إدلريا أو مشغلا….
03: الولوج للخدمات الصحية:
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يرى لزاما إعمال استراتيجية وطنية يتمثل الهدف العام منها في حماية صحة النساء. وينبغي أن تُدمج هذه الاستراتيجية تدخلات الطب الوقائي والعلاجي لكل الأمراض التي تصيب النساء، وكذلك وسائل محاربة العنف ضد النساء. كما يجب أن تضمن أيضا ولوج جميع النساء إلى مجموعة كاملة من العلاجات ذات جودة عالية وبكلفة في المتناول، وأيضا الولوج إلى الخدمات الصحية في مجال الجنس والإنجاب.
وهذا يقتضي تخصيص موارد من الميزانية وموارد بشرية وإدارية كافية لحماية صحة النساء، بكيفية تتم بها معاملة الرجال والنساء بكيفية متماثلة، في إطار ميزانية الصحة العمومية، وذلك اعتبارا لحاجياتهم الطبية المختلفة.
وإن السهر على أن يتم تبويء المناصفة بين الجنسين مكانة متميزة في جميع السياسات العمومية وجميع البرامج التي لها تأثير على صحة النساء يتطلب إشراك النساء في وضع تصور وإعمال وتتبع هذه السياسات والبرامج وفي تنظيم العلاجات الطبية المقدمة للنساء.
والمداخل الأساسية لذلك:
أ. السهر على القضاء على جميع العوامل التي تحد من ولوج النساء إلى العلاج والتعليم والمعلومات، خاصة في مجال الصحة المتعلقة بالجنس والإنجاب، وتخصيص موارد كافية للبرامج الموجهة إلى المراهقين من الجنسين بصفة خاصة، وذلك من أجل الوقاية وعلاج الأمراض المتنقلة جنسيا، سيما العدوى بفيروس فقدان المناعة البشرية/داء فقدان المناعة المكتسبة؛
ب. إيلاء الأولوية للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه وللتخطيط العائلي والتربية الجنسية، وتقليص نسب وفيات الأمهات بواسطة خدمات للولادة بدون مخاطر والمساعدة السابقة على الولادة. وعند الاقتضاء، ينبغي تعديل التشريع الذي يجعل من الإجهاض جريمة جنائية وإلغاء العقوبات المفروضة على النساء اللائي يقدمن على الإجهاض؛
ج. تتبع عن كثب لأصناف العلاج المقدمة للنساء من طرف هيئات عمومية ومنظمات غير حكومية أو مقاولات خاصة حتى يتمكن الرجال والنساء من الحصول على علاجات من نفس المستوى والجودة؛
د. السهر على أن تراعي جميع أصناف العلاج المقدمة حقوق المرأة، وخاصة منها الحق في الاستقلالية والكتمان والسرية، وحرية الاختيار وتقديم موافقتها وهي على بينة من أمرها؛
ه. السهر على أن يتضمن تكوين المعالجين دروسا إلزامية مفصلة وتولي عناية خاصة بالمناصفة بين الجنسين والصحة والحقوق الأساسية للنساء، خاصة في مجال العنف ضد النساء.
04: الولوج للتعليم:
ينطلق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من مرجعيته الاشتراكية الديمقراطية التي تجعل من العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين ركيزتين لبناء الدولة الاجتماعية المنشودة. وفي هذا الإطار، يعتبر الحزب أن الحق في التعليم، وخاصة بالنسبة للفتيات والنساء، حق أساسي غير قابل للتفويت، وأن ضمانه مجانيا وعادلا وذا جودة يشكل شرطا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ورغم المجهودات التي بذلتها الدولة المغربية لتحسين مؤشرات تمدرس الفتيات، لا تزال هناك اختلالات بنيوية وعوائق اجتماعية وثقافية تحد من تكافؤ الفرص، من أبرزها:
الفوارق المجالية: حيث ضعف البنية التحتية في الوسط القروي والمناطق النائية، وقلة الداخليات ووسائل النقل المدرسي، ما يؤدي إلى الهدر المدرسي المبكر للفتيات.
العوامل الاجتماعية والاقتصادية: فالفقر والهشاشة يدفعان الأسر إلى تزويج القاصرات أو إخراج الفتيات من المدرسة للمساعدة في الأعمال المنزلية، في غياب التحفيز المالي للأسر على تمدرس بناتها.
التمثلات الثقافية التقليدية: إذ لازالت بعض العقليات تعتبر أن تعليم الفتاة غير ضروري أو ثانوي، مما يحتم مضاعفة مجهودات التوعية بحقوق المرأة في التعليم والمشاركة المجتمعية.
أعطاب بيداغوجية: حيث يلاحظ نقص في التكوين البيداغوجي المراعي للنوع الاجتماعي.
واستمرار مناهج دراسية لا تزال تكرس صورا نمطية عن المرأة. مع استدامة ضعف حضور النساء في مهن التربية والتسيير والبحث العلمي على مستوى المناصب العليا مقارنة مع حضورهن المكثف على مستوى التدريس.
وبما أن تصور الحزب ينطلق من المرجعية الاشتراكية الديمقراطية التي تقوم على المساواة التامة بين الجنسين في الفرص والحقوق، والعدالة المجالية والاجتماعية لضمان نفس شروط التعلم في المدن والقرى، والتضامن الوطني كآلية لإرساء دولة اجتماعية تضع التعليم في قلب مشروعها المجتمعي، والتمكين عبر المعرفة باعتباره شرطا للتحرر الفردي والجماعي. فإننا نرى ما يلي:
في التعليم الأولي والابتدائي:
تعميم التعليم الأولي المجاني في جميع المناطق، مع تحفيز الأسر الفقيرة على تسجيل الفتيات عبر دعم مالي مباشر.
ضمان القرب الجغرافي للمؤسسات التعليمية من التجمعات القروية.
تكوين المربيات والمدرسين على مقاربة النوع الاجتماعي.
إدراج مضامين تربوية تزرع قيم المساواة والاحترام بين الجنسين منذ السنوات الأولى.
في التعليم الإعدادي والثانوي:
توسيع شبكة الداخليات والنقل المدرسي للفتيات في الوسط القروي.
إنشاء برامج دعم نفسي وتربوي للفتيات المهددات بالانقطاع.
مراجعة المناهج لتفكيك الصور النمطية حول أدوار المرأة والرجل.
دعم النوادي التربوية والثقافية النسائية في المؤسسات التعليمية.
في التعليم العالي:
اعتماد منح تفضيلية للفتيات المنحدرات من الوسط القروي.
تحفيز ولوج الفتيات للتخصصات العلمية والتقنية.
دعم البحث الأكاديمي في قضايا النوع الاجتماعي.
تمكين النساء من مناصب المسؤولية في الجامعات ومجالسها.
يعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي أن رهان الدولة الاجتماعية، كما ورد في تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، يمر عبر ضمان تعليم مجاني، منصف، ومنتج للمواطنة
ولهذا يدعو الحزب إلى:
جعل تمدرس الفتيات أولوية وطنية داخل السياسات العمومية.
إدراج مؤشرات المساواة في التعليم ضمن معايير تقييم الأداء الحكومي.
تعبئة المجتمع المدني والمنظمات النسائية والنقابات في معركة محو الأمية والتمكين التعليمي للنساء.
إن تمكين الفتيات والنساء من الولوج إلى تعليم مجاني وذي جودة ليس فقط قضية إنصاف اجتماعي، بل هو استثمار في المستقبل، فمجتمع متعلم ومتوازن لا يمكن أن يبنى دون مشاركة كاملة للنساء في جميع مستويات المعرفة والإبداع.
ومن هذا المنطلق، يجدد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التزامه التاريخي بالدفاع عن مدرسة عمومية ديمقراطية، منصفة، ومجانية، ترسخ قيم المساواة والكرامة والمواطنة.
خامسا: تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية:
ينطلق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من إيمانه الراسخ بأن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية لا يمكن فصله عن تحقيق العدالة الجندرية، فأي سياسة تنموية لا تراعي حاجيات النساء، خصوصا في الوسط القروي وشبه الحضري، تظل منقوصة وغير فعالة.
ولهذا، يقترح الحزب مقاربة تقاطعية تجمع بين النوع الاجتماعي، والانتماء الطبقي، والمجال الجغرافي، لضمان إدماج النساء في التنمية كفاعلات لا كمستفيدات فقط.
فرغم التقدم التشريعي والمؤسساتي في مجال المساواة بين الجنسين، لا تزال النساء، خصوصا في المجالات القروية والهامشية، يواجهن إكراهات مركبة:
الفوارق الاقتصادية والاجتماعية: وتتجلى في ارتفاع نسب الفقر والهشاشة في صفوف النساء، خاصة الأرامل والمطلقات والعاملات غير النظاميات، ومحدودية ولوج النساء لفرص الشغل والتمويل الذاتي للمشاريع الصغري، وضعف الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، خصوصا للعاملات في القطاعات غير المهيكلة.
الفوارق المجالية: من مثل ضعف الخدمات الأساسية في المناطق القروية (تعليم، صحة، نقل، ماء، طاقة)، وضعف تمثيلية النساء في المجالس المحلية والجهوية، ما يحد من قدرتهن على التأثير في القرار الترابي.
الإكراهات الثقافية والبنيوية: وتبرز جلية في استمرار أنماط تفكير محافظة تقيد أدوار النساء في المجال العام، وتضعف ولوج النساء إلى المعلومة والتمكين الرقمي، ويتفاقم الأمر مع محدودية فعالية البرامج العمومية بسبب غياب التنسيق بين الفاعلين.
ومن المهم التذكير بأن ما يؤطر تصور الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لموضوع المساواة المجالية والاجتماعية، هو المنظور الاشتراكي الديمقراطي الذي يقوم على المبادئ التالية:
الإنصاف كجوهر العدالة الاجتماعية، لا المساواة الشكلية.
التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء كرافعة للتنمية الوطنية.
التوزيع العادل للثروة والخدمات على أساس مجالي وجندري.
المواطنة المتساوية باعتبارها المدخل لبناء الدولة الاجتماعية الديمقراطية.
كما يستند التصور إلى ما ورد في تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إلى “تحقيق المساواة الفعلية وتمكين النساء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي”، وإلى ما نص عليه الدستور المغربي (2011) من التزام الدولة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وانطلاقا من ذلك يرى الحزب أن المقاربة التقاطعية هي المدخل الأنسب لفهم تعدد أشكال التمييز التي تتقاطع في واقع النساء. فالفلاحة القروية الفقيرة، مثلا، لا تواجه فقط التمييز بسبب جنسها، بل أيضا بسبب موقعها الجغرافي ووضعها الاقتصادي ومستوى تعليمها.
لذلك، يجب أن تصمم برامج تقليص الفوارق وفق رؤية تشمل كل هذه الأبعاد، لا أن تختزل في بعد واحد.
وعليه يقترح الحزب ما يلي:
على المستوى الاقتصادي:
خلق صناديق جهوية لدعم المقاولة النسائية القروية، وتبسيط شروط الولوج للتمويل.
تمكين النساء من الولوج إلى الأراضي الجماعية والموارد الطبيعية وفق مبادئ المساواة والشفافية.
تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني النسائي عبر التعاونيات والمشاريع الجماعية.
إدماج منظور النوع الاجتماعي في برامج الاقتصاد الأخضر والفلاحة المستدامة.
على المستوى الاجتماعي :
توسيع التغطية الصحية والتقاعد ليشمل النساء في القطاعات غير المهيكلة.
تعميم دور الطفولة والمراكز النسوية في القرى والمناطق الجبلية.
تطوير برامج محو الأمية الوظيفية والرقمية لفائدة النساء البالغات.
إدماج خدمات النقل الاجتماعي الآمن للنساء العاملات في القرى.
: على المستوى الترابي والمؤسساتي
فرض مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانيات الجهوية والجماعية.
تعزيز تمثيلية النساء في المجالس المحلية والجهوية، مع تكوينهن في القيادة الترابية.
إحداث مرصد جهوي للمساواة والعدالة المجالية لمتابعة أثر السياسات العمومية على النساء.
على المستوى الثقافي والتوعوي :
إطلاق حملات تواصلية لتغيير الصور النمطية حول أدوار النساء.
دعم الإبداع النسائي القروي (حرف، فنون، تراث) كرافعة للكرامة والتمكين.
تشجيع التعاون بين الفاعلين السياسيين والمدنيين في تنزيل مشاريع تراعي النوع الاجتماعي.
يرى حزب الاتحاد الاشتراكي أن تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية هو قلب مشروع الدولة الاجتماعية، ولذلك، لا يمكن أن يتحقق هذا المشروع دون دمج النساء في كل حلقاته: من التخطيط إلى التنفيذ إلى التقييم، كما يدعو الحزب إلى أن تكون مقاربة المساواة مبدأً أفقيا في السياسات العمومية وليس مجرد محور قطاعي.
فبناء مغرب العدالة الاجتماعية والمجالية يمر عبر تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في كل المجالات، ومن هذا المنطلق، يجدد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التزامه النضالي من أجل التمكين للنساء في كل المجالات وتحقيق التنمية الشاملة ذات البعد الإنساني والاجتماعي، وإرساء دولة اجتماعية ديمقراطية تجعل من الكرامة والمساواة والمواطنة المشتركة أسسا لمغرب المستقبل.
.