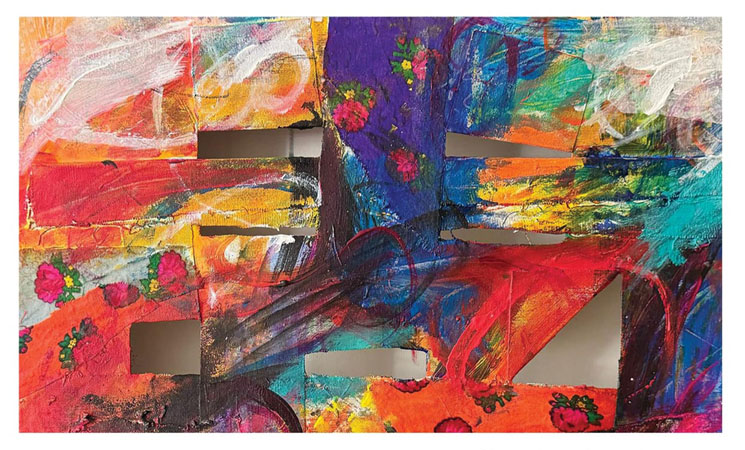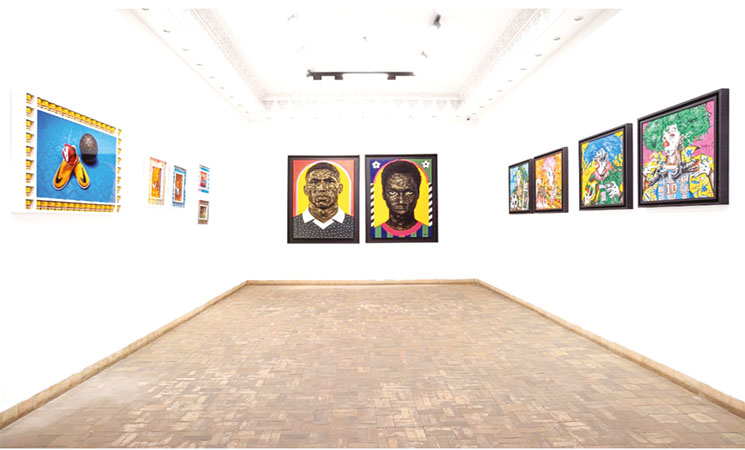سبق لـ « الإتحاد الإشتراكي» أن سلطت الضوء على المخرج المغربي الشاب محمد الهوري، خلال شهر شتنبر الماضي، للتعرف على مساره الفني وإماطة اللثام على المحطات التي تجاوز عقباتها، خاصة وأن السبل التي اتخذها للوصول إلى حلمه كمخرج لم يكن اعتياديا. كما أن دراسته الأكاديمية استهدفت العلوم الإنسانية لصقل مواهبه في اتجاه مزاولة فنه هذا، رغبة منه في معرفة فلسفة الحياة وكنه التصرفات النفسية للأشخاص قصد عكسها في أعماله. ومن بين المواضيع التي أثارته «تيمة الموت» التي ترجمها من خلال فيلمه القصير الذي يحمل عنوان «إعدام ميت».
مرت أسابيع على هذا الحوار ونال هذا العمل الفني جائزة أحسن إخراج في مهرجان بهولندا. حول هذا التتويج وأعمال أخرى كان هذا اللقاء.
p فيلمك القصير «إعدام ميت» نال جائزة أحسن مخرج بمهرجان بهولندا. كيف حصل ذلك؟ وهل خططت للأمر؟
n صراحة هذا هو أول مهرجان أجنبي أشارك فيه، وكان ذلك بمحض الصدفة حيث أن صديقة مخرجة هي التي قامت بطرحه على الصفحة، ولم أكن أتوقع نيل جائزة بما أنه كانت تنافسني افلام قصيرة لا يستهان بها. في الواقع، يتطلب المشاركة في المهرجانات من الفنان أن يكون دائم البحث وله علاقات وضمن شبكة معينة لكي يعرف متى وأين تتواجد هاته المهرجانات.
أقول دائما بأن «المهرجان هو مدرسة ومكان للتكوين»، فأنا شخصيا لم أتعلم السينما في المدارس بل من خلال مشاهدة الأفلام وأثناء مناقشتها مع مخرجين كبار أو من خلال «ماستر كلاس» ، إذ يكون هناك تحليل عميق للأفلام، وهناك تعلمت اللغة السينمائية المعبرة وليس التقنية، حيث هاته الأخيرة بالإمكان تعلمها بالمعاهد ولكن اللغة المعبرة الإبداعية تعلمتها أثناء المهرجانات.
فالفيلم القصير (أو الطويل) إذا كان يمتاز بالتقنية يكون جميلا ولكن إذا كان من الناحية الفنية متقنا في السيناريو وفي الأداء وفي التشخيص، فإنه يكون متميزا أكثر من التقني ونلاحظ هذا كثيرا في الأفلام القديمة التي طبعت المشهد السينمائي ولو أنها لم تكن تتوفر على تقنيات كبيرة.
العمل الفني عبارة عن سلسلة مترابطة، وبالتالي إذا ما كان هناك رابط ضعيف فهو يؤثر على العمل ويفسده.
p وهل تسعى هذه الأيام لأعمال جديدة؟
n أنجزت فيلما قصيرا في أواخر شهر شتنبر بعنوان «على حافة البحر» ويتطرق موضوعه للهجرة السرية والناس الذين يركبون المخاطر قصد الهجرة. وركزت فيه ليس فقط على المغاربة بل أيضا على الأفارقة القادمين من الجنوب والذين يتشاركون في نفس الحلم «الحريك»، الكل في نفس المركب.
جلبني هذا الموضوع وقررت تناوله بشكل مغاير بعض الشيء، إذ أن بطل القصة قروي لديه أراضيه الشخصية إلا أن حلم الهجرة ينخر جسده، وكان مانعه الوحيد هو جدته المقعدة. الجميل أن دور الجدة قامت به الفنانة راوية التي منحته لمستها الرائعة.
يستغرق الفيلم ما بين 15 و20 دقيقة، وهو لازال في مرحلة التوضيب، لأنني صراحة لست من النوع الذي ينهي الفيلم ساعتها، بل أترك ذهني يرتاح قليلا، حتى أستطيع تطوير رِؤيتي خلال المونتاج.
من بين الشخصيات التي تؤدي أدوار قصته: الممثلة القديرة راوية وكذلك الفنان محمد لقلع الذي يعرف خاصة في المجال الكوميدي، ولكن في هذا العمل منحته دورا مختلفا: دور أب فقد أحد أبنائه في البحر خلال الهجرة (الحريك) وتأثر كثيرا بالأمر لدرجة أصبح نوعا ما تائها «بوهالي» وهناك أيضا الفنانة الشابة عتيقة العقال ثم الفنان الشاب المغمور رشيد العماري.
ورغم الصعوبات، مر العمل في ظروف جيدة وتم التصوير بنواحي مدينة الجديدة. تمثلت هاته الصعوبات في الإمكانيات المحدودة خاصة وأنه تمويل شخصي. فضلا عن ذلك، يكون الفيلم القصير أصعب من الفيلم الطويل قلبا وقالبا، لا من ناحية الحكي إذ على المخرج أن يبرز إبداعه وكذا رسالته في وقت قصير، تمرين يظهر فيه مهارته.
من جهة اخرى أنا منهمك حاليا في كتابة سيناريو جديد لفيلم قصير آخر، عنوانه «عابرون» ويحيل إلى عبور كل إنسان في هذه الدنيا الفانية. هو امتداد ل»تيمة الموت» التي سبق وتعرضت لها في فيلم «إعدام ميت». فتيمة الموت كما سبق وشرحت خلال حوار سابق مع «الإتحاد الإشتراكي»، تغريني منذ القديم واستعملتها لتجاوز خوفي من الموت ولكي نتعايش معه. ولاحظت مؤخرا في الشبكات العنكبوتية كثرة النعي وكل واحد يتعامل مع «الموت» من زاويته، مما جعلني أرغب في الاستمرار في طرح هذا الموضوع من جانبه الفلسفي، لأنه لم يستنفد فحواه بعد.
إضافة إلى هاته الأعمال، انتهيت من تصوير فيلم طويل للفنان الشاب والمتميز المخرج ياسين فنان، وهذه أول تجربة لي في فيلم طويل بصفتي مساعد مخرج. أعتبرها تجربة جد متميزة وناجحة جعلتني أحتك بالعمل مع ممثلين كثر بالمقارنة مع الفيلم القصير الذي تعودت عليه، كما جعلتني أعرف سبل اخراج الفيلم الطويل، الذي أنوي مستقبلا الخوض فيه.
الفيلم بعنوان «لا درنيير ربيتيسيون» ويجمع ما بين الأسلوب المسرحي والسينمائي، من إنتاج شركة «م ف م» التي أتعامل معها والتي استدعتني لهذا العمل. الأدوار من تشخيص الفنانين: عبد الإله عاجل، حسناء الطنطاوي، جميلة العوني ثم الممثل الصاعد نبيل المنصوري وبعض الشباب الأخرين.
p ذكرت خلال إجابتك مسألة الدعم، فحبذا لو تخبرنا ما رأيك فيه بصفة عامة خصوصا ما أثاره مؤخرا من جدل بعد نشر أسماء الفنانين المطربين الذين استفادوا منه.
n ألاحظ أنه كلما طرحنا موضوع الدعم وكأننا نتحدث عن إعانة، في الوقت الذي هو بعيد كل البعد عن هذه التسمية. فالدعم يقدم للفنان الذي لديه مشروع يبيعه للدولة ولوزارة الثقافة والاتصال. هي مساعدة فقط لكون الوزارة تشتري مجهوداته بما أن لدينا مشكلا في التسويق للأعمال الفنية وبما أنه ليس بإمكان الفنان أن يتوفر (كما يفعل الغربيون) على دعم من طرف الخواص من شركات وغيرها كوكالات الإشهار مثلا، وبالتالي تتدخل الدولة لمساعدة هذا القطاع لكونه ثقافيا وليس تجاريا.
p هناك من يتفق معك في كون الدعم من حق الفنانين الذين يقدمون مشاريع، لكن يرفضون فقط توقيت هذا التصريف بما أننا نمر بهاته الجائحة.
n صحيح نحن نعيش فترة استثنائية، لكنها لن تدوم إلى الأبد.
وبالتالي فالدعم الذي تم تهويله مؤخرا، هو مؤسس له منذ سنوات لكن ما جعله يطرح الآن هو كون الكثير من الموسيقيين وغيرهم من الفنانين عرفوا بطالة مفروضة مع أنهم ككل الأشخاص لهم التزاماتهم الأسرية..
p على ذكر الالتزامات، ألا تعتقد بأنه حان الوقت للحكومة أن تسمح بفتح المرافق أمام مهنيي الفن ومنظمي التظاهرات الفنية ككل؟
n فعلا في ظل هاته الجائحة، المجال الفني يحتضر وكذلك الكثير من الفنانين الذين كانوا يتعيشون من هذه المهنة.
p ألا تظن بأن هذا القطاع كان من قبل يعرف مشاكل ولكن الجائحة زادت لتثقل كاهله أكثر؟
n بالفعل كان البعض ممن يمتهنون الفن عملهم موسمي أصلا ومع هاته الجائحة توقف كل شيء، وبالتالي العديد منهم اضطر لبيع تلفزاتهم أو آلاتهم الموسيقية.. لكي يشتروا ما يقتاتون به لهم ولأسرهم والأدهى أنهم لا يشتكون بسبب عزة نفسهم.
وإذا لاحظنا فإن أفلام السبعينيات لم تكن تستفيد من أي دعم وكان السينمائيون آنذاك يبدعون بما توفرت لديهم من إمكانيات، وهناك من كان يبيع منزله لكي يتمكن من الاشتغال. علما أن الإمكانيات التكنولوجية حينها لم تكن متطورة كما اليوم، فالفيلم القصير آنذاك كان يتطلب حوالي 20 مليون درهم لكي ينجز، وبالتالي فالدعم الذي يقدم اليوم هو بشكل من الأشكال رد للاعتبار.
المسألة التي لم تفهم هي أن للوزارة المعنية ميزانية مخصصة للمشاريع التي تقدم إليها وتمت المصادقة عليها، فهي لا تمنح زكاة أو تبرعات، بل مقابل خدمة. وهناك فنانون لا يعرفون كيفية تقديم المشاريع لأن عملهم هو التمثيل أو الغناء. فحسب.
p (مقاطعة) وهؤلاء يجب أن تقدم لهم إعانات…
n بل هؤلاء عليهم أن يجتمعوا في إطار شركة مثلا ويقدموا مشروعا ما ليحصلوا على دعم مقابل عملهم. في نظري عليهم بالاجتهاد والعمل. الحالة لوحيدة التي قد لا أتفق بخصوصها مع المسؤولين هو عدم نقسيم الدعم بشكل عادل.
ثم هناك مسألة أخرى تتجلى في اعتبار الدعم من حق الطبيب أو العسكري في فترة الجائحة. مع احترامي لهم، هناك وزارات تابعون لها هي التي من واجبها دعمهم ماديا أما الفنان فدعمه لدى وزارة الثقافة وهو دعم مشروع من حق المبدع ولولا الفن في ظل هاته الجائحة (أو بصفة عامة) لما ارتاح ذلك الطبيب أو العسكري ليستطيع القيام بعمله. فهؤلاء عندما يحتاجون للراحة يلجؤون لسماع الموسيقى أو رؤية فيلم. ثم إنه كثير من الجنود والأطباء هم موسيقيين أو فنانين…الفن ضروري كما جميع المجالات الأخرى.
عانى الفنان في فترة الحجر الصحي وهذا بديهي. فقد كنا في حالة حرب وارتقاب أمام عدو لا نعرفه، ولكننا الآن وقد تعرفنا عليه، أن تستمر الحياة وأن نتعايش مع الداء. وهذا ليس هو أول داء تعرفه البشرية ولا المغرب فيجب أن نفتح الباب للعمل مع أخذ الاحتياطات اللازمة بالطبع.
p ما رأيك في فكرة أن زمن كورونا عرى عن عورة المجال الفني؟
n كورونا جازاها لله خيرا، عرت على جميع الميادين، سواء التعليم أو الصحة أو الفن و الثقافة…وأظهرت وجهنا الحقيقي. لأن البنية التحتية جد هشة وفي بعض الأماكن منعدمة أصلا أو متواجدة بشكل محتشم. الجائحة أبرزت إذن عدة عيوب.
ويبقى السؤال هو هل حان الوقت لنهتم بها كمجالات تعد أعمدة أي مجتمع بما فيها التعليم والصحة والفن والثقافة والتي مع الأسف تخصص لها ميزانيات ضئيلة.
p إذن في نظرك يجب فتح المجال لمهن الفن والتظاهرات لكي تزاول مع أخذ الاحترازات الوقائية؟
n بالفعل علينا التعايش مع الأزمة فالتوقف يعني قطع الأنفاس. ربما علينا التحسيس والتوعية أكثر بالموازاة مع كل هذا ولا أعني الزجر كفرض غرامات. الأمر يتطلب إفهام الناس وليس استخدام العصا بالمعنى المجازي للكلمة.
هناك فكرة تراودني وأحب من هذا المنبر ان أقترحها كبديل: لطالما دعم المركز السينمائي المنتجين في افلامهم بنصيب من المال يعد استثمارا يسترجعه كطرف في العقد، بعد إخراج الفيلم للوجود. أقترح في هذا الصدد أن يتكلف نفس المركز ببناء قاعة سينمائية تابعة له في كل مدينة على غرار قاعة «الفن السابع» المتواجدة بمدينة بالرباط، حيث يعيد بث الأفلام المغربية في تلك القاعات بعد انتهاء المدة الزمنية القانونية التي يعرض فيها بالقاعات الخاصة.
من خلال ذلك، يضرب المركز السينمائي عدة عصافير بحجرة واحدة: يستعيد ما سبق واستثمره في ذاك العمل الفني كما يروج للأفلام الوطنية، فكم منها توضع في الرفوف دون أن نراها سوى في المهرجانات أحيانا، مما يساهم في تشجيعها وخلق صناعة سينمائية في المغرب.