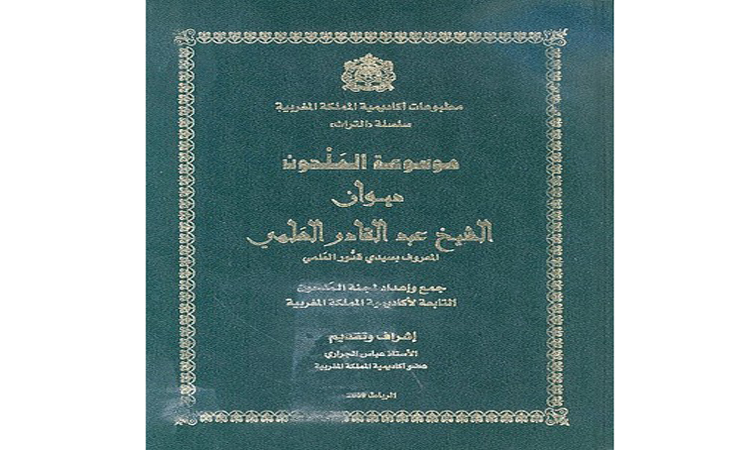إن القراء اليوم المولعين بـ «تراث فن الملحون» الأصيل يريدون أن يتعرفوا – بدورهم – على بعض الجوانب الخفية من حياة فرسان الزجل بالمغرب، وهي جوانب جد هامة ومفيدة، ظلت مخزونة بين ثانيا الصدور، ومحفوظة في الذاكرة الشعبية زمانا غير يسير، وعلى تعاقب الأجيال المغربية؛ وقد رصدنا من أجل توثيقها مجموعة من اللقاءات والمهرجانات الفنية أزيد من خمسة عقود خلت.
لقد عرف الشيخ العلمي رحمه لله بعدد كبير من أولياء المغرب حيث يذكر بعض رجال مدينة مراكش. كالقاضي عياض، والإمام السهيلي، وأبي العباس السبتي، ويوسف بن علي، والجزولي، وغيرهم :
قاضي عيَّاضْ والسَّهْــلِـــي وَالسَّبتي
أبو العباس غـُـــوثـْــنا بُو الدّْراوَشْ
هـُو يَطْفي ابصَرخـْـتـُو صَهْـــدْ الهَـفْــــتِي
الـْما يَطْفي الْـمَا الـْظـَا جُوفْ العـَاطشْ
الـْجزُولي الشّْريف ستجبْ لـَدعــــــــوتِي
دعوت مَن اعـْـلـَى الَعْطَفْ يَبْحْثْ وايفَايَشْ
لَلاَّه يـَا رْجَالْ حضرة مرَّاكش
وذكر بعض ملازمي العَلمي أنه يخيل إليه في لحظة الاستغراق، أن الوجود كله قد راق، وخلا من كل شر ونكد، وامتلأت القلوب فيه محبة وولاء لله ، ولرسوله – صلى لله عليه وسلم-، وهذه اللحظات الرهيبة التي كان يشعر بها العلمي هي تلك اللحظات الروحية التي ينتقل معها السالك – عند بعض المتصوفة – إلى فكرة الاتحاد، وهي درجة هامة من درجات الاستشراق تتحد فيها الأرواح اتحادا تاما بالخالق، وذلك بالتجرد عن حول العَبد وقدرته، إلى حول لله وقدرته، فيقوى بذلك وتتلاشى شخصيته البشرية في الذات الإلهية عن طريق عدم رؤية العبد لنفسه؛ وفي هذه الأجواء الروحانية بمدح الرسول في القصيدة التي يقول في مطلعها :
الصْلاة وَالسَّلامْ علـَى النـّْبي الـْمَبْرُورْ
اعـْدادْ ما خـَلـْقْ الله ْ امْيَاتْ ألفْ مرَّة
نعم، ففي هذا القسم من أقسام هذه القصيدة يخاطب فيه الرسول الأعظم، صاحب المعجزات، والمحظوظ بالإسراء والمعراج، والذي فتح لله أمامه الحجوب في بساط العز والثناء، ثناء أرواح الأنباء من قبل أن ينشأ الكون، وظهور جميع المخلوقات؛ وإلى هذا يُشير العلمي في الأبيات الآتية:
مَنْ صَدْقْ الحَقْ فِيكْ يَابُو المعجزاتْ
من قـَبْلْ انْشَا اجمْيعْ الاشْياتْ انْشِتِيي
وتـْرقـِّـتي في امْنَازَه السَّبْعْ اسْمَوَاتْ
وعـــلى الامْــلاكْ والارْسَالْ اسْتوْلِيتِي
وفتحْ لـَكْ ابْوابْ الحْجوبْ العْظْمَاتْ
فِــي ابْسَاطْ الـْعَزّْ معَ الـْحَقّْ اتْـناجِيتي
وَارْوَاحْ الأنْـــبـــــاء عليهم الصَّلاة
في بيت المقدس اجْميعْ بهُمْ صَلِّيتي
وعليهم بالمقام والقـَـدْرا عْليتي
******
وهذه صورة شعرية أخرى من نفس القصيدة المسماة «الشَّافي» يتوسل فيها إلى ربه ضارعا، خاشعا، يقول في مطلعها ما نصه :
يـَا الشَّافِي بْحَكمْتـَكْ حـَالْ كـُـــــلْ مضْرُورْ
اشْفِي عـْلايَـــــــلْ ذاتِ منْ ذَا الوْجَاعْ نـَـبْرَا
طَهَّرْ ادْوَاخـَلْ قـَلـْبي مَنْ اجْمِيع الكـْــــــدُورْ
كـْمَا اطْهَارْتْ قـْلُوبْ الصَّادقينْ اهْلَ البَشرَة
امْحَاسَنْ الدُّنياَ هَجْرُوها بغاية الـنــُّــــــــــورْ
امْنينْ غـَنـْمـُوا في وَجْهْ سِيدْ الرّْسُول نـَظْرَة
مَنْ ادْعـيتـْنـَا لـَصْلاتـُه في كـُلْ مَـسْـطُـــورْ
اعْـلِيهْ ألـَفْ اصْلاة وَالرَّضْوَانْ على الـْعَشرَة
والـْعْـمَامْ والأنْصَـــــــــارْ مَع الازْوَاجْ البْدُورْ
واهْلَ البيتْ اوْلادْ المْشَرْفـَة الزَّهْـــــــرَة
وفي هذا السياق – أيضا- ذكروا أن العلمي، كان يستغرق في العبادة وقتا طويلا، حتى يخيل للناس عامة أنه لا شغل له سوى العبادة والخلوة إلى ربه؛ ومرة نراه يسرف في حب جماعته ومحيطه، ويخصص الكثير من أشعاره العلاجية الاجتماعة حتى يخيل لنا أن العلمي، قد انقطع عن العبادة، وغدا شغله الشاغل، قضاء مآرب الناس، ومتابعة أحوالهم، والجلوس إليهم في كل مناسبة من المناسبات ؛ نعم، فلقد كان – رحمه الله – يتودد إلى ربه، يناجيه ويخلو إليه، كما كان يتودد إلى جماعته العريضة، ويحبها، ويخلص إليها إخلاصا، إن المتأمل في قصائد المديح، وما يتفرع عن هذا اللون من موضوعات أخرى صوفية، سيلاحظ أن العلمي – رضي لله عنه – قد كشف بحبه للرسول – عليه السلام – ولآل بيته الطاهرين – رضوان لله عليهم – عما كان ينفعل في نفسه من بَرَم وضيق خانق بحال الدنيا وأمراضها الاجتماعية من خلال سلوك الناس، ومعاشرتهم. فلقد أراد أن تحس مشاعره هذا الحب متمثلا في الأخلاق والمعاملات، وفي أعراف الناس وتقاليدهم. ظاهرا وضوح الشمس في النهار في كل نفحة من نفحات الحياة؛ وحين غابت هذه الصورة بمعالمها، وقسمات مظاهرها المثالية التي كانت يحلم بها العملي، توجه إلى الوعظ والإرشاد مرة، وإلى تنبيه الناس واستنهاض هممهم ومشاعرهم مرات، ومرات : عساهم ينهجون نهجه الصوفي، فيتوبون إلى الله ويستقيمون، وهذا مبتغاه ومناه. وفي مدينته – مكناسة الزيتون – كان يلاحظ عن كثب مشاهد من الأوبئة الاجتماعية التي انتشرت في محيطه، ومن الفساد الأخلاقي الذي عم كل مظاهر حياة جماعته الشعبية العريضة ؛ نعم، شاهد هؤلاء وهم منشغلون بمفاتن الدنيا وزينتها عن الدين والاستقامة، ويعيشون فيها كما تعيش الدواب، بل هم أضلّ، فلا مطمع لهم فيها سوى إرضاء شهواتهم، وإنعام الغرائز البهيمية، والتسلط، والتجبر !!
وحين علم العلمي بأن هذا السلوك من جماعته ومحيطه قد استحكم في النفوس، وهيمن على ذوي الهمم الباردة، تصدى – بتوفيق من الله – لمقاومته ومناهضته بنفس قلقة مضطربة، فانطلق في مدائحه، وزهدياته، وحكمه يذم الدنيا ساخطا على متعها، رافضا لمباهجها، لم توفر لجماعته ما كان يتمناه ويرتضيه، ولم تعانق الناس عامة عناق الاطمئنان والسلامة وهدوء البال !! انطلق من خلال تجربته يعظ الناس، ويُرشدهم، محلقا بروحه في سماء معالي أهل لله .
* – مظاهر من الجذب في حياة العَلمي:
إن الذاكرة الصوفية بمدينة مكناس، تختزن الكثير من أخبار العلمي، وما كان يُروى عن أحوال الجذب في حياته؛ ومن هاته المرويات في هذا السياق، ذكروا أن أحد مريديه، أنشد في حضرته قصيدة التوسل بعد أداء صلاة الصبح يوم جمعة ، فانتشى العلمي بها انتشاء، ومع طلوع الشمس، نظر إلى السماء نظرات، وأطال التأمل على غير عادته، وكأنه حمل إلى السماء بهذا التوسل نورا وهاجا يوصله بتلك القبة الزرقاء، ومن ورائها قبس نوراني، يشع بين أرجائها ويرسل نورا هاديء إلى كل قلب خفاق من قلوب السالكين مسالك الخير والمتجلية له من خلال المعاني السامية التي تضمنها توسُّله. وتضرعه إلى ربه بنفس راضية مرضية؛ إنها معاني الخلود، قد ألقت في روعه خواطر من الإلهام، فتحولت هذه المعاني إلى كلمات، وجمل دافقة اهتز لها اهتزازا، فصارت بمواهبه من بدائع التجليات الربانية، يوتيها الرب الكريم لمن يصطفيه من عباده ويختار ؛ وفي هذه الحالة من حالات الجذب التي تعتريه من حين لحين، خرج العلمي وهو يردد الصفات الآتية من أسماء لله الحسنى، لم نهتد إلى ألغازها، ومراميها البعيدة عنده: قوي، فعال، مريد، مهيمن، غفور، شكور، تواب، عليم خبير، فعال لما يريد، وتعالى لله عما يراد. وإذا كان ارتباط العلمي بمحيطه وجماعاته العريضة قد ساهم في إنضاج تجربته فإن أسلوب تفاهته بزخرف الدنيا كان بمثابة سخط والد رحيم يوجه نصيحته الغالية إلى أبنائه فلذات كبده، ويعطيهم الكثير من عمق تجربته وأسرار عراكه مع الحياة في سرائها وضرائها وفي صحوتها وغفوتها.
ولذا فإننا لا نحمل بَرَمَ العلمي وضيقه من أعداء الحياة وصروفها ومن عيوب الناس وخذاعهم ومكرهم على ضبابة نفسيته وعلى شقائه، بدل على ما كان – أيضا – يعانيه قبل هذه المرحلة العمرية بالذات وهي مرحلة جذب واستشراق جاءت معها نفحاتُ ا لإبداع، على غير ما عرفته مراحل عمرية سابقة.
انتهى