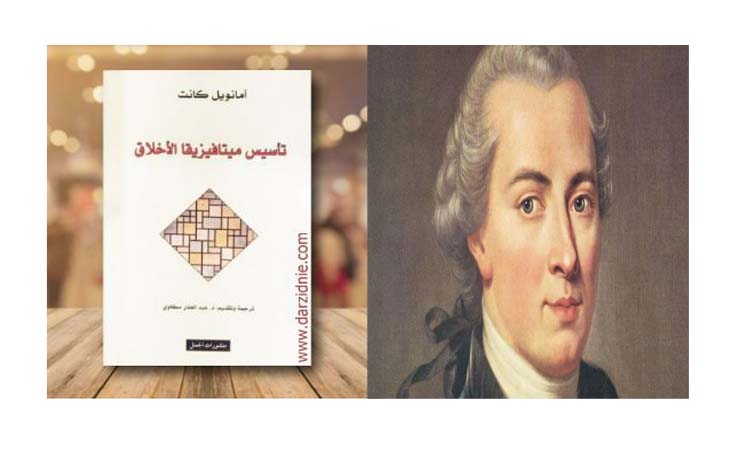«ميتافيزيقا الأخلاق» هو أحد كتب إيمانويل كانط (1724 – 1804 ) الذي لم يترجم للغة الضاد بعد، رغم الأهمية القصوى له، لتوسيع معرفتنا بهذا الوجه الفلسفي الألماني، الذي شغل عالم الفكر عامة، والفلسفة على وجه الخصوص منذ أول دروسه الفلسفية في جامعة كونيغسبيرغ Königsberg (كالينينغراد Kaliningradالروسية حاليا) عام 1755. سنحاول، في السنة الثلاث مأة (300) على ولادته، رسم الوجوه المختلفة له من خلال قرائتنا للجزء الأول من هذا الكتاب، على أن نعود لاحقا إلى إكمال هذا الرسم عندما نختم الفصل الثاني.
الجزء الأول: „النظرية القانونية“ حافل بمواقف تقربنا أكثر من شخصية كانط كفيلسوف وإنسان عاش العواصف الأخيرة للثورات الأوروبية الكبرى (في فرنسا وأنجلترا وإيطاليا وإسبانيا إلى حد ما)، وتفاعله مع أحداث عصره ومسايرته للجو الفكري العام، الذي فرض نفسه أنذاك، فيما يسمى بعصر الأنوار والتغييرات السياسية الجذرية، التي تأسست بالخصوص على أفكار قانونية، مقابل الفيوداليات، التي كانت تحكم بقوانينها الخاصة، مستوحاة بالأساس من سلطة الكنيسة، التي كانت أكبر عقبة لتجديد النسيج الفكري والسياسي الأوروبي. ومن المعلوم أن ألمانيا كانت من أبطأ الدول الأوروبية التي حدثت فيها هذه التحديثات، ونلمس حذر كانط الكبير باللف والدوران حول مواضيع قانونية بعينها، وبالخصوص تلك التي كانت تمس مباشرة أنظمة الحكم وممالك ألمانيا أنذاك، بل وحتى هيمنة الكنيسة السياسية، التي لم يدخل كانط معها في مواجهة مباشرة، على الرغم من إن „قلبه“ كان ينبض بالخصوص للثورة الفرنسية وما حققته.
1. كانط بين المحافظة والتجديد السياسيين
يسبح كتاب „ميتافيزيقا الأخلاق“ فيما سماه كانط نفسه، الفلسفة التطبيقية، البنت الشرعية للعقل العملي عنده. ولرفع أي التباس، فإن العقل العملي لا يعني عنده العقل البرغماتي الأداتي، على الرغم من أن هناك نصيب كبير من البراغماتية في هذا العقل، بل يعني فيما يعنيه تتبع أساليب ومناهج منطقية للوصول إلى نتائج يقبلها العقل. وحتى وإن كان كانط يؤمن بالعقل وقدراته الهائلة، غيمانه بوجوده ذاته، إلا أنه في سلوكه العملي اليومي في تفكيره السياسي، سقط في تناقضات -من خلال نتائج قرائتنا للفصل الأول هذا-، بل قد لا تكون تناقضات بالمعنى المتعارف عليه، لكن تجاذب، نشعر كانط يتأرجح فيه كالباندول بين العقل الثوري والتوجه المحافظ، يقدم رجل ويسحب الأخرى بحذر رهيب، وكأنه يمشي في الغابات المحيطة بمدينة كونيغسبيرغ في ظلمة حالكة وقلبه يرتعش خوفا. يبني في هذا الجزء ترسانة من المفاهيم القانونية ويعين معانيها ويعطي أمثلة على ذلك، ويؤكد جهرا بضرورة بناء دولة يحكم الشعب فيها نفسه بنفسه، دولة مؤسسة على قوانين يصادق عليها الشعب، من خلال ممثليه. لكن هذا الشعب لا يحق له النهوض ضد هذه الدولة، حتى وإن كانت ضد الشعب، وتعمل في غير صالحه، لأن ذلك، حسب فهمه، سيُرجع المجتمع لقانون الغاب. بكلمة موجزة، يقف كانط هنا في صف الدولة ومشرعيها ضد الشعب، وهو وقوف يمكن تأويله بطرق شتى، بل لا يبرر حتى لماذا على الشعب أن يقبل ما تشرعه دولته دون نقاش، ولا يقدم أية بدائل لهذا الشعب ليسحب ثقته بالحكومة ويختار أخرى. يقول بالحرف: „إذا كان هناك شعب توحده القوانين تحت سلطة واحدة، فإن فكرة وحدته تحت إرادة عليا قوية تُعطى كموضوع للتجربة؛ ولكن بالطبع في المظهر فقط؛ أي أن هناك دستور قانوني، بالمعنى العام للكلمة؛ وعلى الرغم من أنه قد يتضمن عيوبا كبيرة وأخطاء فادحة، وقد يتطلب تحسينات مهمة تدريجيا، إلا أن مقاومته غير مشروعة وإجرامية بالكامل؛ لأنه إذا اعتقد الناس أن من حقهم استخدام القوة ضد هذا الدستور، رغم أنه لا يزال معيبا، وضد السلطة العليا، فسيعتقدون أن لديهم الحق: في وضع القوة بدلا من التشريع، الذي ينص على جميع الحقوق بشكل أعلى؛ والذي من شأنه أن يعطي إرادة عليا لتدمير الذات“.
2) كانط بين العلمانية والدين.
لم يعرف على كانط معاداته الواضحة للكنيسة، بل كان دائما حذرا في هذا المضمار، حتى في الكتب المخصصة للنقد. ويطالعنا كانط في هذا الجزء من الكتاب الآنف الذكر بموقف متذبذب للغاية اتجاه الكنيسة، بل وحتى اتجاه العلمانية، وبالخصوص الفرنسية منها. فحتى وإن سجل في مضمار حديثه عن قانون الإرث والملكية بأن الرهبان لا يخلفون أطفالا، وتحتفظ الكنيسة بممتلكات قديسيها عند موتهم، فإنه يدعو صراحة ألا يجرد المرء الكنيسة من ممتلكاتها هذه، لأنه يعترف لها بدور روحي وخيري، بل يؤكد على نوع من حرية المعتقد للشعب، أي الإيمان بالمسيحية، كالدين المسيطر في البلد. يقول في هذا الإطار: „إن رجال الدين (الكاثوليك)، الذين لا يتكاثرون، يمتلكون، بفضل الدولة، أراض ورعايا تابعين لهم، وهذه الأرض وهؤلاء الرعايا ملك لدولة روحية/دينية (تسمى الكنيسة)، منحها العلمانيون أنفسهم كملكية لهم بالوصية لخلاص أرواحهم، وهكذا فإن رجال الدين، كطبقة خاصة، يمتلكون ملكية يمكن توريثها قانونيا من جيل لآخر وموثقة بما فيه الكفاية بالفتاوى البابوية. فهل يمكن أن نفترض أن العلاقة التي تربط الكنيسة بالشعب، بسلطة الدولة العلمانية، يمكن أن تؤخذ منها، ألا يكون ذلك بمثابة أخذ مُلك أحد بالقوة، كما يحاوله كفار الجمهورية الفرنسية؟“.
كل هذا بنقده الجريئ لحملات التنصير، التي قادتها الكنيسة في أمريكا اللاتنية مثلا، وعدم اتفاقه على فرض الدين المسيحي على شعوب لها معتقداتها الخاصة. لكن عندما نمعن النظر، ونقرأ بتأن نصادف أيضا دفاعه على هذه الممارسة الكنسية، لأنها في عرفه „تُنَوِّرُ“ و“تُحَضِّر -من الحضارة- شعوبا „متوحشة“ في نظره. وتقودنا هذه النقطة إلى لمس، بل تعرية، الفكر الكانطي العنصري، الذي لا مبرر له، والذي نجده كذلك وبوضوح في مواضع أخرى من مؤلفاته.
3) كانط بين الإنسان الكوسموبوليتي والإقصاء
قد نكون طوطولوجيين إن ذكَّرنا بأن كانط صنَّف الأجناس البشرية طبقا للمعايير العرقية في شكل سلم سيكو-فيزيولوجي، يحتل فيه البيض الصدارة ويعتبرون عنده أذكى بشر على وجه البرية، وهم، في نظره، بناة الحضارة. يليهم الجنس الأصفر ثم الأسود والأحمر. يكفي هذا بالكامل لفهم المركزية الأوروبية الكانطية. ولا يمكن، بل لا يجب، اعتبار فكرة العرق هذه مظهرا خارجيا فقط عنده، بل إنها بمثابة قانون أخلاقي، بدليل أنه لا يعترف مثلا للإنسان الأسود بإنسانيته كاملة، لأنها لا توجد إلا عند الأوروبيين البيض في نظره.
تفكير كانط في هذا الإطار يقدم لنا وجها خاصا له وعنه، ذلك أن ما اشتغل عليه من نظريات وتحليلات كبرى في المنطق ونظرية المعرفة، لا يتطابق مع ما قدمه في الأخلاق بالذات، باعتبارها فلسفة تطبيقية. وبهذا يمكننا التأكيد، دون خجل ولا تحفظ، بأن ما يسمى أصالة الذات، منعدمة بتاتا عنذ كانط. والمراد بهذه الأصالة، طبقا لإيريك فروم، هو أن يحاول الإنسان تقليص الهوة بين تفكيره وسلوكه إلى الحد الأدنى، ليصبح سلوكه اليومي مرآة لفكره. ولا نلمس هذا عند من «نظر» لحقوق الإنسان، الذي يقول في كتابه «الإحساس بالجميل والجليل»: «إن زنوج إفريقيا لا يثيرون في النفس الإنسانية أيا من المشاعر الراقية، وهذا يجعل التخلص منهم أمرا لا تهتز له المشاعر الإنسانية، ومن ثم لا يمكن تجريم ما يفعله المستعمر الأوروبيّ في إفريقيا». أو عندما يقول عن الهنود الحمر: «إن مَلكة العقل لديهم ناقصة بطريقةٍ أو بأخرى، […] تثقيف الأمريكيين وتعليمهم أمر مستحيل؛ فهم لا يملكون دوافع تحفيزية، إذ تنقصهم العاطفة والشغف».
تأسيسا على ما سبق، يمكن القول أن الأخلاق التي وضع لبنتها كانط هي أخلاق شجعت البيولوجيا العنصرية، استغلها الرجل الأبيض في تعامله مع الأجناس البشرية الأخرى، وبالخصوص في عز حملاته الإستعمارية وغزوه لشعوب بعيدة بآلاف الكيلوميترات عن أوروبا. هناك إذن توجه واضح أوروبي مركزي واضح عند كانط، لا يمكن إنكاره، لأن نصوصه واضحة في هذا الأمر ولا غبار عليها. وليس هناك أي مبرر، ولا يجب خلق الأعذار لكانط على هذا التوجه، لأن فلاسفة عاصروه لم يسقطوا في هذا الفخ، بل على العكس من ذلك، ناضلوا ضد الميز العنصري وفكرة تفوق الإنسان الأوروبي، باعتباره بشرا مثل الآخرين، لا أقل ولا أكثر.
ختاما، فإن الجزء الأول من «ميتافيزيقا الأخلاق» مليئ بمواقف كثيرة متجاذبة لكانط، عن التربية، وتصوره للمرأة، والثورة، والحرب، والسلم، وبناء دولة قانونية، وعلاقة أوروبا بالشعوب الأخرى، وما النقط الثلاث التي قدمنا هنا بتركيز شديد، إلا عينة على هذه المواقف. ولا يُنقِص هذا التجاذب من قيمة كانط الفلسفية، ولم يكن هدفنا من تقديمها الطعن فيه كفيلسوف، بل فقط إتمام الصورة التي نعرفها عنه، بالأدوات النقدية التي طورها هو نفسه، وورثتها أجيال متعاقبة بعده، بما فيهم من كان يريد إقصائهم من باحة التفكير في نظريته حول أجناس البشرية. ولو كان على قيد الحياة، لكانت هذه الأجناس أثبت له، بأن ما أكده عنها، ليس له أي أساس من الصحة، وأن السود يشاركون سياسيا في تسيير شؤون العالم وفي البحث العلمي والرياضة إلخ، وبأن الهنود الحمر، على الرغم من إبادتهم الجماعية، لايزالوا متشبثين بحقهم في الحياة وفي الحرية وفي العيش الكريم، وبأن الآسيويين يستعود لقيادة العالم أو فرض اقتسام هذه القيادة.