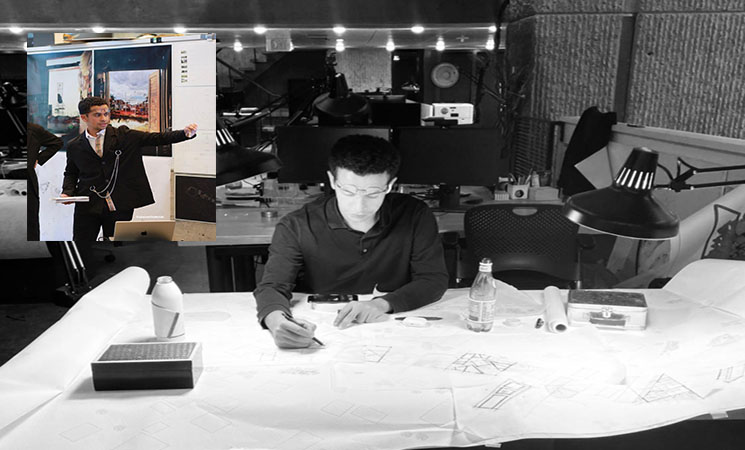بعد أن استعرضنا في الجزء الأول أهم الأفكار والأطروحات التي تأسست عليها مواقف منظمة « إلى الأمام» و « منظمة 23 مارس» و» ولنخدم الشعب»،
نستعرض في هذا الجزء أهم الأطروحات النظرية والسياسية للفقيد عبد السلام المودن، وللأستاذ علال الأزهر المنبهي بوصفهما قياديين بارزين من مؤسسي اليسار المغربي الجديد، ومن الكوادر التاريخية لمنظمة 23 مارس. وتلتقي كتابات الفقيد عبد السلام المودن، وكتابات الأستاذ علال الأزهر في دحض الأطروحات الانفصالية، في أبعادها السياسية، والوطنية، والقومية، والاشتراكية في مرحلة دقيقة من الصراع الداخلي الذي كان يتجاذب مواقف التنظيمات الثلاثة، سواء من داخل تجربة السجن ، أو خارجه. ولتيسير مقروئية هذه المواضيع سنعمل على استعراض أهم مضامينها، وخلاصاتها حسب التسلسل الوارد في المصدرين اللذين اعتمدناهما في انجاز هذا الملف.

بهذا المعنى ،فإن الامبريالية ،حسب عبد السلام المودن ، من حيث الجوهر الاقتصادي لا تعني شيئا آخر سوى الرأسمالية الإحتكارية. وبما أن الظاهرة الامبريالية لم تكن مقتصرة على دولة أوربية واحدة، وإنما شملت مجموع الدول الرأسمالية المتطورة، لذلك كان لا بد من أن ينشب تنافس وصراع بين الامبرياليات حول المغرب. وهذا الصراع كان بين: فرنسا، وبريطانيا ،وألمانيا ،وإسبانيا (بحكم موقعها الجيو- سياسي). ولقد انتهى ذلك الصراع إلى اتفاق سلمي بشأن المغرب. (لنلاحظ أن الامبرياليات المتصارعة حول اقتسام مناطق أخرى من العالم، قد عجزت عن التوصل إلى اتفاق سلمي، إذ بعد سنتين فقط من الاتفاق بشأن المغرب اتخذ الصراع طابع انفجار حرب عالمية شاملة). إن الحل الامبريالي لما سمي بالمسألة المغربية، قد أدى إلى تمزيق وحدة التراب الوطني المغربي، ونزع السيادة عن الدولة المغربية الوطنية. إذ قبل هذه الواقعة، كانت الطبقة الاجتماعية الحاكمة التي تمثل الدولة الوطنية المغربية، هي الطبقة الإقطاعية.
ولقد تشكلت تاريخيا الدولة الوطنية الإقطاعية، على أنقاض الدولة الإمبراطورية التجارية التي سبقت هذه المرحلة من تاريخ المغرب. وذلك أن الانتقال من عصر الإمبراطوريات المغربية الكبرى إلى عصر الممالك الإقطاعية، هو الذي خلق الشروط الموضوعية لرسم وتعيين الحدود الترابية التاريخية والطبيعية للدولة المغربية الوطنية.
إن الأساس الاقتصادي لهذه الدولة الوطنية، هو استغلال فائض إنتاج الفلاحين المغاربة من قبل الطبقة الإقطاعية المغربية، بجناحيها معا، الإقطاع المركزي الذي يمثله الحكم المخزني، والإقطاع المحلي الذي تمثله الزوايا( خصوصا في فترات ضعف الحكم المركزي) . وهذا الأساس الاقتصادي هو النقيض للأساس الذي قامت عليه دولة الإمبراطوريات السابقة، والذي كان يتجلى في الفائض التجاري الناجم عن تجارة الذهب التي كان يقوم بها المغرب بين إفريقيا السوداء وبين أوروبا والشرق الأوسط.
ويعتبر عبد السلام المودن أن الطبقة الإقطاعية المغربية إذن، هي صانعة الدولة الوطنية المغربية بحدودها الترابية التاريخية – الطبيعية. ومنذ تأسيس هذه الدولة في المرحلة الثانية من العصر المريني في القرن الخامس عشر، قد شكلت ميدانا للصراع الوطني، (من جهة ضد الأجنبي الاسباني والبرتغالي المسيحي، ومن جهة أخرى ضد الأجنبي العثماني المسلم الذي كان يحتل التراب الجزائري والتونسي)، وفي نفس الوقت ميدانا للصراع الطبقي بين الإقطاع والفلاحين من جهة، وبين الإقطاع المركزي المخزني والإقطاع المحلي من جهة ثانية. (إن هذا الصراع الطبقي داخل الطبقة الإقطاعية الواحدة، الذي كان يحركه تفاوت التطور بين الإقطاع المركزي المخزني والاقطاع المحلي – الإقليمي للزوايا، هو الذي يفسر ظاهرة تعاقب سلالات مختلفة على رأس الدولة المغربية: السلالة المرينية، فالوطاسية، فالسعدية، فالعلوية). ويخلص الفقيد عبد السلام المودن إلى أن» الحدود الترابية الطبيعية للدولة المغربية، قد ترسخت تاريخيا عبر ذلك الصراع الوطني والطبقي نفسه».
وفي سنة 1956 بعد حصول المغرب على استقلاله السياسي، لم تكن حدود دولة الاستقلال هي الحدود الطبيعية الديموقراطية للدولة المغربية التاريخية.
فلقد تم بتر بشكل تعسفي أطراف هامة من ترابها، إذ أن طرفاية وافني والصحراء الغربية ظلت خاضعة للإستعمار الاسباني، بينما الامبريالية الفرنسية اقتطعت منطقة شنكيط لتؤسس فيها دولة موريطانيا مصطنعة، كما أنها ضمت منطقة تندوف إلى التراب الجزائري (هذا فضلا عن استمرار احتلال مدينتي سبتة ومليلية والجزر).
ومنذ ذلك التاريخ والشعب المغربي يناضل من أجل الحدود الديموقراطية لدولته الوطنية. وما قضية الصحراء الغربية سوى حلقة ضمن ذلك النضال الوطني العام.
فما هو إذن الموقف السياسي السليم الذي ينبغي على كل مناضل اشتراكي حقيقي أن يلتزم به تجاه هذه القضية؟.
إن قضية الصحراء ليست قضية وطنية فحسب. بل هي أيضا قضية ديموقراطية لأن الحدود التي ورثها المغرب عن المرحلة الكولونيالية الامبريالية ليست حدودا ديموقراطية. هناك إذن تناقض: بين الامبريالية التي رسمت بشكل تعسفي اضطهادي، حدودا مصطنعة للدولة المغربية، وبين حق الشعب المغربي في رفع الاضطهاد والتعسف من أجل إقرار الحدود الطبيعية لدولته التاريخية.
ولأن الاشتراكيين هم أكثر الديمقراطيين ديموقراطية، بسبب عدائهم التام لكل أشكال الاضطهاد والتعسف، فبالتالي لا يمكن لأي مناضل اشتراكي منسجم مع نفسه، إلا أن يناهض الاضطهاد الامبريالي الموجه ضد الحدود الطبيعية للدولة المغربية.
غير أن بعض مناضلينا الاشتراكيين، يفهمون الديمقراطية بشكل مقلوب تماما. فهم مع الديمقراطية، لكن ليست تلك التي تقر الحقوق الوطنية المشروعة للشعب المغربي، وإنما التي تساند «حق» جماعة من المغاربة الصحراويين في الانفصال عن بلدهم وشعبهم.
إن هذا الموقف السياسي خاطئ جذريا، لأنه يستند إلى أسس نظرية مهزوزة ومنخورة. ويمكن حسر أسس ذلك الموقف، في أطروحتين رئيسيتين:
الأولى: هناك شعب صحراوي، وهذا الشعب يطالب بحقه في الانفصال عن المغرب وتأسيس دولته المستقلة. لذلك، من وجهة نظر ديمقراطية، يجب دعم هذا المطلب الديمقراطي.
والثانية: أن النظام المغربي نظام تبعي للإمبريالية، لذلك فإن الصحراء في حالة ضمها إلى المغرب، ستخضع بذورها للاستغلال الإمبريالي.
إن هذا الرأي الذي يعتبر نفسه ديمقراطيا وثوريا –وهو كذلك في المظهر- ليس في جوهره ،حسب الفقيد عبد السلام المودن، سوى رأيا سطحيا وذاتيا وزائفا. فلو كانت الظواهر تتطابق مع الجواهر، لما كانت هناك حاجة للعلم (كما يقول ماركس). فلنناقش إذن أسسه النظرية بتفصيل، ولنبدأ بالأطروحة الثانية.