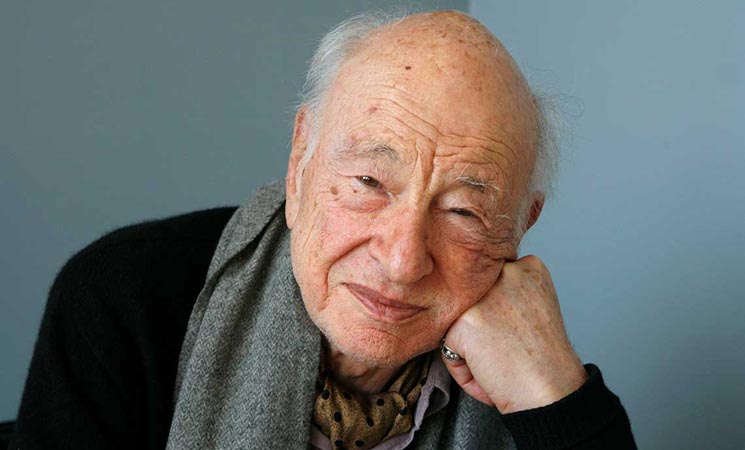يحضر النقاش بشدة حول غيوانية الحي المحمدي، من طرف أبنائه ومريديه وعشاقه وعدد كبير من الباحثين من داخل المغرب وخارجه، هذا الحي الذي يوجد ضمن جغرافية أحياء الدار البيضاء بالمغرب، فالحي المحمدي حقا حي صغير جغرافيا ولكنه كبير بقيمته الاعتبارية الفنية والثقافية وغيرها، لذا نستحضر الرصد الأنثربولوجي ،كمطلب توصيفي واستفساري يساعدنا في توظيف واستنطاق الذاكرة والتاريخ والمتن والحوار العام والخاص تثمينا لتاريخ فني أثبت ذاته، كما انخرط في الجدل الحاصل حول ميلاد الظاهرة (أعني بها جينالوجية الحي ككل) وأسبابها ومنجزها وأعلامها وأثرها على المستوى المحلي والوطني وجدله الجهوي والقطري والقاري من خلال أسئلة إشكالية ومحورية: هل مازال مصطلح الظاهرة موافق للتجربة؟ ألا يمكن أنتنعت التجربة بتوصيف آخر؟ ما هو موطنوميلاد الظاهرة الحقيقي؟ كيف نشأت، وفي أي ظروف؟ وهل للجيل الحالي ظاهرته؟ أو هل من الممكن أن يولد ظاهرته الخاصة أو التي لها علاقة بمرحلته؟ وهل من الممكن أن تبعث الظاهرة بلبوسات أخرى؟ وهل هناك أرضية مماثلة أو شبيهة لميلاد إحدى الظواهر، خصوصا الفنية والثقافية؟ ناهيك عن النبش والحفر عن المؤسسين الفعليين لهذه الظاهرة وصولا إلى مرحلة النمط والاتجاه والتوجه الغنائي الذي أثبت خاصيته ونوعه، وعلاقة الغيوانية بالداعمين لها فكريا واجتماعيا وصولا إلى جمهور الظاهرة.
هذه الدينامية الظاهراتية التي تحولت وتطورت بقوة وجودها وفنها وضرورتها التفريغية حتى أمست حركة ونمطا غنائيا أثبت ذاته وخلق ديناميكيته التي واكبت حركية عالمية ولدت في أواخر الستينيات، وبرزت في السبعينيات وواكبت الثمانينيات وجزء من التسعينيات، وخطت عقدها الثالث للقرن الماضي ومازالت حية وحيوية وحاضرة بعقدين آخرين مضافين إلى القرن الألفيني الحالي الذي انخرط في باكورة العقد الثالث الألفيني، مما يؤكد أننا نتكلم الآن والهنا عن حياة فنية ومختبر غنائي عمره أكثر من نصف قرن أي أكثر من خمسة عقود كاملة وقد دشن عده للنصف الثاني، وبذلك يحتفل بيوبيله الذهبي بجدارة واستحقاق وتاريخ ومسار وسيرة أنماط.
الغيوانية تؤرخ للحي المحمدي من مدخل الفن والثقافة عموما والنمط الغيواني على وجه الخصوص مع: ناس الغيوان، تكدة، جيل جيلالة، لمشاهب، مسناوة، السهام، وأهل الخلود وباقي المجموعات الوطنية الأمازيغية وغيرها، إذ أصبح لكل مدينة مجموعاتها بل لكل حي مجموعاته، ونذكر هنا النمط المجموعاتي الغنائي الأمازيغي الغني، الممثل لجهة سوس وغيرها والمتزامن مع ظاهرة المجموعات والذي يشبه ميلاده النمط الغيواني بل يعد مرجعية من مرجعياته بحكم السبق والتجربة ونذكر من المجموعات الأمازيغية الشبيه: لقدام، تيتار، تاودا، أوسمان إزنزان، أرشاش، لرياش، وغيرها كثير ممن ساروا على درب الأجيال المستمرة على نهج المجموعات في النمط الغنائي.
يعد النمط الغيواني بكل مرجعياته مطلب كل الأجيال عبر الوطن الكبير والوطن الصغير الحي المحمدي باعتباره مختصر المغرب، والدليل الجذبة الصوفية التي يمارسها الجميع مع هذا النمط الغيواني، تطهيرا وتفريغا وتواصلا فكريا وفنيا واحتفاليا ثم تنمويا وتأريخيا، من هنا نجد أن المجموعات سبب ميلادها جاء ليجيب عن ذائقة ومطلب له علاقة بالجسد القادم من إرث عروبي بتراثه ثم للاحتفاء بهذا التراث وتكريمه ولم لا بعته في حلة جديدة ومتجددة ومتطورة ومنفتحة على باقي الأنماط لاسيما وقد أبانت بعض التجارب عن هذا المنحى.
الحي المحمدي عاصمة غيوانية:
للحي المحمدي تاريخ عمران وتعمير، تؤكده جينالوجيته التي عمرته وأثبتت أنه حي ظاهرة له مرجعية فلاحية رعوية ومرجعية نضالية تاريخية بمقاومة وطنية مشهودة ومرجعية اعتراف وتقدير من سلطان المغرب طيب الله تراه محمد الخامس الذي شرفه باسمه حينما زار هذا الحي سنة 1956 بعد العودة الميمونة إبان الاستقلال، ردا على الصحافة الفرنسية التي نعتته بـ”ملك كريان سنطرال” وهو في المنفى بسبب انتفاضة المقاومة، ويشهد لهذا الحي أنه جمع مكوناته بشكل انتقائي طبيعي وكأنها عينات مختارة من الجهات الأربع للوطن، وبذلك نحول الحي المحمدي إلى وطن صغير، عمرته ساكنته بفعل الهجرة والعمل في معامل السكر ولافارج والسككي الحديدية وغيرها وأسباب أخرى.
أتت الساكنة من الشرق والغرب والشمال والجنوب وسكنت رقعة جغرافية بين (عين السبع، وروش نوار، وعين البرجة ووسط المدينة المفضي للمدينة القديمة، وطريق الرباط، والحدود مع تيط مليل، ودرب السلطان، واسباتة…) حي له تاريخ الكاريان المتنقل من السكة وروش نوار، وتاريخ البلوكات العمالية والعمارات السكنية التي صممها بروست سنة 1922، وفيما بعد كورشار، وبذلك تأسس تراث عمراني له تاريخه وأجياله ومعالمه التي أتمت 100 سنة. تأسست الدروب الأولى للحي المحمدي، وعلى رأسها درب مولاي الشريف وسوسيكا والشابو وحي سعيدة والسعادة والكدية والمستقبل وكريانات لها صفات وأسماء أعلام بتاريخانيتها إلخ..وانصهرت الساكنة في مكان محدد الجهات وتلاقحت الثقافات وبفعل المثاقفة كان ميلاد الحي كظاهرة عمرانية ومن بوتقته خرجت ظواهر أخرى اجتماعية وغيرها، وعلى رأسها الظاهرة الغيوانية التي مهدت لها الأرضية من خلال لقاء وحوار الثقافات والعادات والتقاليد والأهازيج والأنماط والإيقاعات والمحكيات وغيرها، والتي انصهرت وتأثرت بالأشكال الفرجوية القادمة من التاريخ والعابرة له مع “الحلقة” كأقدم لقاء يجتمع حوله الناس للبسط والترفيه والاستفادة وحرية القول والغناء والتعبير الذي ينتمي للتروبادور والأشكال الفنية المسافرة في الثقافات والعادات والتقاليد الأممية، وعليه يعتبر الحي المحمدي بهذه المقومات، العاصمة الغيوانية بامتياز وملتقى الثقافات الشعبية باسم كل الوطن وإثنياته، والدليل أن معظم المجموعات الرائدة خرجت من رحمه وأصبحت نمطا وحركة وظاهرة تنتمي للرقعة الوطنية والعربية ثم الدولية..
ميلاد أول دار للشباب بالمغرب، في الخمسينيات من القرن الماضي مهدت لميلاد الظاهرة:
حينما اجتمعت ثقافات وفنون البوادي وجهات المغرب الأربع في رقعة موحدة لها تاريخها العمالي والفلاحي والنضالي والرياضي ثم الاجتماعي والسياسي والاعتباري وغيره وكونت حاضرة بهذه المرجعية، حينها تأهلت إلى الفعل والتفاعل بفضل الحوار الذي حصل بين إيقاعاتها وكلماتها وأنغامها وموروثها، لأنها أتت إلى الحي المحمدي لم تأت بأراضيها وخيمتها بل أتت بعاداتها وتقاليدها واحتفالياتها وحكيها وسرجها وموروثها الثقافي، تم تلاقت الثقافات وكان فعل المثاقفة وبذلك أنتجت فنا حضريا أو فنا تلاقحيا يحافظ على هويته في إطار طرح حضري إبداعي غير مسبوق، ومن تم استحقت هذه التلاقحات الفنية والثقافية أن تنعت في البدء بالظاهرة لبزوغها المفاجئ بالنسبة للجميع وحتى لمريديها وصناعها، لكن قوة حضورها وجدارة مختبرها واجتهاد وجهد المحيط الفني العام أهلها بأن تصبح نمطا غنائيا فنيا، لاسيما وقد اجتمع شباب المرحلة الستينية والسبعينية بموروثهم ومرجعياتهم التراثية والإثنية في دار الشباب الحي المحمدي وتلمسوا طريقهم الأول في مسار المسرح الذي مارسوه بشكله الشعبي الذي يجمع بين ما هو قروي وماهو حضري ومع الترقي المجتمعي أضاف ما هوغربي بمدارسه وبعض اتجاهاته ثم تجريبي يدمج الاجتهادات والمشاهدات في نفس الوقت بقوة الطرح والإبداع وتلاقح الإرث والموروث الفني، وكان من اللازم أن يحضر التشخيص والغناء الذي يقوده الراوي أو الحكي المشخص غنائيا، لأن تاريخ المسرح يعرف الكورس أي المجموعة التي تقدم مواويل بين المشاهد والفصول ومعظم الغناء الغيواني انطلق من هذه المرجعية.
لهذا السبب كان التجاوب الكبير بين رواد الحركة المسرحية بدور الشباب، الحي المحمدي أساسا مع مسرح الطيب الصديقي الذي تتلمذ على يد أستاذه بفرنسا جون فيلار مؤسس المسرح الشعبي الفرنسي ومهرجان أفينيو، وعلى منواله أسس الطيب الصديقي بدوره للمسرح الشعبي المغربي حينما رجع إلى التراث المغربي بوصية من أستاذه جون فيلار، ونهل منه شكلا ومضمونا ونمطا في مسرحياته الخالدة: “سيدي عبد الرحمان المجدوب” و”الحراز” وغيرها، وهذا ما يبرر تعامله المبكر والمرتبط بالحفريات التاريخية الباحثة عن الشكل المسرحي المغربي الخالص الذي يشبهنا، ومن تم كان التعامل مع التجارب المؤهلة بنمطها وتجربتها الجنينية والتي قادت الظاهرة فيما بعد وطورتها إلى أن تأهلت كنمط غنائي خالص غير مسبوق، وقد كان من ضمن الجيل الذي ساهم في إبراز أطروحة هذه المرحلة، والمؤسس لنمطه من خضمها، الأسماء التالية: مولاي الطاهر الأصبهاني، عمر السيد، العربي باطما، بوجميع أحكور، أحمد دخوش الروداني، محمد مفتاح وحميد الزوغي ومصطفى سلمات وخليلي وغيرهم، ومن خضم هذا الجيل انبثقت: “ناس الغيوان”، “جيل جيلالة”، “تكدة”، “لمشاهب”، وفي ما بعد “السهام” و”مسناوة”، وهلمَ مجموعات غنائية منها المستمرة ومنها التي تراجعت أو اضمحلت ومنها التي تواصل سيرها مستندة على التاريخ، ومنها المجموعات التي ورثت هذا التراث وتوارثته، وانطلق الاسم الواصف للظاهرة في البدء وبالضبط في سنة 1970 بـاسم “الدراويش الجدد”، كون هذه المجموعة تماثل المجاذيب والبوهالا والنظاما، كما صرح بذلك العربي باطما في بداية الطريق والتأسيس، وذلك قبل أن يستمد الاسم من أهل لفهامة، “ناس الغيوان”، ويعتبر العربي باطما المجموعة “نظاما” أي أولئك الذين يقولون الشعر ويحبكون جزلا مغناة وملحنا ومؤداه في نفس الوقت وهو تميز خاص بالمجموعات الغيوانية التي انطلقت بظاهرتها المتفردة المستمرة والمتحولة بقوة الطرح إلى أن تأهلت ووسمت النمط الغنائي المختلف والنوعي. وهنا يقول الطيب الصديقي عن أفراد المجموعات الغنائية التي تشكلت منها الظاهرة: “إنهم ليسوا مغنون بالمفهوم الكلاسيكي والعام، ولكنهم ممثلون يغنون” وشبههم بفرق ”
التروبادور” الذين يتنقلون بين الأحيان والمدن والقرى وهم يغنون أشياء تهم الناس وتشخص قضياهم وحكاياتهم ومعاناتهم الاجتماعية الخاصة والعامة..
أهل الحال يا أهل الحال إمتى يصفى الحال؟!:
في محيط جغرافي محدد ومسار ينزل بك إلى درب مولاي الشريف من جهة ويصعد بك إلى الكدية ودورة المذاكرة من جهة أخرى، أو يأخذك إلى دوار سي أحمد من جانب مرورا بالقشلة وإلى الكاريانات المأسوف عنها من جانب آخر برحبته وباقي فضاءاته إلى السكليرة المرحومة وحاليا دار لمان وفضاء لحلاقي أو السوق الفوقاني الغائب، وتمركزا بعاصمة الحي المحمدي بين سينما سعادة الواقفة في وجه الزمن والمتوقفة صحبة ظلمتها وظلامها بدون بث ولا فرجة كما هو الحال لسينما شريف، والسينمات الأخرى المستحدثة مع الأحياء الجديدة، والغائبة في نفس الوقت، وكأنه تضامن احتجاجي لغياب الجيل المؤسس والمدشن أو الذي يستحق الفرجة بشاشة كبرى حالمة، ودار الشباب، المدرسة الأولى لجيل الغيوان ورواد القلم والتي تصارع الزمن وتحافظ على استمرارية نضالية بجمعيات مثل “الشعلة”جمعية الحي المحمدي الثقافية والفنية والتربوية، وهي الجمعية الوطنية بسعة حلم مرحلة التأسيس انطلاقا من الحي، والجمعية الوطنية الأخرى التي انبثقت من الحي المحمدي، جمعية التربية والتكوين التي تخوض نضال المجال التربوي وجمعيات أخرى تغيب وتحضر ومستشفى السعادة الباحث عن الرجع التاريخي ومقهى السعادة ومقهى الطاس المنتظرتين لزمن العفو أو الإعفاء وفضاء أبا صالح دار الغيوان الحرة، وتيران الحفرة الذي خرجت من فضائه الطاس (الاتحاد البيضاوي، كفريق كرة ونضال ومدرسة الأجيال) والدروب المحيطة بالحفرة التي أعطت لاعبين من الكبار مثل الريشي وغيره، الفضاء الذي يذكرنا بالبناية الكولونيالية وجمالياتها وملعبها وفندقها، ويذكرنا ببا العربي الزاولي وجيله، هذا الملعب الذي ينتظر بعته الجديد بأدوار متجددة، لاسيما وهو شاهد على مرور تاريخ كروي كبير وأسماء مؤسسة وأيقونات كروية رائدة مرتبط بشكل جدلي بالحي المحمدي وأحياء البيضاء، ومدرسة عمر بن الخطاب الذاكرة والشاهد الزمني، تم دار الشهداء إلخ، فعلا الحي المحمدي أكبر من حي إنه متحف مفتوح في وجه الزمن.
في هذا المحيط الموسوم بالعاصمة كان اللقاء ذات تاريخ بين بوجميع وعلال يعلي والعربي باطما وعمر السيد، وتزامنا معهم لقاء أحمد دخوش وعمر دخوش وجيله، وفي زمن آخر محمد باطما والسوسدي وجيلهم، تم مشفق عبد المجيد وأخوه خالد وحنين إذ كان اللقاء بإعدادية المستقبل وبذلك كانوا المستقبل صحبة الجيل المؤسس من فنانين وفعاليات فكرية وسياسية وثقافية وغيرها، هذا الجيل الذي واكب التجربة من خلال الصداقة وكان الداعم المعنوي الأول والجمهور الأول والمؤمن الأول بالتجربة ورهانها الذي انفتح محليا ثم وصل إلى وسط المدينة بين جدران المسرح البلدي، وخرج إلى الناس في فضاءات بيضاوية مختلفة ثم انفتح وطنيا فعربيا ودوليا، وكان الأثر المشهود مع الفيلم السينمائي “الحال” سنة 1981 للمخرج المغربي أحمد المعنوني، وكان البث التلفزيوني الأول للنمط الغنائي بالقناة التلفزية المغربية لـ”ناس الغيوان” المشروط سنة 1986، وتحقق الإشعاع غير متصور ولا منتظر عبر المعمور وصولا إلى الشهادة التاريخية لأعلام عالمية ومنها شهادة المخرج الأمريكي العالمي “مارتن سكورسيزي”، عن نمط “ناس الغيوان” إذ تعرف عليهم من خلال فليم “الحال” ووسم المجموعة بأنها ثمرة جيل الاستقلال المغربي وشبه ناس الغيوان بـ”التروبادور” وأشاد بهم كونهم عادوا إلى تراثهم وتاريخهم وكان ميلادهم صوتا للمغرب الحر المنفتح على تجارب العالم، مع الإشارة إلى أن ميلاد التجربة الغيوانية تزامن مع ميلاد تجارب قادها شباب الستينيات في مدن بل أحياء تشبه موطن الحي المحمدي عبر المعمور.
يتبع