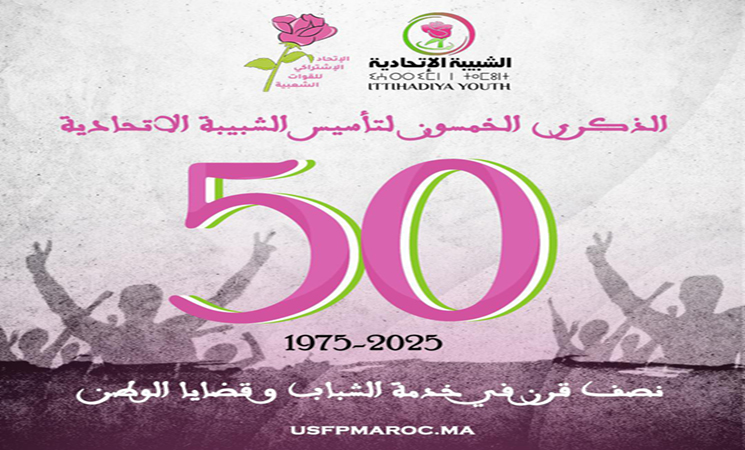افتتح مختبر السرديات موسمه الثقافي الجديد بلقاء نقدي احتضنه فضاء الحرية بعين الشق، يوم السبت 18 أكتوبر 2025، تحت عنوان: “الخطاب والمرجع: قراءات في كتب نقدية”، وذلك بتنسيق مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم. وقد عرف اللقاء حضور ثلة من الأكاديميين والأساتذة والطلبة الباحثين والقراء المهتمين بالسرد والمرويات الدينية. أدارت الجلسة الكاتبة والباحثة لطيفة هدان، التي أكدت في كلمتها الافتتاحية أن هذا اللقاء يأتي في سياق الاحتفاء والانفتاح على الدراسات والأبحاث الأكاديمية التي انتقلت من مرحلة البحث الجامعي إلى فضاء النشر النقدي، من خلال مناقشة كتابين صدرا حديثاً عن تجربتين أكاديميتين هما: “الرواية العربية والعرفان في الألفية الثالثة” للباحث محمد أعزيز، “العجائبي في قصص الأنبياء” للباحثة سارة الأحمر.
وأوضحت هدان أن كتاب “الرواية العربية والعرفان في الألفية الثالثة” لمؤلفه حمد أعزيز يُعدّ نتاج أطروحة دكتوراه تناولت العلاقة بين الرواية العربية والعرفان ضمن مقاربة ثقافية متعمقة، إذ يكشف الكتاب كيف يمكن للرواية أن تحمل أبعاداً عرفانية، وكيف يتداخل السرد مع الأفكار الروحانية والفلسفية في سياق معاصر. وبذلك، يتجاوز العرفان في هذا الكتاب الفهم الصوفي التقليدي ليصبح رؤية معرفية وإنسانية تنفتح على أسئلة الوجود والمعنى والجمال والحرية.
وأشارت هدان إلى أن الروائيين العرب في الألفية الثالثة جعلوا من الرواية فضاءً للتفكير الفلسفي والروحي، ومختبراً لإعادة بناء الذات العربية وترميم شروخها في مواجهة الفراغ القيمي والتحولات الحضارية الراهنة والمستقبلية. ويُسهم ذلك في فتح آفاق جديدة للتجربة الرواية المتطورة باستمرار، كما يمنح فرصة إضافية للتأمل في السرد من منظور تأويلي وإنساني.
أما بالنسبة لكتاب “العجائبي في قصص الأنبياء” للباحثة سارة الأحمر، فقد أبرزت هدان أنه يمثل أيضا ثمرة أطروحة دكتوراه، ويقدّم مقاربة أدبية جديدة للنصوص الدينية من زاوية تحليلية تهدف إلى فهم العجائبي دلالياً وجماليا ويدعو إلى الدهشة والتأمل والتفكير، وكشف الأبعاد الرمزية والمعرفية والمقدسة في النص الديني. مشيرة إلى أن الكتاب يناقش تجليات العجائبي في قصة خلق الكون وقصص الأنبياء، حيث يتقاطع المقدس بالعجائبي في فضاء يتجاوز الزمان والمكان ليمنح هذه القصص دلالات رمزية ومعاني إنسانية تتجاوز حدود السرد.
الرواية العربية والعرفان
في الألفية الثالثة
في مداخلتها الأولى، تناولت الباحثة نادية شفيق ورقة بعنوان “العرفان والجماليات السردية في الرواية العربية: قراءة نقدية في كتاب الرواية العربية والعرفان في الألفية الثالثة” لمحمد أعزيز. وأبرزت أن الكتاب يُعد أحد أبرز الإسهامات النقدية العربية المعاصرة التي سعت إلى إعادة بناء العلاقة بين الأدب والمعرفة في ضوء التحولات الفكرية والروحية التي يشهدها العالم العربي مع مطلع الألفية الثالثة.
وأشارت الباحثة إلى أن الكتاب، الصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، ويقع في 390 صفحة، يتضمن ثلاثة فصول متكاملة تجمع بين الرؤية الفلسفية والتحليل النقدي، كما يعكس وعيا عميقا بتقاطعات الأدب والثقافة والعرفان في الحقل السردي العربي الحديث. ويُفتتح بمدخل تمهيدي، حدّد أهم المفاهيم والإشكالات والسياقات.
وأفادت المتحدثة أن محمد أعزيز ينتمي إلى الجيل الجديد من النقاد العرب الذين انفتحوا على حقول معرفية متعددة، فهو يزاوج بين الفكر الفلسفي والنقد الأدبي والتحليل الثقافي في مقارباته، ويؤمن بأن الرواية لم تعد مجرد جنس فني فحسب، بل أصبحت خطابا ثقافيا يكشف تحولات الوعي العربي. وقالت شفيق: “يواصل أعزيز في الكتاب مشروعه البحثي في ربط الأدب بالعرفان، وهو الاتجاه الذي بدأ يترسخ في النقد العربي خلال العقدين الأخيرين، خاصة مع بروز الحاجة إلى تأويل الظواهر الجماعية في ضوء التحولات القيمية والاجتماعية”.
وتوقفت الباحثة عند عنوان الكتاب الذي يشكل مفتاحاً تأويلياً لقراءة المشروع النقدي الذي يقترحه المؤلف، فهو يزاوج بين الرواية العربية والعرفان في علاقة تركيبية تحتكم إلى بعدين متكاملين: البعد الجمالي والبعد المعرفي. موضحة أن تركيب العنوان يشير إلى رغبة الكاتب في تجاوز القراءة الشكلية للرواية نحو مساءلة أسسها الفكرية، فالعرفان هنا لا يقصد به هنا البعد الصوفي التقليدي فحسب، بل هو رؤية معرفية شاملة تحاول أن تفهم الوجود الإنساني في عمقه وتعيد تأسيس صلة الإنسان بالمعنى. إضافة إلى أن الألفية الثالثة تمنح الخطاب النقدي بعده الدلالي والزمني، إذ تضع الرواية العربية في سياق حضاري متحول تتقاطع فيه الأسئلة الروحية بالتكنولوجية والمعرفة بالفراغ القيمي، إنها محاولة لإدراك موقع الرواية العربية في عصر ما بعد الحداثة، حيث تحول السرد إلى مختبر فلسفي وجمالي لإعادة بناء الذات. وشددت على أن “العنوان لا يعلن فقط عن موضوع الكتاب، بل يجسد استراتيجية فكرية يتأسس عليها مشروع بأكمله، وهي السعي إلى إعادة قراءة الأدب العربي من منظور عرفاني ثقافي يتجاوز المقاربات التقليدية”.
تطرقت الباحثة أيضا إلى المنهج الذي اعتمده المؤلف في كتابه، من خلال مقاربة ثقافية، تقوم على تجاوز التحليل الجمالي التقليدي للنص الأدبي نحو مساءلة علاقته بالثقافة والمجتمع والفكر، هذه المقاربة تنطلق من فرضية أساسية مفادها أن الرواية ليست مجرد نص سردي، بل هي خطاب معرفي ينتج رؤية للعالم ويتقاطع مع الأسئلة الفلسفية حول الذات والمعنى والسلطة. وأضافت “في إطار هذه المقاربة يوظف الكاتب مفهوم العرفان باعتباره أفقا تأويليا يتأسس على معرفة ذوقية وروحية، تسعى إلى فهم الإنسان في كليته، وليس بوصفه كائناً تاريخياً. فمن خلال العرفان يحاول محمد أعزيز قراءة الرواية العربية كفضاء يعيد بناء الوعي ويتيح للذات أن تتأمل وجودها في ضوء التجربة الباطنية. وهكذا يقدم العرفان لا كخطاب ديني مغلق بل كمفهوم أنثروبولوجي وثقافي مفتوح يعيد وصل الأدب بالمعنى والروح”.
في ارتباط بما سبق، أكدت الباحثة أن الكتاب يأتي في لحظة نقدية عربية تتسم بتنوع المناهج وتراجع القراءات الانطباعية أمام صعود المقاربات التأويلية والثقافية، فالنقد العربي المعاصر يبحث عن أدوات جديدة لفهم الأدب في علاقته بالتحولات الفكرية والروحية. وفي هذا السياق يشكل كتابه مساهمة نوعية، لأنه ينفتح على مفهوم العرفان الذي ظل لسنوات طويلة حبيس الدرس الفلسفي أو الصوفي ويعيد إدماجه في التحليل الأدبي والثقافي. وأشارت الباحثة إلى أن الشعر كان سبّاقا في توظيف العرفان، مستعرضةً مجموعة من النماذج البارزة، مثل: ابن الفارض، جلال الدين الرومي، ورابعة العدوية. كما لفتت الانتباه إلى بعض النماذج السردية، من بينها واسيني الأعرج، الذين اتخذوا من العرفان موضوعا محوريا في أعمالهم. وشدّدت الباحثة على أن المؤلف يعيد الاعتبار إلى البعد التأويلي في النقد العربي، ويقترح توجّها جديدا يربط بين السرد والمعرفة، وبين الرواية والبحث في الوجود، وهو ما يجعل مشروعه قريبا من الطروحات الفلسفية التي قدّمها نقاد مثل عبد الكبير الخطيبي ومحمد مفتاح. كما توقفت الباحثة عند بعض الإضاءات التي جاءت في فصول الكتاب، ومن بينها: “النزعة العرفانية وتحولات الوعي الثقافي”، و”الرواية العرفانية والبحث عن المعنى”، و”العرفان والسلطة”.
العجائبي في قصص الأنبياء
من جانبها قدّمت الباحثة زينة إيبورك من مختبر السرديات والخطابات الثقافية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، مداخلة موسومة بـ: “تجديد القراءة التراثية: تقديم كتاب العجائبي في قصص الأنبياء لسارة الأحمر”. أوضحت أن الكتاب يسهم في فتح زاوية بحثية قلّما تناولتها الدراسات السابقة بهذا العمق، إذ تسعى الكاتبة إلى استكشاف البعد العجائبي في سرد قصص الأنبياء كما وردت في النصوص الدينية. وأكدت أن هدف الكتاب ليس إعادة سرد الوقائع المعروفة، بل الغوص في أبعادها العجائبية التي لا تدهش فحسب، بل تفتح أيضا أبوابا للتأمل والتحليل.واعتبرت الباحثة ” أن العجائبي في هذه القصص لا يظهر فقط خارقاً للطبيعة، بل كوسيلة رمزية للتعبير عن التحول والاختبار والاصطفاء الإلهي، متناولا تجليات العجائبي في قصص الأنبياء كما وردت في النصوص المقدسة، ويمثل خطوة معرفية جادة في سياق تجديد القراءة التراثية من خلال تسليط الضوء على البعد العجائبي في القصص النبوي كما وردت في المصادر الدينية”. انطلاقاً من هذا الوعي، فإن هذا الكتاب وفق إيبوك، يفتح أفقا جديدا للعجائبي لا بوصفه خارقا للمنطق فحسب، بل كجزء من خطاب له امتداداته البلاغية والعقدية والرمزية. وأشارت إلى اشتغال المؤلفة وفق المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستعانة بالمنهج التاريخي عند العودة إلى قصص الأنبياء. وقد تميز الكتاب بلغة علمية رصينة وعناية ظاهرة في تنظيم مادته، مما يجعله مرجعا مهما للباحثين سواء في الدراسات الدينية أو في السرديات، إلى جانب المهتمين بفهم البعد الرمزي والوظيفي للعجائبي في المرويات الدينية.
واعتبرت زينة إيبورك أن هذا العمل يشكل إضافة نوعية للمكتبة العربية، ويؤكد حضور سارة الأحمر كباحثة واعية بالتحولات المعرفية والمنهجية التي يشهدها الحقل الأدبي والديني،”إنه بادرة فكرية تفتح المجال أمام المزيد من الدراسات التي تعيد قراءة التراث بعين ناقدة وبروح منفتحة على المناهج الحديثة دون أن تتنازل عن احترام خصوصية النص وعمقه الديني”.
نقاش وتفاعل
تناول الكلمة الكاتب محمد أعزيز، مؤلف كتاب “الرواية العربية والعرفان في الألفية الثالثة”، مؤكّدًا أن الإشكالية التي أطرها هذا العمل، الذي هو في الأصل أطروحة جامعية، انطلقت أساسا من محاولة اكتشاف ملامح الرواية العرفانية وتموقعها ضمن الإبداع الأدبي العربي مع مطلع الألفية الثالثة. وأوضح أعزيز أنه من خلال عملية استقصائية للأعمال الروائية، توصل إلى أن عددا من الروائيين عمدوا إلى توظيف العرفان في الرواية كل وفق رؤيته، وقد اقتصرت الدراسة على خمس روايات اعتُبرت عينة تمثيلية تعبّر عن خصائص الرواية العرفانية في الألفية الثالثة. وأضاف أن الإشكالية المركزية للبحث انطلقت من جملة تساؤلات أساسية، من بينها: ما الداعي إلى العودة إلى العرفان في الألفية الثالثة؟، وما الإضافة التي يمكن أن يقدمها العرفان لتجديد الرواية العربية؟، ثم إلى أي حد يمكن لهذا العرفان أن يعبّر عن واقع الروائي، خاصة في تناوله لقضايا إشكالية تتصل بواقعه وراهنه وتأملاته في التاريخ والمعنى؟
وأشار أعزيز إلى أنه، في اختبار هذه الأسئلة، انطلق من فرضيتين أساسيتين: أولاهما أن الرواية أسعفت الروائي في تمثيل قضاياه وإشكالاته الراهنة، وثانيهما أن الرواية العرفانية قدّمت إضافة نوعية للرواية العربية. وقال: “لقد وجدت أن العرفان كان حاضرا في الرواية العربية منذ بداياتها، ولم يكن ظاهرة جديدة، بل ظلّ مصاحبا لها في مختلف محطاتها التاريخية، غير أن سياق التوظيف والعودة إليه بهذا الزخم والتراكم في الألفية الثالثة هو ما يستحق الوقوف عنده، إذ بتنا نتحدث عن تنظيرات لهذا الاتجاه. ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما قام به الروائي عبد الإله بن عرفة في روايته “جبل قاف”، التي صاحبها بتنظير نقدي أطلق عليه اسم “التأسيس لرواية جديدة”، ونُشر في مجلة ذوات التي كانت تصدرها مؤسسة “مؤمنون بلا حدود”، تحت عنوان: الرواية العرفانية تؤسس لأدب جديد”. ومن هنا حاولت أن أختبر ما إذا كنا أمام تأسيس فعلي لأدب جديد، أم أننا بصدد أسئلة ودوافع أخرى تحكم هذا المسار.
مشاركة المرأة المثقفة…”ما لايؤنث لا يعول عليه”
أما الروائي والأستاذ الجامعي شعيب حليفي، رئيس مختبر السرديات والخطابات الثقافية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، فقد أكّد أن أهمية هذا اللقاء تتجلى في جانبين أساسيين. أولهما، التأكيد على أن الدخول الثقافي يجب أن يكون دخولا ثقافيا فعليا، لا أن يظل النشاط الثقافي والبحث العلمي ظرفيا أو مناسباتيا. وأضاف أن علينا أن نتعلم أن هناك دخولا اجتماعيا وتعليميا وجامعياً، وكذلك دخولا ثقافيا ينبغي الحرص عليه، ليس فقط في مدينة الدار البيضاء، بل من خلال مجموعة من الأنشطة الثقافية في مختلف المدن والجهات المغربية.
وانسجاما مع المقولة الشهيرة: “كل مكان لا يؤنث لا يعول عليه”، أكد حليفي أهمية مشاركة المرأة المثقفة والمبدعة في الأنشطة والندوات واللقاءات الفكرية، مبرزا أن الثقافة المغربية والبحث العلمي ظلما النساء في كثير من المحطات، وهو ما يفرض ضرورة الانتباه إليهن وإعطائهن المكانة المستحقة. وأوضح أن المطلوب ليس مجرد حضور رمزي أو شكلي كما تفعل بعض الجمعيات أو السلطة لاستكمال المشهد النسائي، بل حضور فعلي وفاعل يعبّر عن إسهام المرأة الحقيقي في الفعل الثقافي. وأضاف أن التجربة الثقافية المغربية، سواء في المدن الصغرى أو في البوادي، تُثبت أن المرأة هي التي تؤثث الأنشطة الثقافية وتقومها وتنجحها أكثر من الرجل، مشددا على أنه “ينبغي أن نعطي للمرأة المثقفة، وللمرأة عموما في المغرب، قيمتها ودورها المستحقين”. كما اعتبر رئيس مختبر السرديات، أن لهذا اللقاء دلالة فريدة لا نجد مثيلًا لها في العالم العربي ولا حتى في أوروبا، تكمن في أن عددا كبيرا من الأطاريح الجامعية تُناقش في مختلف الجامعات، غير أننا لا نلمس لها أثرا واضحا سوى في المغرب. وقال إن هذا الأمر يعكس حيوية جيل جديد من الباحثين والشباب. وأشار الأكاديمي إلى أن عشرات الباحثين المغاربة يصدرون كتبا سنويا، وهو أمر مهم ولا نظير له في دول عربية أخرى مثل مصر أو الجزائر، حيث تبقى مؤلفات الباحثين غالبا حبيسة الرفوف والنسيان.
وأضاف أنه منذ سنة 2015 حرص مختبر السرديات على إصدار كتب الباحثين سنويا، غير أن الرهان يكمن في عدم التوقف عن الكتابة والاستمرار في هذا الزخم ومواكبته نقدياً. ولهذا يأتي هذا اللقاء لتثمين هذه الكتب التي يرى أنها بمستوى عربي رفيع، ويمكن أن تجد مكانها في الساحة الثقافية المغربية والعربية، بل وحتى خارجها، سواء بلغتها الأصلية أو عبر ترجمتها. مؤكّدا أن هذه الإسهامات تشكل إضافة نوعية غير مسبوقة في الأدب العربي، ولا نظير لها في النص الأوروبي، تماما كما هو الشأن بالنسبة لرافد العرفان في الرواية.
وختم حليفي مداخلته بالتأكيد على أن المعول هو دعوة الباحثين إلى مواصلة الكتابة وإصدار مؤلفات جديدة، مشيرا إلى أن المختبر يحرص على فتح المجال الندوات والأنشطة الثقافية في الدار البيضاء وعبر مختلف المدن المغربية، من أجل بناء تصوّر فكري متكامل حول قضايا الأدب والمعرفة. وأضاف أن وجود المثقفين والباحثين لا يكتسب معناه الحقيقي إلا بالثقافة والمعرفة، فهما الشكل الأسمى للمقاومة والتعبير، معتبرا أن الثقافة هي السبيل الوحيد لتحقيق ما نصبو إليه من وعي وتجديد وإبداع.
شهد اللقاء تفاعلاً حيوياً من طرف الحضور، الذي انخرط في طرح أسئلة نقدية حول مفهوم العرفان في النصوص الروائية، وحدود العجائبي في النصوص الدينية، بالإضافة إلى قدرة النقد العربي الراهن على تجديد أدواته القرائية في ظل التداخل بين الفلسفي والجمالي والديني. واختُتمت الجلسة بكلمة منسقة اللقاء، لطيفة هدان، التي عبّرت عن شكرها للمشاركين والحضور، بالإضافة إلى مختبر السرديات على إتاحة هذه الفرصة لتنظيم جلسة قرائية نقدية تم خلالها تبادل مجموعة من الأفكار والرؤى في سبيل مواكبة الإنتاج النقدي المغربي والعربي وتعزيز الحوار الأكاديمي حوله.