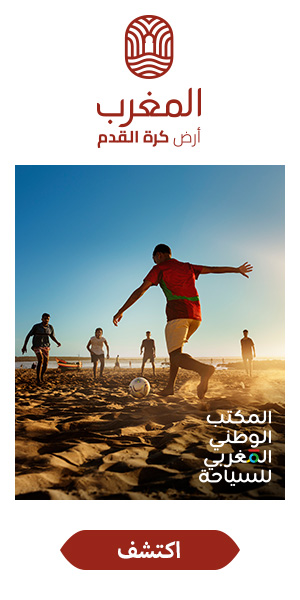استهلال أليغوري: «السلطان طبيب، والراعي مضرور، ولا وزير يبلغ الخبارا»، أغنية « النحلة شامة» لمجموعة «ناس الغيوان».
ينظر إلى الحركات الاحتجاجية كأحد أبرز الأشكال التعبيرية التي تمزج بين الاجتماعي والجمالي في قوالب نضالية، حيث تتقاطع فيها مطالب واقعية تتعلق بالعدالة الاجتماعية مع صيغ فرجوية تعكس مخيال الجماعة وإبداعها. فما يعرفه المغرب هذه الأيام، من احتجاجات جيل «Z» اتخذ منحى خاصا، بسبب طبيعة المطالب الاجتماعية كالصحة، والتعليم، والشغل، وغيرها، وكذا بسبب الوسائط الإبداعية والجمالية التي اعتمدها المتظاهرون، كالشعارات الإيقاعية والأغاني الحماسية، التي وثقت في المسيرات والساحات العمومية، واللافتات الورقية والرقمية.
هذه الوسائط، التي تستلهم من التقاليد الفنية الشعبية منهجها، تشكل مادة خصبة لتحليل سوسيوجمالي راهن.
إننا، بصدد تحليل حراك « Z» الاحتجاجي، إزاء ظاهرة مركبة تركيبا ومعقدة تعقيدا، حيث يتخذ الاحتجاج هيئة عرض جماعي ساخرCollective sarcastic performance ، تتجسد فيه أجساد المحتجين كجوقة غنائية بأقنعة غروتسكية، واهتزازات راقصة، وشعارات صاخبة، تنهل من الإيقاع الشعري والموسيقى، وتجعل من الشارع مسرحا كبيرا منفتحا على الارتجال والإبداع النضاليين.
هذه القراءة تجعلنا نفكر في الاحتجاج ليس فقط كفعل سياسي، بل كفعل فني وتربوي يحمل بين طياته بذور إعادة التفكير في العلاقة بين السياسة والفن والتربية في سياق مغربي زاخر بالعيش المشترك والديمقراطية الاجتماعية. غير أن الخوض في الموضوع يتطلب تموضعا وفهما دقيقين للمشهد المغربي الساخن والنقاط الحارقة التي ساهمت في تعميق الأزمة المركبة على مستوى القطاعات الحيوية والأولويات السوسيواقتصادية.
على رأس هذه الأولويات، نجد التعليم، والصحة، والشغل، التي تمثل القطاعات الداعمة لأي مشروع مجتمعي تنموي مشروع. غير أن ما يطبع هذه المرحلة يكمن في التناقض الصارخ بين الخطاب السياسي الرسمي، الذي يكثر من وعود التنمية، والعدالة الاجتماعية، ورفع أفق التوقع، وبين الواقع الملموس الذي يعيشه المواطن المغربي المخذول، لا سيما الأجيال الشابة.
ففي قطاع التعليم، مثلا، تعرف المدارس العمومية هشاشة بنيوية واضحة، تتجلى في ضعف البنيات التحتية، ونقص الموارد البشرية، والاكتظاظ داخل الأقسام، وغياب تكوينات فعالة للأساتذة، مما ينعكس سلبا على جودة التحصيل الدراسي ويعمق الفوارق التعليمية بين الفئات الاجتماعية. كذلك الأمر في قطاع الصحة، الذي يعاني من أزمة خانقة تتجلى في النقص الحاد في المستشفيات والمراكز الصحية، وضعف التجهيزات الطبية، والهجرة المتواصلة للأطر الصحية نحو الخارج.
هذا الوضع يجعل المواطنين، خاصة في المناطق الهشة والقرى، عاجزين عن الوصول إلى الحد الأدنى من الخدمات الصحية، ما يضاعف الشعور بالإقصاء؛ ولعل خروج دواوير آيت بوكماز بمناطق الحوز أبلغ دليل. وما زاد الطين بلة، هو بقاء الكثير من الأسر المشردة جراء زلزال الحوز بعدما استفاد المغرب من مساعدات خارجية وداخلية. زد على ذلك، الوضع المزري الذي يعيشه الشباب في مواجهة البطالة المتفاقمة (1)، وغياب فرص عمل قارة، وانتشار الهشاشة المهنية، مما يغذي الإحباط وفقدان الثقة في المؤسسات الرسمية.
من خلال هذه الموضعة السياقية في الواقع الاجتماعي والاقتصادي، يبدو التناقض الجذري واضحا لا غبار عليه، ولا أدل على ذلك غير الاختيارات الاستثمارية التي تظهر الاهتمام المبالغ فيه بإنشاء ملاعب كبرى لكرة القدم بمواصفات عالمية، في وقت لا تتوفر فيه المدارس على أبسط التجهيزات الأساسية ولا المستشفيات على الحد الأدنى من الأدوية والتجهيزات الطبية.
هذا التباين شكل حالة من «السكيزوفرينيا السياسية»، حيث يظهر الخطاب الرسمي المنمق منغمسا في الاحتفاء بالإنجازات الرياضية والمهرجانات التي تشجع على العنف والانحلال، بينما يتكبد المواطنون معاناة جراء تقشف مفروض على القطاعات الحيوية التي تمس كرامتهم وجودة حياتهم.
ينضاف إلى ذلك الزيادات المتكررة في الضرائب وغلاء الأسعار، والتي فاقمت من تدهور القدرة الشرائية للأسر، وجعلت الحياة اليومية أكثر صعوبة، خصوصا بالنسبة للطبقات الوسطى والدنيا.
كل هذه العوامل مجتمعة عمّقت الشعور بغياب العدالة الاجتماعية، وساهمت في تنامي الوعي الاحتجاجي لدى جيل «Z»، الذي يرى في الاحتجاج شكلا مشروعا وضروريا لمساءلة الخطاب السياسي وكشف تناقضاته.
هذا الوعي الاحتجاجي، الذي ترجم إلى مظاهرات سريعة سرعة المنصات الرقمية والشبكات التواصلية، مظاهرات غير مؤطرة ولا منظمة من جهة حزبية ولا نقابية تعكس الخروج عن القوالب والأنماط المهيكلة قانونيا. بالتالي، فالحراك نهج التفكير خارج الصندوق والترافع خارج المظلات، وذلك راجع لفقدان الثقة في هذه الكيانات التي يعدها جيل «Z» كيانات صورية تمارس الخطاب السياسي الفج وتحافظ على المصالح الخاصة بدل تقديم إجابات عملية تنطلق من هموم الشعب وتستجيب لتطلعاتهم.
الاحتجاج، خطابا
سوسيولوجيا: من المطالب الاجتماعية إلى التمثلات الرمزية
جيل «Z» المغربي، يحدد بالأفراد المزدادين تقريبا بين 1995 و2010، والذين نشأوا بالموازاة مع الفضاءات الرقمية المفتوحة، حيث الإنترنت ومنصات التواصل تتجاوز كونها وسائط معرفية أو ثقافية، إلى كونها بيئة حياتية. بالتالي، فإن لغة هذا الجيل الاحتجاجية لم تكن في البدء خطابات مطولة ولا بيانات مكتوبة، بقدر كونها شعارات مكثفة، وساخرة، وموسيقية، وقابلة للتداول عبر الفيديوهات والهاشتاغات، المستفزة، ثم الانتقال للشارع.
هذه الصياغة ترتبط ارتباطا نسقيا بقدرتهم على تحويل اليومي إلى أداء شبه فني نظرا لزخم المحتوى الرقمي الذي يستهلكونه، وهذا يتجلى في قدرتهم على التعبير عن الغضب الاجتماعي في قوالب غنائية كورالية ومسيرات غير منظمة، في إشارة إلى خرق النظام وعدم الانصياع للقانون الوضعي منظورا له ككيان يحمي مصالح الطغمة الحاكمة. بذلك، يكون حراك هذا الجيل رسالة قوية للسياسي المغربي لإعادة النظر في الخطاب الممارس، وتمثيلا لقطيعة تاريخية مع الأساليب التقليدية في الاحتجاج والمطالبة بالحقوق.
فمن خلال مجموعة من الشعارات المعتمدة في هذه الورقة للتحليل الفعل الاحتجاجي موضوع الدراسة، يتضح أن ثيمات الصحة، والتعليم، والشغل تشكل القضايا الأساس في هذا الحراك.
هذه القضايا تعكس تمثلات جيل كامل يشعر بالانكسار أمام انسداد الأفق الاجتماعي والاقتصادي والتيه الاستراتيجي.
فالشعارات والهتافات، من هذا المنطلق، تمثل إعادة صياغة جماعية لمعنى الحياة اليومية، حيث المرضى بلا تطبيب، والمدارس بلا أفق، والوظيفة بلا أمان، وهذا ما عبر عنه الحراك التاريخي المليوني للأساتذة سنة 2023، فهل من مُصغ؟ لذلك، يمكن القول إن الشعارات التي رفعت خلال الحراك هي بمثابة خطاب مضاد يندد بالتهميش والإقصاء، ويطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة.
ووفق هابرماس ، فإن الفضاء العمومي يشكل مجالا رمزيا مفتوحا حيث يسود الحوار الديمقراطي والتفكير النقدي ويتم مناقشة القضايا الاجتماعية وتداولها من أجل تشكيل الإرادة السياسية التي تضفي طابع الشرعية ، وتعمل كوسيلة للنقد الدائم على تعديل شروط شرعنة الهيمنة السياسية .
غير أن حراك جيل «Z» الاحتجاجي حول الفضاء العمومي إلى مسرح فرجوي، حيث الأصوات والأجساد واللافتات تعمل معا لتجسيد خطاب جماعي دال. بالتالي، صار الشارع منصة يلتقي فيه الفن بالسياسة، وتلتقي فيه السلطة بالمتظاهرين في مواجهات لا تخلو من عنف.
جمالية الاحتجاج: الإيقاع،
اللغة، الجسد
تتميز شعارات جيل «Z» بالإيقاع المسجوع والمتكرر، ما يجعلها أقرب إلى الأهازيج الشعبية. فمن منظور علم الجمال العصبي neuroaesthetics، فإن هذا التكرار الإيقاعي يسهم في تنشيط الذاكرة الجمعية وتحفيز الشعور بالانتماء. وهنا يظهر الشعار كأداة للتعبئة لا تقل قوة عن الخطاب السياسي الكلاسيكي التعبوي؛ بل تضاهيه. ذلك أن المتتبع للمظاهرات في هذا الحراك يجد حضور الإيقاع في الشعارات والهتافات حيث اعتمد النمط المتسارع تارة والمتباطئ تارة أخرى: كريشندو وديكريشيندو، حيث التدرج في الصوت من الضعف إلى القوة أو العكس ،مما ما يخلق نوعا من الجاذبية والتي تصبح أكثر تأكيدا مع الكلمات القوية والعبارات النضالية المبتدعة في شعارات بألحان حماسية. هذه الشعارات والأناشيد تعكس خصائص الجيل «Z»؛ حيث إنها تمتاز بكونها:
لغة مباشرة وحادة، خالية من التعقيد، وتحمل طابعا شعبيا وجماهيريا يسهل ترديده وتذكره، مثل: فموازين شكيرا، راها دات مليار، حنا طلبناها صغيرة، كويتونا بالأسعار، بربي مافيا كبيرة، كلشي ولى شفار. أو: نسبة البطالة والخدمة دافعة CV، السبيطارات مراض وكلشي ولا بريفي. هذه العبارات النضالية التي ظل يرددها مشجعو الفرق الرياضية في مدرجات ملاعب كرة القدم، على قوتها وتعبيريتها، لم تجد آذانا صاغية من طرف المسؤولين، لذلك خرجت من أسوار الملاعب نحو الشارع والساحات كما خرج المسرح من العلبة الإيطالية؛
لغة إيقاعية موسيقية، حيث إن الكثير من الشعارات تأتي على شكل عبارات وجمل مغناة، أو مقاطع قصيرة ذات إيقاع يجعلها أقرب إلى الأناشيد الجماعية، مثل المقطع: بلادي بلاد الحكرة، ودموعنا فيها سالو، العيشة فيها مرة، ماكذبوش لي قالو، قتلونا بالهضرة، مشفنا فيها والو. فمن خلال هذه المقاطع وأخرى، يناجي الشباب ويشكو حالة النفاق الاجتماعي الذي يحس به تجاه الناخبين؛
لغة مجازية ورامزة، حيث استعمال صور بلاغية مثل: مارانيييش أليييز في بلاد الشفففارة، ليس بمعنى مادي صرف، وإنما كرموز للعدالة الاجتماعية ودعوة لإحقاق القانون بشكل ديمقراطي. حيث إن هذه التعبيرات وأخرى تتيح سيرورة تأويلية بمدلول معروف اجتماعيا حيث يتطور وينمو انطلاقا من التأويلات التي يتلقاها من سياقات متنوعة وظروف تاريخية مختلفة .
لغة تكرارية وتقريرية، لكون التكرار وسيلة لترسيخ المعنى وإبراز التحدي، وهو خاصية لغوية مرتبطة بالتأثير السيكوسوسيولوجي للشعار: مغرب يخلص عالشمور، مغرب يعاون عا البلية، مغرب كلشي عايش فور، كولشي يقول الدنيا هانية. هنا يصف الشباب الوضع المزري الذي يعيشه ويقبله على مضض بكل مساوئه.
لغة هجينة، تمزج بين العربية الدارجة: شكاتكول نتايا شكاتكول، والفصحى: بلادي بلاد التنمية، وأحيانا كلمات فرنسية: هذا كلاش كونطر بارول، أو إنجليزية: ماتحلموش بالباراديز نتلاقاو عند مولانا، هذا التوظيف الهجين يعكس هوية جيل متعدد المرجعيات، ينهل من كل ما يخدم تفكيره ويحقق له الحد الأدنى من تطلعاته.
النبرة الساخرة، أي أن السخرية والتهكم وسيلتان لنزع الهيبة عن الخطاب السياسي الرسمي، وتحويله إلى مادة للاستهجان الجماعي، مثل: البرلماني فيه الخير، كيف الفقير كيف الوزير، بلاد مافيها فقراء، غي 40 مليون كسالى. هذه العبارات تسخر من الحالات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، من مسؤولين برلمانيين ووزراء يتلعثمون في قراءة أوراقهم وينامون في قبة البرلمان. كما هو إحالة للعديد من التقويمات الوطنية والدولية التي صنفت المغرب في ذيالة الترتيب (7).
من هنا، ففي كثير من الشعارات نجد الحضور القوي لمبدأ السخرية، حيث التلاعب بالألفاظ، والمحاكاة الساخرة للأغاني النضالية الغيوانية، والعبارات المشفرة، ما يجعلها تحمل بعدا جماليا مضافا، مثل: البرلماني فيه الخير، كيف الفقير كيف الوزير، بلاد مافيها فقراء، غي 40 مليون كسالى. فالمحتجون يحولون الألم إلى ضحك، والخذلان إلى تهكم، في شكل من أشكال كَرْنَفَلة اللغة، أو ما يندرج ضمن ما يسميه ميخائيل باختين بــ: الحوار الكرنفالي ، حيث تتبدد السلطة الرمزية عبر السخرية، ويتحرر الكلام من الجدية الكئيبة للفلسفة الرسمية، وكذلك من الحقائق المبتذلة والأفكار الشائعة .
في السياق ذاته، نجد أن الأداء الصوتي يقترن بحركات الجسد كالتصفيق، والقفز، والتمايل، والمناورة، وتعديل الموقع، مما يجعل الشعار والاحتجاج عرضا فرجويا بالمعنى الذي تقترحه إريكا فيشر ليشته حول القوة التحويلية للفرجة . هذه الأخيرة، حسب خالد أمين تمتاز بمبادئ خمسة نربطها، هنا، بالفعل الاحتجاجي لحراك جيل «Z»، حيث مبدأ المباشرة، ومبدأ الارتجال، ومبدأ المشاركة، ومبدأ الشرعية، ومبدأ الأفق الاستشرافي ، فالمشارك في الاحتجاج لا يقتصر على ترديد الكلمات فحسب، بل يجسدها بحضوره، وبحركاته مؤمنا بأن فعله فعل شرعي وأن دوره جزء أساس من طقس جماعي مفكر فيه من أجل تحقيق أهداف ما. غير أن بعض الممارسات اللامسؤولة زاغت عن النسق بشكل مرفوض قانونا وخلقا. هذا ما يشير إليه غوستاف لوبون بصدد الحديث عن سيكولوجيا الجماهير، حيث إن ذوبان الفرد في الجماعة يجعله ينخرط في الحشد ويفقد وعيه النقدي، ويتحول إلى جزء من عقل جمعي يسيطر على أفعاله وتصوراته ؛ وهذا ما يؤدي إلى الانفلاتات والانزلاقات السلوكية غير المتحكم فيها.
البعد السوسيولوجي للتعبير الفني: بين المقاومة والتربية
انتقل حراك جيل «Z» المغربي من مرحلة الوجود بالقوة إلى مرحلة الوجود بالفعل. أي الانتقال من منصات الواقع الافتراضي كديسكورد، والواتساب، والتيكتوك، والفيسبوك، وغيرها، إلى الشارع. فهذا الجيل يتقن الانتقال من الافتراضي إلى الواقعي. فنجد أنه يبدأ الشعار في فيديو قصير على TikTok أو Instagram، ثم يتحول إلى لازمة جماعية في مسيرة حية يطبعها العدوان والتهور .
هذا التحول يعكس دينامية مزدوجة: خاصية الرقمنة، التي تعطي الشعار حياة أولية، ثم الشارع الذي يمنحه سلطة جماعية.
هنا يلتقي أسلوب «الميم» الرقمي مع «الأهزوجة» التقليدية ليشكلا لغة هجينة وجديدة أشبه ما تكون بعملية مخاض وولادة سريعة سرعة الجيل ووسائله. بالتالي، فإن للاحتجاج، كما للمدرسة، أثرا تربويا وتوجيهيا هاما. فالشاب الذي يشارك في التظاهرة يمكن أن يستقي آليات النقاش، والتفاوض، والتضامن، ويكتسب كفايات اجتماعية وأخلاقية لا تقل أهمية عما يبنى في مرافق كلاسيكية منوطة بهذا الفعل.
هذه الكفايات، مثل التعاطف، وروح الفريق، والجرأة على التعبير، وغيرها، تمثل جوهر ما تسميه البيداغوجيا النقدية عند باولو فريري بالتربية من أجل التحرر ، وهذا مربط الفرس في الممارسة الفنية بشكل عام والفعل الاحتجاجي بوجه خاص. ذلك أن المجتمع قادر على بناء تصورات وتحديد معايير جمالية والتواضع حولها بشكل عفوي، وهذا ما يصطلح عليه بورديو بالجماليات الشعبية. هذه الأخيرة، تشكل الفعل المضاد الاجتماعي ضد ما يسمى بالجماليات الكنطية التي تمثل قالبا منظما من المعايير الجمالية التي تجعل من الحكم على الجميل فعلا معقلنا.
كما يمكن النظر للشعارات وأشكال الاحتجاج في حراك جيل «Z» من منظور فني، كونها شكلا من أشكال المقاومة الناعمة Soft resistance التي لا تمثل هدفا في حد ذاتها، وإنما وسيلة لإعادة صياغة السلطة. فمن خلال الإيقاع والغناء، والاهتزازات يتحول منطق الاحتجاج من مواجهة صلبة إلى مقاومة ناعمة قادرة على الاستمرار والتأثير والتأثر في جو منظم قبل أن تزيغ المظاهرات عن السياق السلمي لتصير فعلا ارتجاليا للحشد يقوم على منطق الفعل ورد الفعل.
على سبيل الختم
يمكن القول، إذن، إن الفهم المزدوج لظاهرة حراك جيل «Z» يجعلنا إزاء ظاهرة اجتماعية فريدة وخطيرة. ذلك أن هذا الفعل لا يعد فعلا سياسيا خالصا، بقدر ما هو فعل فرجوي يمتزج فيه السياسي بالاستراتيجي، والثقافي بالاجتماعي، والفني بالتربوي. فالتحليل السوسيوجمالي يكشف أن الاحتجاج، وإن كان يخلق حالة غير مرغوب فيها من طرف المخزن، إلا أنه مدرسة بديلة؛ حيث إنه يحفز على الإبداع والانخراط، وتجاوز مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج. كما إن هذا الوضع يجعل من الحراك الراهن صفعة للسياسي لإعادة النظر في النظم المتبعة، وتجديد آليات التواصل مع فئات الشعب المختلفة، وكذا إعادة بناء فلسفة سياسية قائمة على العمل الجاد والملموس بدل تمرير الخطابات الفجة التي لا تعدو كونها وصفا لفهم أحادي وفوقي يسخر وسائطه لمحاولة تغطية الشمس بالغربال.
(°) ناقد مسرحي سينمائي، عضو مركز روافد للأبحاث والفنون والإعلام، من أعماله: «خطاب السينما المغربية وتخوم التربية: بحث في الجماليات».