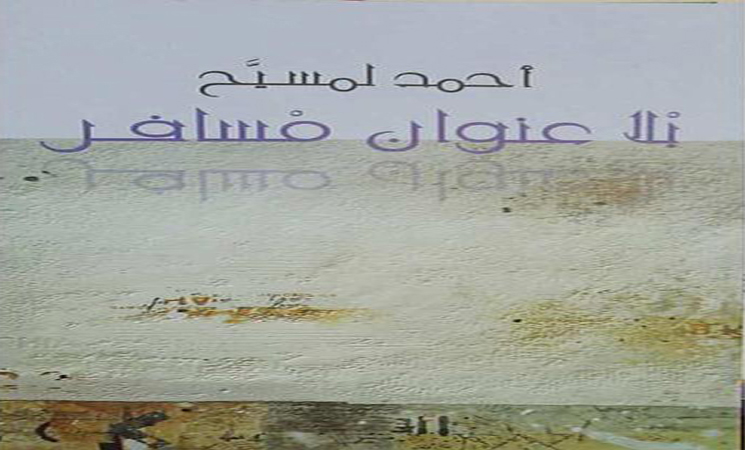…لعلّ من هنّات الكتابة الشعرية هيمنة النموذج/ النمط الشعري، ذاك الذي لا يحكم فقط علاقة السلف الشعري بخلفه، والذي لا ينتج آخر المطاف إلا صوتا شعريا واحدا يظل يتكرّر بأقلام مختلفة، بل يحكم مسيرة الشاعر الواحد نفسه حتى ليسهل علينا القول إن الشاعر لم يكتب الا قصيدة واحدة بتنويعات متشابهة، وإنه ظل طيلة سيرته الشعرية أسير نموذجه/ نمطه. ولعلّ هذا أيضا ما وقف عائقا أمام استساغة التجديد، والجرأة على تكسير النموذج، والمغامرة في فهمه في أفق بناء سقف شعري جديد منذور هو نفسه للتكسير خضوعا لسنّة الشعر الأبدية. حينها يصبح مشروعا الحديث عن سيرة شعرية موازية لسيرة الشاعر الحياتية ضدا على الذائقة الشعرية التي هي نفسها تخضع لمنطق التربية على الذوق، وهو لعمري أمر مرتبط أشدّ الارتباط بمنطق بنية في التفكير لا يزيدها المنطق الشعري إلا رسوخا، وهو الموكل له أمر التغيير كأضعف الايمان.
إنه الأمر الذي يخوّل لنا، في حال تداركه، الحديث عن مدارج شعرية، وعن تجارب شعرية في تجربة الشاعر الواحد، وكأني به هو نفسه يثور، ولا يتمرّد فقط، على النموذج/ النمط الذي يسكنه.
إنّها الإشكالية التي يضعنا في صلبها ديوان الشاعر أحمد المسيح «بلا عنوان مسافر»، وقد يكون من باب المصادرة على المطلوب تسرّعنا في القول إن الدواوين الأخيرة للشاعر إنّما تنتقل الى مرحلة ثانية (أو ثالثة)من كتابة القصيدة، ذلك بإقامة مسافة شعرية فاصلة بين همّ الواقع الموضوعي، وهمّ القصيدة، بتعبير آخر من همّ سؤال الـ»ماذا؟» الى همّ سؤال الـ»كيف؟»، الى تسليط الضوء على سؤال المبنى في القصيدة. إنّه ما يندرج، في تقديري، داخل سؤال « قلق الكتابة»، وتحديدا سؤال الوعي بالكتابة.
إنّه، بشكل عام، بحث عن كتابة قصيدة مغايرة توضع أسسه من داخل القصيدة نفسها، أي رؤية إبداعية لما ينبغي أن تكون عليه القصيدة القادمة، غير تلك الرؤية التي تثقل كاهلها، والموضوعة سلفا قبل كتابتها. فهو لا ينطلق من عنوان سابق، قارّ وثابت، ومعروف بل « يسافر بلا عنوان «، وليس الأمر من باب بوهيمية معيشية، أو تشرّد رومانسي، أو عدمية وجودية في أحسن أحوالها كما قد يغلّطنا العنوان، بل هو إقرار بلا مرجعية دوغمائية، مُكبّلة، ومُلجمة للفعل الإبداعي الذي أنجبته البشرية حرّا، والذي من شيّمه التحرّر من كلّ السياجات المرسومة بإتقان حتى قبل الشروع في الكتابة، يقول في الصفحة 18:» آدم لو عاد بلا ذاكرة»، وهو العنوان المطابق لما أسماه « موريس بلانشو»، ذات ثورة أجناسية، ب « الكتاب القادم» ضدا على «الكتاب القديم».
إنّه ما حدا بالشاعر الى عنونة مدخله ب» بيان – فاتحة «، وهو دليل القصيدة المنتظرة، والمفتوحة دوما على آفاق انتظار مفترضة (ديوان بغلافين…منتهاه بدايته، يسير دوما الى الأمام في خاتمته)، بيان بفاتحة لابد منها، وبخاتمة حرّة طليقة، يزيدها تأكيدا قوله في الصفحة 25:
«لا تختمي الحكاية،
ولو كانت ظل سحابة لا تخليها تزول»
وفي نفس الإطار، وبحثا عن القصيدة المشتهاة، يقول في الصفحة 20:
« وأنا ف جذبة الكتابة
ما كرهتش تزيدي تعطلي»
ويزيدها إقرارا قوله في الصفحة 77:
« طلقت الخامية ع لعقل
خليت الطوير يرفرف»
ليفتح فضاء القصيدة على مصراعيه لسفر سندبادي هوائي، نكاية بكل ثقل مرهق. سعيد، حرّ هو في لا قصديته، تلك التي سجنتها القصديات التقريرية المباشرة المرسومة سلفا.
وفي تقابل قصائدي، مبني على التضاد الخلّاق، يصرّح الشاعر في فاتحة بيانه بالتقابل المشار إليه ضمنيا في السابق، مؤشّرا على منحَيين في كتابة القصيدة، يقول في الصفحة 8، كاشفا عن موطن التناقض:
« مال الشاعر جهة خيالو
طاش ف» الباين»»
ليقابله في الحدّ الأقصى بلغته قوله:
« قبالتو شاعر سابح فخيالو
يطير فدواخلو»
فإذا كان الشاعر الأول يعتمد في صوره على الاستعارات التي نحيا بها، الموروثة أبا عن جدّ، فإن القصيدة، في تصور الشاعر الثاني،مستغنية عن الاستعارات المطروحة على قارعة الطريق، تخلق سرّها الخاص مستغنية عن الأسرار المفضوحة مادامت قد آمنت أن السرّ لا يمكن أن يكون سرّا الا إذا كان مطمورا، يقول بوفاء لنفس التقابل في الصفحة 12:
« وشلّة كلام ف» الموزيط»
مليوح ف السكّة»
يقابله في الصفحة 17:
« جا النص يراوغ
مستور المعنى»
وفي نفس السياق يقول في قصيدة بعنوان دال على ما نحن بصدده» القصيدة كلمة السر»:
« طلعت للسما نفتّش على شي صور
نوصف بها قصيدتي
لقيتها مخبية.»
إنّه ما يجعل القصيدة المشتهاة ليست نقلا للشيء، سرقة موصوفة، بل إحساسا به، ومكابدة عسيرة لنقل هذا الإحساس الملتبس، حيرة عميقة لا تستسهل التعبير عن التجربة المتفرّدة وتسترخصها، بل تعيش ولادتها المتجدّدة، يقول في الصفحة31:
« ما جاتني ضحكة
ما جاتني بكية
كنت» محظور» وصعابت القصيدة»
ويقول أيضا في قصيدة بعنوان آسر: «القصيدة كتفت يدي»:
« سولت القصيدة مالك حاجبة سؤالي
بغيت نكتب، والقصيدة كتفت يدي
يمكن يدي ما كانتش معقمة»
إنّه ما يجعل «القصيدة»، ليست ناقلة لتجربة خارجية، بل ملتبسة بتجربتها الداخلية، صانعة لعالمها الخاص، قارئة بتعبيرها الشخصي عالمها الخاص الذي لا يشبه في شيء أنماطه العتيقة، محطّمة كل التناصّات المسروقة في واضحة النهار، يقول في الصفحة 61:
« ما حرق سفون
ما خلا بحر وراه
كان الفاتح
وكان جيشه كهرباء ف المسام»
كل هذه الخبايا المشتغلة بصمت داخل القصيدة، أنتجت النص الشعري المتقطّع الذي لا يؤمن بالاكتمال ولا بما حصل اكتماله، وهو يلد النص المنزاح، الخارق لذوقنا المنمّط، والصانع دهشته الخاصّة في سيرورة الانفصال، لا الاتصال.
من هنا تأتي القصيدة الشذرية المشكّلة من شذرات تشكّل نسيج النص، تمنح معنى في عزلتها غير المكتملة، سيمفونيتها تناغم الشذرات كنوطات موسيقية يخفي العازف حكاياتها المعزولة، وروائزها المدفونة، يقول في الصفحة 63:
« الجسد كله نوطات محتاجة عازف»
والجسد هنا ليس الا متن القصيدة كما سمّاه العرب القدامى وهم يتحدثون عن النص المحكم، وهو ما ينقلنا من كتابة الوعي، كما عهدناها في القصيدة النمط، الى الوعي بالكتابة كما تبشّر به القصيدة المشتهاة.
مع قصيدته «بهلوان» تزداد مسؤولية صاحب الجسد/ المتن في أن يقدّم عرضا يليق بصفة القصيدة المشتهاة، «ألعاب خفّة بمهارة طيّار» ص55، نعيش معها روعة مهارة صاحب الجسد الذي قد تبدو حركاته سهلة طبيعية، ومتيسّرة لأنّه أخفى مظهره التقني في تركيب «نوطاته» داخل جمالية الجسد، يقول في الصفحة56 :
عيني عليهم «عْصابة» وماشي فوق الحبل
نصيد فراشات اللغة» .