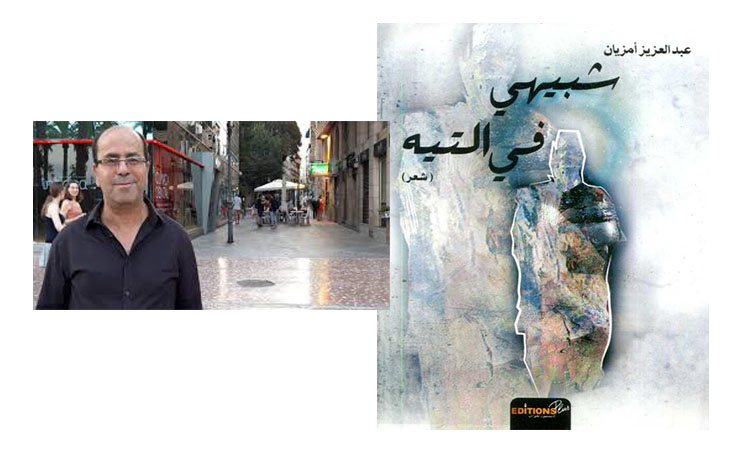1 – مقدمات أولية:
هيمنت اللحظة البنيوية، برغم قصرها، على النّقد. وفرضت على الدّرس الأدبي ما قدّمته من جديد خاصة في مستوى أدوات التحليل. وكان من أهّم مرتكزاتها النظرية الاهتمام بالنص وإعلان “موت المؤلف” كما قال رولان بات. ونتيجة لهذا كانت الذّاتُ الغائبَ الكبيرَ في الإشكاليات الفلسفية والتاريخية والأدبية، إذ اعتبرت فرضية مزعجة وبدون فائدة.
لكنّ العودة القوية لخطاب الذات مع بداية الثمانينات من القرن الماضي خلقت جيلا جديدا من النقاد الذين دافعوا عن عودة الفرد. وأعادوا على المستوى المنهجي ربط الصلات الحميمة مرة أخرى بين الأدب والتخصصات الأخرى كالفلسفة والعلوم المعرفية. وفي هذا السياق، تم التقليل من حدّة النقد الذي يبخس خطاب الذات حتى من طرف أشد أعدائها الذين وجدوا في الأدب كلّ إغراءات الرجوع إلى الذات.
شكلت أبحاث فيليب لوجون وجورج ماي تأسيسا نظريا مهما لمقاربة السيرة الذاتية، غير أن البدايات الأولى ظلت مشدودة إلى النسق البنيوي المهيمن. واستلهم النقاد العرب أهم المفاهيم التي بلورها هؤلاء الباحثون، منشغلين في الآن نفسه بهوية هذا الجنس وخصائصه وبداياته في الأدب العربي.
وفي الوقت الذي قطعت فيه الدراسات الغربية شوطا مهما في إعادة مقاربة خطاب الذات بأدوات منهجية جديدة، ظلّ الخطاب النقدي العربي خاصة في دراساته الأكاديمية مشدودا إلى تطبيق المفاهيم التي تجاوزها منظروها الأوائل أو عدلوها ومنهم فيليب لوجون، مع استثناءات قليلة انفتحت على المداخل الجديدة للنقد نذكر منها الدراسة المهمة التي أنجزها شكري المبخوت عن سيرة طه حسين “الأيام” بعنوان: “سيرة الغائب…سيرة الآتي” التي استثمر فيها نظرية ديكرو في الحجاج اللغوي من أجل مقاربة هذا النص السيري المُؤسس.
ونسعى في هذه المقالة إلى استثمار المقاربة التداولية لإبراز دور الفضاء في إنتاج سيرورة الاستدلال من خلال استحضار الكاتبة الزهرة رميج في سيرتها الذاتية المعنونة بـ”الذاكرة المنسية” لمجموعة من “الأمكنة” كمقدمات تنطلق منها الذاكرة الفردية لتحويل هذه الذاكرة إلى فنّ (البعد الجمالي) من جهة (ذاكرة تتخيل)، وإنتاج رؤية للمستقبل (البعد المعرفي) من جهة أخرى(ذاكرة تفكر).
وتستند هذه الورقة منهجيا على اجتهادات دان سبيربر Dan Sperber في تصوره لعملية التواصل الإنساني، باعتبارها سيرورة للاستدلال، تنطلق من قدرة الإنسان على تشفير الرسالة اللغوية، التي يمر تلقيها من المستوى الإخباري إلى المستوى التواصلي الذي تتحقق فيه المعرفة انطلاقا من المقصدية والسياق والكفاية الموسوعية.
هذا المدخل المنهجي يتخذ من فعل التذكر أساسا لبناء غايات التواصل، فالكاتبة في خطاب السيرة لا تتذكر أحداثا وأماكن فقط، بل تعرف أنها تتذكر، وتسعى إلى “إقناعنا” لا بما تتذكر فحسب، ولكن بالطريقة التي تتذكر بها.
ويعتبر بول ريكور هذا الأساس التداولي جانبا مهما في مقاربة الذاكرة؛ لأنّه يعضّد المقاربة المعرفية التي يقدّمها التاريخ الحافل لموضوعة الذاكرة في الفكر الإنساني خاصة الفلسفي منه.
وبما أنّنَا سننطلق من مفهوم أساس وهو “الفضاء”، فإننا سنستثمر الأبحاث الفينومينولوجية المهمة التي قدّمها المفكر غاستون باشلار في كتابه “شعرية الفضاء” مركزين على دراسته للفضاء في علاقته بنفسية الإنسان وبالذّاكرة.
2 – سياق “الذاكرة المنسية” وفرضيات القراءة
أصدرت الكاتبة الزهرة رميج سيرتها الذاتية “الذاكرة المنسية” عن دار فضاءات للنشر بالأردن سنة 2016، وتأتي هذه السيرة بعد أن قدمت إلى الخزانة المغربية والعربية العديد من الأعمال الروائية والقصصية، بالإضافة إلى ترجمة أعمال كتاب آخرين إلى اللغة العربية.
ويؤشر العنوان الذي اختارته الكاتبة لسيرتها الذاتية “الذاكرة المنسية” على العودة إلى الماضي، من أجل استحضار أحداث وأشخاص وأماكن…كان لها الأثر في حياة الكاتبة، ولكنه يُعلن في الآن نفسه عن نية الكاتبة في إخراج هذه العناصر من دائرة النسيان إلى دائرة الحضور. إنّ الكاتبة تستجيب لرغبة ذاتية في بناء هويتها من خلال السرد، ولإعادة الاعتبار لهذه الذاكرة التي “تستحق أن تروى” بعبارة جورج ماي.
ويعزز التقديم الذي صدّرت به الكاتبة سيرتها افتراضنا السابق، إذ إنّ، الكاتبة بحافز من أحد أصدقائها، كانت تنوي المشاركة في فيلم يحكي عن بعض ذكريات طفولتها، لكنها اعتذرت عن ذلك، غير أنّ هذا ولّد لديها الرغبة في الكتابة عن طفولتها. تقول الكاتبة في التصدير: “…مدينة بكتابة هذه السيرة لرشيد بيي…والذي وإن لم يثمر الفيلم الذي كان يحلم بإنجازه، فقد أثمر هذا العمل الذي اهتدى بخطاه…” (ص14)
تمنحنا المقدمة مؤشرات متعددة، نتخذها مداخل لقراءة هذه السيرة، أولها انتصارها ، لهويتها ولفعل الكتابة، وتفضل هذا الفعل على “اختيار وسائط أخرى” للتعبير عن الذات.
إن انتصار الزهرة رميج لوسيط الكتابة يجعلها أمام رهانات الوصول إلى “معارف غائبة”، انطلاقا من الحاضر، باعتبار أن السيرةَ حكيٌ استرجاعيُّ عن أحداث وشخوص وأماكن… تغيب عن الحواس، وفي هذا السياق تقول ميري ورنوك: “لمعرفة الذاكرة أهمية هائلة بالنسبة إلى شخص الذي يعرف ويتذكر، لكنه قد يفشل في التعبير عن هذه الأهمية أمام أي شخص عدا نفسه… ولكن ما دام الراوي فنّانا، فإن غايته العليا ستكون اقتحامَ هذا الحاجز…وظيفة الفنّان بأكملها تتمثل في توصيل هذه الحياة سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، وعليه أن يكتشف الوسائل لعمل ذلك”.
3 – الفضاء السيري وسيرورة الاستدلال
من الذاكرة:
ركزت الكاتبة في سيرتها الذاتية على الانطلاق من الأماكن، ومن خلالها استحضرت مجموعة من الذكريات التي عاشتها فيها، فهي من خلال هذه الفضاءات تبني مؤشّراتٍ تساعد على جعل “الذاكرة تفكر”. وهي بهذا البناء تنطلق من الذّاكرة؛ إذ يصبح المكان وسيلة لاحتضان الذاكرة في مواجهة “العدو الأول” الزمن، حينما تختزل أبعاده الثلاثية (الماضي والحاضر والمستقبل). وفي هذا السياق، سندرس مثالين دالّين على وظيفة المكان في إنتاج المعرفة، وذلك باتخاذه مقدمة/موضعا لإنتاج الاستدلال السردي.
نبرز في المثال الأول سيرورة الاستدلال في إنتاج المعرفة؛ إذ تنطلق الكاتبة من فضاء البيت والانتماء القبلي لتعبر عن موقفها من التعصب والشوفينية. ونبرز في المثال الثاني سيرورة الاستدلال في بناء جمالية النص؛ حيث تقابل الكاتبة بين صورة البيت الذي سكن ذاكرتها (بيت الماضي)، وصورة البيت الذي زارته بعد مرور خمسين سنة (بيت الحاضر)، لتعبر عن دور الذّاكرة في الوصول إلى “الفردوس المفقود”.
وهذان المثالان لا ينفصلان عن منطلقنا المنهجي الذي يركز على علاقة الذّاكرة بالأدب، ومن هذا المنظور يوضح رونات لاشمان Renate Lachmann هذه العلاقة بقوله: “عندما نسلط الضوء على الأدب من منظور الذّاكرة، يظهر أن الأدب هو فن الذّاكرة بامتياز. الأدب هو ثقافة الذّاكرة ليس بوصفها وسيلة بسيطة للاستحضار، ولكن باعتبارها جسدا لتمثيل المعرفة المخزّنة ثقافيا…فالكتابة هي في الآن نفسه فعل للذاكرة و لإعادة التأويل الذي يسمح بوضع نص جديد في إطار فضاء الذّاكرة العام…”
4 – من ذاكرة البيت/المكان إلى الذّاكرة الحية
تفتتح الساردة سيرتها بما يلي:
“المكان الذي يوجد فيه البيت الذي ترعرعت فيه، والمدرسة التي قضيت فيها سنواتي الدراسية الأولى، يسمى لبّيرات ويقع على بعد سبعة عشر كيلومترا، من مدينة خريبكة”. (ص15)
وانطلاقا من هذا المكان تحدد انتماءها إلى قبيلة بني يخلف، “تقع لبيرات في قبيلة بني يخلف…”(ص16)
وتحكي الساردة عن أصل هذه القبيلة المختلَف فيه بين العربي والأمازيغ، وهو ما تعكسه عادات أهلها وتقاليدهم (عربية/أمازيغية).
لتخلص إلى نتيجة:
“سواء أكان أصل هذه القبيلة عربيا أم أمازيغيا، فإنها تعكس حقيقة المجتمع المغربي الذي انصهر فيه هذان المكونان…ليخلقا الشخصية المغربية الأصيلة بكل مكوناتها، دونما تمييز.” ص18
واستنادا على سيرورة هذا الاستدلال تصدر موقفا:
“لذلك أستنكر وجود الحركات الأمازيغية المتعصبة التي تكن عداء سافرا للعرب…” ص19
يمثل هذا النموذج مثالا واضحا لطبيعة الاستدلال الذي ينطلق من الأماكن، وهو نموذج اعتبره المؤرخ الفرنسي بيير نورا وسيلة لإعادة بناء الذّاكرة التاريخية في كتابه الشهير “أماكن الذاكرة”. فانطلاقا من مكان البيت ومكان المنطقة، وما حملته الساردة من ذكريات، تصل إلى ذاكرة تنظر إلى المستقبل. هذه الذّاكرة ليست ذاكرة تاريخية ولكنها نموذج للذاكرة الجماعية التي تكون ميّالة إلى إصدار الأحكام. ويتجلى هذا في تعبير الساردة عن موقفها بشكل سافر: “أستنكر….”، إنها تنتصر لقيمة التسامح والتعايش الذي يجمع مكونين أساسيين من مكونات سكان المغرب، وهم العرب والأمازيغ.
لقد تحوّل المكان “البيت/القبيلة…” من فضاء هندسي إلى موضع يختزن ذاكرة يمكن أن تتحول إلى دليل للشهادة، وهنا تتقابل الذاكرة الجماعية التي يمثلها المحكي عن أصل القبيلة إلى معرفة (عرف هولبفاكس الذّاكرة الجماعية بأنها كل ما تتناقله الأجيال من خلال الأطر الاجتماعية: الأسرة، القبيلة…)، ويمكن مقابلتها ب”التراث”. غير أن هذه الذاكرة الجماعية تتحول إلى “ذاكرة حيّة” تنظر إلى المستقبل من خلال “فعل التذكر” الذي يسميه أيضا بيرغسون “مجهودَ التذكر” ، وهي ذاكرة قادرة على المواجهة، والمواجهة هنا تقتضي اتخاذ موقف “استنكار النزعة الشوفينية التي يسعى إلى نشرها بعض المتعصبين”.
توظف الكاتبة الذاكرة للتعبير عن المشترك عبر الزمن، ويرى بول ريكور أن الذّاكرة التي تعي صلتها الوثيقة بالزمن هي تلك الذّاكرة الحية. وهي حين ترتبط بالممارسة تدخل مجال التداول المشترك، وتراهن على الفعالية عبر الانتقال من الصمت إلى الكلام، فتصبح حينئذ قادرة على الإسهام في بناء الحاضر والتأسيس للمستقبل.
5 – من ذاكرة البيت إلى الذّاكرة المتحررة
ربط غاستون باشلار في كتابه “شعرية الفضاء” بين الفضاء والأحاسيس الإنسانية؛ فهو، وإن كان إطارا جغرافيا تتحرك فيه الذات، يضطلع أيضا بوظيفة التأثير في أحاسيسها. ولذلك ذهب إلى الإقرار بأن دراسته “تستحق أن تسمى هوس المسح الشامل Topophilia “. إنها تبحث في تحديد القيمة الإنسانية لأنواع المكان الذي يمكننا الإمساك به، والذي يمكن الدفاع عنه ضد القوى المعادية، أي المكان الذي نحب”.
وقد رصد باشلار تجليات الفضاء النفسية اعتمادا على جانبين اثنين:
+ جانب إدراكي: له علاقة بالذاكرة وطريقتها في الاشتغال؛ يعمد بحيث الفرد إلى الربط بين أحداث الماضي وبين أحواله النفسية في علاقتها بالفضاء وما تحمل من شحنات عاطفية ، فمن خلال “توهج الصور يتردد الماضي البعيد بالأصداء”.
+ جانب فني: يظهر من خلال العلاقة بين الفضاء والصورة الفنية في عدد من الإبداعات الأدبية، ذلك أن التحقق الفني للفضاء يربط بين الواقع والخيال، ويدفع المتلقي إلى البحث عن دلالات الصورة التي يقدمها الفنان / الأديب عن الفضاء.
تعود الساردة بذاكرتها إلى “بيت الطفولة”، تقول في الصفحة 21: “البيت الذي تفتح وعيي عليه هو بيت لبيرات الذي ارتبطت كل ذكرياتي الطفولية الأولى به وبفضاءاته الخارجية …”(ص21)
إن الفضاء الذي انطلقت منه الكاتبة فضاء حميمي سبق وأن حققت ألفة معه، يعرف باشلار “بيت الطفولة” بوصفه “مكان الألفة ومركز تكييف الخيال، فعندما نبتعد عنه نظل دائما نستعيد ذكراه، ونسقط على الكثير من مظاهر الحياة المادية ذلك الإحساس بالحماية والأمن اللذين كان يوفرهما لنا البيت”.
تعبر الساردة عن حنينها الدائم إلى هذا البيت بقولها:”انتقالي إلى المدينة لم يشعرني بالسعادة إذ عانيت في السنوات الأولى من إقامتي بها، من الغربة والحنين إلى بيتنا الريفي. كنت أبكيه بحرقة كمن يبكي عزيزا فقد إلى الأبد…”(ص22)
وتقول أيضا: “مرت السنوات، وكونت أسرة، وأصبح لي بيتي الخاص الذي يحتضن حياتي الجديدة، ومع ذلك، ظل بيت البادية يزورني في أحلامي من حين لآخر، وظل في ذاكرتي رمزا للجنة”. (ص23)
فالعناصر التي تؤثث هذا البيت في ذاكرة الساردة، تمثل تحققا فعليا لجمالياته المرتبطة بتجربة الذات، في إطار ما سماه باشلار “المسح التحليلي Topo-analysis”؛ حيث “تظهر صورة البيت وكأنها أصبحت طوبوغرافية وجودنا الحميم”.
هذا المكان المُنْطَلَق للسرد والموتيف الفاعل، سيعيد ترتيب ذاكرة الكاتبة اللاإرادية؛ ويظهر هذا في العودة إلى البحث عن هذه “الجنة المفقودة”، وتماما كما حفزت “البلاطة” سارد بروست على الإمساك بالزمن الضائع، ستحفز العودة إلى زيارة البيت، وتجاوز عتبته إحساسَ الساردة، غير أن إحساس بطل بروست بالفرح سيقابله إحساس الساردة بالحزن.
تقول الساردة: “ما إن تجاوزت عتبة البيت…خفق قلبي بشدة، وأنا أجيل البصر لأعانق كل ركن فيه. بدا لي ضيقا! هل خانتني ذاكرتي الطفولية….خرجت من بيتنا القديم منكسرة النفس، شديدة الحزن. أين هذا البيت من ذلك البيت الذي يسكنني؟ أين فضاءاته الكئيبة هذه من تلك الفضاءات الآسرة؟…”(ص27)
لقد انْتُزع جمال البيت الذي اختزنته في ذاكرتها، فتحوّل إلى “طلل” يكفي الوقوف عليه، لتنهمر سيول الذكريات من “عل”.
تقابل الساردة بين صورتين: صورة البيت الذي سكن ذاكرتها، وصورة البيت الذي لم يعد موجودا في الواقع. وهي في الواقع تقابل بين زمنين: زمن ماضٍ ومنته، وزمن حاضر يبرز “بؤس” البيت.
هل كانت الساردة/ الراشدة/ العاقلة تبحث فعلا عن بيتها الأول؟ وإن فعلت هل كانت تعتقد أنها ستجده كما هو؟
يجيب غاستون باشلار عن جزء من هذا الإشكال بكشفه عن الإدراك النفسيِّ للفرد، وهو يوظف الخيال لاسترجاع فضاءات الذاكرة بما تحمله من قيم. فالبيت ليس فضاء لأجل السكن ذا أبعاد هندسية محددة، إنه أكبر من ذلك وأعظم؛ لأنه يجسّد “ركنَنَا في العالم…كونَنَا الأول، كونا حقيقيا بكل ما للكلمة من معنى. وإذا ما نظرنا إلى الأشياء بألفة فسيبدو أبأس بيت جميلا”.
إنّ الساردة، وهي تعود إلى البيت وفضاءاته، تتخذ طريقين:
-طريقَ مواجهة الزمن، وهو الذي تجسد في عودتها إلى البحث عن بيتها الأول بعد مضي خمسين سنة على مغادرته.
-طريقَ الذّاكرة التي هي الزّمن نفسه، والتي تحفظ صورة “البيت الأول” بروائحه وأثاثه وطاحونته وحوض نعناعه…
في الحالة الأولى تعود الساردة منكسرة لأن الزمن سلبها “وجودها الأول” بقسوة ودون أي إحساس بالشفقة. وفي الحالة الثانية تحافظ الساردة على “وجودها الأول” من خلال ذاكرتها. وفي هذه الحالة ينسل صوت الكاتبة/الواعية. فهي لا تتذكر ولكنها تعرف أنها تتذكر؟ وكيف تتذكر؟
تقول الساردة في الصفحة 34: “…لا شيء مما تراه العين، وتسمعه الأذن، ويشمه الأنف، وتلمسه اليد يمحى من الذاكرة… كل تلك الأشياء تظل مركونة في الغرفة السوداء المظلمة…تظل تغط في سبات عميق إلى أن تبعث إليها إشارة ما، أو يتسلل إليها خيط نور رفيع… إن اللاوعي هو الخزّان الأعظم الذي ينهل منه المبدع، وهو الذي يوسع آفاق خياله باستمرار”. ص34
يبرز هذا المقطع وعي الكاتبة بالذاكرة في البحث عن الألفة وتحقيق الحميمية، فقيمة البيت أو “جمالياته”،بعبارة باشلار، لا تعني البحث عنه، كما كان في الماضي، ولكن استنادا إلى كينونة ذاتية حالمة متصلة بالقيم الإنسانية المنسوبة إلى أحلام اليقظة، وهو ما يجعل هذه “البيوت تعيش معنا طيلة الحياة”.
إن أساس الاستدلال هو ربط العلاقة التي أوجدتها الكاتبة بين فضاء البيت والجوهر الإنساني، فعبره تدمج الأفكار والذكريات والأحلام ويتداخل الماضي والحاضر والمستقبل، ويتم الجمع بين الجسد والروح لإعادة الإنسان إلى عالمه الأول، هناك حيث تتحقق الطفولة بما تحمل من رؤى وأحلام، لتتجسد بذلك معرفة النفس من خلال الفضاء وليس الزمن، وبتعبير باشلار بدون فضاء “يصبح الإنسان كائنا مفتتا”.
كم هي عجيبة هذه الذاكرة!، لقد تأمّلها شاتوبريان قائلا:
“ماذا سنكون بدون ذاكرة؟ سننسى أصدقاءنا، أحبتنا مسرّاتنا، أعمالنا. وسيعجز العبقري عن استجماع أفكاره، ويخسر أكثر العشاق اندفاعا رقته إذا عجز عن تذكر شيء. سيختزل وجودنا إلى لحظات متعاقبة من حاضر يتلاشى أبدا، ولن يكون لنا ماض أبدا.
أيّ مخلوقات مسكينة نحن، فحياتنا من الخواء بحيث إنها ليست أكثر من انعكاس لذاكرتنا”.
خلاصات المداخلة:
نخلص في نهاية هذه المداخلة إلى أهمية المكان في السيرة الذاتية؛ فمعظم الكتاب في سيرهم يتذكرون “البيت الأول”، و”المدرسة الأولى”…لكن المكان لا يحضر في كل السير بالطريقة نفسها، فقد يتجاوز واجب تأثيث السرد، ليشكل موضعا للاستدلال تقوم فيه الذاكرة بإنتاج معرفة تتجاوز الزمن. غير أننا رأينا أن الذّاكرة، وهي تستحضر فضاء البيت. مثلا، لا تكفُّ عن “التفكير” كما بيّنا في المثال الأول الذي انطلقت فيه الساردة من ذاكرة فردية تستحضر فيها بيتها وموقعه؛ لتصل إلى ذاكرة تتخذ مواقف وتنظر إلى المستقبل، ليس المستقبل الفردي فقط، ولكن مستقبل الآخرين الذي هم في حاجة إلى الإحساس بقيمة المشترك.
كما أن الذاكرة “تتخيل”؛ فالتجربة الفردية التي قادت الساردة إلى البحث عن بيتها قد جعلتها تنكسر واقعيا، ولكنها “حرّرتها” من إكراهات هذا الواقع بذاكرة تفتح كل أبواب الماضي، ليَعبُر الإحساس بسعادة استرجاع الأشياء المفقودة. فـ”الذّاكرة هي المفتاح إلى الفردوس المفقود”. والأدب أروع نموذج لإعادة صياغة الفرح، لأنه يمنحنا الفعل والقدرة على التذكر، والقدرة على أن نتقاسم ما نتذكره مع الآخرين.
ونختم بقولة لبروست من رحلته في “البحث عن الزّمن الضائع”:
“لنترك صوتا أو عطرا، سمعناه أو شممناه فعلا في الماضي. يطرق أسماعنا أو نشمه من جديد في الحاضر والماضي معا، فهو واقعي دون أن يكون حقيقيا، ومثالي دون أن يكون مجرّدا، عندها سنجد أن جوهر الأشياء الدّائمَ والخفيَّ سيتحرر في الحال، وسوف يستيقظ وجودنا الذي ظلّ يبدو لوقت طويل ميتا..ويحيا..إن لحظة تتحرر من نظام الزمن تعيد فينا خلق الإنسان المتحرر من ذلك النظام نفسه لكي يتمكن من أن يعيه. ونحن نفهم أن اسم الموت لا يعني شيئا بالنسبة له، إذ كيف يتأتى له أن يخاف المستقبل، وهو موجود خارج الزمان؟”.
المصادر والمراجع المعتمدة:
-الزهرة رميج، الذاكرة المنسية، فضاءات للنشر والتوزيع، عمان، 2016.
-ميري ورنوك، الذاكرة في الفلسفة والأدب، ترجمة فلاح رحيم، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2007
-بول ريكور، “الذاكرة، التاريخ، النسيان” ترجمة جورج زيناتي، دار الكتاب الجديد،ط1،2009.
-غاستون باشلار، جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، ط2، 1984
–جورج ماي، السيرة الذاتية، تعريب محمد القاضي وعبد الله صولة، دار رؤية للنشر، ط2، 2017.
-شكري المبخوت: “سيرة الغائب، سيرة الآتي:السيرة الذاتية في كتاب الأيام لطه حسين” سنة 1992. دار رؤية للنشر، ط2، 2017.
– Dan Sperber. 2000. La communication et le sens. Dans Yves Michaud (ed.) Qu’est-ce que l’humain? Université de tous les savoirs, volume 2. Paris: Odile Jacob. 119-128