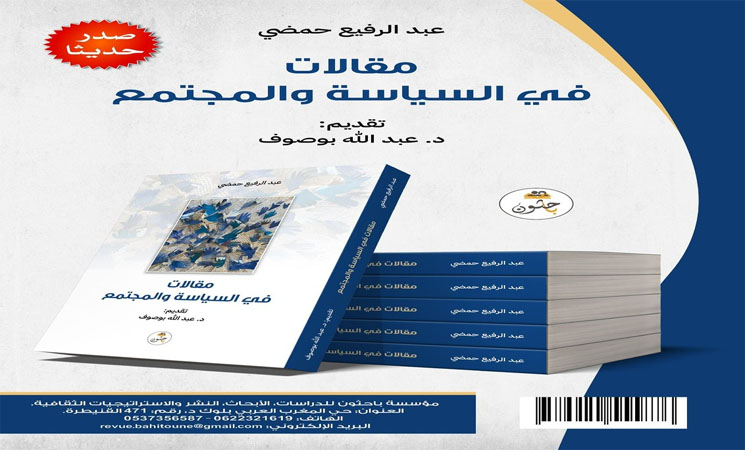الجيغولو (دعارة الرجال) تحت المجهر

في البداية، لا بد من الإشارة إلى أنني لست ناقدا يمتلك أدوات النقد ومشارطه، تكون وسيلته لتشريح النص الإبداعي عموديا وأفقيا، وسبر أغواره واستخراج ما تجود به أنامل الكاتب من صور بلاغية جميلة وعبارات جزلة وبناء روائي محكم، ويعرج على ما فيه منمعايب ونقائص. لكن هل يمنع هذا أن يعبر القارئ عما يخالج نفسه سلبا أو إيجابا وهو يقرأ أي نص إبداعي شعرا كان أو نثرا؟ أليست القراءة الفاحصة هي كتابة ثانية للنص الإبداعي كما جاء مع نظرية التلقي التي كسرت ثنائية (كاتب/ كتاب)، لتجعل القارئ في صلب أية عملية إبداعية؟.
في روايتها هاته «مخالب المتعة»، الكاتبة فاتحة مرشيد بلغتها الشاعرية، وبجرأتها الأدبية تناولت باقتدار موضوعة «الجيغولو» (دعارة الرجال). ما أظن أحدا طرقها بالعمق الذي تناولته بها. فقد وضعت قلمها على جرح هذه الظاهرة بكل ما أوتيت من إبداع روائي، حتى إنه أوجع البعض، فلم يجد بدل الحجة بالحجة غير المنع وسيلة لمجابهتها، إذ منعت هذه الرواية من العرض بمجموعة من الدول العربية. ألم يكن الأولى بدل سلاح المنع، فتح نقاش جاد حول ما فصلت فيه الكاتبة يتعلق بهذه الظاهرة؟ و لم لا يكون على الهواء مباشرة، وللجمهور العربي رأيه في الإقبال على الرواية أو الإعراض عنها؟ فقد علقت في أحد حواراتها على هذا القرار بالاستغراب والاستهجان: «كم من كاتب عربي يكتب عن دعارة النساء، ويتفنن في نقل وقائعها حد القرف، فلماذا يضيق بعض أصحاب القرار ذرعا بكتابتي عن دعارة الرجال، إذ قامت قيامتهم ولم تقعد».
ما الفرق بين الرجل والمرأة؟ ألا يبيع كلاهما جسده ليأكل به. ألا ينطبق القول المعروف «تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها» على الرجال أيضا؟ المفروض يجوعون ولا يسترزقون بأجسادهم، يبيعونها للنساء من الطبقة المخملية بمقابل مادي مغر؟ فالظاهرة تنتشر بشكل مضطرد، إذ أصبح الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي يعرضون أجسادهم كأية بضاعة للبيع. بل وكم منهم يُعَرّضون أنفسهم للخطر، بلجوئهم للمكملات الكيمائية حتى يكتسبوا أجساما مغرية، لاستقطاب أكبر عدد من الزبونات الباحثات عن المتعة، هذا دون الحديث عما تسببه مداومة الجنس من مشاكل صحية خطيرة على هؤلاء الشباب تصل إلى العجز الجنسي التام.
إن الرواية تحاكم المنظومة التعليمية برمتها، وتؤشر على فشلها الذريع، بما أنها تستقبل الملايين سنويا بدون أفق يضمن لهم كرامتهم عند تخرجهم، مما يجعل معظمهم بشواهدهم العليا يصطدمون بسوق الشغل. وحتى إن اشتغلوا فلا علاقة لتخصصاتهم بما يشتغلون به، كما هو حال الشبان الثلاثة في الرواية (مصطفى، عزيز، أمين). أما الرابع رشيد فقد ترك باكرا جمل الجامعة بما حمل لما ألحقه والده بمعهد، ليصاهر عند تخرجه والتحاقه بالعمل رئيسه المباشر، وهو رجل أعمال معروف، فدخل مجتمع الثراء من بابه الواسع.
كان نقدها لاذعا للمنظومة التعليمية. فقد جاء على لسان رشيد: «الزمن تغير، وهناك شعب دراسية يجب إلغاؤها بالمرة مثل: التاريخ والجغرافيا والآداب و الفلسفة.. كلها دراسة نظرية محضة.. ألا توافقني؟ ماذا ستفعل بالدكتوراه في الفلسفة مثلا؟ لا شيء غير التدريس لتكون بدورك عاطلين آخرين» ص43 ، وإن كان السؤال الذي يفرض ذاته حول ما إذا كان العيب في الفلسفة أم في السياسات المتبعة. أليست الفلسفة هي قرينة الفكر الناقد؟ أليست هي الوعي بالذات وبالآخر؟
لو لم تكن على قدر من الأهمية، لما كانت ولاتزال في عين العاصفة من قبل كل الديكتاتوريات عبر العصور؟ وقس عليها بقية الشعب كالقانون والتاريخ والجغرافيا والأجناس الأدبية بمختلف تعبيراتها، شعرا و نثرا.
تناولت الكاتبة تيمات روايتها بأسلوب أدبي شائق، ينم عن تمكن محكم من أدوات صنعتها الروائية متنقلة بسلاسة بين شخوصها بدون أن تحس لتنقلها همسا ولا حسا، كمايسترو بمهارة يقود فريقه لأداء معزوفة موسيقية ماتعة تشد الأسماع.
فمن وصف حال أمين الذي منذ تخرجه انخرط في البحث عن شغل يناسب تخصصه في التاريخ والجغرافيا، وهو الذي اختاره اعتقادا منه كما في الرواية «بأن لا مستقبل بدون تاريخ، ومصير الشعوب تحدده الجغرافيا» ص 9، لتعقب بنفس الصفحة بالقول «هراء». فقد ظل عالة على أخته التي تشتغل في صالون للحلاقة، كل صباح تدس له في جيبه ما يدخن به ويؤدي ثمن فنجان قهوة. ولنا أن نتصور حال شاب ينتظر ما تجود به عليه أخته، علما أنها المعيل الوحيد للأسرة منذ وفاة والده. أليست هذه هي المحضن الخصب لتفريخ كل الفطر المدمرة من إرهاب ومخدرات واحتراف كل الموبقات؟
أمين ظلت هذه حاله إلى أن التقى بصديق دراسته عزيز الذي فشل في استقراره بألمانيا وعاد خاوي الوفاض ليجد ضالته في الاتجار بفحولته وجسده، ببيعه للنساء الثريات من الطبقة المخملية ك»ليلى». عن عمد عرّفته بامرأتين غيرها، بما أنه لا يهمها أي نوع من الحب، بمعدل يومين لكل واحدة منهن يقول «أرتاح يوم الأحد لأنه اليوم الذي يخصصنه للزوج والأسرة» ص 26.
انتهى بها المطاف لتُقتل على يديه. فهو مع الوقت أحبها فعلا رغم فارق السن بينهما، ولم يعد يستسيغ الاتفاق الذي كان بينهما «جنس بلا حب» فطفق يردد «لست أحد فساتينها تلبسه يوما وتستغني عنه في الغد» ص 99. اقتفى أمين أثره بعد تردد، إذ اقتنع أخيرا بمنطق صديقه ببيع نفسه هو الآخر «اللهم الملقى مع ميمة حنينة ولا شابة تعيشك فالمحينة»، بعدما قال له «إنها تكبرك سنا، جميلة، ثرية، وتعيسة. مواصفات تجعل منها زبونة مثالية» ص24، وإن كانت تجربته مختلفة مع «بسمة» المرأة الثرية، التي لم تكن في حاجة سوى لمن يشاركها حزنها على ولدها الفقيد، يصغي إليها ويواسيها، فاشترطت عليه «حبا بدون جنس». فالحنان مسموح والشهوة محظورة. القبل مباحة والمضاجعة ممنوعة، قائلة في ص77 «القبلة فعل حب بدليل أن العاهرات لا يقبلن زبائنهن».
انتهى الأمر بها بعد مقتل صديقتها لتهاجر إلى كندا، بعد أن ضمنت له تعيينا في معهد للتكوين. كان ذلك من الكاتبة لتؤكد على أمر غاية في الخطورة. إنها آفة الزبونية والمحسوبية في أحقر تجلياتها، تضرب في مقتل مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب طالبي الشغل.
النموذج الثالث كان مصطفى حاصلا على دكتوراه في الفلسفة، الذي ربما بحكم تكوينه الفلسفي خبر الواقع المرير، وبدون أن يقطع حذاءه في البحث عن سراب وظيفة أو عمل يناسب تخصصه، قبل بأول عمل يصادفه فاشتغل سائقا لسيارة أجرة لدى أحد محتكري الكريمات، وتزوج من أخت أمين وكفى المؤمنين القتال. الكاتبة بحكم تخصصها الطبي وشغفها بعلم النفس، تدرك جيدا ماذا تعنيه السنوات الأولى لدى أي إنسان. عزيز أنه عاش طفولة متشظية إثر انفصال والديه وهو ابن التاسعة من عمره، فتزوج من شابة تصغره سنا، حصل أن أجلاه والده سي علال وطرده من البيت شر طردة، بعدما ضبطه يتلصص عليها في الحمام، فانتقل ليعيش مع زوج أمه الشاب الأعزب، فكان كالمستجير من الرمضاء بالنار. فقد أذاقه من كأس المهانة حتى الثمالة إلى أن اجتاز امتحان الباكالوريا، فكان من أمره ما كان، سواء خارج الوطن بألمانيا لما تأكد لخطيبته تحرشه بأختها، أو داخل الوطن لما انتهى به المقام بالسجن بسبب قتله لـ»ليلى».
ليلى نفسها هي الأخرى تعرضت في طفولتها للاغتصاب من طرف زوج أمها، حكم عليها بتزويجها من رجل يكبرها بثلاثين سنة، وإن كانت تقول «لم أكن راضية طبعا، لكن اغتصابي من مجهول أهون من الاغتصاب الذي يمارسه علي زوج أمي» ص87. فتكونت لديها عقدة من الحب حملتها معها طول حياتها تقول «لا أومن بالحب. وحدها المتعة تحركني. متعة أشتريها .. متعة مع رجال يصغرونني سنا. لا أتحمل الجنس مع من هم أكبر مني .. أرى فيهم شبح زوج أمي» ص87
هو حال الأثرياء كما تؤكده الكاتبة «أصحاب المال عندما يضيع منهم الشباب يحاولون شراء شباب الآخرين» ص 29.
نموذج آخر تؤكد فيه على تأثير السنوات الأولى من عمر الإنسان، و هو المتعلق بأحمد كما ورد على لسان صديقه إدريس، لما تقاعد قرر أن يحقق حلما ظل يراوده لمدة خمسين سنة، بأن يسافر إلى الهند تلبية لرغبة تولدت لديه أثناء مشاهدته لفلم سينمائي هندي ولم يكن يتجاوز حينها الثانية عشر من عمره، فقط ليزور المحل الأسطوري «تاج محل»، كان البطل يغني أمامه و يراقص حبيبته. ف»الأحلام لا عمر لها» ص146 . ومما يحسب للرواية أنها بين الفينة والأخرى ترصد على لسان شخوصها، ما يعيشه المجتمع من تناقضات عصية على الفهم، من قبيل ما ساقه عزيز في سياق نقاشه مع صديقه
أمين الذي استنكر الفارق العمري بين الجيغولو والنساء الثريات، «لماذا عندما يتعلق الأمر برجل مسن يدخل في علاقة مع فتاة في سن حفيدته يعتبر الأمر عاديا.. و عندما يتعلق الأمر بامرأة تعاشر رجلا أصغر منها سنا تصبح المسألة غير مقبولة بل ولا أخلاقية؟ ص 30.
من المفارقات أيضا ما جاء على لسان أمين في حديثه عن «أمي البتول» التي كان الجميع يهابها، لم ينس قصتها مع تبوله اللاإرادي في الصغر، وكيف أنها فرضت عليه كل خميس أن يجلس أمامها على الكسكاس ليقسم قائلا «حق هاذ البلبول مانبول». والطامة يقول لما لم تجْد هذه الوصفة نفعا مرت للخطة «ب» في العلاج، هنا بيت التناقض السافر، لما أشارت على أمه بوصفة الفول مطبوخ ببوله مؤكدة لها أنه «حطة ببطلة»، وطالبته بتقديم هذه الوجبة لأصدقائه لينتقل التبول إليهم.
ظواهر أخرى عرجت الرواية عليها بمرارة، مثل الطلاق الذي تتفاقم نسبته سنة بعد أخرى، وعادة ما تكون النساء ضحاياه من عدة وجوه، تقول الكاتبة على لسان «ميمي» النادلة بإحدى الحانات «ميلودة» في الأصل «أعلم أنني متهمة، لكنني فهمت أن التهمة الكبرى بهذا البلد السعيد، هي كوني امرأة مطلقة» ص104، نصب عليها زوجها، فسلبها كل ما تملك من نقود وأساور، وترك لها ورقة الطلاق وهاجر، لتجد نفسها وجها لوجه مع عوادي الزمن، تتحمل مسؤولية طفل من صلبه وأم وأخ وجدة. ومع المأساة التي تغرق فيها فهي ملزمة بالابتسام في وجه الجميع.ظاهرة أخرى تتعلق بالتقاعد على لسان إدريس يحكي قصة صديقه أحمد الذي ظل ينتظر لمدة نصف قرن فيحقق حلمه، إذ لما وجد نفسه وحيدا بما أن زوجته لم تعد تكف عن التنقل بين بيوتات أبنائهما لتلبية حاجيات أحفادها، كان أمله أن يحج إلى محراب الحب «تاج محل» . فبعدما قر قراره على السفر، عقد اجتماعا طارئا بحضور زوجته وأبنائه من أجل إخبارهم بالأمر وليس التشاور معهم. «تبادلوا نظرات تحمل قرارات مضادة، وانصرفوا». أيام معدودات كانت كافية ليجردوه من كل ممتلكاته بعدما حجروا عليه. «انهارت قواه وسقط طريح الصدمة» ص148.
كانت صدمته قوية لما صار ابنه الذي ضحى من أجل تعليمه خارج الوطن، يتزعم الكيد له والحيلولة دون تلبية رغبته، فظل يتألم ويتحسر وهو يقارن حاله بحال المتقاعدين هناك «وإن تقاعدوا عن العمل فهم لا يتقاعدون عن الحياة، بل يتهافتون على السفر واكتشاف العالم» ص149. أيام فوُجد جثة هامدة بإحدى قاعات السينما حاملا معه غصته في حلقه.
ألا تؤكد لنا هذه الظواهر التي لا تزال تعشش في مجتمعاتنا، أن المسافة بيننا وبين
الوعي اللازم لا تزال بعيدة المنال؟
ألا تدعونا لنكثف مجهوداتنا للقطع معها على درب اللحاق بالأمم الأخرى؟
-ألا تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها فتسعى لإصلاح المنظومة التعليمية بما أنها قاطرة كل القطاعات؟ ولم لا إعادة النظر فيها لتكون الفضاء الأمثل للتعليم الجيد والتأهيل المناسب لسوق الشغل، لتجنب الشباب المآلات التي رصدت الرواية جزءا منها؟ وما محل المثقفين ورجال الدين المتنورين، والأساتذة وجمعيات المجتمع المدني من إعراب التغيير المجتمعي؟