قصة «سينما كاميرا « لمحمد لفتح (1946-2008) هي واحدةٌ من قصص مجموعته التي تحمل عنوان «وردةٌ في الليل» الصادرة عن منشورات «لا ديفيرونس» بباريس سنة 2006، وتجري أحداثها بأول قاعة للسينما بمدينة سطات التي لم تَسْلم، بدورها، من الهدم الذي حَملَها في طريقه، مع ذاكرتنا وأحلامنا وشغبِنا الحكيم، في بدايات ثمانينيات القرن الماضي. تُقدِّم القصةُ حكايةً من بين الحكايات الكثيرة التي عاشها أبناء جيلي في قاعة السينما هذه وفي محيطها. إنها حكاياتٌ تتقاطع، تتعارض وتَتَّحِد لتعزف سمفونية واحدة، سمفونية «الزمن الضائع» التي ينقلها واحد من أبناء هذه المدينة التي شكلت فضاءاتُها مسرحا للعديد من نصوصه السردية المدبَّجةِ بلسان موليير. روائي طبَّقت شهرتُه الآفاق دون أن ينتبه إليه أبناء مدينته

إلى زمن سينما كاميرا، «الزمن الضائع»…
.سينما كاميرا، إنهما الكلمتان اللتان اختارهُما المالكُ لتسمية قاعة السينما التي افتتحها للتو، القاعة الأولى التي فتحت أبوابها في سطات آنذاك، والتي ظلت كذلك لردح طويل من الزمن. سينما كاميرا، كلمتان كانتا تُعبران بالفعل في ذاك الزمن عن الجِدَّة في أبهى صورها، عن الانتعاش، وعن السحر الذي كانتا تنطويان عليه.
في سينما كاميرا، لم يكن يهمنا أن تتسرب، خلال موسم الأمطار، بضع قطرات خبيثة عبر شقوق سقف السينما القصديري، كما لم نكن نعبأ بالأصوات المتوالية لبذور البطيخ [الزريعة] حين تناوُلها من قبل المتفرجين، والتي كانت تتناهى إلى الأسماع أثناء عرض الفيلم، ثم إننا لم نكن نبالي بتعليقات المتفرجين على ما يجري داخل القاعة. وحدها عبارة «لنذهب إلى سينما كاميرا» كان لها وقع السحر علينا.
بَيْد أنه لم يكن لها الوقعُ السحريُّ ذاتُه على نفْسِ طفلٍ ينحدر من أسرة غنية، طفلٍ خجولٍ، لا ينتمي إلى أية عصابة من عصابات الأطفال، طفلٍ كان أول اتصال له مع هذا العالم موسوما بطابع العنف. قبل ولوجه القاعة، اقتنى تذكرته الرخيصة الثمن الخاصة بالمقاعد الأمامية. مقاعد كانت عبارة عن ثلاثة صفوف من الكراسي البسيطة المثبتة على الأرض، والتي كانت مخصصة بطبيعتها للأطفال. جلس في طرف الصف الثالث بالقرب من أحد منافذ الإغاثة التي تؤدي إلى الحديقة البلدية. فجأة، وعلى الرغم من وجود مقاعد شاغرة في الصف الأمامي، رأى صبيا يكبره سنا يقف أمامه، ويأمره بصوت عدائي ومهين:
– هيا، انهض، ارفع…عن هذا المقعد
وبدلاً من أن يرفع ما طُلب منه، رفع الطفلُ وجهَه، وهو مُندهِشٌ، صَوبَ الصبي الذي كان يهاجمه بدون أي سبب. كان يبدو من ثيابه الرثة أنه ينحدر من الأحياء الفقيرة، كما أن بشرَتَهُ كانت تكسوها طبقةٌ سميكة من القذارة. ومن نظراته، كانت تنبعت نارُ حقدٍ تجاه الطفل الغني الذي كان يرتدي ملابس أنيقة ويجلس بعيدا عن أقرانه.
-لماذا…؟ يُجيب الطفل الغني مستغربا.
كان الطفل يعلم أنه كان ينبغي عليه أن يمتثل للأمر المُوجَّه إليه، وأن لا فائدة تُرجى من أي نقاش مع الصبي. تَلقى ضربة من الركبة على حين غفلة وسط بطنه جَعلتْه ينكمش على ذاته ويحبس أنفاسه. أمسكه المهاجم من أعلى قميصه، وألقى به أرضا وجلس مكانه. ولِحسن حظه، فقد كان يتابع المشهدَ عن كثبٍ رجلٌ كبيرٌ في السن، تائهٌ وسط هؤلاء الأطفال المزعجين والمشاكسين، اتجه هذا الأخير صوبه لمساعدته على النهوض، ثم قاده نحو منفذ الطوارئ الذي يُطل على الحديقة. وعندما وجد الطفل نفسه في الهواء الطلق، أخذ نفسا عميقا، لحظتها بدا له الهواء الذي ملأ صدره الضيق أكثر سحراً من أي فيلم في العالم.
حينئذ، أقسم الطفل الذي ينتمي إلى الأسرة الغنية على ألا يأتي بمفرده في المرة القادمة التي سيعود فيها إلى سينما كاميرا، بل سيحمل معه سِكِّينا مطويّا.



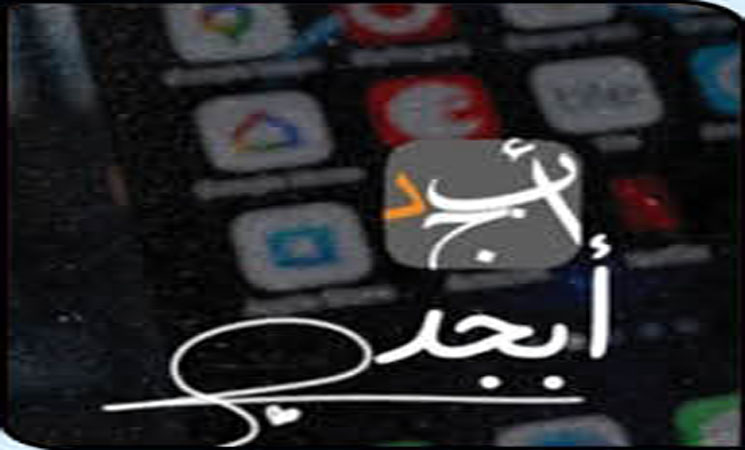



اترك تعليقاً